أولاً: قبسات من شمس تركيا التي لا تغيب
منذ أن ظهر فتح الله كولن وقطاره في حركة لا تهدأ، وفي تقدم لا يتوقف، حتى إنه في زحمة الأسفار نسي أن يتزوج، وسنكتفي هنا بتسجيل ما بدا لنا بأنه أهمّ المحطّات في حياة هذا الرجل العملاق:
- ولد محمد فتح الله كولن في 11 نوفمبر 1938 من أسرة متدينة تنتسب إلى آل البيت، في قرية كوروجُك التي تنتمي إلى محافظة “أرضروم “، وهي من أكثر المناطق تديّنًا ومحافظة في تركيا، فقد اعتنقت الإسلام مبكرًا على يد الرعيل الأول من الصحابة الكرام أيام الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان. وتقع هذه المحافظة في شمال شرق هضبة الأناضول.
- بدأت أمُّه “رفيعة هانِم” بتعليمه القرآن وهو ما زال في السنة الرابعة من عمره، وواصل دراسة القرآن حتى فهمه وأتم حفظه. أما أبوه رامز أفندي فقد علَّمه أسس علوم الشريعة وقواعد اللغتين العربية والفارسية، بحكم أن كثيرًا من المؤلّفات الإسلامية التراثية أُلفت بهاتين اللغتين، وأتقن بجانب هاتين اللغتين التركية، بل صار أحد أبلغ الناطقين بالتركية في هذا العصر.
- بدأ فتح الله يدرك مشاكل المسلمين من خلال مجالس والده التي كان يحضرها بعض الصلحاء من قريته ومنطقته، حيث كان أبوه إمامًا لأحد المساجد، وبدأ الابن يتعامل مع القضايا الإسلامية بروح المسؤولية، فكان شيخًا في إهاب طفل. وكان العمود الرئيسي في المبنى العلمي لكُولَن هو القراءة والتعلّم الذاتي، وبهذا تتلمذ على أيدي فطاحلة الأمّة كالغزالي وابن تيمية وابن القيّم وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من القدامى، وأمثالهم من المحْدَثين كحسَن البنّا وسيّد قطب وأبو الأعلى المودودي ومحمد إقبال وبديع الزمان النورسي وغيرهم؛ وقد أخذ من الجميع وترك، وبالتالي أوجد ذاته المستقلّة المتميزة. وبقدر اهتمامه بالعلوم التي هي غذاء العقل، فقد اهتمّ بمجالس الذكر التي هي غذاء الروح، ومن هذه المرحلة المبكرة بدأ اكتساب التوازن الشديد بين العقل والروح.
- حصل على الشهادة الابتدائية النظامية عن طريق التعلم عن بُعد، لكنه كان أكبر من المدارس الحكومية، حيث سعى للاستفادة ممن بقي من أهل العلم الشرعي؛ فكان دائم الطلب، دائب الحركة للبحث عن هؤلاء، وكان كثير التنقّل من واحد إلى آخر، نظرًا لأنه لم يجد مَن يروي عطشه أو يُشبع نهمه، فقد كان بحرًا يطلب المدد من سدود أو بحيرات، وكان شمسًا تطلب الضياء من كواكب. جَمَع في تحصيله العلمي بين العلوم الشرعية التقليدية، والآداب، وعلوم الاجتماع والنفس، وانفتح بعدها على كل علوم الغرب، بما فيها العلوم المادية كالفيزياء والكيمياء والفلك.
- أثناء رحلة الطلب المعرفي تعَرَّف في طريق قطاره على “رسائل النور” سنة 1957، وكان عمره 19 سنة، وهي لمجدّد تركيا قبل كولن: بديع الزمان سعيد النورسي. كانت هذه الرسائل قناديل من النور بَهَرتْه وسحرتْ لُبَّه ووجد فيها ضالّته، حيث أشبعت نهمه، وأروت ظمأه، ولذلك أحبّ بديع الزمان حبًّا جَمًّا، وتلْمَذَ نفسَه عليه حتى صار أحد أنجب تلاميذه رغم أنه لم يلتقِ به وجهًا لوجه أبدًا، بل وتفوَّق على مَن تتلمذوا عليه مباشرة في استلهام فكره وتطويره ومَأْسَسَتِه في مشاريع تبني الإنسان وتعمر الأرض.
- بعد محاولات عدّة استطاع الحصول على وظيفة رسْمية، كإمام لمسجد، وكان قدَرُه قد دفَعه إلى مدينة “أَدِرْنَة” التي تقع في القسم الأوربي من تركيا (تِرَاقْيا الشّرقية). وهناك تعَرَّض لابتلاءات كثيرة، لكنه استعصم من غوايات الشيطان بالاستمساك بأمر الله وحبْله المتين، فنجاه الله كما نجى يوسف u من امرأة العزيز، وأنْجاه كما أنجى إبراهيم u من النار، لكنها هنا نار الشهوة والغواية المتحالفتين مع الشيطان.
- أثناء عمله كإمام في أدرنة طُلب لأداء الخدمة العسكرية في أنقرة وإسكَنْدرُون، وعندما انتهى منها عاد إلى أَدِرْنَة مرّة ثانية، وبقي فيها فترة، وعندما اتّسع تأثيره وكثر معارفه؛ اشتد عليه التضييق، فطَلب مِن بعض معارفه في الإدارة الدينية في أنقرة مساعدته للانتقال مِن أدرنة.
- انتقل عمله إلى مدينة إزمير سنة 1966 التي تقع في جنوب غرب تركيا، وتطلّ على البحر إيجه المتوسط، وهي أهم المصايف الجاذبة للسياحة الخارجية والداخلية، ولذلك تكاد أن تكون أكثر المدن التركية تغرّبًا. وبهذا أضافت هذه المدينة بعدًا جديدًا إلى طاقة التحدي التي امتلأ بها كولن، كحال حسَن البنّا مع مدينة الإسماعيلية في مصر.
- عُيّن مديرًا لمدرسة دينية تابعة لأحد المساجد في إِزْمِير، وهي تتبع الحكومة رسميًّا، لكن تمويلها كان يأتي من جمْعية خيرية شكَّلها الأهالي لهذا الغرض، ومِن هنا التَفَت إلى أهمّية الأهالي في تمويل مشاريع الخدمة التي أسّسها فيما بعد.
- بدأ يتحرك في إِزْمِير على أكثر من صعيد، حيث كان يخطب، ويؤمّ، ويعظ، وأسَّسَ في تلك الأثناء جمعية “الانبعاث”، لكنه سرعان ما عاد وحَلَّها، لما رأى عدم انسجام مؤسّسيها، وعدم وضوح الغايات من إيجادها، وبالتأكيد أنه استفاد من هذا الدرس السلبي بطريقة إيجابية.
- تولى جمع التبرّعات من أصدقائه ومعارفه التجّار، من أجل بناء أول ثانوية للأئمّة والخطباء في إِزْمير، وبناء مقرّ للمعهد الإسلامي للتّعليم العالي التابع لجامعة إِزْمِير، والذي كان مبناه متهالكًا، وبذلك ذاع صيته، وزاد ألقُه، ولاسيما وسط طلاّب وأساتذة جامعة إِزْمِير.
- ذهب للحج عام 1968، وكانت عودته من مكّة إلى أنقرة، فدعي هو ومفتي إِزْمِير لزيارة بعض البيوت التي أعدّها طلاب النور لسكن الطلاب، وهناك أُعجب المفتي بما رأى من أنشطة دينية واجتماعية للطلاب، فأخبر كُولَن أنّه يريد مثل ذلك في إِزْمِير، وهنا انطلقت شمسُ فتح الله لتُنير الكثير من الدروب المظلمة. وبدأ في تلك الأثناء بإقامة المخيّمات الصيفية للطلاب في إِزْمِير وضواحيها.
- تأثّر به في إِزْمِير تلاميذ كثيرون من طلبة الجامعة والتجار، ويبدو كأنه بدأ معهم عملاً منظّمًا منذ عام 1971، وهو العام الذي تعرّض فيه للاعتقال، بعد الإنذار الذي وجّهه الجيش للحكومة، بحجّة وجود محاولات من داخلها وخارجها للانتقاص من العلمانية الأتاتوركية.
- قام في إِزْمِير بحمْلة نشطة لبناء عدد من المساكن الطلابية، وانتقل بعدها إلى إيجاد معاهد الإعداد للجامعة، ولما صارت مخرجات هذه المساكن والمعاهد من أفضل الكوادر الطلابية، فقد توسّعت في أنحاء تركيا خلال سنوات، حتى وصلت إلى كل الأطراف، فضلاً عن إسطنبول وأنقرة.
- وكان منذ عام 1970 قد بدأ بتشكيل مخيّمات صَيفية للطلاب، بالتعاون مع بعض مَن تأثر به وأحبّه وآمن بأفكاره وطريقته في إصلاح الشباب، وانتقلت هذه العدوى الطيبة إلى تركيا كلّها فيما بعد.
- أصبح خلال هذه الفترة واعظًا متجوّلاً في كل مناطق جنوب غرب تركيا، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى، وألقى خلالها آلاف الدروس العامة والخاصة، والمحاضرات، والمواعظ، وخطب الجمعة.
- وفي الفترة من 1970 إلى 1980 كان نشاطه قد وصل إلى الذروة، وكانت التيارات الإسلامية ذات الاتجاه السياسي نشيطة، إضافة إلى وجود عوامل أخرى أدّت بقائد الجيش كَنْعان إِيفْرِين إلى قيادة انقلاب عسكري على الحكومة الديمقراطية، وصار فتح الله كولن أحد المطلوبين للقبْض عليهم.
- في الوقت الذي كان فتح الله مطاردًا، قام بعض تلاميذه ببناء أوّل مدرسة نموذجية للتعليم الأساسي سنة 1981، وهي مدرسة الفاتح، ثم توالت سُحُبُ مدارس الخدمة لتُمطر في كل الأصقاع. وانتشرت في كل مدن تركيا الرحيبة أشعّة شمس كولن مبدّدةً ظلمات الجهل والتخلّف والتعصب.
- ظل كولن متخفيًا من عام 1980 إلى 1986، وهذا منحه تفرّغًا للتركيز على بناء تلاميذه بناء فولاذيًّا، ليكونوا أهلاً لتحمل المسؤولية، فكانوا لها أهلاً، حيث كفوا ووفوا.
- عندما وصل تُورغُوتْ أُوزَال إلى السلطة بعد عودة الديمقراطية سنة 1982، حدث انفراج للحرّيات في تركيا، ولاسيما في ما يرتبط بالأنشطة الإسلامية؛ فتصاعدت وتيرة عمل فتح الله وتلاميذه الذين صاروا يُعرفون بتيّار “الخدمة”، وظهروا في أعمالهم منظّمين، رغم نفيهم لكونهم تنظيمًا من أي نوع، وإصرارهم على أنهم أصحاب خدمة ممن أحبّوا هذا الدين وتأثّروا بكُولَن، مسخّرين طاقاتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة وطنهم وأمّتهم.
- بدأ كولن الوعظ في إسطنبول منذ عام 1977، لكنه ظل ينطلق في كافة مناشطه وتحركاته من مدينة إِزْمير، التي طلعت منها “شمسه” رغم أنها تقع في “الغرب”، وهذه من عجائب فتح الله وكراماته. مع سنة 1985 بدأ يتنقّل ما بين إزْمِير وإسطنبول، وفي عام 1996 استقر نهائيًا في إسطنبول.
- منذ أن وطئت قدماه أرض إسطنبول -عاصمة المسلمين طيلة قرون- بدأ فتح الله حملة واسعة لزيارة الصحف والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الثقافة والإعلام والفن والرياضة، ثم دعا الجميع إلى موائد الطعام في بيوت تلاميذه “أبناء الخدمة”، فتقابل فيها المتخاصمون والمتنازعون لأوّل مرة وجهًا لوجه، واكتشفوا بمساعدة كولن أن المسافة بينهم ليست بذلك البُعد الشاسع الذي كانت تبدو عليه من قبل.
- أنشأ عام 1994 “وَقْف الصحفيين والكُتَّاب” الذي أصبح مؤسسة عملاقة أقامت عشرات الفعاليات داخل وخارج تركيا حول الحوار بين المثقفين والمفكرين والأديان والقوميات والمذاهب والطوائف، وتوزعت بين مؤتمرات وندوات وحوارات ومحاضرات، شارك فيها نجوم الفكر والثقافة والأدب والفنّ والرياضة من بلدان إسلامية وغربية كثيرة. ويتبع هذا الوقف عدد من وسائل الإعلام، ولاسيما المجلات الثّقافية والفكرية، إضافة إلى تسعة منتديات ضخمة محلّية ودولية، صارت أنشطة بعضها ملء سمع الدنيا وبصرها.
- عندما وقع الانقلاب العسكري المبطن ضدّ الحكومة المنتخبة التي كان يقودها زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان عام 1997، هاجر فتح الله إلى أمريكا وأقام فيها بضعة أشهر للعلاج، وعندما انقشعت العاصفة عاد إلى تركيا ليواصل دوره في قيادة تيّار الخدمة الذي أصبح أحد أهمّ أسس النهضة التركية المعاصرة ولاسيما المنتظرة منها؛ إذ يمتلك هذا التيار مئات المدارس النموذجية وأكثر من خمس عشرة جامعة، وعشرات الصحف والمجلات والدوريات المختلفة، ومئات المدن والبيوت السكنية للطلاب، وتسع قنوات فضائية، وعشرات المواقع الإلكترونية التي تتحدّث بـ 22 لغة عالمية، وأقسام للترجمة إلى أهمّ لغات العالم الحية (42 لغة).
- وبسبب وجود مخاطر على حياة كولن من عدد من الأمراض القاتلة التي يعاني منها، ومن بعض الجهات الخفية في تركيا التي تستهدف اغتياله لإحداث فتنة داخلية، فقد هاجر في 21 مارس 1999 إلى الولايات المتّحدة الأمريكية، وهو منذ ذلك العام مقيم في ولاية بنسلْفانْيا في مخيّم على قمّة جبل تحيط به غابة، يمارس الكتابة وتعليم تلاميذه علوم القرآن، رغم منع الأطبّاء له من ذلك.
- حصل عام 2008 على المركز الأول بين أكبر مائة شخصية علمية هي الأكثر تأثيرًا في ذلك العام على مستوى العالم، وذلك في استفتاء قامت به مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الذائعة الصيت في الأوساط الأكاديمية، بالتعاون مع مجلة “بروسبيكت” البريطانية المشهورة.
- أنشأت له عدة جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا كراسي باسمه، ومراكز علمية متخصصة باسمه كذلك، وأقيمت عنه وعن تجربته عشرات المؤتمرات والندوات والورش النقاشية، إضافة إلى حوالي مائتَي رسالة أكاديمية أعدّت أو تعد عنه وعن جوانب متعددة من خبراته وتجاربه، ولاسيما في دائرة التعليم والتربية والعمل الإعلامي والاجتماعي.
- تعرض للاعتقال عدة مرات، وحوكم في بعضها، لكن براءته ثبتت في كل مرة من التهم المنسوبة إليه.
- ترك فتح الله آثارًا ضخمة، توزّعت بين الآلاف من شرائط الكاسيت وشرائط الفيديو التي احتوت على كثير من خطبه ومواعظه ودروسه ومحاضراته، وبين الكتب التي وصلت إلى خمسة وستين كتابًا، تُرجم بعضُها إلى أكثر من أربعين لغة، منها الإنجليزية والبلغارية والألبانية والأندونيسية والروسية والكُوريّة، وقد تُرجم إلى العربية خمسة عشر كتابًا من كتبه حتى الآن.
ثانيًا: تدابيرُ القدَر في حياة خادمِ المسلمين الأَبَرِّ
لا يختلف عاقلان في أن الأنبياء المرسلين هم خير مَن اصطفتهم السماء وأفضل مَن أنْجبتهم النّساء، وأعظم من سطعت عليهم الشمس، وأتقى من انتسبوا إلى آدم وحواء؛ ذلك أن الله اختارهم من أَنْفس معادن البشر، ومن أنقى طبائع الناس، وبجانب ذلك فقد أدَّبهم فأحسن تأديبهم وفْق المنهج السببِيّ، رغم قدرته على أن يقول للشيء كن فيكون.
ومن ذلك اصطفاء الله لرسوله محمد r الذي قال عن نفسه: «أنا خيارٌ من خيار من خيار»، ورعايته تعالى له في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم تتبعه بالتأديب والرعاية منذ ولادته إلى مبعثه r كما قال: «أدّبني ربي فأحسن تأديبِي».
لقد هيأ الله ظروفًا عديدة، لإعداد الرسول r وتهيئته لحمل الرسالة، عَبْر تزكيته بالحوادث، وتربيته بالمواقف، حتى يسْمو إلى القمّة السامقة التي لم يصلها بشَر قط، ومن ذلك ولادته في أسرة شريفة لكنّها غير ثريّة وغير متسلطة، وموت أبيه وهو ما زال في بطن أمه، ووفاة أمّه في طفولته ليرعاه جدُّه، ثم فَقْده لجده وانتقاله للعيش في كنف عمّه مع أبنائه، ثم ممارسته للرعي ووقاية الله له من نزوات الشباب ونزغات الشيطان، ونشأته في بيئة صحراوية في الجغرافيا والمناخ وفي الثقافة والعلم، مع قدْر من الغنى في الحرية والقيم الأخلاقية كالكرَم والشجاعة، ونجدة الملهوف، والصدق، والأمانة، والوفاء، إضافة إلى ثراء بالغ في الفصاحة والبلاغة والبيان، وكذا في الاعتداد بالذات.
كل ذلك لا شك أنه ترك بصماته وآثاره على شخصية المصطفى r، فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
ولما كان العلماء والدعاة والمصلحون والمفكرون هم ورَثة الأنبياء، فقد منحهم الله حظًّا من هذه الرعاية وذلك الإعدادِ، ومِن هؤلاء فتح الله كولن الذي جمع الله في شخصيته العلم والفكر والدعوة والإصلاح.
ومن يقرأ حياة هذا العملاق، سيلاحظ عناية الله به، فقد “دفعته” تدابير القدر نحو الكمال المقدر له و”رفعته” إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى في: الفاعلية الدعوية، والتجديد الفكري، والإصلاح الاجتماعي، وصناعة التمكين الحضاري.
هذا الإعداد الربّاني، والتهيئة الإلهية، والعناية السماوية، قد لا يفهمها المحبوسون في قوالب المادة، والحبيسون في المعادلات المتحركة في إطار عالم الشهادة، دون أدنى التفاتة إلى عالم الغيب، لكن ذلك لا يلغي وجودها وتأثيرها.
ويمكن إيضاح هذه العناية السماوية بفتح الله كولن، وإعداده للقيام بما قام به فعلاً من دور كبير في إشاعة النور، وتوزيع الخدمة، وتربية قوافل من الأجيال، وصياغة كتائب من الأفكار، تساهم اليوم في صناعة الحياة، وصياغة التاريخ، وذلك من خلال سبع نقاط على النحو التالي:
1-فتح الله كولن وتطابق الاسم مع المسمى
من المعلوم أن الأسماء في تركيا مركبة، بمعنى أن الشخص يكون له اسمان، واسم هذا العملاق وحده محمد فتح الله، ولأنه من عائلة علم وتدين، فيبدو أن أباه عندما أطلق عليه هذا الاسم، كان يقصد -أو على الأقل- يتمنى أن يكون ابنه على قدر هذا الاسم.
- محمد: اسم أعظم رجل أنجبته البشرية في كل عصورها، فأخرجها من غياهب الجهل إلى أنوار العلم، ومن دياجير الظلم والضلال والعبودية إلى شموس العدل والهداية والحرية.
ولا بد أن والد هذا الرجل العملاق كان يضع ابنه بهذا الاسم -ولو أمنية- في المسيرة التي يقودها محمد بن عبد الله r، كي يكون وفيًّا له، وسائرًا في صراطه المستقيم، وداعيًا إلى دينه العظيم ومستظلاًّ تحت لوائه الرحيم، فلم يخب رجاء الوالد!.
- وسماه فتح الله، فقد أغلقت كل الأبواب والنوافذ أمام هذا الدين في تركيا عندما ولد هذا العملاق، فتقزّمت تركيا، فهي كالعرب لا عزّ لهم جميعًا إلا بهذا الدين، وكأن الوالد دعا الله بصدق، وعمل على تحقيق هذه الدعوة بجدٍّ من خلال تربية ابنه حتى يكون فتحًا لهذا الدين، فكان كذلك بتوفيق الله. فها هي تركيا تعود اليوم إلى أحضان الإسلام، كأفضل ما تكون العودة، من خلال الأعمال لا الأقوال، ومن خلال الشعائر لا الشعارات، ومن خلال المضامين لا العناوين، عودةً تتجاوز المظهر إلى الجوهر، والقشور إلى اللباب، والاسم إلى المسمى.
- كُولن: وتكتب كاف وفوقها شرطة “گُولَنْ”، فتُنطق بالتركية جُولن وتعني الضحّاك أو البسَّام. وهنا لم يكن له نصيب وافر من هذا الاسم كما في اسمه الخاص بشخصه؛ لأن أكثر صفة عُرفت عنه هي البكاء. فرغم عقلانية خطابه إلا أنه صاحب قلب حيّ وفؤاد يقِظ، وذو كبِدٍ يتفتّت ألَمًا كلّما شاهد أو تذكّر ما أصاب أمّته، وعندما يتحدّث عن الآخرة كأنه يراها رأْي العين لقوّة إيمانه، ولذلك فإنه يبكي في مواعظه ويُبكي. وقد عُرف بين أتباعه بالبكَّاء -رغم أن اسمه الضَّحاك-، حتى أن أحدهم لقَّبه بـ”الناي”؛ لأنه حزين ومحزن، ويمكن للناظر في وجهه أن يرى هذا الحزن بدون أدنى مشقّة. يقول في إحدى مواعظه: “كيف أخلدُ إلى الراحة والعالم الإسلامي يعيش حالة اغتراب ومعاناة؟! لقد حرّمتُ على نفسي الضحِك مثل صلاح الدين الأيوبي.. ما أردتُ أن أفكّر إلاّ في هموم أمّة محمد r.. ودعائي الدائم هو: “اللهم اجعلني حليمًا سليمًا أوّاهًا منيبًا”.. فاخترتُ أن أكون من أهل الأنين دومًا، لأنّ وضع العالم الإسلامي وضع يُرثى له. نعم اخترتُ الأنين والنواح”.
2-اقتباس أشعّة الضياء من أسماء الأقارب
اتسم فتح الله بالحساسية الشديدة، فقد كان لَمَّاحًا، شديد النباهة والانتباه، دائم الملاحظة واليقظة، دائب التفكير والتأمل، قوي الحرص على الغربلة والاقتباس والاستفادة من كل من يحيط به من أقارب وأباعد.
ولا بد أنه استفاد من أسرته ومن البيئة التي عاش فيها سنوات عمره الأولى الكثير من الفوائد، واقتبس الضياء حتى من أسماء هؤلاء الأقارب نتيجة شدة جاذبية التربّي والتزكّي.
لقد كان اسم جده “شامل”، ولا بد أن هذا الاسم ساهم في تركيز انتباهه على شمول الإسلام واستغراق القرآن لشتّى نواحي الحياة، فلم يكن من الذين جعلوا القرآن عِضين، ولا من الذين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، بل أثبتت الأيام والسنوات أنه من الذين أدركوا أن أنوار القرآن لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من زوايا الحياة إلا وغمرتها بأشعّتها، كاشفةً لأغوارها وأعماقها.
وتعلّم من جدّته “مؤنسة هانم” كيف يأنس بالله كمؤمن لا يغيب عنه إلهه ومليكه وحبيبه في أي ظرف؛ لأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ولذلك لم يشعر بالغربة أو الوحدة ولم تتسلل إليه الوحشة أو اليأس في أسوأ الظروف، وذلك عندما كانت عواصف التغريب وزوابع الإلحاد تجتاح كل جميل من قيم تركيا الوطنية والحضارية، وظل متفائلاً على الدوام لشعوره بمعيّة الله، وأُنسه بمناجاته، وتذوّقه لحلاوة الإيمان به، وثقته بنصره وتأييده وتمكينه لمن يؤمنون به ويحبّونه ويخدمون خَلْقه ودينه.
وتعلَّم من أمّه “رفيعة هانم” كيف تُبنى الرفعة بدون كبْر، وكيف تُجْنى العزّة بدون غطرسة، من خلال الترفع على قيم الجاهلية المنحرفة، مع التذلل بين أيدي المسلمين، ولو كانوا من معتنقي هذه الأفكار العوراء، فإنهم في الأصل ضحاياها، وفي كل الأحوال فإن البُغض يكون للأفكار لا للأشخاص.
أما والده “رامِز أَفَنْدي” فقد تعلَّم من اسمه كيف يرمز إلى حقائق الإسلام كقيم حضارية ووطنية وإنسانية، وكيف يحقّق الهدَف دون أن يستفز العلمانية أو يقع تحت طائل قوانينها العمياء.
وكان له عمٌّ اسمه “أنْوَر أَفَنْدي” وقد اقتبس منه “النور”، وربما حبَّبَه هذا الاسم في تيار “النور” -الذي أسسه وكان يقوده في تلك الأثناء بديع الزمان النورسي-، وربما دفعه اسم عمّه إلى المزيد من العشق للنور والتلذذ برشْفِهِ والاستزادة منه، حيث ظل يسابق أهل “النور” في ذلك حتى صار “أَنْوَر” زمانه!
وكان له في مقتبل عمره شيخ يدعى “محمّد لُطْفِي”، ومن المحتمل جدًّا أن هذا الاسم المحبوب لديه كان أول ما لفت نظره إلى جمال اللطف وأهمّية التلطّف، مما دفعه فيما بعد لكي يجعل منه أساسًا من أسس منهجه في الدعوة والتربية والتعليم.
مما يجدر ذكره أن واقع الحال يقول إن هذه الأسماء استقرّت، مثل سائر المؤثرات، في العقل الباطن لكولن، فتأثّر بها في أعماقه الشعورية والفكرية، وصار يصدر عنها في تصرفاته، مما أعانه على طيّ الزمان والمكان تحت إبط عبقريته الفريدة.
3-القفز على “الزمان” والتوحد مع “المكان”
ظل ديدن العباقرة في كل زمان ومكان هو التعامل الفريد مع الزمان والمكان، وهذا ما ظهر في سيرة كولن في أوضح صورة، فقد فاق أقرانه، وكان ذلك سببًا في عدم مواصلته للدراسة في التعليم الرسمي النظامي، بجانب عوامل أخرى بالتأكيد. فعندما فُتحت أول مدرسة ابتدائية في قريته من قبل الحكومة لم يُسمح له بدخولها لصغر سنه، لكنه بسبب شغفه بالعلم وعشقه للدراسة، أصرّ على الانخراط فيها كمستمع، واستمر على هذا الحال لمدة ثلاث سنوات، وكانت المفاجأة التي صعقت أساتذته هي تفوقه على زملائه الرسميين والذين يفوقونه في السِّن، وكأنه كَرِه بعدها أن يعود إلى الوراء للدراسة الرسمية، فاكتفى بالمشاركة الحرة، وهو نوعٌ من التعليم غير النظامي، حيث أكمل الشهادة الابتدائية على هذا النحو مكتفيًا بها.
وانتقل بعدها -كما كان أثناءها- إلى التعلُّم الذاتي، وسبَق أقرانه بالدخول في وقت واحد في عدد من الجامعات غير التقليدية، بسبب قدرته الخارقة على استيعاب معارفها، وعطشه الشديد إلى المعرفة، وجوعِه المَسْغَبي إلى التربية، ثم قدْرته الهائلة على تشرُّب العلوم من سائر المنابع التي كانت تبدو لكثيرين كأنها متناقضة… إنها جامعات العلماء الموسوعيّين.
فقد ذهب إلى العلماء القريبين منه ونَهَلَ أفضل ما عندهم، وعكف على كتب كبار علماء الأمّة في العصور المُشْمسة، حيث اقتبس الضياء من كل من يملك منه نصيبًا، مهما كان اتجاهه الفكري ومذهبه الفقهي وفرقته الكلامية وطريقته الصوفية، ولم يتوقّف عند علماء الطوائف والتيارات الإسلامية، بل تجاوزهم إلى فلاسفة ومفكّري وأدباء الغرب، حيث اقتبس منهم بعض ما يشبع النَّهَم أو يروي الظمأ، من أطعمة الحكمة ورحيق الخبرة، فلم يهتم بهُوية النحل لكنه اهتم برشف العسل ما دام مُصَفّى.
ولما كانت تركيا من أعرق بلدان العالم، لكنها من أشدها تطرفًا في القفز إلى الحداثة إلى حد هضم الماضي ومحاكمة الأمس وجَلْد التاريخ، فقد نشأت علاقة وثيقة بين كولن والزمن بأبعاده الثلاثة، ففي المدُن العريقة والمساجد العتيقة تعلَّم أن الحاضر بدون عراقة الماضي وجذوره التليدة يصبح يبابًا وعدمًا، وفي أفضل الأحوال يصبح بنيانًا أُسّس على شفا جرفٍ هارٍ. ولهذا عمد إلى استجماع الزمن، فجعل الماضي أساسًا متينًا لمبنى الخدمة، وجعل الحاضر أداة للبناء ورافعةً للإطلالة على القادم واستشراف المستقبل، من خلال امتلاك أفكار الانطلاق، وتجهيز مواد التشكيل، وابتكار وسائل الصياغة وأدوات الضبط وفق مقاصد الإسلام ومصالح الأنام.
وكانت محاولات الانطلاق إلى الأمام قد بدأت في مدينة “أَدِرْنة” التي تقع في الشطر الأوربي من تركيا، وبالتحديد في تراقيا الشرقية، وتعلَّم منذ البداية مهارات النزول إلى المجتمع بكلّ ما فيه من معادن وإمكانات، ومن علل وموانع. ففي هذه المدينة العريقة ثم مدينة إزْمير بدأ كولن “تنبيه” الناس من غفلتهم من داخل “المقاهي”، كما فعل الإمام حسَن البنّا في مدينة الإسماعيلية في مصر في نهاية العقد الثالث من القرن الميلادي المنصرم.
وفي هذه المدينة الأوربية تولى كولن إمامة مسجد كان له أثر بالغ في حياته، وكان يسمّى مسجد “الشرفات الثلاث”، فكان بالنسبة له محطّة عظيمة للتأمل ولمراكمة المعرفة ومزاولة التزكّي والترقّي الروحي. ولا بد أنه في هذه المحطة الضخمة لممارسة التعلم الذاتي، قد نظر إلى آيات الله الشاملة من هذا المسجد، مسجد “الشرفات الثلاث” فانطبق مسمّى المسجد على اسمه -بالنسبة لكولن-: ففي الشرفة الأولى كان “يتدبّر” آيات القرآن، وفي الشرفة الثانية صار “يتفكّر” في آيات الكون، وفي الشرفة الثالثة ظل “يتبصّر” في آيات الأنفس.
وعبر روافع التدبر والتفكر والتبصر ارتقى كولن في الآفاق، وامتلك شمس البصيرة، لكن هذه الشمس لم “تُشرق” أشعّتها الساطعة في أَدِرْنَة وإنما في مدينة إِزْمِير التي تقع في “غرب” تركيا!.
4-“شروق” شمس كولن من “غرب” تركيا
من تدابير القدَر التي منحت كُولَن بعض الكرامات والغرائب، أن تُشرق شمسُه -التي صارت شمسًا لوطنه وأمّته- من غرب تركيا، وبالتحديد في مدينة إِزْمِير التي تطلّ على شاطئ البحر المتوسط، وهي مدينة سياحية يرتادها ملايين الغربيين سنويًّا للاصطياف، ولهذا وغيره صارت أكثر المدن التركية تغرّبًا وتحللاً وفناءً في الغرب. وتأبى الأقدار إلا أن تبدأ دعوة الخدمة بوضع أسسها في هذه المدينة الغربية جغرافيًّا وثقافيًّا.
وفي هذه المدينة (إِزْمِير) وصل كولن أول مرة -في مارس 1966- إلى سُوق الكسْتناء وسط المدينة والذي يسمّى بالتركية “كَسْتَانة بَزَارِي”، وفي القلب من هذا السوق توجد مدرسة للتعليم الديني تشرف عليها إدارة رئاسة الشؤون الدينية وبتمويل من بعض الخيريّين. ومن هنا بدأت علاقة كُولَن بالتعليم، والتفاتته إلى دور رجال الخير في تبنّي التعليم وبنائه. وبفضل هذه الالتفاتة، مع تقديره البالغ للتعليم، تنتصب الآن مئات المدارس العملاقة في قلب المدن الكبرى في تركيا، ثم في وسط آسيا، ثم في أوربا وأمريكا، ثم في الوطن العربي وأكثر بلدان العالم الأخرى؛ حيث نجحت هذه المدارس في صناعة أعداد غير يسيرة من الرجال، وتفوّقت في استخلاص دماء جديدة، نجحت في ضخها إلى أوصال كثير من البلدان ولاسيما الإسلامية، حيث صارت شجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها.
وفي جامع “سوق الكستناء”، بدأ بالتجارة الرابحة مع الله، فقد كان يتْبع هذا المسجدَ مدرسةٌ، صار فتح الله مديرًا لها، ويتبعه أيضًا مسكن للطلبة، سرعان ما حوَّله إلى محضن دافئ للتربية وملجأ آمن، وَضَعَ فيه من استخلصه من بين براثن التيه والضياع.
وهكذا بدأ عملية النهوض نحو امتلاك المستقبل مستثمرًا كل ملكاته وإمكانياته. ففي المدرسة يُعلِّم ويُفَهِّم، وفي المسجد يدعو ويعِظ، وفي المسكن يزكّي ويربّي.
الجدير بالذكر أن هذه المدرسة كانت لها جمعية خيرية تنفق وتُشرف عليها، ومن هنا بدأ تركيز كولن على إيجاد واقفين لأنشطته الخيرية والتربوية والدعوية والثقافية التي أشرقت أشعّتها من هذه المدينة.
وبعد أن ثبَّت قدميه في هذا المسجد وتوابعه وأوجد له جذورًا قويّة فيه، بدأ بالانطلاق خارجه؛ لإطفاء حرائق التغريب التي اشتعلت في هذه المدينة أكثر من غيرها، وأشعلت غَيْرَة كولن على أهله ووطنه ودينه، وأنضجت طاقاته المخبوءة وفجَّرت مواهبه الكامنة، وأطلقت فاعلياته في العمَل الإيجابي الهادئ.
وكان أول نشاط عملي له هو جمع التبرّعات لبناء ثانوية للأئمة والخطباء في هذه المدينة، ولبناء مقرّ للمعهد الإسلامي للتعليم العالي التابع لجامعة إِزْمِير والذي تقادم حتى كاد أن يسجد على رؤوس الطلاب، من شدّة الإهمال والإذلال المقصودين.
هذه التجربة الثرية لا بدّ أنه تعلم منها أمورًا كثيرة وعظيمة، كعادته دومًا، ومنها:
- أهمّية العمل من داخل مؤسسات وإمكانات النظام العلماني.
- الاهتمام بالتُّجّار كمحرّك ضروري لهذه المناشط، وتفعيل الخطاب الموجَّه إليهم.
- المزاوجة في هذا الخطاب بين الإقناع العقلي والإمتاع الوجداني، باستفزاز الأفكار واستجاشة العواطف، ثم استثارة النوازع الوطَنية والقومية ذات الصلة بالتشرّف بالإسلام وخدمته، وتصوير هذه الخدمة كتيجان على رؤوس مَن يقومون بها.
- دفع المتبرّعين بالمال أو بالجهد إلى إدارة مناشطهم بأنفسهم، حتى يوقنوا أنّها مشاريعهم وحتى لا ينجح الشيطان في تسريب أيّ ذرة من الشك في الداعية.
وفي إزمير أيضًا أسَّس جمعية سمّاها “جمعية الانبعاث” كمحضن قانوني لأنشطته هو وزملاؤه وتلاميذه الذين كان بعضهم طلابًا في جامعة إِزْمِير. ورغم قيامه بحلِّها بعد مدة وجيزة؛ نتيجة عدم الانسجام بين أعضائها، وبسبب عدم الاتّفاق على رؤية كلِّية موحدة، إلا أنه -كعادته- لا بد أنه قد تعلَّم منها دروسًا بليغة، مثل:
- الإصرار على المضيّ الوئيد في مشروع الإقلاع الحضاري، ولاحِظْ معي اسم الجمعية أيّها القارئ الكريم، فقد بدأ كولن منذ الآن “ينبعث” كالعنقاء من بين رماد هذه المدينة المتغرّبة، ومثَّلت هذه الجمعية مرحلة “الفجر الكاذب” في مشروعه الحضاري، لكنه كان بشارة اقتراب “الفجر الصادق”.
- ضرورة العمل الحثيث داخل المجتمع من أجل تقريب الأفكار والرؤى وتأليف الأحاسيس والمشاعر، ولذلك حاول إيجاد قواسم مشتركة بين الأفكار والأفعال الاجتماعية، بحيث تصير العقول المتقاربة والقلوب المؤتلفة جناحي الإقلاع في آفاق السموّ الحضاري المنشود.
- التركيز على الفكر الخلاّق والعمل الفعَّال، فقد تعَلَّم من هذه التجربة أن “الكلام” وحده لا يبني عقلاً ولا يقدّم خدمة، حيث لا يُشبع الكلام من جوع ولا يداوي من سقم، ولا يغني من حاجة.
وفي عام 1968م كان كولن مع مفتي إزمير في زيارة لمدينة أنقرة، فتلقّيا دعوة للزيارة من أحد بيوت السكن للطلاب الجامعيين، والذي كان يتبنّاه طلاب النور -وهم من أتباع بديع الزمان النورسي- ولما رأيا مدى إخلاص هؤلاء الطلاب في حبّ هذا الدين وتفانيهم في خدمته، أبدى المفتي انبهاره وطلب من كولن أن يتبنّى مثل هذا المسكن في إِزْمِير، وهو سيبحث عن مموّلين، وهنا بدأت علاقته القوية بهذا الميدان الخصب للتربية والتزكية والإرشاد، حيث سابق أهل “النور” حتى سبقهم وتفوَّق عليهم. وفي نفس الوقت زادت هذه التجربة من حسن ظنّه بالعاملين داخل النظام العلماني، بسبب حبّه لهذا المفتي، واجتهد دومًا في التنقيب عن هؤلاء وسط أركمة الانحراف والفساد، ودَأبَ على التعاون معهم في المشتركات التي تخدم الوطن والشعب والدين.
وبعد أن توثّقت علاقة كولن بالمساكن الطلابية بدأ بإقامة رحلات ومخيمات صيفية لهم وسط الأشجار والغابات في تركيا، وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى.
5-العيّش في كَنَفِ الشَّجَر والتتلْمُذ عليها
بدأ كولن منذ عام 1968م بإقامة مخيمات صيفيّة لتربية طلاّبه، وعادة ما كان يقيم هذه المخيمات في الجبال الغارقة بين الأشجار. وعندما اشتهر أمر هذا المخيّم وسط أهل هذه الدعوة، وتذوّقوا ثماره اليانعة، تولّى تجّار مِن محبّي الخدمة دعمه بقوّة، وسرعان ما بدأت هذه المناشط تتراكم كمُزْن مثقلة بالخير، ثم حملتها رياح الخدمة فأمطرت في كثير من أنحاء تركيا، وهكذا صار كولن كالمطر أينما وقع نفع.
وللعلاقة الودّية بين كولن والشجر، فإنه لعوامل عديدة عندما خرج من تركيا وأقام في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم منذ مارس 1999م، اختار الإقامة في قمّة جبَل وسط غابة من الشجر في ولاية بنْسلْفانيا، فلماذا الشجر؟ وما سرّ عشقه لها؟ وما هو تأثيرها عليه وهو الشخص الشديد الحساسية، السريع التعلم من كل أحد بل ومن كل شيء؟
من فهمي المتواضع لنفسيّة هذا الرجل العملاق، يبدو لي أنه تعلَّم منها الكرَم، واقتبس من طبيعتها العطاء، واستقى من ثباتها الشموخ أمام أعتى الرياح والأعاصير، واستمدّ الصبر على تقلّب الجوّ وعلى عوامل التعرية وتداعيات القحط والجفاف، وكذا على التعامل الجائر معها من قبل الناس، إذ يرمونها بالحجَر فترميهم بالثَّمر.
لقد صار دوحةً باسقة تتدفّق حيوية فـ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾(إِبْرَاهِيم:25)، وتمُدَّ الآخرين بـ”أوكسجين” الإيمان وإكسير الحياة، إضافة إلى أنضج الأفكار وأينع الثمار.
وبالمناسبة زرتُ السكن الذي كان يقيم فيه كولن، ويقع في الدور الخامس من مبنى مدرسة بإسطنبول، وشاهدتُ أكبر شرفة صادفتها في حياتي، وفيها أشجارٌ وأزهارٌ وورودٌ كثيرة تكفي لتزيين بستان كامل، إنه العشق لهذه الأشجار التي بينه وبينها قواسم مشتركة كثيرة، وكأنه مدينٌ لها بالكثير مما تعلَّمه، ومن ذلك الثبات، ولذلك يأبى أن يموت إلاّ واقفًا وهو في حالة من العطاء، فما زال يفكّر ويربّي، يُعلِّم ويكتب، رغم كبر سنه ومعاناته الشديدة من بضع أمراض قاتلة، ورغم منع الأطبّاء له من الكلام والكتابة وإجهاد نفسه بأيّ صورة.
ولا بد أنه اكتسب منها اللّين، فإن الثبات لا يعني الجمود لأنه قد يؤدّي إلى التيبُّس ومن ثم الانكسار، ولهذا تتمايل الشجر مع الرياح وتحني رؤوسها للعواصف حتى تمرّ، وهذا هو ديدن كولن وطبيعة دعوته.
وتشهد الأيام أنه امتلك قدرة هائلة على التفاعل مع الأحداث واستيعاب المتغيرات، والتكيف مع الواقع دون أن يُضيع البوصلة أو ينسى الأهداف، ولهذا نجح في الاستفادة من سائر الأحداث والحوادث.
6-التتلمذ على أيدي الأعمال والحوادث
في عام 1961م أدّى كولن في العاصمة أنقرة خدمة التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، وكان مسؤولوه قد عيّنوه مسؤولاً عن راديو اللاّسلكي، ومن المحتمل أن هذه التجربة ساهمت في لفت نظره إلى ضرورة اكتساب الخبرة اللاّزمة لإيصال صوته إلى قلوب الناس بدون لاسلكي. فكان له ذلك مع تحليه بالإخلاص والشفّافية الروحية، واهتمامه الخاص بوسائل الإعلام، كالراديو الذي امتلكت دعوته منه الكثير، إذ صار لها في كلّ محافظة قناة إذاعية.
وقد اشتهر ببكائه عند استماعه لسيرة الرسول r أو قراءته لحديثه. وبجانب عوامل كثيرة أوصلته إلى هذه المكانة المرموقة في التفاعل مع “الحديث” الشريف، لا بد أن إمامته لمسجد “دار الحديث” في أدِرْنَة سنة 1964م كانت عاملاً إضافيًا في ذلك.
وفي عام 1968م ضرب زلزال إقليم “كَدِيزْ” فهبَّت إزمير لجمع التبرّعات، وكان كولن أحَد الناشطين في حركة جمع التبرّعات، وذهب لتوزيعها بنفسه على المتضرّرين، ولا بد أن هذا الحادث أنضج البُعد الإغاثي في تيّار الخدمة، ومازال فكرةً في رأس كولن وهَمًّا في قلبه.
وفي مرحلة مخيّمات إِزْمِير استعار ذات يوم مع إخوانه حافلة من إدارة الإفتاء، وقادها بنفسه، لنقل الطلبة من مدينة بُوجَا إلى المخيّم، فتقلّب بها أو انقَلَبَت به. وجرى له حادث آخر عندما اشترى له إخوانه سيّارة لذات الغرض، إذ حاول أن يُشغِّل شريط القرآن، فانشغل عن المقود، وانقلبت السيارة به.
ومن طبيعة كولن الشديدة النباهة والحسّاسية، نستنتج أنه تعلَّم من هذين الحادثين قيَم التركيز والحرص الشديد والانتباه لسائر المتغيّرات، أثناء قيادته لقطار الدعوة حتى لا يسقط في هذا الأخدود، أو يتعثّر بهذا الحاجز، مما جعله شديد اليقَظة، دائم النهل من منابع الحكمة. وصار قائدًا حكيمًا ماهرًا، يعرف متى يسرع وأين يبطئ، متى يتحرّك وأين يتوقّف، وحرص بقوة على امتلاك خارطة للطريق، توضّح له معالمها وانحناءاتها والْتواءاتها. واستعان بأهل الدربة والخبرة والدراية حتى لا يقع في أفخاخ العلمانيين السلطويين أو في كمائن القانون السائد، فضلاً عن توَقّيه الشديد من الخروج عن سِكَّة “الدستور” والوقوع في وَهْدة “اللاّشرعية”.
وفي أغسطس 1977م بدأ كولن بالوعظ في إسطنبول، وكانت البداية في مسجد “يَنِي جامع” أي “الجامع الجديد”، وفي هذه الآونة كان قد توصّل إلى أن حلّ مشاكل الأمّة يكمن في إيجاد “الإنسان الجديد”، ولهذا ظلّ مهمومًا في سياق خبرته وسلسلة تجاربه بإيجاد الإكسير الذي يعيد للمسلم جِدّته وفاعليته، بحيث ينتقل من الأثرة إلى الإيثار، ومن طلب الحقّ إلى أداء الواجب، ومن غرور الشعور بالتشريف إلى حسّاسية المسؤولية عن التكليف.
الجدير بالذكر في هذا المقام أن كولن أقام بإزْمِير في كوخ صغير لا تزيد مساحته عن 2×2 متر مربع، بناه له أصحاب جمعية مدرسة سوق الكستناء، ومن هذا الكوخ الضيّق انطلقت مسيرته الواسعة نحو إعمار تركيا وإعادة الألَق إلى إنسانها المهترئ بفعل فرّ النهارات وكرّ الليالي.
7-تقدير الحرية في السجون وتقديسها
تُعرف قيمة النعمة عندما تُفقد، وتُعرف القيمُ بأضدادها، وكان كولن قد أُدخل السجن في 1971م، وهناك تعرَّف على أصناف من المسجونين. ورغم اشتراكهم في ابتلاء السجن، فقد كانوا شركاء متشاكسين، ولذلك أدرك كُولَن أهمّية الحوار للتّعايش، وتحوَّل الحوار بعدها عنده إلى مبدأ وقيمة بل إلى “استراتيجية” ضرورية لإيجاد مجتمع حضاري متمكن. فإذا كان استيعاب تحدّيات السجن غير ممكن بدون حوار، فكيف بابتلاءات الحرية؟!. فلا شك أنها أحوج إلى حوار، حتى لا يتحول التعدد من عنوان “للتعارف” إلى أداة “للتعارك”… وهكذا أدرك نفاسة “الحرّية” في سجن من سجون “العبودية”!
ولاحتواء السجون على أعداد من أصحاب المعادن النفيسة، ممن تعرّضوا للظلم، أو من الذين غَطَّت أتربة الظروف على معادنهم الثمينة وفطرهم الأصيلة، فقد اكتسب كولن في السجن ملكة النقد التي مكّنته من معرفة معادن “الرجال” وتمييزهم عن “الذكور”، ولهذا كان يُنَقِّب في جنبات السجن عن أصحاب المعادن الصلبة والعناصر الثمينة، حتى يمسح عنهم الغبار ويجلو عنهم الصدأ ويصطفيهم للخدمة.
وبسبب هذه الإيجابية الشديدة التي اتّسمت بها شخصية كُولَن، نجح خلال فترة وجيزة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وفي استثمار القوّة الذاتية لهذا الدين لتَمْتين علاقة المجتمع بدينه، والتمكين لقيم التطور والرقي الحضاري ذي الأسس الإسلامية والإنسانية.
ولهذا تبدلت طبيعة العلاقة بين كُولَن والشيوعيّين الذين كانوا أكثر من الهمّ على القلب في تركيا آنذاك، وبعد أن كانوا يحاصرونه داخل زنزانة ضيِّقة في إزْمِير، انتقل أبناؤه لمحاورتهم ليس في تركيا وحدها، بل ذهبوا إليهم في قلب دارهم في جمهوريات ما كان يسمّى بالاتحاد السوفْييتي التي تضمّ شعوبًا إسلامية عديدة، بما فيها روسيا المسيحية ذاتها.
لقد انتمى تلاميذ كُولَن إلى الخدمة التي نهلت من معين الإسلام، وتسلّحت بالقوّة الذاتية لهذا الدين العظيم، وتقوّى هؤلاء بكتائب الأفكار الفتّاكة والقابعة في معسكرات الكتب التي أبدعتها أنامل كولن الذَهبية، وهي كثيرة كما سيأتي في الموضوع الآتي.
ثالثًا: “كتائب” الأفكار في “كتب” فتح الله كُولن
صار من المعلوم أن الشيخ فتح الله كُولَن من أكثر علماء المسلمين المعاصرين تأثيرًا على الفكر الإسلامي الحاضر وعلى واقع المسلمين الراهن؛ لكونه مفكّرًا وداعية ومربيًّا، وأوجد تيّارًا باسقًا أصله ثابت وفرعه في السماء، أما فروعه وأوراقه وثماره وأفياؤه فقد امتدّت إلى كل بقاع الأرض.
إن هذا الجَمْع الْمُحْكم في شخصية كولن بين ثلاثية: المفكر والداعية والمربّي، والتفرّغ التام للقيام بهذه الأدوار، لدرجة أنه نسي نصيبه من الدنيا، ولم يذق من طعمها إلا الْمرارة والحرمان، ولم يمتلك من زينتها لا مالاً ولا بنون، هذا كلّه مكّنه من أن يكون خطيبًا ومحاضرًا ومحاورًا ومربيًا ومعلمًا وكاتبًا، حيث صار غزير الكتابة، كثير الخطابة، وترك من وراء ذلك كنزًا لا يقدّر بثمن، وثروة تطاول الزمن.
ومن ذلك تأليف قرابة السبعين كتابًا، يمثل كل “كتاب” منها “كتيبة” كاملة من الأفكار والمشاعر التي ساهمت في فتح العقول والقلوب التي لا يحصي عددها إلاّ الله.
ولو جُلنا في هذه الكتب لرأينا فيها دائرة معارف كبرى، ولوجدنا فيها زاد الألباب والأفئدة، بشمولها وتنوعها وعمقها وظلالها النديّة، وسنمُرُّ في هذه العجالة على عناوين كتب فتح الله المترجمة إلى العربية لنلتمس فيها فرادة الفكر وزاد الروح، أصالة المعاني وجمال المباني، تشويق العناوين وإشباع المضامين.
ومنذ البداية سيلحظ القارئ لكتابات كولن حضور الفخامة وعذوبة التعبير وسلاسة الصياغة، حيث يمتزج جمال المبنى بجلال المعنى، وتتضافران لصياغة أقوم الأفكار وأصدق المشاعر، ويمكن وصف هذه الكتابات بأنها “ترانيم روح وأشجان قلب” إذ سطّرها بنور عقله ودم قلبه، وبسبب جاذبيتها وشدة تأثيرها وقوّة إشعاعها وعمق ارتباطها الرباني؛ يمكن عدّها “أضواء قرآنية في سماء الوجدان” لأنه استمدها من صيدلية القرآن، فما مِن داء في هذا الواقع إلا ووجد له دواء ناجعًا وترْياقًا نافعًا في هذه الصيدلية الرّبانية، إذ لم يغادر الله صغيرًا أو كبيرًا من الأدوية، عَلِمَها مَن عَلِمَها من دارسي القرآن، وجَهِلَها مَن جهلها ممن لم يتدبّروا القرآن، يستوي في ذلك من جعلوه قراطيس ومن جعلوه عِضين، فضلاً عمن تحمّلوه في الذاكرة ولم يتحمّلوه فكرًا وسلوكًا. وبهذا ساهم كولن في إحياء أوجُه الإعجاز التربويّ والاجتماعي والتشريعي للقرآن في هذا العصر، وتبوّأ مكانة مرموقة في الفقه الشامل الأصيل؛ لأنه جمع باقتدار بين فقه الواجب وفقه الواقع.
لقد ساهمت كتابات هذا المفكر الداعية في صناعة “الموازين أو أضواء على الطريق” إذ صنع الكثير من القناديل من مادّة العرفان وأنارها بطاقة الوجدان، مما أدّى إلى إضاءة الكثير من القلوب والدروب، وتبديد مساحات عريضة من الدياجير الحالكة، وإطفاء الكثير من الحرائق المشتعلة والفتن العمياء، وتوفير الزاد للسائرين في صراط الله المستقيم.
وساهمت هذه الكتابات أيضًا في تبديد حيرات الطرق المتشابهة وتمزيق ظلمات الجهل، وتوفير الإجابة الشافية عن “أسئلة العصر المحيرة”، فقد أوجد لكل سؤال جوابًا، وصاغ لكل مشكلة حلاًّ، ورسم لكل متاهة مخرجًا، وساهم في الكشف العلمي البرهاني عن تهافت الكثير من الشبهات التي أُطلقت ضدّ الإسلام، ولاسيما ما يتعلق منها ببيان “حقيقة الخَلْق ونظرية التطور” التي برزت على يد تشارلز دارْوِين، وكان لها حضور طاغ وتداعيات سلبية في تركيا وأكثر بلدان المسلمين طيلة عقود عديدة.
وفي ذات السياق اهتمّ هذا العملاق بإبراز “روح الجهاد وحقيقته في الإسلام”، فأحسن وأجاد في بيان الصورة الوضيئة للجهاد، وإزالة ما علق به من تشوهات نتيجة ما ران عليه من غَبَش (الجمود) التقليدي وما التصق به من كيد “الجحود” التغريبي.
ولما كان كولن داعية بجانب كونه مفكّرًا، فقد امتلك تجربة ثريّة في التوجيه والتأثير، ومقدرة عجيبة في الوعظ والإرشاد، إذ حباه الله بجاذبية آسرة، بسبب مواهبه الطبيعية، التي صقلها وحلّاها بعلمه الوافر وإخلاصه البالغ، وبسبب مواءَمته في الأفكار والأفعال بين العقل والقلب أو بين الفكر والوجدان؛ فقد راكم تجارب بالغة الثراء، وامتلك خبرات شديدة الأثر، ولهذا أهدى الدعاة إلى الله عصارة تجاربه ورحيق خبراته، من خلال قيامه بالكشف عن “طرُق الإرشاد في الفكر والحياة”، وعرض للموضوعات العقدية والفكرية الملتبسة والتي ساهم سوء الفهم لها عند كثير من المسلمين في تعميق وتأصيل تخلّفهم المعاصر، ومن هذه الموضوعات الخطيرة: الموقف من الأسباب، حيث كشفه بجلاء سافر، عندما نجح باقتدار في قراءة “القَدَر في ضوء الكتاب والسنة”، وانتقد الأفهام الجبرية التي جعلت المسلم كالريشة في مهبّ الرياح، تحت ذريعة الإيمان بالقدر، داعيًا إلى مدافعة الأقدار بالأقدار كإحدى السبل للخلاص من الغثائية المعاصرة.
هذا المفكر يمكن القول إنه فريد عصره وعملاق دهره، وقد بدا تميّزه منذ البداية بانتمائه إلى “القلوب الضارعة” التي تعلّقت بالله العظيم، فاتّجهت إليه، وتمحّضت له، وفَنِيَت في حبّه والوَلَهِ فيه، وبقدر شعورها بالضآلة بين يديه تعالى صارت عظيمة بمواقفها واهتماماتها، بعيدة عن السفاسف، حريصة على المعالي، وهذا كله صار بعضًا من سجايا كُولَن، ولهذا جعل همَّه الأكبر وغايته العظمى الاتجاه نحو “التلال الزُّمُرُّدية: نحو حياة القلب والروح” ليس من خلال الشعارات والشعائر فقط، حيث العبادة اللاّزمة، ولكن من خلال المساهمة الفاعلة في تشكيل “ملامح الجيل المرتقب” حيث العبادة المتعدّية، التي يتضاعف أجرها بقدر اتساع المستفيدين منها ماديًّا ومعنويًّا، ويستمر ريعُها بعد الممات، ما دام هناك من يستفيد منها في شؤون المعاش وأمور المعاد.
وكلما اتجه الناس لإقامة صروح الدنيا، صروح الذات: الهوى واللهو والشهوة والزينة والمتاع، صروح الغواية والإغراء، صروح المجد الشخصي والأنا العليا والهُوَ الْمُتَسفِّلة، وكلما تسفَّل بعضُهم أكثر في هذا المنحدر، ازداد كولن علوًّا وسموًّا، وازدادت وتيرة عمله نشاطًا واتّساعًا، ليصبح حَدْوُه وحُداؤه: “ونحن نقيم صرح الروح”.. يقولها بلسان الحال ويهتف بها عن طريق السلوك. إنها الروح التي تجعل من عمارة الدنيا عبادة تصنع العزّة في الأرض، وتنسج الفلاح في السماء، حيث تتضاعف الأجور وتتراكم الحسنات على كل الحركات والسكنات، بما فيها مقاربة المباحات ومقارفة الشهوات، حتى النوم يكون مأجورًا عليه كما قال الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “إني لأحتسب نَوْمتي كما أحتسب قَوْمتي”. ولهذا كتب الله لفتْية الكهف أجر عبادة ثلاثمائة وتسع سنوات على نومة ناموها، لأنهم ناموا بأرواحهم وليس بأشباحهم فقط.
إنها الروح التي تُعِيد لأمّة المسلمين كرامتها وحرّيتها، ولذلك ظلّ ديْدنُه ودَنْدَنَتُهُ: “ونحن نَبْني حضارتنا”، لكن الحضارة لا تعني شيئًا بدون الإنسان، فهو المقصد قبل أن يكون الواسطة، ومن هنا اعتنى كولن بتربية الفرد: تخليةً وتحليةً، مبنًى ومعنًى. وعمل حثيثًا على إيجاد الإنسان الجديد الذي يتمثل قيم القرآن ويستدعي نموذج الصحابة من جديد، الجيل الذي وصلت البشرية عبره إلى ذروة الرشد وقمّة السداد وإلى سقف الكمال البشَري النسبي.
الجدير بالذكر أن هذا القنديل الذي استضاءت بنوره قلوب مظلمة، واستنارت بفكره عقول معتمة، اقتبس نوره من مصادر كثيرة: قديمة وحديثة، إسلامية وإنسانية، لكن المصدر الأول والأكبر هو “النور الخالد: محمد r… مفخرة الإنسانية” الذي أحبّه كولن حتى الثمالة، وصار حبُّه يجري في دمه مزاحمًا كُريّات الدم البيضاء والحمراء، واستمدّ منه الأنوار والأزواد، وتأسّى به في كل صغيرة وكبيرة.
إنها كتائب الأفكار التي حشدها فتح الله ليفتح بها آذانًا صُمًّا وعيونًا عميًا وقلوبًا ميّتة، حيث توافرت لها صوابية العلم وروحية الإخلاص، فآتت ثمارها كل حين بإذن ربها، فمَن ذا الذي يمكن أن يقف أمام هذه الكتائب الناعمة التي لا تمنع حركتها الحدود ولا تغلّ انطلاقها القيود؟!

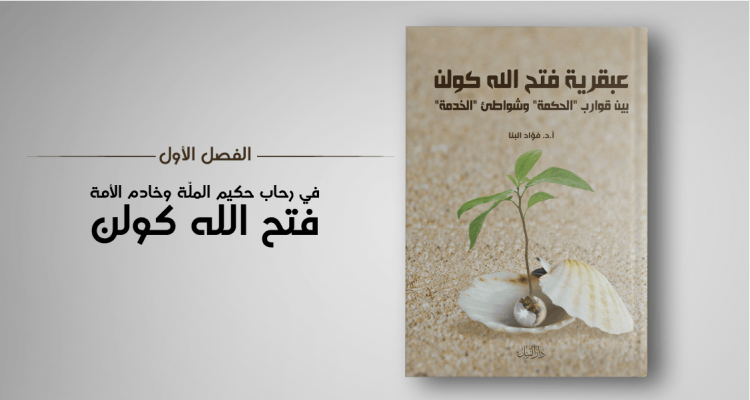
Leave a Reply