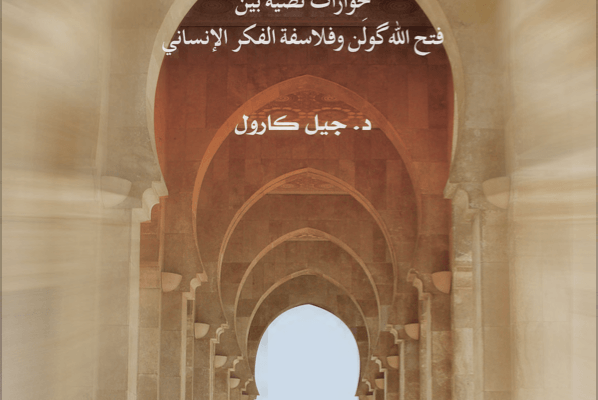في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2004، سافرت إلى تركيا لمدة عشرة أيام ضيفة على “معهد الحوار بين الأديان” (Institute for Interfaith Dialog – IID) بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وكان بصحبتي حوالي عشرين من الأساتذة الجامعيين ورجال الدين وقيادات المجتمع من ولايات تكساس وأُوكلاهوما وكنساس. لم يكن أينا قد زار تركيا من قبل ولم يكن أينا يعرف ماذا يمكن أن يتوقع، فكل واحد منا سبق -بطريقة أو بأخرى- أن جاءه واحد أو أكثر من الشباب التركي سواء في المدرسة أو الكنيسة أو في أي مكان آخر في المجتمع الذي يعيش فيه وسأله عن إمكانية السفر إلى تركيا للمشاركة في حوار الأديان كضيوف على المنظمات التي يتبع لها هؤلاء الشباب. وقد تعرف بعضنا بشكل أفضل قليلاً على هؤلاء الشباب وزوجاتهم من خلال تناول العشاء معهم في منازلهم أو حضور حفلات الإفطار الجماعي التي يرعاها “معهد الحوار بين الأديان” في شهر رمضان، وقد قبلنا جميعًا الدعوة من منطلق شعورنا بأن هؤلاء الشباب وزوجاتهم والمنظمة الداعية هم جميعًا موضع ثقة.
وما لم أكن أعرفه في بداية تلك الرحلة -ولكنني اكتشفته فيما بعد- هو أن مؤسِّسي “معهد الحوار بين الأديان” والمتطوعين فيه وكذلك منظِّمي رحلتنا سواء في الولايات المتحدة أو تركيا كانوا جميعًا متطوعين في حركة متعددة الجنسيات من الأشخاص الذين ألهمتهم أفكار عالِم مسلم تركي يدعى فتح الله كولن، وأن خطبه ومحاضراته تنتشر منذ عقود في جميع أنحاء تركيا وخارجها منذ أصبح واعظا رسميًا في عام 1958 وتم تعيينه في وظيفة بمدينة إزمير غربي تركيا. وقد زرنا العديد من المدارس وإحدى المستشفيات ومنظمة معنية بالحوار بين الأديان، وجميعها مؤسسات أنشأها أفراد من محبي كولن. وتناولنا الوجبات مع أسر تركية في منازلهم، وفي كل مرة كنت أسأل المضيفين عن كيفية سماعهم بأفكار كولن وما الذي ألهمهم تحديدًا للانخراط في تلك الحركة، فكانت الإجابة واحدة في مضمونها. فكبار السن منهم كانوا يعيشون في إزمير عندما بدأ كولن في ممارسة الوعظ، وقد تأثروا واقتنعوا برسالة التربية والتعليم وروح الإيثار التي كان يدعو لها. أما الأشخاص الأصغر سنًا ممن لديهم أطفال في سن المدارس فقد تعرفوا على الحركة من خلال مدارس قريبة منهم لديها سمعة تعليمية ممتازة، وبذلك أصبحوا ملتزمين بالرؤية الخاصة بالسلام العالمي والتقدم من خلال التعليم والحوار بين الأديان. وهناك آخرون كانوا طلابًا في مدارس أسسها رجال أعمال تأثروا بأفكار كولن، ويقومون الآن بدعم المدارس والأعمال الأخرى الخاصة بحوار الأديان من خلال رعايتها بطرق مختلفة. وفي كل مرة، كنت ألمس مدى عمق تأثر الشخص الذي أتحدث إليه برسالة كولن ورؤيته وتعهده بنشرها في جميع أنحاء العالم.
رجعت إلى هيوستن -مقر “معهد الحوار بين الأديان”- ووطدت علاقتي بالمعهد، وقد استضاف “مركز بونيوك لدراسة وتعزيز التسامح الديني” (Boniuk Center for the Study and Advancement of Religious Tolerance) التابع لجامعة رايس -حيث أعمل- مؤتمرًا حول أفكار كولن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 حضره علماء من الولايات المتحدة وأوروبا ووسط آسيا، وتعاوَنَّا مع “معهد الحوار بين الأديان” في عدد من المشروعات والمحاضرات والاجتماعات الأخرى. وقد عدت إلى تركيا مرة ثانية في مايو/أيار عام 2005 ويوليو/تموز عام 2006، والتقيت بالمزيد من الأشخاص ممن تأثروا بأفكار كولن، وهو ما زاد من فهمي لأفكاره وتأثيرها على الأفراد في تركيا وعلى تركيا نفسها. فمنذ رحلتي الأولى إلى تركيا، قرأت كثيرًا من أعمال كولن المترجمة وجرت بيني وبين أصدقائي الأتراك الكثير من الحوارات بشأن أعماله. ورغم أنني مازلت لا أعد خبيرة في أفكار كولن أو في تاريخ تركيا الحديث أو في الصوفية، فإنني مع ذلك متخصصة في الدراسات الدينية (الفلسفة العامة للدين) ومتخصصة في الأديان العالمية ولديَّ معرفة عامة في ميدان العلوم الإنسانية. وقد قمت بتدريس بعض المقررات العامة أو “الدراسات الإحصائية” في مجال الإنسانيات ضمن مناهج الجامعات والدراسات العليا طوال ما يقرب من خمسة عشر عامًا. وتتضمن هذه المقررات الأدب العالمي المقارن وعلم الأخلاق والفلسفة القديمة والكلاسيكية والفلسفة السياسية الحديثة، علاوة على تدريس مقررات “أمهات الكتب” في مجالات التاريخ والفلسفة والدين والأدب سواء في الغرب أو الشرق. ويتسع مجال اختصاصي ليشمل الفكر “الشرقي” وكذلك “الغربي”، وذلك بسبب تخصصي في الفلسفة الدينية. وبالتالي، عندما بدأت في قراءة خطب كولن ومقالاته المترجمة، بدأت الأجراسُ تدق في عقلي بسبب أوجه الشبه العميقة التي لاحظتُها بين أعماله وبين أفكار بعض الفلاسفة والمفكرين العظماء في التاريخ الفكري العالمي.
وتتلخص مهمتي في هذا الكتاب في وضع أفكار فتح الله كولن في سياق العلوم الإنسانية الأوسع، فأنا أسعى بالتحديد إلى إقامة محاورة نصية بين نسخ منشورة من مقالاتٍ أو مواعظ أو خطب مختارة ألقاها كولن من ناحيةٍ وبين نصوص لمجموعة منتقاة من المفكرين أو الكتاب أو الفلاسفة أو المنظرين في مجال الخطاب العام في العلوم الإنسانية أو ما يعرف بالإنسانيات من الناحية الأخرى. وهؤلاء المفكرون هم كونفشيوس وأفلاطون وإيمانويل كانط وجون ستيوارت ميل وجان بول سارتر. ويدفعني موقع أفكار كلٍّ من هذه الشخصيات في مجال الإنسانيات (في مقابل العلوم) إلى وصفهم -بمن فيهم كولن- كمفكرين إنسانيين، رغم أن هذا التوصيف قد يبدو مثيرًا للجدل، على حسب التعريف الذي يتم تبنيه لـ”لفلسفة الإنسانية” (Humanism). وقد اخترت في هذا العمل أوسع تعريف ممكن للفلسفة الإنسانية، وهو تعريف لا ينظر إليها باعتبارها النقيض الضروري لوجهة النظر الدينية أو الإيمانية. وقد أطلق الفلاسفة ومؤرخو الحركة الفكرية وَصْفَ “الإنسانية” على كل أفكار أو نُظم فكرية تمتد إلى العصور القديمة منذ عصر الفيلسوف الإغريقي بروتاجوراس صاحب المقولة المشهورة: “الإنسان هو مقياس كل شيء”. وبروتاجوراس لم يكن ملحدًا لا هو ولا أيٌّ من الفلاسفة الإغريق الكلاسيكيين الآخرين الذين عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد والذين حولوا محور تفكيرهم من التساؤلات عن الطبيعة وعناصر الكون (الماء والهواء والمادة إلخ) إلى التساؤلات عن معنى الحياة والقيم الإنسانية وطبيعة الحياة الصالحة ومكونات المجتمع الإنساني العادل. وهذه القضايا هي التي تميز عادةً الفلسفة أو الفكر الإنساني، والعديدُ من الفلسفات والرؤى -سواء الدينية أو اللادينية- تنتمي إلى الفلسفة الإنسانية في هذا السياق.
وقد قامت الفلسفة الإنسانية في عصر النهضة -التي أحيت أفكارًا كانت موجودة في العالم القديم- بتحويل محور اهتمامها من الله إلى “الإنسانية” (humanity)، إلا أن الفلاسفة الإنسانيين بشكل عام في هذه الفترة لم يكونوا ملحدين ولم ينادوا بالإلحاد كمظلة لرؤيتهم “الإنسانية”. كل ما في الأمر أن التركيز على القدرة والإنجاز الإنسانيين -وما صاحبه من رؤية تقلل من التدخل الإلهي في الأشياء- فتح الطريق لظهور وجهة نظر علمية في الغرب مكنت البشر من اكتشاف نواميس الكون -التي هي نفسها من خلق الله-. وقد توصل المفكرون الأوروبيون في تلك الحقبة إلى هذه الرؤية بالطبع في إطار التعاليم الدينية الأوسع للمسيحية، وهم مدينون للعلماء المسلمين من الأجيال السابقة الذين بلغوا بالفعل أعلى مستويات التقدم في الطب والفلك والرياضيات وعلم النبات والكثير غيرها من ميادين العلم في إطار التعاليم الدينية للإسلام. وفي كلتا الحالتين، لم تأت الفلسفة الإنسانية لتنادي بعلو القوة الإنسانية فوق قدرة الله أو ضدها، بل على العكس يشهد البشر بقدرة الله عندما يستعملون إمكاناتهم التي وهبها الله لهم للكشف عن أسرار الكون التي خلقها الله ويستخدمون هذه المعرفة في سبيل تقدم المجتمع البشري وازدهاره بأكمله. إذن، فإن هذا الشكل من الفلسفة الإنسانية لا ينكِر بأي حال فكرةَ الدين أو الإيمان بالله، بل إن العلماء المسلمين -والعلماء المسيحيين السائرين على خطاهم- يعدون أمثلة كبرى على هذا الشكل الواسع من الفلسفة الإنسانية المتدينة.
صحيح أن الأشكال الأخرى من الفلسفة الإنسانية علمانيةٌ أو ملحدة تمامًا؛ ففي فترة ما بعد عصر النهضة، انشقت عن الفلسفة الإنسانية الأوسع فلسفاتٌ ترفض بالذات أيَّة رؤية دينية أو غيبية للعالم، إلى درجة العداء للدين. فالفلسفة الإنسانية العلمانية هي فرع ملحد انشق عن الفلسفة الإنسانية لا يتوافق مع وجهة النظر الدينية إلى حد كبير. ولا يمكن وصف كولن -ولا أي مفكر ديني آخر- بأنه فيلسوف إنساني ضمن هذا التعريف للفلسفة الإنسانية، وكذلك كانط ومِيل وكونفوشيوس؛ فهؤلاء جميعًا يشار إليهم عادةً كفلاسفة إنسانيين وإلى أفكارهم كشكل من أشكال الفلسفة الإنسانية، إلا أن أحدًا منهم لم يكن ملحدًا. وبالتالي، فقد أصبح من الواضح أن التعريف الإلحادي العلماني الضيق للفلسفة الإنسانية الحديثة ليس هو التعريف الإجرائي الذي نتبناه في هذا الكتاب.([1])
ولذلك، فإنني أستخدم تعريفًا أوسع للفلسفة الإنسانية في هذا الكتاب، تعريفا يستطيع -بدقة أكبر من التعريفات الحديثة المتواترة- أن يعبر عن تاريخها الطويل وعن الإنجازات الكبرى التي حققها البشر في الدين والفلسفة والأدب والأخلاق والفن والعمارة والعلوم والرياضيات في ظل قاعدتها الرئيسية، وهي التركيز على الإيمان بأهمية الإنسان وقدرته ومكانته وسلطته، وهو إيمان لا يتناقض بأي حال مع المعتقدات المحورية أو مع تاريخ الديانات الموحدة الثلاث الكبرى. وفي ضوء ذلك، فإنني أصنف كولن ضمن هؤلاء المفكرين الإنسانيين الآخرين، لأن أعماله -مثل أعمالهم- تركز على القضايا المحورية عن وجود الإنسان التي ظلت طويلاً جزءًا من خطاب الفلسفة الإنسانية سواء في شكلها الديني أو اللاديني. وبعبارة أخرى، إن هؤلاء المفكرين يهتمون بالتساؤلات الأساسية عن طبيعة الواقع الإنساني والحياة الإنسانية الصالحة والدولة والمبادئ الأخلاقية، كما توصلوا إلى نتائج متشابهة في العديد من هذه القضايا والتساؤلات بعد دراستها والتفكر فيها ضمن السياق الثقافي والتراثي الخاص بكلٍّ منهم.
و”التشابه” الذي أقصده هنا لا يعني “التطابق”، فهؤلاء المفكرون قادمون من خلفيات وفترات زمنية وسياقات ثقافية ووطنية وتقاليد دينية وروحية شديدة الاختلاف، وهم يختلفون عن بعضهم البعض بطرق معينة حتى إنهم في مواضع معينة من مؤلفاتهم قد يرد بعضهم على آراء البعض الآخر (وهو ما يحدث مع الكُتَّاب المتأخرين) أو قد يتخيل المرء أن الواحد منهم قد ينتقد الآخر في العديد من النقاط إذا كان هناك حوار حقيقي دائر بينهم (وليس مجرد حوار “مركب”). فكولن في معظم أعماله ينتقد سارتر والوجوديين وغيرهم من الفلاسفة الملحدين بشكل متكرر. ورغم أنني أكتفي في هذا الكتاب بوضع كلٍّ من هؤلاء المفكرين في محاورة نصية مع كولن وحده وليس مع بعضهم البعض، فلنا أن نتخيل قدر المحاورات التي قد تنبع من اختلافاتهم الكبيرة، فميل ينادي بنوع من الحرية يمكن أن يجده أفلاطون أمرًا بغيضًا في جمهوريته الفاضلة، وعلى العكس قد يجد ميل في جمهورية أفلاطون الفاضلة استبدادًا وظلمًا في كثير من الجوانب. وأعمال سارتر تنتقد أية تفكير في “جنة الأفكار” (heaven of ideas) العالمية والغيبية، سواء جاءت من جانب أفلاطون أو كانط أو كولن. أما كونفوشيوس -القادم بوجهة نظر صينية من القرن السادس- فليس لديه سوى القليل من الأفكار المشتركة مع المفكرين الغربيين في عصري التنوير وما بعد التنوير مثل كانط أو ميل.
والذي يهمني بشدة هو المحاورة بين أفراد لديهم وجهات نظر متباينة، كما أنني أُومِنُ بأن هذا النوع من الحوار هو ما نحتاج إليه في هذا العصر الذي دَفعت فيه العولمةُ ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الأفرادَ والجماعاتِ إلى التجمع معًا بطريقة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل. فالبشر في القرن الحادي والعشرين يتفاعلون ويتأثرون أكثر من أي وقت مضى بأفراد وجماعات مختلفة عنهم تمام الاختلاف. ونحن نواجه بشكل متزايد أفرادًا وجماعات أفكارهم تختلف تمامًا عن أفكارنا، وهؤلاء الأفراد هم جيراننا وزملاؤنا في العمل وزملاء لأولادنا في الدراسة وأصهارنا وعملاء لدينا ورؤساؤنا في العمل وغيرهم. ونحن غالبًا ما نحاول أن نقلل احتكاكنا بالأفراد المختلفين عنا حتى لا نضطر للخروج من الحدود المريحة بالنسبة لنا، وقد نعزل أنفسنا ونضع سفينة حياتنا في مدارات مألوفة بالنسبة لنا تضم أفرادًا يشبهوننا في المظهر والتفكير والحديث والاعتقاد والصلاة. لكن هذه العزلة أو هذا التقليل للاختلاف ليس حلاً عمليًا في جميع الأحوال، ففي هذا العصر الذي يتميز بترابط عالمي، يجب علينا تطوير القدرة على الحوار وإنشاء نقاط اتفاق مع من يختلفون عنا بشكل كبير. وجزء من هذا المشروع هو إيجاد أفكار ومعتقدات وأهداف ومشروعات… إلخ يمكننا من خلالها تحقيق تفاهم مع بعضنا البعض. وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون متشابهين معهم بالكلية، ولكن ينبغي علينا أن نجد قدرًا كافيًا من التشابه بيننا يمكِّننا -لمسافة معينة- من أن نضم أيدينا معًا كرفاق في رحلة هذه الحياة، مع وعينا الكامل باختلافاتنا في الكثير من الأمور.
لقد كان كولن خلال مسيرته كواعظ في تركيا وكعالم ومعلمٍ ومصدرِ إلهام للناس في جميع أنحاء تركيا وخارجها مناصرًا للحوار كالتزام ونشاط ضروري في العالم المعاصر، لذلك فإنه من المناسب وضع كولن -من خلال كتاباته- “في محاورة” مع مفكرين وكتاب آخرين لديهم رؤى مختلفة عنه تمامًا. فمثل هذا المشروع يقدم لنا كقراء سبيلاً للشعور بالراحة مع الاختلاف، لكن الأهم هو أن مثل هذا الحوار بين أشخاص معروفين بعلمهم ومواهبهم يمكن أن يساعد جميع من يهتم بهذه الأشياء على التركيز بشكل أعمق على القضايا الكبرى الأزلية في الحياة الإنسانية. فرغم أن حياة البشر تختلف في تفاصيلها من عصر لآخر، فإن الطبيعة العميقة للحياة الإنسانية -وما تستثيره من تساؤل وقلق- لم تتغير. فنحن اليوم نطرح نفس التساؤلات التي طرحها أجدادنا عن معنى الوجود وقيمة الحياة البشرية وعن كيفية بناء مجتمع وعن حدود الحرية. وأملي هو أن تسهم هذه المحاورة التخيلية بين كولن والآخرين الذين سبق ذكرهم في مَنْحِنا -نحن الذين يقع المستقبل على عاتقهم- الفرصةَ لكي نتحمل مسؤولية صياغة أنفسنا ومجتمعنا والعالمِ وفقًا لأسمى وأفضلِ المثُل الممكنة.
وقد نظمتُ المحاورةَ بين كولن والمفكرين الآخرين حول خمسة أفكار أساسية ترصد القضايا والهموم الأساسية الخاصة بالحياة الإنسانية في العالم، وهذه الأفكار هي:1- القيمة الإنسانية المتأصلة والكرامة الأخلاقية و2- الحرية و3- الإنسانية المثالية و4- التعليم و5- المسؤولية. وهذه الأفكار معروفة جيدًا لأي من الطلاب المتخصصين في الخطاب العام للعلوم الإنسانية، سواء من العصر القديم أو العصر الحديث، وسواء من أوربا أو آسيا أو إفريقيا، وسواء من وجهة نظر دينية أو علمانية. وفي كل فكرة، أقوم باختيار واحد من المفكرين السابق ذكرهم ليدخل في تفاعل نصي مع كولن. وقد اخترت هؤلاء المفكرين على أساس حجم التشابه بين تعبيرهم المحدد عن موضوع المحاورة وتعبير كولن عن نفس الموضوع من منظوره الإسلامي. وقد كان يمكن أن أختار مفكرين آخرين وأحقق نفس النتيجة -في الغالب- بإيجاد تعبير قوي عن الأفكار الكلاسيكية الدائمة والتشابه مع كولن في تلك الأفكار، لكنني اخترت المفكرين الذين سنتناولهم لأنني شعرت بأنهم كانوا أكثر براعة في تعبيرهم، وبصراحة بسبب إعجابي العميق واحترامي الشديد لعملهم بعد تدريسي لأفكارهم في قاعات الكلية طوال خمسة عشر عامًا حتى الآن. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحوارات تُناقش موضوعات أعتقد أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لدراستنا العلمية والمدنية.
وفصول هذا الكتاب مترابطة فيما بينها ترابطًا موضوعيًا وبعضها يحيل إلى بعض في نقاط معينة، إلا أن هذه الإحالات قليلة، فالفصول في أغلبها مستقلة عن بعضها البعض بحيث يستطيع القارئ أن يقرأ الكتاب بأي ترتيب يريد أو أن يقرأ الفصول التي تجذب اهتمامه فقط دون أن يفقد شيئًا من ترابط الكتاب وتماسكه، فالقارئ الذي سيقوم بذلك لن “يتوه” في النص. وقد قمت بتأليف هذا الكتاب لجمهور أكثر عمومية ممن تستهدفهم الكتب الأكاديمية، وأنا لا أفترض أن يكون القارئ قد قرأ كتابات كانط أو سارتر أو كونفوشيوس أو أفلاطون أو ميل أو حتى كولن، ولذلك لا أقضي وقتا كثيرًا في إيراد معلومات عن حياة هؤلاء الفلاسفة لأن هذه المعلومات متاحة للقراء من مصادر متعددة، لكن هدفي هو شرح أفكار هؤلاء المفكرين وتبسيطها لجمهور من المتعلمين بشكل عام قد تكون لديهم خلفية في العلوم الإنسانية كما يتم تدريسها في الغرب أو قد لا تكون لديهم هذه الخلفية. ولهذا السبب اخترت التغاضي عن العديد من التفاصيل التي كان يمكن أن تحتل قدرًا كبيرًا من الصفحات والهوامش لو أنني كنت أكتب كتابًا علميًا أكثر تقليدية. وبهذا، آمل أن أكون قد وضعت بين أيديكم كتابًا مفيدًا ومهمًا وممتعًا يجده من يهتمون بتاريخ الأفكار والتاريخ الفكري العالمي وحوار الثقافات نافعًا وملهمًا للأفكار.
[1] للمزيد من المعلومات عن الفلسفة الإنسانية وفروعها المختلفة وعلاقتها بالدين والإسلام، انظر: جوثري (Guthrie)، 1969، ورابيل (Rabil Jr.) 1988، وديفيدسون (Davidson)، 1992، وفخري (Fakhry)، 1983، وجودمان (Goodman)، 2003، وكراي (Kraye)، 1996.