إن “الفلسفة الإنسانية” (Humanism) تضع الإنسان -كفرد وكمجموع وكنوع وكشكل للوجود- في مركز اهتمامها؛ ولذلك كان أكثر ما تنادي به الفلسفة الإنسانية هو أن الحياة الإنسانية بشكل عام -وحياة كل إنسان بشكل خاص- تتضمن شكلاً من أشكال القيمة الإنسانية المتأصلة، واحترام هذه القيمة الإنسانية المتأصلة -في العديد من النظم الإنسانية- يشكل المنطلق أو الأساس للمبادئ الأخلاقية الأساسية. ولم يؤكد أحد على هذا المعنى بقوة واتساق أكثر من الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط الذي عاش في القرن الثامن عشر؛ فقد حاول في كتابه “أسس ميتافيزيقا الأخلاق” (Grounding for the Metaphysics of Morals) الذي نُشر عام 1785 التعبير عن “المبدأ الأسمى للمبادئ الأخلاقية” (the Supreme Mrinciple of Morality).([1])
وقد قصد كانط التعبير عن هذا المبدأ من الناحية العقلانية البحتة -وليس الإمبريقية (التجريبية)- حتى لا يُفهم أن الأفعال الأخلاقية تعتمد على الأحوال أو المشاعر أو الأهواء أو الظروف الإنسانية. ولا يتسع المجال هنا لتناول مزايا طريقة كانط أو استنتاجاته فيما يتعلق بالأخلاقيات العقلانية في مقابل الإمبريقية أو لتلخيص أفكاره وأطروحاته بشكل كافٍ، لذا سنركز على تلك النقاط الأكثر ارتباطًا بمناقشته لموضوع البشر كغايات في ذاتهم وبالتالي أصحاب قيمة متأصلة لا يجب المساس بها.
وترتكز جدلية كانط في كتاب “أسس ميتافيزيقا الأخلاق” على ثلاثة مفاهيم محورية وهي: العقل والإرادة والواجب، وقد ربط كانط بين هذه المفاهيم الثلاثة بطريقة محددة للغاية، وتنقّل من مفهوم إلى آخر بشكل منطقي حتى يشكل السياق العام لفلسفته الأخلاقية. ويبدأ كانط بالإرادة، فالإرادة -وخصوصًا الإرادة الصالحة- شيء مطلوب في أي مفهوم عن المبادئ الأخلاقية، وهذا ما يؤكده كانط في أول جزء من مؤلفه، فيقول:
“ليس ثمة احتمال على الإطلاق بالتفكير في أي شيء في العالم -أو حتى خارجه- يمكن اعتباره صالحًا بدون مسوغ لذلك إلا الإرادة الصالحة، فالذكاء والفطنة وحسن التمييز وكل ما يرغب المرء في ذكره من المواهب العقلية هي بلا شك صالحة ومرغوبة من نواحٍ عديدة، تمامًا كالصفات المزاجية مثل الشجاعة والعزم والمثابرة. لكنها قد تكون أيضًا سيئة وضارة للغاية إذا كانت الإرادة -التي يفترض أن تستفيد من هذه المواهب الطبيعية والتي في قوامها الخاص تسمى الشخصية- غير صالحة… فرؤية كائن لا يتحلى بلمسة من الإرادة الصالحة والنقية لكنه يتمتع بحالة من النجاح المتواصل لا يمكن أن يسعد المشاهد العقلاني المتجرد. وبناء عليه، فإن الإرادة الصالحة يبدو أنها تمثل الشرط الذي لا غنى عنه حتى لاستحقاق الشعور بالسعادة”.([2])
لا يمكن، إذن، أن يوجد شيء صالح من دون الإرادة الصالحة، بغض النظر عن المواهب والقدرات الأخرى التي قد يمتلكها الفرد؛ فالإرادة الصالحة هي حالة أساسية للشخصية، ولا غنى عنها في السلوك الأخلاقي.
ويواصل كانط تحليله بالانتقال إلى مفهوم العقل، فهو يرى أن العقل هو ما يفرق البشر عن الحيوانات بشكل عام، لكن العقل -بتحديد أكبر- يعمل في البشر بطريقة توضح اختلافًا أساسيًا أكبر بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية. ويتناول كانط المبدأ القائل إن الطبيعة تضع التكوين الخاص بكل كائن معقد بحيث لا يوجد أي عضو في الكائن لا يحقق هدفًا، وبحيث يكون هذا العضو وحده هو الأصلح لتحقيقه بأعلى وأفضل الإمكانيات. وبعبارة أخرى، كل عضو له هدف وهو يحقق هذا الهدف أفضل من أي عضو آخر في الكائن الحي. وينظر كانط إلى العقل باعتباره نوعا من الأعضاء، ويتساءل عن الهدف الذي يحققه للحياة الإنسانية، فيقول:
“والآن، لو كانت المحافظة على هذا الكائن أو رفاهيته أو -باختصار- سعادته هي الغاية الحقيقية للطبيعة في حال امتلاك العقل والإرادة، لكانت الطبيعة قد اختارت ترتيبًا سيئًا للغاية في جعل عقل هذا الكائن يحقق ذلك الهدف، لأن جميع الأفعال التي يتعين على هذا الكائن القيام بها في ظل هذا الهدف وكذلك القاعدة العامة لسلوكه، كانت ستُفرض بشكل أكثر صرامة من خلال الغريزة، ولكان تحقيق الهدف المقصود يتم بالغريزة أكثر مما يتم بالعقل”.([3])
هنا يؤكد كانط على أن تحقيق السعادة بمفهومها الذي يدور حول المحافظة على بقائنا أو رفاهيتنا ليس وظيفة العقل لدى البشر أو الكائنات التي تمتلك العقل والإرادة؛ فالرفاهية أو البقاء أو السعادة يمكن تحقيقها بالغريزة مثلما يمكن تحقيقها بالعقل إن لم يكن أفضل، حيث إنها توجد لدى الحيوانات أيضًا. ولذلك يقول كانط: “إن للوجود هدفًا آخر أهم بكثير خُلق العقل من أجله، وليس من أجل السعادة”.([4]) وينتهي كانط إلى أن الهدف من العقل هو إنشاء الإرادة الصالحة، فيقول: “يعتبر العقل أن أعلى وظائفه العملية هي إنشاء الإرادة الصالحة، والتي من خلالها يكون العقل فقط قادرًا -في سعيه لتحقيق تلك الغاية- على الوصول إلى نوع الإشباع الخاص به”.([5])
إذن ما هي الإرادة الصالحة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
باختصار، يعرِّف كانط الإرادة الصالحة في البشر بأنها: القدرة على التصرف من منطلق الواجب وحده وليس بوازع من أي ظروف أو انفعال. وينبهنا هذا التعريف إلى ما يمكن أن نعتبره الهم الأساسي لكانط في مقالته، وهو البحث عن أساس ثابت للأخلاق. فالنظم الأخلاقية التي ترتكز على اللذة أو السعادة أو الانفعالات لا تقدم، من وجهة نظره، أساسًا كافيًا للأخلاقيات، نظرًا لأنها أشياء عابرة تخضع للكثير من المتغيرات في حياة الإنسان، فانفعالاتنا قد تتغير تبعًا للظروف، وما كان مصدرا للمتعة في السابق قد لا يظل كذلك. فهذه المتغيرات لها تأثير ضئيل في عالم الحياة الدنيوية، إلا أن تأثيرها يكون كبيرًا في عالم الأخلاق. فطالما أن الأخلاق توجِّه وترشد تصرفاتنا تجاه الناس، فإن المبادئ التي توجهنا قد تتغير حسب حالتنا المزاجية أو أهوائنا أو ظروفنا إذا كانت تقوم على المشاعر أو المتعة، فقد نشعر أحيانًا بعدم الرغبة في قول الحقيقة أو في إبداء التعاطف أو العدل في تعاملاتنا مع الناس. وبالنسبة لكانط، فإن تأسيس الأخلاق على المشاعر أو اللذة هو بمثابة بناء بيت فوق رمال متحركة، وهو ما يُعد مخاطرة بكل شيء. لذلك يبحث كانط عن أساس أكثر أمنًا للأخلاق. وهو يؤمن أنه يستطيع أن يجد هذا الأساس في العقل والإرادة والشعور بالواجب، والتي تُفهم بشكل ملائم عندما تتفاعل وتتلاحم في الحياة الإنسانية.
وباختصار، يستحيل، بالنسبة لكانط، وجود الخير بدون الإرادة الصالحة، وقد خلق العقل فينا لتنمية تلك الإرادة، وهي قدرة البشر على التصرف من منطلق الواجب فقط، بغض النظر عن المشاعر أو الظروف أو المتعة المكتسبة. ويفرد كانط معظم أطروحته لشرح تلك المفاهيم الجوهرية الثلاثة، وهي العقل والإرادة والواجب، وعملها في إطار افتراضي من الأخلاق يستطيع البشر من خلاله صياغة مبدأ أخلاقي عام يوجه كل أفكارهم وأفعالهم. هذا المبدأ العام يسمى “الواجب المطلق” (categorical imperative)، وهو يأخذ في تلك الأطروحة عدة أشكال، أكثرها شيوعًا هو أنه “لا يجب أبدًا أن أتصرف إلا بالطريقة التي يمكن أن أريد أن يصبح سلوكي فيها قانونًا عامً”.([6])
ولكن ما هي علاقة كل ذلك بالقيمة الإنسانية المتأصلة؟ يرى كانط أن البشر كائنات عاقلة، وهم يمتلكون في طبيعتهم الأساسَ الحقيقي للأخلاق، وبالتالي فهم يمتلكون قيمة متأصلة في داخلهم. أما خارج نطاق البشر ككائنات عاقلة فليس هناك أي مفهوم عملي للخير الأخلاقي، إذ لا يمكن لأي كائن حي أن يحددها عقلانيًا وأن يطبقها على مستوى عام باستثناء البشر. فالكائن العاقل هو كائن يحدد بنفسه ما هو القانون الأخلاقي العام، وهذا الكائن الذي يضع المبادئ القيمية هو قيمة أو خير في ذاته. وبحسب تعبير كانط: “الطبيعة العاقلة توجد كغاية في حد ذاته”.([7])
وفي الحقيقة، يرسم كانط صورة للواجب المطلق تتمركز حول المحور التالي: “تصرف بالطريقة التي تتعامل بها مع الإنسانية، سواء في شخصك أنت أم في شـخص أحـد آخر، باعتبـارها دائمًا غاية وليسـت مجرد وســيلة”.([8]) يتصور كانط وجود “مملكة من الغايات”، أي مجتمع منتظم حول تلك المبادئ الأخلاقية التي يشرِّع فيها البشر -ككائنات عاقلة وأيضًا كغايات في ذاتهم- القانون الأخلاقي العام، بالنظر إلى البشر كغايات في ذاتهم وليس كمجرد وسائل. وفي هذه المملكة، يكون لكل شيء إما ثمن أو كرامة، أي قيمة سوقية (Market Value) أو قيمة متأصلة (İnherent Worth). ويشرح كانط ذلك قائلاً:
“أي شيء ذي ثمن يمكن استبداله وإحلال شيء آخر مكافئ محله، ولكن في المقابل فإن أي شيء أسمى من أي سعر -وبالتالي ليس له مكافئ- تكون له كرامة. فأي شيء له علاقة بالميول والحاجات الإنسانية العامة يكون له سعر سوقي… لكن ما يشكل الحالة التي يمكن فيها فقط لشيء ما أن يكون غاية في ذاته، لا تكون له مجرد قيمة نسبية -أي سعر- بل تكون له قيمة أصيلة وجوهرية -أي كرامة- والآن نجد أن الأخلاق هي الحالة التي يمكن فيها وحدها لكائن عاقل أن يكون غاية في ذاته، لأنه بذلك فقط يمكن أن يكون عضوًا مشرِّعًا في مملكة الغايات. وعليه، فإن الأخلاق والإنسانية -بقدر ما يمكنها الالتزام بالأخلاق- لهما كرامة وحدهما. فالمهارة والجد في العمل لهما سعر سوقي، لكن الذكاء واتساع الخيال وروح الفكاهة لهما قيمة وجدانية، في حين أن الوفاء بالوعود وحب الخير على أساس من المبادئ (وليس بالغريزة) لهما قيمة جوهرية.([9])
إن القيمة الإنسانية غير قابلة للمساومة، فهي ليست شيئًا يباع ويشترى أو شيئًا نسبيًا في قيمته على حسب ظروف السوق. فصياغة كانط للإنسان تجعلنا ننظر إلى الفطرة الإنسانية “باعتبارها الكرامة، وتجعلها أعلى بشكل مطلق من أي سعر، بحيث لا يمكن وضعها موضع المنافسة أو المقارنة دون انتهاك قدسيتها – إذا جاز التعبير”.([10])
ويكمل كانط قائلاً:
“إن الطبيعة العقلية تتميز عن باقي الطبيعة بأنها تمثل غاية في حد ذاته”،([11]) لذا فهناك بعد آخر للواجب المطلق وهو “أن الكائن العاقل نفسه يجب أن يكون الأساس لكل النماذج السلوكية، وبالتالي يجب ألا يُستخدم أبدًا كمجرد وسيلة بل باعتباره الحالة العامة التي تحكم استعمال كل الوسائل، أي أن يبقى دائمًا غاية في الوقت نفسه”.([12])
وكما ذكرنا سابقًا، يعتبر البشر غايات في ذاتهم، لا مجرد وسائل لتحقيق غاية أحد آخر، فلا يمكن أن يُستعمل إنسان كأداة كي يخدم بها أهداف شخص آخر أو خططه أو أيديولوجيته. صحيح أنه يمكن توظيف البشر في تلك الجهود، ولكن لا يمكن معاملتهم باعتبارهم مجرد موظفين في مشروع، فهم دائمًا وفي الوقت نفسه غاية في ذاتهم، وهم يحملون كرامة وقيمة متأصلة بغض النظر عن أي ميزة أو منفعة يخدمون بها مشروعات أي شخص آخر أو خططه.
وقد كان كانط بطرحه لتلك الرؤى يقدم أفكارًا جذرية بالنسبة لعصره، فهو يعزز حوارًا معينًا في الغرب بدأ قبله بجيل أو نحو ذلك مع فلاسفة مثل جون لوك الذي نادى بنظام حكومي لا يَحكم بموجب حق إلهي، ولكن بالإرادة السيادية للمحكومين، أي أفراد المجتمع السياسي. والطريقُ الوحيد الذي جعل هذه الأفكار معقولة ومتسقة مع المنطق هو أن يُعطَى البشر قيمة حقيقية كبشر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تشديد كانط على القيمة الإنسانية لم يكن مبنيًا على أساس ديني رغم أنه نفسه كان مسيحيًا، كما أن مقولات لوك لم تكن مسيحية هي الأخرى، رغم إيمانه الشخصي. فكلاهما أراد أن يطرح نظريته عن القيمة الإنسانية بعبارات غير دينية، لتحصينها بقدر الإمكان ضد ما رأوه أهواء في الدين. ويتعين هنا أن نتذكر أن كليهما عاش في فترات الحروب الدينية في جميع أنحاء أوروبا، حين كان يتم إعدام الناس بسبب اختلاف ديانتهم عن ديانة الملوك الذين كانوا يحكمون بالحق الإلهي، ولم يكن للشعوب ملاذ يلجأون إليه للقصاص لمظالمهم ضد هؤلاء الملوك. وعلاوة على ذلك، كان كانط يدرك جيدًا تلك الهالة العاطفية التي تحيط بالدين في الغالب، وبالتالي لم ير في الاعتقاد الديني أساسًا مستقرًا بما يكفي للمبادئ الأخلاقية، والتي تتضمن الكرامة المتأصلة لدى كل الناس. وقد ألف كتابًا كاملاً عنوانه “الدين في حدود العقل وحده” (Religion Within the Limits of Reason Alone) حاول فيه استخلاص الممارسة والقناعة الدينية وفصلهما عن مشاعر وميول التدين، ثم ربطهما بشكل حصري مع تكوين الشخصية ذات الخلق والسلوك الأخلاقي القائم على المبادئ. كان شغله الشاغل في هذا الكتاب هو إبراز القيمة المتأصلة للبشر بأكثر السبل عمومية -والتي رأى أنها تتأتى باستخدام العقل الذي يملكه جميع البشر- حتى يصبح وجود منظومة أخلاقية مستقرة أمرا ممكنًا في العالم، بغض النظر عن الحالات الطارئة في الحياة، كتغيير نظام الحكم واعتناق أديان جديدة، واختلاف الأذواق الشخصية وما إلى ذلك.
وقد ناصرتْ حركةُ التنوير الغربي -التي كان كانط جزءًا منها- الأفكار حول الكرامة الإنسانية المتأصلة، وهو ما أحدث تغييرات اجتماعية جذرية في القرن الثامن عشر وما بعده. وبالطبع، فإن هذه الأفكار ليست خاصة بالتنوير الغربي فحسب، إذ يؤكد المفكرون والكتَّاب في شتى أنحاء العالم على تلك المفاهيم في إطار قواعدهم الفلسفية أو الدينية أو الثقافية الخاصة بهم. فالعلماء المسلمون -على سبيل المثال- منذ قرون مضت ومن مختلف أنحاء العالم، يفسرون القرآن بتفسير يعبر عن القيمة الإنسانية الأصيلة والكرامة الأخلاقية. ويعتبر عمل كولن مثالاً للباحث الإسلامي الذي يؤكد على “الصوت” القرآني، مع الإصرار على الجمال والقيمة المميزين للبشر. وفي الحقيقة، يجد كولن في القرآن وغيره من المصادر الإسلامية إشارات قوية إلى الكرامة الإنسانية في المقام الأول، وهو لا يربط مثل هذه الإشارات بالقرآن بعد تحديدها عن طريق وسائل أو مصادر مختلفة. ويشير كولن بشكل متكرر إلى أجزاء من القرآن عند الإجابة على أسئلة عن الجهاد والعنف والإرهاب واحترام الحياة الإنسانية بشكل عام (وليس حياة المسلم فقط). وفي هذه الأقسام من أعماله، يتضح تناغم كولن مع أفكار كانط، رغم أن كلاً منهما يؤسس تعبيراته الخاصة عن القيمة الإنسانية الأصيلة والكرامة الأخلاقية من منظورات مختلفة اختلافًا كليًا.
ويتحدث كولن في مختلف أعماله عن القيمة السامية للبشر، فيبدأ إحدى كتاباته بهذه العبارة القوية:
“إن البشر -وهم أعظم مرآة تعكس أسماء الله وصفاته وأعماله- يمثلون مرآة لامعة، وهم إحدى ثمار الحياة الرائعة، ومصدر للكون بأكمله، وبحر يبدو كقطرة صغيرة، وشمس تشكلت كبذرة ضئيلة، ولحن عظيم رغم مكانتهم المادية المتدنية، وهم سر الوجود كله مجموعًا في جسم صغير. إن البشر يحملون سرًا مقدسًا يجعلهم يساوون الكون بكامله بما يمتلكونه من ثراء في شخصيتهم، وهو ثراء يمكن أن يتطور إلى تفوق”.([13])
ويستمر كولن فيقول: “إن الوجود بكامله يصبح كتابًا مفتوحًا مع الفهم والبصيرة الإنسانية فقط… فالبشر -بجميع ما فيهم وما حولهم- … شهود يشهدون لمولاهم”.([14]) وينهي كولن هذه الفكرة بقوله: “عندما يتصل هذا الكون غير المحدود -بكل ما فيه من ثروات ومقومات وتاريخ- مع الإنسانية، يتضح لماذا تتجاوز قيمة البشرية قيمة أي شيء آخر… فالبشر -في الإسلام- لهم السيادة ببساطة لأنهم بشر”.([15])
في هذه العبارات، يتحدث كولن عن أن للبشر القيمة العظمى -في مقابل الملائكة أو الحيوانات- بصفتهم شهودًا ومفسرين للكون. فكونهم شهودًا يجعلهم انعكاسًا لبعض صفات الله ومرايا للكتاب السماوي للكون. ومن دونهم لا تكون هناك معرفة بالكون ولا يكون هناك أحد أصلاً لكي يعرف الكون.
وفي موضع آخر، يكرر كولن أن البشر هم مركز الكون ومعناه، وبالتالي فهم يمتلكون قيمة أكبر حتى من قيمة الملائكة، فالبشر -من خلال أوجه نشاطهم وتفكيرهم- يعطون للحياة جوهرها. فيقول:
الإنسان هو جوهر الوجود والعنصر الحيوي فيه، وهو المؤشر والمقوم الأساسي للكون، فالبشر هم مركز الخلق، وكل ما عداهم -سواء كان حيا أو غير حي- يشكل دوائر متمحورة حولهم… وبالنظر إلى كل ذلك التكريم الممنوح للإنسانية مقارنةً بكل ما عداها من مخلوقات، يجب أن يُنظر إلى الإنسانية باعتبارها الصوت الذي يعبر عن طبيعة الأشياء، وطبيعة الأحداث، وبالطبع طبيعة تلك الذات العلية التي تقف وراء كل شيء، وفهمُها باعتبارها القلب الذي يسع كل الأكوان. فبوجود البشر عثرت الخليقة على من يفسرها، وتم تحليل المادة من خلال معارف البشر وصولاً إلى مضمونها ومغزاها الروحي. فمراقبة الأشياء قدرة يتميز بها البشر وحدهم، وقدرتهم على قراءة كتاب الكون وتفسيره امتياز ينفردون به، ونسبتهم كل شيء إلى الخالق نعمة عظيمة يتمتعون بها. فتأملهم بصيرة، وكلامهم حكمة، وتفسيرهم الحاسم لكل الأشياء محبة.([16])
إذن، فيما ينادي كانط بوجود قيمة متأصلة للبشر تنبع من كونهم كائنات عاقلة من خلالها يصبح للقانون الأخلاقي وجود عملي في هذا العالم، يتحدث كولن عن قيمة البشر باعتبارهم الخلفاء الوحيدين الذين يمكن من خلالهم التعرف على كتاب الله من المخلوقات، والتعبير عن عجائب الوجود. وفي الحالتين، نجد البشر -كأفراد أو كمجموعات- لا غنى عنهم بالنسبة للمقومات الأساسية للوجود، والتي هي الأخلاق التي يدركونها بالعقل أو جميع أشكال المعرفة والحكمة والمحبة التي يكتسبونها من كونهم انعكاسًا لأسماء الله وصفاته.
علاوة على ذلك، نجد أن كلاً من كولن وكانط يعد القيمة والكرامة الإنسانية هما الأساس في تعريف السلوك الشرعي وغير الشرعي تجاه أفراد المجتمع، رغم أن كولن يبني دعواه على القرآن لا على العقل وحده، على خلاف كانط. ففي إحدى كتاباته حول حقوق الإنسان في الإسلام، يؤكد كولن أن الإسلام يتضمن التصور الأمثل لحقوق الإنسان العامة، ولا يتفوق عليه في ذلك أي ديانة أو نظام أو هيئة، فيقول: “يعتبر الإسلام أن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، فقتل شخص واحد يجيز فكرة أن أي شخص يمكن قتله”.([17]) ويدلل كولن على ذلك بطريقة شائعة عند معظم المفكرين والفلاسفة الدينيين، وهي أنه يجوز قتل من يقتلون غيرهم ومن يحاولون تدمير المجتمع، وهكذا. ففي هذه الحالة لا يكون القتل جريمة بل عقابًا أو دفاعًا عن النفس. وقد شرح ذلك في موضع آخر من وجهة النظر الإسلامية، فقال:
كل إنسان -سواءً كان رجلاً أم امرأة، صغيرًا أم كبيرًا، أبيض أم أسود- له حرمته ويحظى بالاحترام والحماية، ولا يستحل ماله أو عرضه، ولا يجوز طرده من أرضه أو سلب حريته، ولا يجوز منعه من أن يعيش وفق مبادئه ومعتقداته. وما يحرم على غيره يحرم عليه أيضًا ارتكابه بحق الآخرين؛ فلا يحق له إيذاء تلك الهبة (أي الإنسانية) التي وهبها الله له، لأن هذه النعمة ما هي إلا أمانة أودعها لديه الله وحده الذي يملك كل شيء… ويجب على الإنسان أن يدافع عن تلك الهبة وأن يحافظ على سلامتها؛ فهي مقدسة بالنسبة له، فلا يحق له الإضرار بها أو السماح بأن تتعرض للضرر. وعليه أن يقاتل وأن يموت من أجلها إذا لزم الأمر.([18])
هنا أيضًا نجد أن كولن ينسب القيمة الإنسانية إلى الله، فالإنسانية أو الوجود الإنساني هبة لا يجوز التعدي عليها أو انتهاكها، ومن ثم فهي الأساس في كل ما أمر به الله -كحماية الناس والحفاظ على حياتهم- وكل ما نهى عنه -كإيذاء الناس أو سرقة مالهم-. ويرى كولن أن هذه النواهي تتعارض تمامًا مع روح المحبة التي يصفها بأنها “قلب الإسلام”، فيقول:
“الحب في الحقيقة هو زهرة عقيدتنا.. هو قلب لا يشيخ أبدًا. فكما نسج الله ذلك الكون على مغزل الحب، فإن الحب هو دائمًا ذلك اللحن الساحر الذي يتردد في صدر الوجود”.([19])
هذا الحب يتمثل في شكل مشاعر إنسانية تزرع داخل الناس المحبة تجاه الآخرين وتجاه جميع المخلوقات، وتجعلهم يظهرون تلك المحبة بتقديم الدعم والخدمة إلى كل العالم، وهذا هو ما يصفه كولن بأنه جوهر الإسلام. إلا أن هذه الفكرة للأسف قد أُهملت أو أفسدت تمامًا، وهو يوضح ذلك قائلاً:
“الفلسفة الإنسانية عقيدة تدعو إلى المحبة والإنسانية، ولكنها أصبحت تفسَّر في عصرنا هذا بشكل خاطئ، ويمكن التلاعب بها بسهولة من خلال التفسيرات المختلفة لها… ومن الصعب التوفيق بين الفلسفة الإنسانية وذلك السلوك الغريب بتغليب “الشفقة والرحمة” مع من يتورطون في نشر الفوضى والإرهاب لتقويض وحدة بلد من البلدان، أو مع من يقتلون الأبرياء بدم بارد في حركات دامت قرونا بهدف تدمير رفاهية أمة من الأمم، أو الأفظع من ذلك مع من يفعلون هذا باسم القيم الدينية ومن يتهمون الإسلام عن جهل بالإرهاب”.([20])
يشير كولن هنا إلى ذلك النفاق والعنف الموجودين في الكثير من حركات الحداثة التي تدعي أنها إنسانية، وقد ذكر بشكل عابر من يرتكبون فظائع مماثلة باسم الدين، وما نلاحظه في الحالتين هو غياب “عقيدة المحبة والإنسانية” الصادقة التي ينبني عليها كلاهما في شكلهما الحقيقي. هنا يأتي الإسلام -في رأيه- ليشترك مع “الفلسفة الإنسانية الحقيقية” في الالتزام بحب الإنسانية، مع الفارق في أن الإسلام يستمد ذلك الالتزام من القرآن الذي نزل به الوحي، بينما تستمده الفلسفة الإنسانية من مصادر أو طرق أخرى.
وتبدو روح منهج التحليل الخاص بكانط واضحة لدى كولن، وإن كانت تنبع من إطار مختلف تمامًا، وهو نظرة الإسلام الفلسفية الدينية للعالَم. فالقيمة المتأصلة للإنسانية -والتي تصل إلى حد القداسة- تتطلب حماية شاملة وتحرِّم بشكل مطلق أيَّ اعتداء عليها. وفي الغرب، وَجدت أفكار كانط (ولوك أيضًا) عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المتأصلة تجسيدًا سياسيًا من خلال الديمقراطية الليبرالية للدولة القومية الحديثة، في حين طَبقت المجتمعات الإسلامية التزامها تجاه الكرامة الإنسانية بطرق أخرى. ولكن رغم هذه الاختلافات بين الغرب والبلاد الإسلامية، لا يرى كولن أي تعارض أصيل بين الإسلام والديمقراطية بشكل عام؛ فالالتزامات الأساسية تجاه البشر وحقوقهم الجوهرية تتسق مع بعضها البعض، رغم اعتمادها على منطلقين مختلفين (الأول ديني والآخر علماني). إلا أن كولن يؤكد أن الإسلام يمكنه الارتقاء بالديمقراطية في نواحٍ مهمة؛ حيث يَعتبر أن الديمقراطية في العصر الحديث قد تزاوجت مع فلسفات مختلفة من حولها -مثل المادية الجدلية والتاريخانية- يعتبرها كولن “فلسفات مدمرة”. كما أن النُّظم الديمقراطية يمكن أن تخلق حالة من الفردانية الطاغية التي تقوض أركان المجتمع بأكمله، وإن كان كولن يؤكد أنه في الإسلام “جميع الحقوق مهمة، ولا يمكن التضحية بحقوق الفرد بها في سبيل مصلحة المجتمع”.([21]) وأخيرًا يرى كولن أن الإسلام هو مجموعة شاملة من المبادئ المستمدة من الدين يمكن أن توجه الديمقراطية في عملية نموها ونضجها المتواصل. ويوضح ذلك قائلاً:
“لقد تطورت الديمقراطية مع الوقت، وكما مرت بالعديد من المراحل المختلفة في الماضي فإنها ستستمر في التطور والتحسن في المستقبل. وخلال مسيرتها هذه، ستتشكل الديمقراطية لتصبح نظامًا أكثر إنسانية وعدلاً، لتكون نظاما قائما على الصلاح والحق. فإذا نُظر إلى البشر ككل، من دون تجاهل البعد الروحي لوجودهم وحاجاتهم الروحية، ومن دون إغفالِ أن الحياة الإنسانية لا تقتصر على هذه الحياة الفانية، وأن كل الناس يتوقون بشدة إلى الخلود – فإن الديمقراطية يمكنها أن تصل إلى ذروة الكمال، وأن تجلب المزيد من السعادة للإنسانية. وتستطيع المبادئ الإسلامية مثل المساواة والتسامح والعدالة أن تساعد الديمقراطية في تحقيق ذلك.([22])
وكما هو واضح، فإن كولن يرى نقاط ضعف في الديمقراطية يستطيع الإسلام أن يعالجها، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الإنسانية وكيفية النظر إلى البشر. فالديمقراطية تميل إلى إهمال الأبعاد الروحية للحياة ذاتها وللطبيعة الإنسانية أيضًا، وهي الصفات التي تتطلب احترامًا عامًا بل وتبجيلاً من البشر أنفسهم. قد يستنكر كانط هذا الطرح من كولن، على الأقل لسبب واحد هو أن الأخير يؤصل المجتمع بأكمله -بما في ذلك أنظمة العدالة والأخلاق- على أساس رؤية دينية للعالم، وهو ما يعني وضع المجتمع في يدي شيء لا يمكن في النهاية -من وجهة نظر كانط- إثباته عقلانيًا وبشكل مؤكد، وبالتالي يقع في نطاق الضمير أو الإيمان، ولا يمكن فرضه دون استعمال العنف ضد الإنسانية نفسها التي يسعى للدفاع عنها وتكريمها. ومن ناحية أخرى، كان كانط ربما سيسعد بنتائجِ أية رؤية دينية للعالم تضفي قداسة واحتراما أكبر على البشر، بحيث تصبح قيمتهم المتأصلة حقيقة مقدسة، لكنه حينها كان سيقول ببساطة: إن هذه النظرة الشاملة تقف على أساسٍ أقلَّ قوة مما كان يرجو، نظرًا لأنها مبنية على العواطف أو الإيمان الذي لا يمكن إثباته في نهاية المطاف.
ورغم كل شيء، يمكننا القول: إن تلك النظريات عن القيمة المتأصلة للكرامة الأخلاقية للبشر -سواء قال بها مفكرو التنوير الغربي أم علماء إسلاميون يتبعون تفسير القرآن أم غيرهم من أي مذهب كان- تلعب دورًا حيويًا في هذا العصر. فالدعاوى وحدها لا تحقق شيئًا. وكما نرى من حوادث التاريخ، قد يحدث أن ينتظم الناس تحت رايات وشعارات سامية مثل “الإنسانية” و”حقوق الإنسان” و”المواطن العادي” ثم يرتكبون فظائع وحتى إبادات جماعية ضد نفس البشر الذين يدعون احترامهم، وهذا هو النفاق بعينه والخطيئة التي تُلوث الحياة الإنسانية. ولكن عندما يكرس البشر أنفسهم بصدق وبإخلاص لتلك الدعاوى، ويحددون تصرفاتهم وفقًا لها، تصبح الثقافة والمجتمع أقل وحشية وأقل دموية وأقل بهيمية. ويبين لنا التاريخ أيضًا -بخلاف الاضطهاد والإبادة الجماعية- أن المجتمعات التي تُبقي القيمة الإنسانية المتأصلة حية في صميم وجودها السياسي والثقافي تسمح لأبنائها ومواطنيها بدرجة من السلام والاستقرار، وقد وُجدت هذه المجتمعات في كل زمان ومكان عبر التاريخ الإنساني. وعندما تُسقط تلك المجتمعاتُ نفسَها في الاضطهاد والإبادات الجماعية، يكون ذلك في أغلب الأحيان لأنها تركت مبادئ القيمة الإنسانية المتأصلة والكرامة الأخلاقية.
وبالتأكيد على القيمة المتأصلة وكرامة الإنسانية، فإننا نؤكد أيضًا بشكل ضمني على الشروط التي تدعم تلك الإنسانية وتحافظ عليها، فتكريم الإنسانية يعني الالتزام بالنظم الفلسفية والروحية والاجتماعية والسياسية التي تغذي تلك الإنسانية وتصل بها من خلال نموها وتطورها هي إلى أقصى درجات التجسد في الأفراد والجماعات. وأحد تلك الشروط هو الحرية، حرية التفكير والتعلم والتعبير واختيار الحياة المناسبة، وهذه الفكرة هي موضوع الفصل التالي.
[1] Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, 5. (كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق.)
[2] المصدر السابق، ص 7. [3] المصدر السابق، ص 8. [4] المصدر السابق، ص 9. [5] المصدر السابق. [6] المصدر السابق، ص 14. [7] المصدر السابق، ص 36. [8] المصدر السابق. [9] المصدر السابق، ص 40-41. [10] المصدر السابق، ص 41. [11] المصدر السابق، ص 42. [12] المصدر السابق، ص 43.
[13] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 112 (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح). [14] المصدر السابق. [15] المصدر السابق، ص 113. [16] المصدر السابق، ص 116. [17] المصدر السابق، ص 169. [18] المصدر السابق، ص 114. [19] المصدر السابق، ص 8. [20] المصدر السابق، ص 8-9. [21] المصدر السابق، ص 221. [22] المصدر السابق، ص 224.

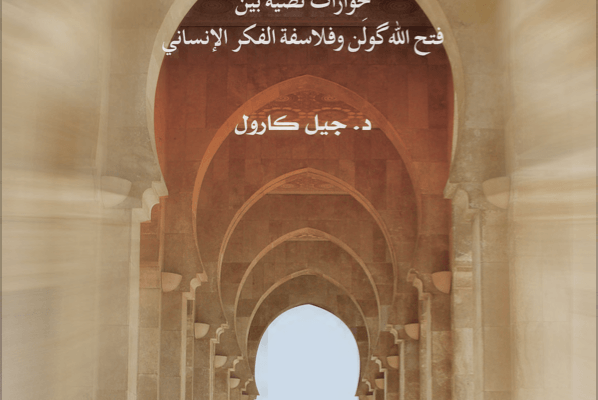
Leave a Reply