هل العلوم المادية أوثق أم الإنسانية؟
تهدف هذه المقالة العلمية إلى التشكيك في حكم قديم حديث، لطالما تكرَّر في مصادر علم “المناهج”، وفي مذكرات الباحثين ومقالاتهم؛ وهو “أنَّ العلوم المادية يسيرة يقينية، يمكن القطع فيها؛ أمَّا العلوم المتعلِّقة بالإنسان، فهي غير منضبطة، ويستحيل الانتهاء فيها إلى قاعدة، أو قانون، أو نظرية علمية محكَمة”؛ ولقد كان الواحد منَّا لسنوات يردِّد هذه القناعة، لِما يبدو فيها من “بداهة وبساطة” ابتداءً، ومن “استرخاء وتبرير” بالتبع. إلاَّ أنَّ العلم من طبيعته أن يتطوَّر، والمنهجَ من شأنه أن يُفرَك،وإلاَّ تحوَّل إلى معيارٍ،وإلى معتقَد، ففقد -بالتالي- وظيفته المعرفية الأبستمولوجية؛ وفي هذا الصدد تأكَّدتُ أنَّ القناعة الواردة أعلاه، ليست صوابًا دائما، وليست خطأً بالضرورة. وبيان ذلك ما يلي:
إنَّ العلوم المادية مصدرها “بشَريٌّ” صِرفٌ، أي إنَّه لم ينزل وحيٌ، ولن ينزل أبدا، يبيِّن الحقائق المادية بالتفصيل والتجزيء، وبالتدليل والتطبيق… ذلك أنَّ الأمر متروك لعقل الإنسان، بل -بالتعبير القرآني- هو موكول إلى “استطاعته” وجهده واجتهاده، قال تعالى: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ(الرحمن:33). ومِن ثم فإنَّ استحالة استيعاب أسرار العلوم المادية سببُه ومرجعه “بشريَّة المصدر”، و”بشريَّة المنهج”، وحتمية “تطوُّر المدارك البشرية عبر الزمن”.
أمَّا العلوم المتعلِّقة بالإنسان، منشأً وموضوعًا، ومسارًا ومنهجًا، والمسمَّاة بـ”العلوم الإنسانية” اصطلاحا؛ فهي إذا عوملت بمنطق بشريٍّ محضٍ، ووُظِّفت فيها قدرةُ “العقل البشريِّ المحدود” بلا سند ولا دليل، تتحوَّل إلى “حقل للأوهام والتخمينات”، وتؤول إلى “غابة للمفاجآت والاحتمالات”؛ ومن ثم يكون الحكم بأنها أقلُّ وثوقية ويقينًا من العلوم المادية صادقا، وصحيحا، لا غبار عليه.
أمَا، وإنَّ ميزة هذه الحقول الإنسانية الاجتماعية الفكرية الحضارية، أنَّ مصدَرها متكفَّل به مِن قِبل “خالق الإنسان والمصدر والعقل معًا”؛ أي ما يُعرف في مصادر المعرفة بـ”الوحي”؛ أمَا وإنها كذلك، فإنَّها تصبح أيسرَ على الفهم والإدراك، وألصقَ بالصدق المطلق، وأقربَ من الحقِّ الخالص، وأعمقَ في النفس بما لا يتجدَّد ولا يحيد؛ أعني بهذا “المصدرَ الربّاني”، الوارد من “أعلم معلِّم”، وممن “لا تبدو له البدوات”، “ولا تندُّ عن علمه شاردة ولا واردة”، بل إنَّ “الإرادة” و”الوجود” و”العلم” في حقِّه تعالى مترادفاتٌ متلازماتٌ لا تنفصل، قال تعالى:
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا(يس:82)، هذه الإرادة اللاّمتناهية،
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ، وهذا الأمر والعلم الذاتيُّ الكلِّي،
فَيَكُونُ، وهذا الوجود والتمثُّل في خطِّ الزمان والمكان.
مِن هنا ننتهي إلى أنَّ إسناد العلوم الإنسانية الحضارية بالوحي يرقى بها إلى مصافِّ “العلم اليقينيِّ”، ويحقِّق إمكانية الوصول فيها إلى “فهم شموليٍّ”، وإلى “إدراك كونيٍّ”؛ وبالتالي يكون لها السبق على العلوم المادية الصِّرفة، التي لا ولن يردفها الوحي، لكونها موكولةً إلى اجتهاد البشر.
أمَّا إذا تخلَّت العلوم المتعلِّقة بالإنسان عن المصدر المطلق المتعالى المتجاوز، فإنها تتحول إلى “ألغام، وألغاز، ومعمَّيات”، فتتفوَّق عليها العلوم المادية؛ لإنها تستند إلى العقل، والمنطق، والتجربة، وتقع تحت “تصرُّف” الراصد والدارس والباحث.
وأزعم من خلال هذه المقالة، أنَّ الأستاذ فتح الله كولن، في نتاجه الفكري وثمراته الواقعية، كان يجتهد في استجلاء معالم “نظرية يقينية، شمولية، حضارية، كونية”؛ لا تقتصر على “جانب دون جانب”، ولا على “حقل دون آخر”، بل تطال الوجودَ البشريَّ كلَّه، وهو في هذا يستقي من نبع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ويسير على خطى سيدنا “ترجمان الحقائق” محمَّد عليه أزكى السلام.
يقول الأستاذ في طرق الإرشاد، تحت عنوان “الشمولية”: “إنَّ الأنبياء عندما يقومون بتبليغ رسالة الله يوفون حقّ هذه المهمة بأصولها وقواعدها وطرقها الصحيحة التامَّة (…) إذ يتناولون الإنسان من جميع جوانبه، كلاًّ شاملا وغير مجزَّأ، ويقدِّمون له رسالته في إطارها الكامل دون أيِّ نقص. ومِن ثمَّ لا يبقى أيٌّ من العقل، والمنطق، والقلب، والأحاسيس، والشعور خارج أنوار الوحي، ولا يترك أو يهمل أيٌّ من هذا”.
وتلك النظرية الشمولية، يمكن -مجاراةً لتطوُّر المفاهيم والمناهج، وقصدًا لإبلاغ المعنى بلغة المعرفة العصرية- أن نطلق عليها اسم “نظرية كلِّ شيء” (Theory of Everything).
فهل يتمكَّن المقال من الدفاع عن هذه الأطروحة العلمية، المكوَّنة من شقين: أحدهما منهجيٌّ فلسفيٌّ، والثاني فكريٌّ حضاريٌّ؟
ذلك ما يمكن الحكم فيه إيجابا أو سلبا، بعد الاطلاع على تفاصيل الدراسة، التي أستعين فيها بالله، وأدعوه أن يريني الحقَّ حقًّا، ويهديني لاتباعه واتباع أهله. والله ولي التوفيق.
النظرية، المصطلح والمفهوم
وظَّف الباحث مصطلح “النظرية”، لا لكونه الأنسبَ والأليقَ بما يحويه هذا المقال؛ لكن لكونه الأكثر تداولا في الدوائر العلميَّة من جهة، وللنسبة التي فرضته فرضا أي “نظرية كلِّ شيء” من جهة ثانية؛ وإلاَّ فمصلطحا “البراديم، والنموذج”، هما الأكثر دلالةً في سياقنا هذا؛ علما أنَّهما يتضمَّنان النسبة إلى “كلِّ شيء” أساسا، ولا حاجة للتخصيص، فلا يستساغ اصطلاحا أن يقال: “براديم كلِّ شيء” أو “نموذج كلِّ شيء”؛ وإلاَّ حصل نوع من التكرار بين مضمَر ومظهَر.
أمَّا مفهوم “النظرية” في هذا المقال، فهو يتجاوز المفهوم الفلسفيَّ، الذي طرحه “لالاند” مثلا، مِن أنها: “إنشاء تأمُّليٌّ للفكر يربط نتائج بمبادئ”، فهذا التعريف يجعل النظرية في تقابل مع الواقع؛ أمَّا في بحثنا هذا فنربط العلاقة بحبل متين بين “النتائج والمبادئ” من جهة، و”الواقع وخطِّ الزمن” من جهة أخرى؛ مستندين إلى دلالة العلم في الفكر الإسلامي، هذه الدلالة التي تربط بين العلم والعمل بلا هوادة ولا توانٍ، وترفض كلَّ شكل من أشكال الفصل بينهما؛ وهو ما يتجاوز مجرَّد النظر العقلي الخالص.
والتعريف الأكثر ملاءمة للنظرية أو النموذج أو البراديم في بحثنا، هو أنها “بنية فكرية تصورية يُجرِّدها العقل الإنساني من كمٍّ هائل من العلاقات والتفاصيل؛ فيختارُ بعضها ثم يُرتِّبها ترتيبًا خاصًّا، أو يُنسِّقها تنسيقًا خاصًّا، بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطًا يتميَّز بالاعتماد المتبادل وتشكل وحدة متماسكة يُقال لها أحيانًا عضوية” ومن ثم ينطلق صاحب النظرية من نظريته بغية تشكيل الواقع وتغييره والتأثير فيه بناء على النموذج، ومِن هنا جاءت أهمية هذه النظرية، وضرورتها، وأولويتها.. في كلِّ بناء فكريٍّ عميق.
والمنهج المتوخَّى في فهم فكرِ صاحب النظرية، أو محاولةُ تمثُّله، هو استيعاب نظريته والعمل وفقها، وبالتالي -من الناحية الوظيفية- يكتسي هذا الفكر -بفضل النظرية- صفةَ العالمية والشمولية، والتجاوز على الزمان والمكان، أمَّا إن افتقد هذا البناء النظريّ وهذا النموذج المنهجيّ، فسيتحوّل إلى حالة زمنية مكانية ظرفية، لا يمكن استيعابها، ولا إعادة تمثُّلها، فتفقد صفة الدوام والصلاحية لكلِّ زمان ومكان ضرورة.
وللنظرية أو النموذج عدَّة خصائص، منها الشمولية لكلِّ جوانب الموضوع، والقدرةُ على التفسير، وعدمُ التناقض، وهي ليست الواقع بعينه، بل هي الصورة المطلوبة للواقع…
ولا بدّ من التنبيه إلى انزلاق منهجيٍّ خطير، وهو أنَّ الهيمنة المعرفية المادية اليوم، من جهةٍ، وضعف التوجُّه التوحيدي معرفيًّا من جهة ثانيةٍ، فرَضَا علينا انهزامًا مفهوميًّا مسبقا؛ حتى إنَّنا لنستكثر على “محمد” أو “إبراهيم” أو “عبد الله” أو أيَّ اسم له صلة بالإسلام أن يكون له “نظرية”، أو ينسبَ إليه “نموذج”؛ أمَّا إذا تعلَّق الأمر بـ”جون” أو “جاك” أو “شيمون”، فهم أهلٌ لأن يُنسبوا إلى الإبداع، وتنسبَ إليهم علوم ونظريات واختراعات… ولا بدَّ أولا أن نعالج هذه الظاهرة على مستوى انهزامنا الذاتيِّ، قبل أن نخاطب بها العالم الخارجيَّ. وهذا ما أعتمده في مقالتي هذه، فهي تعلن بوضوح ودليل أنَّ لفتح الله كولن “نظرية” شمولية كلية متخذة من الوحي منطلقا ومصبًّا، كما أعلنتُ قبلُ أنه صاحبَ “براديم” مختلف هو: “البراديم كولن”، مع احترام العلم والمنهج، وتوخِّي الدقَّة والحذر بالطبع.
“نظرية كلِّ شيء“، التعريف والتطبيقات
“نظرية كلِّ شيء” هي نظرية فيزيائية أساسًا، وتعني “المجالَ النظري للفيزياء الذي يقدِر على تفسير جميع الظواهر الفيزيائية بشكل كامل وربطها معًا (أي كل شيء) في عالم الفيزياء” وترجمة المصطلح باللغة الإنجليزية هو: Theory of everything، أو اختصارا TOE، أو معادلة الكون Weltformel.
وينسب إلى آينشتين هذا “الحلم” الذي أضاع فيه -هو والكثيرون من العلماء- الكثيرَ من الوقت والجهد، بحثا عن نظريةٍ تفسِّر جميع الظواهر الكونية؛ لكنهم لم يفلحوا في النهاية. وقد كان المصطلح في البداية يُستخدم لوصف بعض النظريات العامة بطريقة ساخرة على أنها “نظريات لكلِّ شيء” لعموميتها الواسعة، مع مرورِ الوقت ترسَّخ استخدام المصطلح مع “فيزياء الكمِّ” لوصف النظرية التي تستطيع ربط أو توحيد النظريات المتعلِّقة بالتفاعلات الرئيسة الأربعة في الطبيعة (قوة نووية قوية، قوة نووية ضعيفة، قوة كهرومغناطيسية، الجاذبية).
ولقد ترشحت أربع نظريات لتكون الواحدة منها “نظرية كلِّ شيء”، كلُّها لم تفلح إلى حدِّ اليوم، وهي:
- نظرية الثقالة الفائقة Supergravity
- نظرية-إم M-Theory
- نظرية الأوتار String theory
- نظرية الأوتار الفائقة Superstring Theory
“نظرية كلِّ شيء” في الفلسفة
الفلسفة هو المجال الأنسبُ لمقالنا هذا، ولذا كان من المفيد البحثُ عن “نظرية كلِّ شيء في حقل الفلسفة”، وهذا ما تم فعلاً، فتبيَّن أنَّ ثمة “نظرية كلِّ شيء الفلسفية”، غير أنها لا تعالج إلاَّ ظواهرَ الكون، أي وكأنها نظريةٌ فيزيائية من مدخل فلسفيٍّ، ولذا عرف أنَّ أرسطو، وأفلاطون، وهيغل، ووايتهيد، وآخرون.. كانت لهم محاولات “لبناء نظام شامل للكون”. كما كان هناك آخرون متردِّدون بشكل كبير حول احتمالية وجود مثل هذه النظام. ويبقى أننا لم نطَّلع على “نظرية كلِّ شيء” ذات طابع فكريٍّ حضاريٍّ شموليٍّ إنسانيٍّ؛ وهذا لا يعني نفيِ الوجود بالطبع.
إخفاق الفزيائيين، وطبيعة ذلك
أولا: العجز عن تحقيق “نظرية كلِّ شيء“
لم يفلح الفيزيائيون في بناء “نظرية كلِّ شيء” وقد أصيبوا بخيبة أملٍ كبرى، رغم أنهم جنَّدوا لها جيوشا من الباحثين؛ فمثلا، ورد في مقدمة كتاب “الكون الأنيق: الأوتار الفائقة، والأبعاد الدفينة، والبحث عن النظرية النهائية” للفيزيائي “برايان غرين”، الذي صدر بالعربية ضمن سلسلة “المنظمة العربية للترجمة”، نقرأ هذه العبارة الدالة على مدى العمل العلمي المؤسَّسي في المحيط الغربي، يقول: “إنني أقرُّ بكلِّ امتنان بالدعم الكريم لأبحاثي في الفيزياء النظرية على مدى أكثر من عقد ونصف من السنين، بواسطة المؤسَّسة القومية للعلوم، ومؤسَّسة ألفريد أ. سلون، وقسم الطاقة بالولايات المتحدة. وربما ليس غريبا أن تكون أبحاثي قد تركَّزت على تأثير نظرية الأوتار الفائقة على مفهومنا عن الزمان والمكان، وفي الفصلين الأخيرين قمتُ بشرح بعض الاكتشافات التي كان لي حظٌّ المشاركة في إنجازها. ومع أنني آمل أن يستمتع القارئ بالأمور الداخلية، فإنني أدرك أن ذلك قد يترك انطباعا مبالغا فيه على الدور الذي لعبتُه في تطوير نظرية الأوتار الفائقة. ولذلك أنتهز الفرصة لأقرَّ بفضل أكثر من ألف فيزيائي من جميع أنحاء العالم، ساهموا وكرَّسوا حياتهم لجهود تحديث النظرية النهائية للكون. وإنني أعتذر لكلِّ الذين لم يتضمَّن الكتاب أبحاثهم، ولا يعكس ذلك إلاَّ وجهة النظر التي اخترتها، وتحديد حجم الكتاب”.
والقارئ للمقالات المتخصصة عام 2005، المنشورة في مختلف مجلات ومواقع العلوم، وكذا المطالِع لكتاب “الكون الأنيق: الزمان، المكان، الحقيقة… كل شيء لإعادة التفكير”، الذي تصدَّر قائمة الكتب الأكثر مبيعا، وكان أوَّل كتاب يحظى بهذا الحجم الهائل من الاهتمام، بعد كتاب “موجز تاريخ الزمان” لـ”ستيفن هاوكنغ”، الصادر في الثمانينيات؛ هذا القارئ يلاحِظ أنها تبشِّر ببوادر “نظرية كلِّ شيء”، وأنها هي نظرية الأوتار الفائقة، وهذا سيحلُّ مشكلة تأزُّم الفيزياء، والاختلال الواقع بين قوانين الكون المتناهي في الكبر وقوانين الكون المتناهي في الصغر.
أمَّا بعد عامين فقط، أي خلال عام 2007م، فقد بدا أنَّ المولودَ المبشَّر به لم يهلَّ، أو أنه ولد ميِّتا، فكتب “لي سيمون” -وهو أحد رواد نظرية “الأوتار الفائفة”- مقالات بعنوان: “لا شيء بخير في الفيزياء، فشلُ نظرية الأوتار!”، وهذا بعد تجنيد العقول لأكثر من عشرين عاما كاملةً، على حساب مجالات البحث الأخرى، في الفيزياء بالخصوص، الأكثر نفعا للبشرية، والأكثر إلحاحا على مسار الحضارة. ولقد تحطَّمت جميع نظريات “كلِّ شيء” الفيزيائية على عتبة المشاكل الخمسة للفيزياء المعاصرة.
وهذا بتقديرنا يعني أنَّ الفيزياء ليس دورُها هو الوصول إلى حدِّ اليقين، ولا الاهتداء إلى الصدق المطلق، ولا تحديد المعايير للفكر البشريِّ، ولا شرح الغايات والمآلات والحقائق الكبرى، وإنما دورها الهام جدًّا يكمن في التطوير، وضمان مواصلة عجلة الفكر والعقل في السير، وموضوعها لا ينبغي أن يتجاوز المادَّة إلى الإنسان أو الخالق أو المعنى أو الغيب، فهذه جميعا ليست الفيزياء مرشحة للبثِّ فيها؛ ولذا كان من خصائص العلوم الطبيعية عموما، والفيزياء بالخصوص، ما سماه “كارل بوبر”: “القابلية للتفنيد”؛ فكلَّما كانت نظرية أكثر قابلية للتفنيد كانت أكثر علمية، وكلما كانت أكثر قابلية للتصديق تحولت إلى “معتقد” (dogma).
ولقد زار العالم الأمريكي “مايك سيمونس” معهد المناهج بالجزائر، وألقى فيه محاضرةً حول تبسيط العلوم؛ ومن جملة الأسئلة التي طُرحت عليه من قِبل الحضور، سؤال عن “نظرية كلِّ شيء” وعن مدى تحققها وإمكانيتها؟ فكان جوابه دالاَّ على ما ذكرناه من ضعف الإنسان وأثرِ ذلك على استحالة استيعاب المطلق، قال في ذلك: “لا أستطيع نفي هذه النظرية علميًّا، ولكن، الشيء الذي أنا متأكد منه بأنَّ ضعف الإنسان وضيقَ قدراته المعرفية، لا يستطيع من خلالها أن يفسّر كلَّ ما يحدث أمامه في الكون بنظرية بشرية واحدة. فأنا أرى بأنَّ هذا غير منطقي”.
ثانيا: “النوترينو” يحطِّم بناء الفزياء من لدن آنشتين
ومِن أبرز الأدلَّة على أنَّ العلوم الدقيقة ليست المرشَّح الأوَّل لليقين، أنَّها دوما تستند إلى الرياضيات لتكتسي حلّة من اليقين الرياضي، وفي ذلك يقول “هينري بوانكاري”: “إنَّ العلوم تتسابق لاستعمال الرياضيات للتعبير عن نفسها ولغزو المجهول!”. بل إنَّ القضايا الرياضية نفسها حين تتعلق بالمنطق التجريبي تبقى معلَّقة، وغير يقينية كليًّا.
ودليل آخر على “لايقينية العلوم التجريبية”، هو أنَّ نظريةً ما قد تسيطر على الفكر البشري قرونا، وتؤتي ثمارها وأُكلها، فتبنى عليها صروحٌ، ثم يأتي من يدحضها، ويبين الخطأ فيها، فتموتُ ويولد مكانها مولود هو الأنسب لذلك الزمان، ومن ذلك “نظرية نيوتن” التي حلَّ محلَّها “النظرية النسبية”، ثم جاءت “النظرية الكمومية” لتحلَّ محل “النسبية”، ومن بعدهما برزت “نظرية الفوضى”.
واليومَ، وفي الأسابيع الماضية -فقط- أشارت نتيجة تجربة أجريت في “مُصادم هادرون” العائد للمنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) إلى أنَّه بإمكان بعض الجزيئات أن تتعدَّى سرعة الضوء، الأمر الذي يعتبر من المستحيلات حسب قوانين الفيزياء المعمول بها. فقد لاحظ العلماء أنَّ جزيئات “نوترينو” (Neutrino) التي أرسلت من مقرِّ المنظمة في جنيف بسويسرا (CERN Genova)، إلى مختبر “جران ساسو” (Gran Sasso) في إيطاليا، الذي يبعد عنه بمسافة 732 كيلومترا قد وصلت قبل موعدها بجزء من الثانية.
ولقد وضعت هذه النتيجة التي تهدِّد بدحض كلِّ ما توصَّل إليه علم الفيزياء في القرن الأخير على الأنترنت، لكي يدرسها العلماء. وقد نشرت النتائج يوم الجمعة 23 سبتمبر 2011، على الساعة الثانية، في موقع جامعة “كورنيل” (Cornell)، فتسارعت وسائل الإعلام لنشر الخبر، ثم توالت التجارب آلاف المرات، فأعطت النتيجة نفسها، حتى إنَّ مخابرَ الولايات المتحدة لم تتقبل النتيجة ابتداء، ثم نَقلت التجربة، وأعادتها، فأعطت نتيجة إيجابية.
كلُّ هذا لا يقلِّل من قيمة النظريات العلمية الفيزيائية وغيرها؛ بل الأسف ملء الجوانح من تأخُّر أصحاب الديانات عموما، والمسلمين بالخصوص، في هذا المضمار؛ وإنما المقصد من هذا المقال هو إثبات أنَّ ما يبدو يقينيا في حقبة زمنية قد يصير خطأ في حقبة لاحقة، وهذه ميزة العلم، وهي متلازمة مع وظيفته؛ كما لا يمكن أن تتسم العلوم المعيارية بمثل هذه الصفة، وإلاَّ زال المعيار، وشقيت البشرية.
إخفاق الفكر الغربي، وسقوط الأيديولوجيات التوتاليرية
لو طرح اليوم عالمٌ من العلماء إحدى أبرز النظريات الغربية، على أنها الحلُّ والجواب على “سؤال الأزمة”، فبشَّر مثلا بالماركسية، أو بالنيتشوية، أو بالفرويدية…مثلا؛ فإنه سيتحوَّل إلى مهزلة، وإلى مثال للتخلف الفكريِّ؛ وما ذلك إلاّ لكون النظريات الراديكالية، الشمولية، الاختزالية، التي تقصُر الجواب على أعمق الأزمات في “سبب واحد”، أو “جملة من الأسباب” من طبيعة واحدة، متجاهلةً تركيبية الظاهرة البشرية. يقول المسيري: “تشكل أطروحات نموذج الرصد الموضوعي المادي (المتلقي) التربة الخصبة (وليس السبب الوحيد) لظهور النماذج الاختزالية التي تتسم بما يلي: التماسك الشديد – البساطة – التجانس – الواحدية – السببية الصلبة – الطموح نحو شمولية التفسير – الطموح نحو درجة عالية من اليقينية – الطموح نحو الدقة المتناهية في المصطلحات”.
ولعلنا نقتصر هنا على “العلمانية الشاملة”، التي اكتسحت -ولا تزال- عقول الملايير من البشر، ولم يسلم منها حتى المشتغلون بالفكر من “العالم الديني” كما يُفترض؛ ذلك لأنَّ هذا النموذج هيمن على مناهج وأساليب التفكير بصورة فادحة. فهذا النموذج ثبت فشله، لأنه سعى إلى “فصل القيم والغايات الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة وعن مرجعيتها النهائية، وتطبيق القانون المادي/الطبيعي على كلِّ مناحي الحياة، وتصفية أيِّ ثنائية بحيث يتم تسوية كلِّ الظواهر الإنسانية بالظواهر الطبيعية، فتنزع القداسة تمامًا عن العالم، ويتحول إلى مادة استعمالية يمكن إدراكها بالحواس الخمس” (المسيري).
فيلاحظ استعمال هذه الصيغ العمومية التعميمية: “كل”، و”أي”، و”تماما”؛ فليس فيها احتمال للنسبية، وللخطأ، وللرأي الآخر؛ ذلك أنَّ هذه النظريات الشمولية عوضَ أن تبقى نظريات في مستوى “الاجتهاد البشري”، أريد لها أن تتحوَّل إلى “ديانة”، أو إلى “بديل عن الديانة”، بحيث تجيب عن “أسئلة الوجود”، وإشكالات “الفراغ الكوني”؛ لا باعتماد المصدر الموثوق (الوحي)، والعلم الموثوق (علم الخالق)، وبالواسطة الموثوقة (الرسول)؛ لكن بالتنكر لها جميعا، وبافتراض القدرة على الاستغناء عنها كلية، وبأنَّ العقل والعلم هما المصدران الوحيدان، وما سواهما هو من قبيل “الخرافة”، أو “الغيب الذي لا يصدَّق ولا يكذَّب”.
ولقد أعلن فشل “الإيديولوجيات” في العديد من المحافل، وبصيغ عديدة، منها “النهايات”، على نمط “نهاية التاريخ”، و”نهاية الإنسان”، و”نهاية المعنى”… ثم على صورة “الصدامات”، على نمط “صدام الحضارات”، و”صدام الثقافات”، و”صدام القيم”… وقبل ذلك كانت “الصدَمات” تنخر عمق البشرية، وتعبِّر عن الفشل الذريع للنبوات الجديدة؛ ويعبِّر عن ذلك كتاب “صدمةُ المستقبل”.
ولقد أوصلت “النهايات” و”الصدامات” و”الصدمات” البشريةَ إلى حافة الهاوية، وازداد العنف بمسميات مختلفة، وتأزَّم الاقتصاد، واسغولت أممٌ لقوَّتها، وديست أخرى بسبب حماقاتها وضعفها، وكلُّ هذا لا ينبئ إلاَّ عن فشل الأيديولوجيات التبشيرية، والنظريات الشمولية البشرية، ولا يدلُّ إلاَّ على ضرورة البحث من جديد عن السعادة في منظومة “التوحيد” لا في صفوف “الواحدية”. يقول المسيري: “إنَّ إعلان فوكوياما نهاية التاريخ هو إعلان نهاية الإنسان وانتصار الطبيعة/المادة، أي الموضوع (اللاّإنساني) على الذات (الإنسانية)، ومعناه تَحوُّل العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين الواحدية المادية (التي تجسدها الحضارة الغربية) التي لا تُفرِّق بين الإنسان والأشياء والحيوان والتي تُحوِّل العالم بأسره إلى مادة استعمالية، فنهاية التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي”.
تفرد الفكر الإسلامي بإمكانية تحقيق السعادة البشرية
كتب “مراد هوفمان” كتابا بعنوان “الإسلام كبديل”، ولم يكن في الحقيقة من نوع الكتَّاب الذين يوظِّفون الشعارات الكبيرة الرنانة، لمجرَّد التهويل، وإنما هو عالِم محترَم، له خصائصه الفكرية والحضارية، وصاحب منهج علميٍّ متميِّز؛ ومما جاء في كتابه: “إنَّ الانتشار العفويَّ للإسلام هو سمة من سماته على مرِّ التاريخ، وذلك لأنَّه دينُ الفطرة المنزّل على قلب المصطفى r”. وقال في موطن آخر: “الإسلام دين شامل وقادر على المواجهة، وله تميُّزه في جعل التعليم فريضة، والعلم عبادة… وإنَّ صمود الإسلام ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداث، عُدَّ في جانب كثير من الغربيين خروجًا عن سياق الزمن والتاريخ، بل عدّوه إهانة بالغة للغرب”.
والعالم “مراد هوفمان” يعرف أنَّ الكثيرين من الداخل والخارج على السواء، سيعتبرون هذا مجرَّد حملة دعائية، وأنَّ من المستحيل أن يعود الإسلام إلى واجهة التاريخ، ففنَّد هذا الزعم، وأشار بوضوح إلى شرط تحققه، وقال: “لا تستبعد أن يعاود الشرق قيادةَ العالم حضاريًّا، فما زالت مقولة “يأتي النور من الشرق” صالحةً… إنَّ الله سيعيننا إذا غيّرنا ما بأنفسنا، ليس بإصلاح الإسلام، ولكن بإصلاح موقفنا وأفعالنا تجاه الإسلام”.
كما كتب “هوستن سميث” كتابا مبدعا، بعنوان “لماذا الدين ضرورة حتمية؟!”، طبَّق من خلاله منهج النفق المغلق، الذي صنعته المادية والعلموية المعاصرة، ونهاية النفق هي بالضرورة موصولة بالوحي الإلهي، وقد اعتمد المؤلف على “البرادايمات” وعلى أسلوب “التمثُّل” ليعالج موضوعه، وهو وإن لم يؤكد على ديانة دون أخرى، إلاَّ أنه يشترط الوحي والمدد الرباني لبلوغ السعادة، وبغيرهما ستستمر البشرية في شقائها الانتحاري.
أين الأستاذ فتح الله في هذا السياق؟
لا شكَّ أنَّ بحثا معمَّقا حول “الفكر الشمولي عند الأستاذ فتح الله كولن” سيكون جديرا بالاهتمام، وحقيقا بالعناية؛ وإننا بداية ندعو الباحثين في مختلف التخصُّصات إلى هذا الإنجاز الفكريِّ العلميِّ الحضاريِّ المتميِّز؛ وسنقتصر على بعض الومضات، تمثيلا لا حصرًا، وفتحًا للشهية لا ادِّعاء للطبخة المنتهية الجاهزة.
الوحي وسعادة البشرية
عن ضرورة الوحي لسعادة البشرية؛ نقرأ للأستاذ العديدَ من المقالات، منها: “دنيا في رحم الولادة”، و”وارثو الأرض”، و”الأجيال المثالية”، و”رسالة الإحياء”… وغيرها كثير؛ وفي ذلك يقول في مقال “نحو سلطنة القلوب”: “ينبغي أن لا نرتاب في أنَّ ذوينا وبخاصَّة الأجيال الفتية منَّا، سيكونون في القابل القريب أصحابَ القول الفصل في سنوات الألفية الثالثة، ما لم تعصف رياحٌ معاكسةٌ فلم تبدِّد المكاسب المتراكمة حتى الآن بطريقة أو بأخرى. إنَّ أجيال اليوم المؤمنةَ السائرةَ في الطريق، المشدودةَ بالتحفُّز الروحيِّ الكامل استعدادًا لمنازلة الغبن والقهر والظلم الذي أصابها منذ قرون، يزفون بتحفُّزهم هذا من الآن ببشائر مهمَّة عما سيتحقَّق من تجديدات أساسية في جميع طبقات المجتمع في مطالع الألفية الثالثة. وحينما يحلُّ الموسم سيؤتي الإيمانُ والعزم والثبات وعشقُ الحقيقة والفكرُ المنهجي بثماره -علمًا بأنَّ كلا منها في حدِّ ذاتها طاقة كامنة بالقوة- وسنعيش “انبعاثات عديدةً” تحتضن وحدات الحياة كلها”.
إنَّ “التوتُّر الروحيَّ”، أو ما أسماه فتح الله في هذا المقال “بالتحفُّز الروحيِّ”، هو سرُّ الحركية، وهو الشعلة التي لو لامست محرِّكا (قلبًا) به طاقةٌ وهواءٌ؛ فإنَّه لا شكَّ سيحترق شوقًا وعشقًا، وسيبلغ بالمركبة آمادًا بعيدة، ولسوف يبلِّغها مقاصد سعيدة، في الدنيا أولا، ثم في الآخرة ثانيا. أمَّا مَن فقد ذلكم التوتُّر والتحفُّز الروحيَّ؛ أو كان متوتِّرا ماديًّا ومصلحيًّا ليس إلاَّ، شأن أصحاب الحضارات المادية الإلحادية؛ فإنَّه سيتحرَّك، وسيبني، وسيُنجز؛ لكنَّ حركته وبناءه وإنجازه لن يعدو المظاهر القريبة، وهو ولا ريب آيلٌ إلى هلاك ودمار، إن لم يكن اليوم فغدًا. وهذا مؤدَّى قول السحرة لفرعون: قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(طَه:72) “.
المنجزات العلمية
أمَّا عن زهو العالَم المعاصر بالمنجزات التقنية، فيقول فتح الله: “إنَّ هذا العالم يحاول أن يسلِّي نفسه بالمنجَزات العلميَّة والتكنولوجية هنا وهناك، وأن يُسرِّي عن غمِّه بالثروة والراحة أحيانا. لكن من البدهيِّ أنها لن تَمنح الإنسان سعادةً مستمرَّة أبدا، ولن تلبِّي رغبة البقاء والخلود المكنونةَ في أعماقه. ولذلك، ما من شيء يتخذه دواء وعلاجًا إلا ويزيد في قتامة أفق الأمل الإنساني ويضيف بؤسًا إلى بؤسه الروحي. فهذا العالم يتباهى بالعلم والتكنولوجيا إزاء الفراغ والاكتئاب الذي أوجده في الحياة الاجتماعية نتيجة لخطئه العظيم في تحديد نقطة الانطلاق.. ولْنتركْه يسلِّي نفسه ويلهو باللذائذ والأذواق، أو يتطلع ببصره إلى أعماق الفضاء في حين أنه يعاني من افتقاد الروح والمعنى الذي ضيعه في قلبه، مُهدِرا العمرَ خلف ضالته في وديان أخرى”.
ونسجِّل تنبيهَ الأستاذ إلى “الخطأ في نقطة الانطلاق”، أي بلغة “علم المناهج” يكمن الخطأ في اعتقاد “المسلَّمات”، و”البدهيات”، و”اليقينيات” أي ما عبَّر عنه بـ”افتقاد الروح والمعنى”. وبلغة “نظرية المعرفة” نقول: “يكمن الخطأ في الرؤية الكونية” وفي “النماذج الإدراكية”. فهو يقول في مكان آخر: “بدهي أنَّ نظرياتٍ بدت ثابتةً ومتينة، تترك مواقعها إبان هذه المناقشة والمساءلة لتحلَّ محلها آراء جديدة مختلفة، فتَرحل مُسلّماتٌ كانت تصان في حدقات العيون باسم العلم، متهاويةً واحدة بعد أخرى، لتحل محلها مسلماتٌ أخرى تحط واحدة بعد أخرى”.
ولا أدلَّ على هذا من انسحاق الأيديولوجيات، واحدةً تلو أخرى، بين أضراس العصر الحاضر، بما يحمل من أزمات وحروب وخلافات، دلَّت دلالة واضحة أنَّ المنطلق خاطئٌ، وأنَّ البداية منحرفة انحرافا خطيرًا.
ولقد ألَّف العديد من الكتَّاب والمفكِّرين، الغربيين بالخصوص، بحوثًا ودراسات تصف وتحلِّل هلاك الأيديولوجيات والفلسفات، من ذلك مثلا: “نهاية الأيديولوجية” لـ”دانيال بال”، الذي لاقى إقبالا وصدى بالغا في الدوائر العلمية العالمية.
خلافة الله في الأرض
يحاول الأستاذ أن يعرض ملمحا هامًّا وخطيرا، وهو أنَّ الإنسان “سواء باعتباره عالما” أو “باعتباره موضوعا للعلم”، وظيفتُه الأساسية هي “خلافة الله في الأرض”، فإذا ما استوعب هذا المفهوم، وارتكز عليه وجب عليه “أن يكون عاشقا للحقيقة، وحريصا على العلم والتحرِّي، وشغوفا بالبحث واكتسابِ المهارة في كلِّ مجال. لكن ينبغي أن يتقي المؤمن ويحذر من الاتكاء على المصادر الأخرى في الأمور المتعلقة بالنُّظُم العَقَدية والفكرية، والموضوعاتِ المرتبطة بالكتاب والسنة وبكل ما يتعلق بتمثُّل الرسول r، وطرائقِ التحليل والبحث في السيرة وتاريخِ الإسلام عموما، والفنِّ والأدب ونحو ذلك، لأنَّ الذين أقاموا بنيانهم الفكري على معاداة الإسلام، ونظروا إلى الإسلام وكأنه خارج الوحي السماوي، لا يُرجى منهم التصرفُ بحسن النية وطلبِ الخير للمسلمين وتمنِّي التقدم لهم. أمَّا العلمُ والتكنولوجيا -وهما خارج إطار ما ذكرناه- فقد ظلت الأيدي تتناقلهما بين الأمم في الماضي، وستستمر المبادلة فيهما مستقبلاً، وتنتقل أمانةً ووديعةً في أيدي حائزيها. فالعلوم والتكنولوجيا ليست حكرًا على دين أو أمَّة. لذلك، تستطيع كلُّ أمَّة سليمةِ المشاعر والفكر والمعتقدات، منتصبةٍ على ساقيها بثبات ورسوخ، أن تعتصر هذه العلوم الصِّرفة وتقطرها في روحها، فتجعلَها صوتَ قلبِها ونَفَسَه، ووسيلةً تُوصِل البشر إلى الله تعالى”.
يمكننا أن نطالع هذه الفقرات مطالعة نصية حرفية جافة، أو مطالعة لغوية أدبية فنية؛ غير أنَّ القراءة المعرفية تجلِّي لنا دلالات عميقة لا حدَّ لها، ومن ذلك: اعتماد حكم “الوجوب” الذي هو مِن الأحكام الشرعية المترتب عليها آثار دينية؛ فالأستاذ يحكم بـ:
- وجوب عشق الحقيقة.
- ووجوب الحرص على العلم والتحري.
- ووجوب الشغف بالبحث.
- ووجوب اكتساب المهارة في كلِّ مجال.
وهو ما يعبِّر عنه المفكِّر الأديب عباس محمود العقاد بعنوانه الدال “التفكير فريضة إسلامية”؛ ولا شكَّ أنَّ مصدر هذا الحكم هو القاعدة الأصولية: “ما لا يتم الواجب إلاَّ به، فهو واجب”، فعزَّة المسلمين، ونصرةُ الإسلام، وظهورُ دين الله تعالى، وسعادةُ بني البشر… كلُّ ذلك مقصد للشارع، لا يتمُّ ولا يتحقَّق إلا بالأحكام التي أوردها الأستاذ، لو أنها أخذت بجدية، ولم تقرأ قراءة “استرخائية اختيارية اعتيادية”.
ونقرأ في الفقرة أعلاه، حول “مصادر المعرفة” كون “الوحي” هو المصدر في كلِّ ما من شأنه أن يعالج “النظم العقدية والفكرية”، أو كلِّ ما يعالج حقيقة الكون، ومعنى الإنسان، والمصير، والغيب… فكلُّ ذلك لا يمكن للعلوم الدقيقة أن تبثَّ فيه، ولا حتى أن تدلي بدلوها؛ فهي ليست مرشَّحة لذلك.
ثم يدخل الأستاذ مفهوما “عقديا” في نظرية المعرفة، وهو “النيّة”؛ فمن ساءت نيته ساء مصدره ومورده، ولم ينتظر منه الصدق، ولم يكن أهلا ليتعلَّم منه؛ يقول: “إنَّ الذين أقاموا بنيانهم الفكري على معاداة الإسلام، ونظروا إلى الإسلام وكأنه خارج الوحي السماوي، لا يُرجى منهم التصرفُ بحسن النية وطلبِ الخير للمسلمين وتمنِّي التقدم لهم.”
ولو أنَّك -اليوم- في محفل علميٍّ أكاديميٍّ متخصِّص، حتى في العديد من الجامعات العربية، ربطت بين النية والمعرفة؛ لوجدت الكثير من الدارسين يقفون أمامك محتجين أنَّ النية لا تقاس، وهي “ذاتية”، ولا تؤثر على العلم، وما دخلها في البحث العلمي؟ ودليل ذلك العشرات من المصادر “في منهجية البحث العلمي”، التي كتبت باللغة العربية، من قبل باحثين من مختلف التخصصات، قلَّ منهم من يدرج النية في “شروط الصدق المعرفي”، ولقد أبدع المسيري رحمه الله حين فنَّد خرافة “الذاتية والموضوعية” بالبديل المعرفي، المعنون بـ”التفسيرية”؛ فالنية أكثر تفسيرية من أيِّ معطى آخر في مسار العلم اليوم، ولا يعنينا -كما نقرأ عند الأستاذ- أن تتقبلها الدوائر الرسمية، أو ترفضها. ونحسب هذا من إبداعات الأستاذ فتح الله كولن؛ كاشفا عن صفاء نيته وسريرته.
وفي السياق نفسه تأتي “سلامة المشاعر والفكر والمعتقدات، والثبات والرسوخ” لتمكِّن الأمَّة من أن “تعتصر هذه العلوم الصِّرفة وتقطرها في روحها، فتجعلَها صوتَ قلبِها ونَفَسَه، ووسيلةً تُوصِل البشر إلى الله تعالى”.
أمَّا “العلم والتكنولوجية” في رأي الأستاذ، فهما محلٌّ لأنْ يتمَّ “تناقلهما بين الأمم في الماضي”، و”المبادلة فيهما مستقبلاً”، و”الانتقال أمانةً ووديعةً في أيدي حائزيها”. والخلاصة أنَّ “العلوم والتكنولوجيا ليست حكرًا على دين أو أمَّة”.
فهذه الدلالات المعرفية الواردة، تؤكِّد -بما لا يدع مجالا للشكِّ- أنَّ الأستاذ يرسم الفوارق بين “العلوم اليقينية” التي مصدرها الوحي، وصبغتها “صدق النية”، عن العلوم الأقل يقينية، التي هي ملك لكلِّ من يُعمل فيها عقله؛ ومن ثم فهو يشير إلى شمولية وكلية الأولى، وإلى إنسانية ونسبية الثانية؛ وهذا ما نحاول إثباته من خلال ورقتنا هذه.
الصراع الموهوم بين العلم والدين
في ذات السياق يحلِّل الأستاذ “سبب شقاء البشرية”، وسبب عجزها عن اكتشاف الحقيقة ناصعةً، سواء في الغرب ابتداء، أم في الشرق ولوعا وأثرا، فيقول: “والمؤلم أنَّ فلسفة العلم في أوروبا -وعلى نقيض المرونة في عالمنا الفكري- قد أوقعت الغربَ كله في صراع دائم بين العلم والدين لأمور وأوضاع خصوصية، فخَلَّفَ ذلك انفصامًا بين العقل والقلب. وهذا هو السبب الرئيس للمعضلات المتتابعة منذ عصور في النُّظم الغربية كلِّها. بل لقد تفاقمت الأزمة من مخاصمةِ جبهة العلم والفلسفة للدوغمائيات الكنسية، إلى مخاصمة “المفاهيم” الدينية كافة بمرور الزمان… فكأنَّ العلم والفلسفة حاميةٌ ومدافِعةٌ عن الإلحاد. وقد أصاب -للأسف الشديد- الفكرَ الإسلاميَّ البريء، غبارٌ من هذا العداء ضد الأديان كلها، إذ عُرِّض لأشنع ظلمٍ وأبشعِ غبن، ووُضِع في قفص الاتهام مع الكنيسة التي هي المعنية في الأصل بهذه الخصومة. انقلبت هذه الحركة المعادية لدوغمائياتِ تلك التنظيمات التي ظهرت بمظهر الدين، والمنطلقةُ في بداياتها من الحرية الفكرية والعلمية.. انقلبت بمرور الزمان إلى معاداة الله والدين والتدين، ثم إلى تحمسٍ في أرجاء العالم كله لإسكات المتدينين وإحباطهم وتضييقِ الخناق عليهم، بل إزالتِهم من الوجود تمامًا. ومع أنه لم يكن للعالم الإسلامي مشكلة البتَّة مع العلم أو حريةِ الفكر، ولكنَّ زمرًا من أعداء الدين تغاضوا عن هذه الحقيقة الفارقة واتخذوه غرضًا لمراميهم العدائية الدنيئة مساوين له بالمسيحية الكنسية.”.
الصراع الدائم بين العلم والدين كان منشأه انحرافات في الكنيسة، غير أنَّ الذين حاربوا الانحرافات كانوا “ثوريين”، فعوض أن يصفُّوا مجاري المياه، راحوا يجففون المنابع كلَّها، فحاربوا كلَّ “وحي” وكلَّ “دين” وكلَّ “إله”… يقول كارل ماركس: “الدين تنهيدة الكائن المضطهَد، قلبُ عالم لا قلب له، وروح شروط بلا روح. إنه أفيون الشعب”، أمَّا “جان ميليه” فيقول: “سأختم بالقول بأني أرجو الله الذي تثير تلك الطائفة -أي المسيحيين- سخطَه أن يتلطَّف، ويعود بنا إلى الدين الطبيعيِّ، الذي ليست المسيحية غير عدوِّه الصريح” وما الدين الطبيعيُّ سوى العلم طبعًا، ويفسر “كلوت” ذلك بقوله: “ما من إله آخر غير الطبيعة”.
هذا الصراع أغرى المنتصِر، ومنحه “زهوا” و”غرورا”، حتى ظنَّ أنه يستطيع أن يقول أكثر مما يعلم، أو يمكنه أن يسحب ما يعلم ليشمل ما لا يعلم؛ وإلاَّ فما الذي يبرِّر -مثلا- آراء “ستيفن هاوكينغ” -الكوسمولوجي والفزيائي- عن الله، وعن الغيب، في مثل قوله: في كتابه الأخير “التصميم العظيم”: “إنَّ العلم بات قادرا اليوم على القول إنَّ الله لم يخلق الكون، وإنَّ الانفجار الكبير لم يكن سوى عواقب حتمية لقوانين الفيزياء”. وما هذا الصلف سوى ادعاء -لا مبرر له- أنَّ العالِم هو صاحب القول الفصل في “كلِّ شيء”، وهو القادر على اكتشاف نظرية تفسر “كلَّ شيء” في الوجود، ليس الماديَّ فقط، بل والمعنويَّ كذلك. وليس المحسوس فقط، بل والغيبي أيضا.
وفي رأينا، استطاع فتح الله أن يضع اليد على الجرح، بحديثه عن “ديكتاتورية العلم” أو بالأحرى، “حين يحترف العالم الظلم باسم العلم”، ويقول عنها إنها تحولَّت إلى احتراف: “معاداة الله والدين والتدين، ثم إلى تحمُّسٍ في أرجاء العالم كلِّه، لإسكات المتدينين، وإحباطهم، وتضييقِ الخناق عليهم، بل إزالتِهم من الوجود تمامًا”. ولكم قرأنا من كتب حول “ديمقراطية العلم”، وعن “الحرية في العلم”، وعن أنَّ “الاستبداد وليد الدين لا العلم”؛ وها هو فتح الله يكشف النقاب عن العكس، وهو كذلك لا ينفي أن يولد التعصب والظلم من رحم الدين، حين ينحرف أهله به.
وهذه خطوة أخرى في نظرية المعرفة، من منظور “أصيل” لا “تأصيلي كما يسمَّى أحيانا”؛ لعلَّ فتح الله هو أحد أبرز روَّادها، لو تمكننا من دراستها، والتنظير لها، بعقلية منفتحة، وجهد لا يقتصر على الفرد، ولكن يتجاوزه إلى “جماعة علمية”، بكل ما يعنيه المصطلح من دلالة.
الرؤية الكونية، ومصدر الحقيقة المطلقة
حين يتمُّ الحديث عن “الرؤية الكونية”، يشار أساسا إلى مكوِّنات ثلاث هي “الله،والإنسان، والكون”، ثم يتم التركيز على “التصور، والحكم، والموقف” على هذه العناصر، ولقد كان الحديث عنها قبلُ يحشر في الدوائر الرسمية ضمن “ما وراء العلم”، أو “في حقول الفلسفة” على الغالب؛ أمَّا اليوم، فبفضل جهود علمية متكاثفة، وبسبب إخفاقات تجزيئية إقصائية متوالية، اضطرَّ المنصفون أن يعودوا إلى الجذور، وإلى بواطن المشكلة والأزمة، فوجدوها في التصوُّر، والحكم، والموقف من “الله، والإنسان، والكون”؛ أي في “الرؤية الكونية” ولا ريب.
في كتاب “ونحن نبني حضارتنا”، يعرض فتح الله لهذه المسألة بعمق، لكن دون أن يسميها باسمها المعروف مباشرة، فيكتب مقالا بعنوان “الله، الكون، الإنسان.. والنبوة”، ويمكن تفسيره بعبارة “النبوة والرؤية الكونية”، ومما ورد فيه: “إنَّ قراءة الوجود والأحداث قراءةً جيدة وتفسيرَها تفسيرًا صائبًا، وكذلك الحفاظ على الموازنة بين الإنسان والكون وحقيقةِ الألوهية، لهي من أهم جوانب الأعماق النبوية ومن أرقى مميزاتها.. فإن الإدراك العميق للوجود كـ”كلٍّ”، والفهمَ التام لتجلي الأشياء -التي بعضها نماذج للبعض الآخر- في صورتها العمومية، ولقوانين الوحدة التي هي ذاتُ صفةٍ كونية ومحيطة بالموجودات… كلُّ ذلك إنما تَيسَّرَ للأنبياء وحدهم، وعلى رأسهم حضرة روح سيد الأنام -عليه أكمل التحايا- وهذا أبهر معجزاتهم قاطبة. وإذ لا زالت البشرية تتهجى في أيامنا هذه حروفَ الحقائق المتعلقة بالإنسان والكائنات وما وراء الطبيعة مع توسعها العلمي وتقدمها التكنولوجي، فإنَّ الأنبياء وقفوا مليا -وبجد- على هذه الحقائق منذ آلاف السنين، وقالوا بالتمام لأممهم ما ينبغي أن يقال في شأن الرجوع بالأشياء لصاحبها؛ فبعضهم أجمل وبعضهم فصَّل، وذلك بجَهازهم الخارق للعادة، ومكانتهم الخاصة عند الحق تعالى، والتبليغاتِ المتوالية من الماورائيات”.
لا تخطئ القارئَ النزعةُ “الكونية الشمولية” في هذا النصِّ، إذ الألفاظ والعبارات دالة على ذلك، منها، ألفاظ مثل: “قراءة جيدة… تفسير صائب… الموازنة… الإدراك العميق للوجود ككلٍّ… والفهم التامَّ لتجلي الأشياء… في صورتها العمومية…. وقوانين الوحدة… وصفة كونية محيطة بالموجودات….الخ”. ودلالة هذه العبارات أنَّ “تفسير كلِّ شيء، وبيان كلِّ شيء، سواء أتعلق ذلك بالإنسان، أم بالكون، أم بالحقيقة الإلهية… لا يتأتى إلاَّ للوحي، وللأنبياء، ولا يمكن أن يدركه إلاَّ من ارتشف رشفة من نبع الصفاء الأبديِّ، واغترف غرفة من نهر الحقيقة النورانية؛ وهل يمكن أن تكون هذه سوى “نظرية كلِّ شيء” بدلالتها المعرفية التوحيدية الشمولية، لا بمعناها الأبستمولوجي المادي الواحدي؟!
ليس المقصد التهوين من شأن العلم المادي والتقنية
يشدُّني إلى فتح الله تلكم القدرة على الموازنة والتوازن، فهو بأيِّ مبرِّر كان، لا يميل إلى الغلوِّ، ولا يقبل الأحكام الجزافية المطلقة، ومن ذلك تصحيحه لخطأ قد يقع فيه “الطالب، وغير المتمرِّس”، أو “العالم بالتراث الفقهيِّ، مع جهل بالتراث العلميِّ”، من احتقار ما توصَّلت إليه البشرية من علم، ومن تقدُّم تقنيٍّ وتكنولوجيٍّ لا غبار عليه؛ وفي ذلك يقول: “وأنبِّه هنا إلى أني لا أقصد بما قلته التهوينَ من شأن العلم وثمراته، أو الانتقاصَ من أهمية المباحث العلمية؛ بل نعتقد أنَّ العلم وثمراته منظومةُ قيمٍ هامة جدًّا وتستحق التوقير والتقدير”.
وفي ذات السياق يقول محمد مهاتير: “صحيح أنَّ الإسلام يطلب من المسلمين أن يدرسوا العقيدة، ولكنه يطلب منهم أيضا أن يدرسوا كلَّ المعارف. إنَّ إدارة الظهر للمعارف الأخرى لن يجعل المرء أكثر إسلاما”.
فما هو المقصد المعرفيُّ المنهجيُّ، إذن؟
يجيب فتح الله: “المقصود هو التذكير إلى مصدرٍ للعلم لا يُلتفت إليه اليوم، مع أنه أصح المصادر في التعبير عن حقيقة الإنسان والوجود والخلق، وأكملُها وأشملها، مع تنزهه عن الخطأ فيما يقوله ويرشد إليه… ألا وهو مصدر “النبوة” التي احتفظت بنداوتها أبدًا، باستثناء التحريف الحاصل في بعض الكتب السابقة… إنَّ العلوم المعاصرة اليوم قد تكتشف -من منظور كليٍّ وبتقويم شمولي- أمورًا مهمَّة تتعلَّق بالنظام والانسجام والحركة في الوجود والحوادث، ونحن نستقبل ذلك بالتقدير والتوقير؛ لكنَّ جمعًا من المجهَّزين بجَهاز خاصٍّ، قد أعلنوا في أقدم العصور وبواكير الزمان -ولو بشكل إجمالي- هذه المعلوماتِ والتفسيرات التي توصَّل إليها العصرُ باستخدامِ أعظم التكنولوجيات. فإذا كان هناك قسم من الجهات العلمية لم يلتفتوا إليها أو لم يوقروها التوقير اللائق، فإننا نرفع عند ذاك أصواتنا -في حدود أدبنا- فوق أصواتهم، ونجهر بأعلى صوتنا بما نراه حقًّا”.
فنظرية كلَّ شيء، من وجهة نظر هذا البحث، ومن مدخل الأستاذ فتح الله، لا تعنى بـ”تفسير كلِّ شيء” كما في بعض الطرحات العلمية الغربية؛ غير أنها تعنى بالبحث عن المصدر، أو المصادر، التي تعبر عن الحقائق بصورة شمولية كلية، مصدر لا يشوبه تحريف ولا يعتريه تزييف، ولا يلحقه خطأ ولا يناله خطل، وما ذلك المصدر سوى “الوحي” أوان نقائه، وحين لا تعبث به أيدي الناس، وعندما لا تشوِّه محياه بحماقاتها ونفاقها وتصرفاتها الرعناء؛ وهذا مؤدَّى قول الأستاذ: “المقصود هو التذكير إلى مصدرٍ للعلم لا يُلتفت إليه اليوم، مع أنه أصح المصادر في التعبير عن حقيقة الإنسان والوجود والخلق، وأكملُها وأشملها، مع تنزهه عن الخطأ في ما يقوله ويرشد إليه… ألا وهو مصدر “النبوة” التي احتفظت بنداوتها أبدًا”.
وظيفة العلم، ونظرية كلِّ شيء
هل ثمة وظيفة للعلم سوى تمكين البشرية من السعادة، والرخاء، والطمأنينة الأبدية، لا الظرفية فقط؟
يحلل الأستاذ فتح الله وظيفة العلم، من مدخل معرفي، ويشترط في تحقيقها “تفسير الوجود بفهم شمولي ينتظم كلَّه وجزءَه”، أي الشرط هو “نظرية كلِّ شيء” باعتبار سعة الفهم، ونقاء المصدر، لا بغرض التفصيل في كلِّ شيء بوحداته؛ ثم إنَّ تلكم الوظيفة، ما هي إلاَّ “السعادة”، و”التوازن بين كلِّ الأشياء وتناسبها”، و”ربط كلِّ المخلوقات بخالقها”، و”النجاة من الوقوع في التناقض الداخلي” أيا كان نوعه.
يقول فتح الله: “فالسعداء هؤلاء، لهم نظر خاص إلى الوجود وما وراء الوجود؛ فهم يطَّلعون على كلِّ شيء بأنوار البصيرة، ويقوِّمون الأشياء والأحداث في الدائرة التي وضَعَتْها فيها قدرة الخالق تعالى، ويتناولون كلَّ شيء بحقيقته في نفس الأمر (بحقيقة جوهره)، وإذ يفسِّرون الوجود بفهم شموليٍّ ينتظم كلَّه وجزءَه، يعتنون بتوازنِ كلِّ الأشياء فيما بينها وتناسُبِها، وبروابطها بالخالق تعالى، فلا يقعون أبدًا في تناقض داخليٍّ. ولذلك، هؤلاء وحدهم أفلحوا مدى الدهر في النظر الصائب والفكر الصائب والتعبير الصائب، بشأن حقيقة الإنسان والكائنات والألوهية؛ فهم وحدهم استطاعوا أن يبيِّنوا التوحيد بجميع ضرورياته ولوازمه، وهم وحدهم استطاعوا أن يبينوا الموازنات السليمة بين الأسماء الإلهية والصفات السبحانية والشؤونات الذاتية مع الذات الإلهية… وكذا هم وحدهم عبروا تعبيرًا صائبًا عن خصوصياتِ دائرةِ الألوهية ودائرة الربوبية باعتبارها تجلياتٍ مختلفةً لنبع واحد. ولولا أَنْ تجلت الإرادة الإلهية بالإحسان في إرسال الرسل، لعجزتْ أخصبُ الأدمغة -على توالي العصور والدهور ومع أعظم الهمة والجهد- عن تحصيل مثل هذه الحقائق قطعًا وبتاتا، بل عجزُها ظاهر للعيان بواقع الحال!”.
ولقد ردَّ محمد باقر الصدر، في كتابه “اقتصادنا”، على الذين ادعوا أنَّ العلم على صورته الوضعية، كفيل بإسعاد البشرية، ففنَّد هذا الوهم قائلا: “ويتردد على بعض الشفاه: أنَّ العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحلّ المشكلة الاجتماعية.. إنَّ هذا الإنسان الذي سجَّل في تاريخ قصير كلَّ هذه الفتوحات العلمية، وانتصر في جميع معاركه مع الطبيعة لقادر بما أوتي من علم وبصيرة، أن يبني المجتمع السعيد المتماسك، ويضع التنظيم الاجتماعي التي يكفل المصالح الاجتماعية الإنسانية، فلم يعد الإنسان بحاجة إلى مصدر يستوحي منه موقفه الاجتماعي سوى العلم الذي قاده من نصر إلى نصر في كل الميادين”. ثم قال: “وهذا الادعاء في الحقيقة يكشف الجهل بوظيفة العلم في الحياة الإنسانية، فإنَّ العلم وأساليبه ومناهجه ما هي إلاَّ أدوات بحثٍ ووسائل تحليل، إنها ليست إلاَّ أداة لكشف الحقائق الموضوعية، سواء في الظواهر الطبيعية، أو العلوم الإنسانية”. فسعادة البشرية إذن لا تتأتَّى من باب العلم، ولكنها تتنزَّل من سماء الوحي.
الإسلام كلّ… كلٌّ يستحيل تجزُّؤه
مما تقدم نستنتج أنَّ فتح الله كولن يدافع عن أنَّ “الحقيقة” في كلِّيتها وشموليتها، لا تصدر إلاَّ من نبع التفسير الديني، ولا تكون إلاَّ من مدرسة الأنبياء عليهم السلام، المعلَّمين من قبل ربِّ العزّة، العالم العليم بكلِّ شيء؛ وذروة تلكم الحقيقة هو “كلام الله تعالى”، المنزَّل على مفسِّر أسرار الوجود، محمد عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم.
يقول فتح الله في هذا الشأن: “الحاصل أنَّ الإسلام صوتُ كتابِ الكائنات ونَفَسُه وتفسيرُه وإيضاحه، كذلك هو رسْمُ ماضي الكائنات وحاضرِها ومستقبلِها، وصورتُها وخارطتها، ومفتاحٌ سرّيٌّ لأبوابها التي قد تُظَن أنها مغلقة. الإسلام “كلٌّ” يعبر عن هذه الأمور والشؤون جميعًا. “كلٌّ” يستحيل تَجَزُّؤه، ويستحيل أن يُحمَّل جزؤه القِيَمَ المحمّلةَ على الكل. فإنَّ تجزئته إلى أجزاء، ثم محاولةَ استنباطِ فهمٍ كاملٍ وتام من الأجزاء غلطٌ وخطل وإهانة لروحه. وسوف يبقى من يريد أن يفهمه أو يحصره في تفسيرِ آياتٍ وأحاديث معدودة بأسلوب وعظيٍّ، مهزوزَ الوجدان بأحاسيسِ نقص حقيقي، ومُعانِيًا من خواء روحي دائم؛ مهما كدَّ وسعَى لسماع مجموعة الأنغام الرائعة هذه. الإسلام إيمان، وعبادة، وأخلاق، ونظام يرفع القيم الإنسانية إلى الأعلى، وفكرٌ، وعلم، وفن. وهو يتناول الحياة كلاًّ متكاملاً، فيفسرها، ويقوّمها بقيمه، ويقدِّم لمنتسبيه مائدةً سماوية من غير نقص. وهو يفسِّر أداء الحياة دومًا ممتزجًا مع الواقع، ولا ينادي البتة بأحكامه في وديان الخيال بمعزل عن الحياة. يَربط أحكامَه وأوامره بمعطيات الحياة المعيشة وبإمكانية التطبيق، ولا يَبني الأحكامَ في دنيا الأحلام. الإسلام موجود وحركي في الحياة بكلِّ مساحاتها، من القضايا العقدية إلى الأنشطة الفنية والثقافية… وذلك هو أهم الأمارات والأسس لحيويته وعالميته الأبدية”.
من هنا نخلصُ إلى أنَّ فتح الله مشدودٌ إلى “شمولية الحقيقة”، وإلى “عالمية الفكر الإسلامي”، وإلى “الرؤية الكلية غير المختزلة” للحقائق الثلاثة (الله، الإنسان، الكون)؛ مما دفعه إلى مواجهة كلِّ “نظرة ضيقة”، ومحاربة كلِّ “عصبية مقيتة”، ودحض كلِّ “تجزيئية مميتة”.
أمَّا سبب هذه “الرؤية الشمولية” فلا ريب أنه المصدر الصافي، أي الوحي المتجاوز المتعالي؛ الذي يمثل “الحقيقة كلّها”، وبعالج “أصول كلِّ شيء”، ويصدق أن يقال عنه: “فيه كلُّ شيء”؛ لا بالسرد والتفصيل، لكن بالتمثيل والتأصيل… هذه “الحقيقة الكلية”، هي التي سمّيناها في هذا البحث “نظرية كلِّ شيء في فكر الأستاذ فتح الله كولن”. وما هي في أصلها سوى التفسير لحقائق الوحي، تفسيرا ناصحا مبينا، من عالم ناصح أمين.
ويجمل بنا أن نختم هذا البحث بعبارة جامعة، من كتاب “ونحن نبني حضارتنا”، جاء فيها: “لقد أُرسل حضرة سيد الأنام (عليه ألفُ ألفِ صلاة وسلام) برسالة تتعلق بكلِّ أحد، وكلِّ شيء. وكان يوفي وظيفته حقها ويؤدّيها بعمق، فتمتلئ بحبه الأفئدةُ وتنجذب إليه القلوب”.

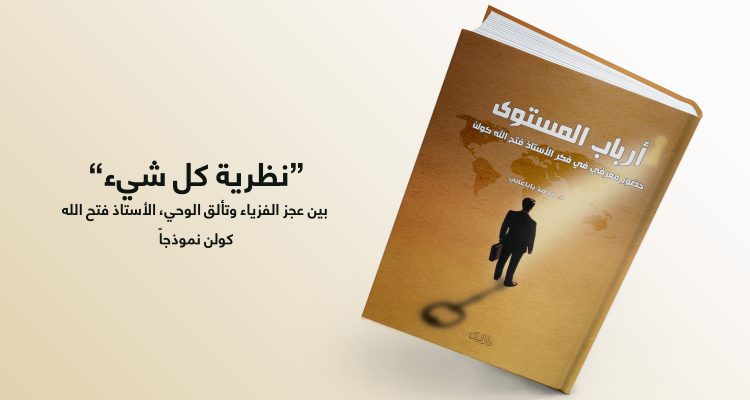
Leave a Reply