تطرح الفلسفات الإنسانية الأكثرُ انتشارًا ومنهجية رؤى مختلفة للمثالية الإنسانية (İdeal Human)، ففي بعض الحالات تكون المثالية اجتماعية أو جمعية في طبيعتها وتشمل السياسة والتعليم والحكم والنظم الاجتماعية وما إلى ذلك، وفي حالات أخرى تركز الرؤية على الفرد وعلى كيفية تحقيق كل شخص لما هو أعلى وأفضل في الحياة. ومن أمثلة الحالة الأولى أشهر ثلاثة فلاسفة من الإغريقيين الكلاسيكيين وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، ومن أمثلة الحالة الثانية الكاتب الرواقي إبيكتيتوس والإبيقوريون وبوذا. إلا أن ما يجمع كل هؤلاء تقريبًا هو رؤية مثل أعلى إنساني باعتباره الهدف المنشود من التطور والإنجاز الإنسانيين. وتبرز الفلسفة الإنسانية -التي تناصر الإنسان في تلك الأمثلة- شكلاً مثاليًّا منه كمعيار للقياس أو كهدف يطمح إليه أي مسعى أو جهد بشري، إما لذاته فقط أو لما يقول به من وجود حقيقة غيبية مطلقة مثل الذات الإلهية.
وفي هذا الفصل والفصل الذي يليه، سأجري محاورة ثلاثية بين الأستاذ كُولَن واثنين من أقوى شارحي المثالية الإنسانية الذين عرفهم العالم، وهما كونفوشيوس وأفلاطون. ومما يثير الاهتمام أن كونفوشيوس (551-479 ق.م) وأفلاطون (427-347 ق.م) كان يفصل بينهما جيل واحد تقريبًا، لكن أحدهما عاش في الصين بينما عاش الآخر في أثينا. وقد تحدثا عن رؤى ثورية متشابهة عن المجتمع والفرد بناءً على ما يعتقدانه من الإمكانيات المتأصلة للطبيعة البشرية من ناحية، وترتيب أو “كيفية وجود” الأشياء في الواقع الأوسع من ناحية أخرى. أما الأستاذ كُولن فيصوغ رؤية لمجتمع متجدد روحيًّا يستمد قوته وتماسكه أساسًا من وجودِ وجهودِ أناس اجتهدوا في تحصيل الكمال البشري -لأقصى مدى ممكن- طبقًا للمعتقدات الإسلامية. ونرى في أعمال الثلاثة، كونفوشيوس وأفلاطون وكُولن، فكرة مشتركة تحرك الرؤى الخاصة بكلٍّ منهم، وهي أن المجتمع يسير على أفضل ما يكون عندما يحكمه ويشكِّله أناس ذوو قوة أخلاقية وعقلية. وبالطبع تختلف تسمية هؤلاء الناس ذوي القوة الأخلاقية والعقلية في أعمال كلٍّ من المفكرين الثلاثة، كما أنهم يوجدون في أطر ثقافية وفلسفية ودينية متباينة، إلا أنهم يتفقون في جوهرهم، وهذا الجوهر المتمركز حول القيمة الإنسانية هو ما سنتناوله الآن.
رغم انتماء كونفشيوس وأفلاطون وكولن إلى خلفيات ورؤى حياتية مختلفة تمامًا، فإنهم يشتركون جميعا في رؤية أساسية واحدة حول بنية الواقع؛ فالثلاثة يتحدثون عن رؤاهم للمجتمع الإنساني من منطلق مثالية غيبية تمثل الأساس والمصدر والحقيقة والأصل لكل الواقع الدنيوي. وهذه المثالية الغيبية تسمى لدى كونفوشيوس “الداو” (Dao) أو “كيفية وجود جميع الأشياء”، والداو ليس إلهاً أو معبودًا شخصيًّا، وإنما هو القوة أو المبدأ أو الطاقة الطبيعية للواقع؛ فكل الأشياء توجد في الداو ومنه تتكون جميع الأشياء. ويعتبر الداو في كلٍّ من الفلسفات الصينية القديمة والكونفوشية والطاوية (Daoism أو Taoism) الأرضيةَ العميقة لكل الوجود والجوهر والواقع، وعن طريق الانسياب أو التكامل مع الداو أو الاتصال به أو تقليده يمكن فقط أن يَحدث التناغمُ في الحياة الإنسانية بأبعادها الاجتماعية والسياسية والكونية.
ويصف أفلاطون هذه الحقيقة الغيبية “بالمثالية” (ideal) في مقابل العالم “الحقيقي” (real). وفي المحاورات التي أجراها عن معلمه سقراط وتلامذته، كان سقراط يركز على هذين البعدين الأساسيين للوجود -المثالي والحقيقي- أو يعبّر عنهما أحيانًا بألفاظ مختلفة مثل الحقيقة والظل. والمثالي أو الحقيقي هو أزلي وغير مادي -أي إنه فكرة أو روح صرفة- لا يفنى أو يتغير، وهو مصدر الخير والحق والعدل وغير ذلك. ويشبِّه أفلاطون تلك الذات بالنور أو السطوع في مقابل الظلام الدامس للواقع الإمبيريقي الذي غالبًا ما يخلط البشرُ بينه وبين الواقع الحقيقي المطلق. أما العالَم الفعلي أو عالم الظل فهو مادي ومتغير وفانٍ، تتعدد فيه تصورات الخير، وتتصارع أشكال الحق، وتكون مفاهيم العدالة نسبية. وباختصار، فالعالم المثالي أو الحقيقي هو عالم العقل أو الروح الصافية ورغباتها، بينما العالم الفعلي أو عالم الظل فهو عالم الجسد ورغباته، ولا تستقيم الحياة الإنسانية على المستويين الفردي والجمعي إلا عندما يكون الأولُ هو الحاكم على الثاني.
وأخيرًا، يؤكد كُولن على تصوره للحياة الإنسانية في إطار الإسلام، الذي يطرح رؤية حياتية تجمع بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ولا تكتسب الحياةُ الدنيا كمالَها ومعناها وأصالتها إلا عندما نعيش فيها ونحن نؤمن بوجود الرب -أو الله- باعتباره المصدر والأساس للحقيقة. وجميع الكائنات هي في جوهرها مسلمة -بمعنى أنها تسلم وجهها لله- لأنه لا وجود مطلقًا لأي شيء بعيدًا عن إرادة الله وقدرته. وعندما تسير الأشياء في حياتها وأهدافها بالطريقة التي فطَرها الله عليها، فإنها تفعل ذلك “في خضوع واستسلام” لله -باعتبارها مسلِمة. وبتحديد أكثر، فإن الحياة في أكمل صورها لا تكون إلا عندما نعيشها ونحن نؤمن -بعقولنا وليس فقط بالفطرة- بتلك الجنّة الأبدية للحياة في خضوع واستسلام لله، سبحانه وتعالى.
إذن، فنحن نرى في الأمثلة الثلاثة السابقة شكلاً من أشكال تقسيم الحقيقة، فالحقيقة واحدة بالتأكيد ولكنها تتكون من أبعادٍ وعوالِمَ وأشكالِ وجود مختلفة. ومَن يدركون هذا ويعيشون وفقا له يَجدون السعادة والخير والحق مهما كانت ظروفهم وأحوالهم؛ لأن توجههم دائمًا يكون نحو الحقيقة الأعلى والأسمى. أما من يَغفلون عن ذلك فإنهم يغوصون في مستنقع الحيرة والشهوات الجسدية، ويغرهم الواقع المحدود والأدنى لعالم الظل. باختصار، هناك صنفان أساسيان من الناس: الأعمى والبصير، ولكي تستقيم الحياة على الأرض ينبغي أن يحكمها ويسودها الصنف الثاني.
وفي كتاب “المقتطفات الأدبية” (The Analects)، يميز كونفوشيوس وغيره بين من لديهم شخصيات “سامية” أو “نبيلة”، ومن لديهم أساليبُ “دنيا” أو “وضيعة” أو عقول “متدنّية”. وغالبا ما تكون هاتان الصورتان على النقيض من أحدهما الآخر. يقول كونفوشيوس:
“الشخص النبيل يختلف عن الآخرين، ولكنه يكون في سلام معهم. أما الشخص الوضيع فهو مثل الآخرين تمامًا، ولكنه لا يكون في سلام معهم على الإطلاق”.((1))
“الشخصيات النبيلة تشجع ما هو جميل في الناس، وتحارب ما هو قبيح فيهم، أما الشخصيات الوضيعة فتفعل العكس تمامًا”.((2))
“الشخصيات النبيلة تبحث عن الحقيقة دائمًا في داخلها، أما الشخصيات الوضيعة فتبحث دائمًا عنها في الخارج”.((3))
في هذه الفقرات نرى أن الشخصيات النبيلة لديها توجه مختلف كليًّا عن الآخرين، فالشخصيات النبيلة هي شخصيات لديها قدرة أكبر في كل أبعادها الداخلية، مما يسمح لها بأن تكون وأن تتصرف في الحياة بطريقة مختلفة جذريًّا عن غيرها. ويستمر النص:
“الشخصيات النبيلة تقدر ثلاثة أشياء: التكاليف السماوية، والشخصيات العظيمة، وكلام أهل الحكمة. أما الشخصيات الوضيعة فهي لا تفهم التكاليف السماوية وبالتالي لا تعظمها، وتستخف بالشخصيات العظيمة، وتسخر من كلام أهل الحكمة”.((4))
“الشخصيات النبيلة لها تسْع سمات: بريق العينين، ورهافة السمع، وبشاشة الوجه، والتواضع في السلوك، والصدق في الكلام، والأدب عند عرض الخدمات، والتحقق عند الشك، والتـروي عند الغضب، والالتزام بالأخلاق عند وجود مصلحة”.((5))
وتسلك الشخصيات السامية في الحياة طريقًا مختلفًا عن ذلك الذي تختاره الشخصيات الوضيعة، فآذانهم تبحث عن الحكمة والأدب والكرامة والمساعدة، بينما الناس العاديون أو “الوضيعون” لا يلْقون بالاً أصلاً لكل هذه الأمور.
أما أفلاطون فيتحدث عن نوع مماثل من الناس في كتابه “الجمهورية” (The Republic)، وهو أطول المحاورات التي أجراها على الإطلاق، وقد أُفردت أعمال كثيرة لتفسير تلك المحاورة وحدها. وأنا لا أنوى -إطلاقًا- عمل تحليل مفصل لأي جزء من تلك المحاورة، بل سأركز فقط على الفقرات التي تهمّنا هنا. وكما ذكرت سابقًا، يقسِّم أفلاطون الواقع إلى عالمين: العالَم الأزلي للفكر أو الروح الصافيين، والعالم المحدود للجسد. ويتعلق جزء كبير من المحاورة بين سقراط وطلابه بالفيلسوف -أو “محب الحكمة”- الذي يفهم بعمقٍ هذا الجانبَ من الوجود، وينتمي إلى العالم المطلق المثالي ويعيش من أجله. وفي آخر المحاورة، يصف سقراط من ليس لديهم حب الحكمة ولا يفهمون الحقيقة وبالتالي لا يتمتّعون بفوائد الحياة المتناغمة مع الحكمة، فيقول:
“وهذا هو حال من ليس لديهم أيّة دراية بالحكمة والفضيلة، لكنهم يشغلون أنفسهم عنها دائمًا بالبحث عن المتع والملذات وما إلى ذلك. فهم أولاً يبدون كما لو كانوا قد انجرفوا إلى القاع ثم صعدوا من جديد حتى وصلوا إلى المنتصف ثم بدأوا يتحركون ويتنقلون ما بين هاتين النقطتين طوال حياتهم، فهم دائمًا محصورون داخل تلك الحدود، ولا يتطلعون أبدًا إلى ما هو موجود فوقهم، ولم يوجد ما يحملهم لأعلى. فهم لم ينعِّشوا أنفسهم أبدًا بجوهر الحقيقة، ولم يتذوقوا المتعة الصافية التي ليس فيها أي خداع. ينظرون دائمًا إلى الأسفل، مُطأطِئي الرؤوس، يعيشون كالأنعام، يأكلون ويسمنون ويتزاوجون، يقودهم الطمع إلى الترافس والتناطح بحوافر وقرون من حديد. ولأنهم نهمون فإنهم يقتتلون، وهم نهمون لأنهم يغفلون البحث عن الانتعاش الحقيقي في ذلك الجانب الحقيقي والصافي من الروح، لذا فهم يضطرّون للعيش بأقنعةِ وأوهام المتعة الحقيقية: فمتعهم لا بدّ أن تمتزج بالألم، وهذا التجاور بين إحساسَي المتعة والألم هو ما يعطي لكلٍّ منهما طعمه وقوته، مما يدفع الحمقى إلى الانغماس في مستنقعات الأنانية وحب الذات، ويظلون يدافعون عن كل هذه الضلالات والأوهام كما روى الشاعر الإغريقي ستيسيكورس قصة المعركة التي دارت في طروادة لمطاردة شبح هيلين من قبل رجال لا يعرفون الحقيقة”.((6))
وكما هو الحال مع مذهب كونفوشيوس، يوجد هنا تفريق واضح بين مجموعتين من الناس: من يتسمون بالحكمة ويركزون انتباههم على المتع العليا، ومن يتسمون بالجهل ويركزون انتباههم على المتع الدنيا. وفي أحسن الأحوال، قد يرتفع الجهلة والعامة إلى مستوى متوسط ولكنهم يقضون معظم حياتهم في المسافة ما بين المنتصف والقاع، فيعيشون أشبه بالأنعام يبحثون عن متع أقرب إلى الحيوانات التي لا روح فيها بدلا من أن يُشبهوا البشر الذين لديهم روح خالدة.
ويصور أفلاطون الفرق بين الفلاسفة والعامة في الجزء السابع من كتابه “الجمهورية” من خلال قصة الكهف الشهيرة، حيث يطلب منا سقراط أن نتخيل أناسًا يعيشون في كهف منذ طفولتهم وهُمْ في وَضْعٍ بحيث لا يرون أمامهم سوى جدار الكهف، ولا يعرفون أن وراءهم ممرًّا طويلاً يقود إلى خارج الكهف، ويوجد خلفهم ضوء ساطع يجعل ظلال الأشياء مِن خلفهم تسقط على الجدار أمامهم. ويعيش هؤلاء الأشخاص حياتهم وهم ينظرون إلى الحائط ويتعاملون مع الظلال الساقطة على الجدار كما لو كانت أجسامًا حقيقية، ولا يدركون أنها ليست في حقيقتها سوى ظلال أو صور للأجسام الحقيقية. وعندما يسمعون أصداء الأصوات تتردد داخل الكهف يعتقدون أن الظلال هي التي تصدر تلك الأصوات، وتبدأ عقولهم في نسج قصص حول تلك الظلال، ويصبح لها معنى لديهم، فهذه الظلال هي “الحقيقة” بالنسبة لهم… وذات مرة، تمكن أحد هؤلاء الأشخاص بشكل أو بآخر من التحرر من هذا الوضع الثابت، واستدار ليرى ذلك الضوء الساطع والظلال التي يكوِّنها، والممر الذي يمتد لأعلى إلى خارج الكهف حيث يوجد نور أكثر سطوعًا، فقطع الممر والنورُ يؤلم عينيه حتى خرج من الكهف إلى ضوء النهار، إلى العالم “الحقيقي”. ولم يستطع في البداية رؤية السطوع الكامل للحقيقة؛ فلا بدّ أن تعتاد عيناه عليها بالممارسة، إلا أنه في النهاية أصبح يرى كل شيء بوضوح، فعاد إلى الكهف ليخبر الآخرين بالظلام الذي يقبعون فيه والنور الذي يُمْكنهم الحصول عليه إذا تحرروا وتركوا تلك الظلال ومشوا عبر الممر إلى النور، فسخروا منه وتشاجروا معه، حتى قرروا قتله في النهاية بسبب أفكاره التي تبدو سخيفة للغاية ولا تمت بصلة للحقيقة.((7))
والشاهد في القصة واضح، وهو أن عددًا محدودًا من الناس هم الذين سيوجهون شخصياتهم بالكامل صوب نور الحكمة والحقيقة ويهبون أنفسهم للبحث عنه رغم كل المصاعب، أما الأغلبية فسوف يفضلون كهف الظلام ويقضون حياتهم مشغولين بالأعمال اليسيرة والهينة التي تنتمي إلى عالم الظلال، على حساب المتع العليا التي تليق بمخلوقات لديها روح حية. ويواصل سقراط قائلا:
“نؤكد أن هذه القوة كامنة بالفعل في روح الجميع، فالطريقة التي يتعلم بها كلٌّ منا تشبه ما يحدث للعين؛ فهي لا تستطيع الانتقال من الظلام إلى النور من دون نقل الجسم بأكمله، لذا فإن المرء -من خلال قدرته على المعرفة، إضافة إلى روحه بأكملها- ينبغي أن يحول وجهته من عالم الأشياء المؤقتة والزائلة إلى عالم الوجود الأزلي الدائم، إلى أن يتعلم في النهاية تحمُّل رؤية أكثر الأشياء سطوعًا في ذلك العالم. وهذا هو ما نسميه “الخير”، أليس كذلك؟”((8))
إذن، صحيح أن القدرة على الحياة بحب الحكمة موجودة فينا جميعًا، إلا أن القليلين هم من يفعِّلون هذه القدرة الداخلية في حياتهم. وتحقيق ذلك يتضمن توجه الفرد بكل كيانه نحو “الحقيقة المطلقة” ومقاومة إغراء المتع الزائلة التي تكون في أحسن الأحوال مجرد صور لتلك الحقيقة. ويتفق أفلاطون مع كونفوشيوس في وجود نوعين أساسيين من الناس في هذا العالم: الأعمى والبصير.
وبعد أفلاطون وكونفوشيوس، يأتي كولن ليحدد خصائص البشر المثاليين التي تميزهم عن القطاع العريض من الناس العاديين. وقد أعطى كولن في أعماله أسماء عديدة للأفراد الذين يُعتَبَرون مثالاً للكمال الإنساني، منها “ورثة الأرض” (Inheritors of the Earth)((9)) و”الشخص ذو المثل العليا” (Person of Ideals)((10)) و”الأشخاص المثاليون” ((Ideal People).((11)) وأيًّا كانت التسمية، فهؤلاء الناس يشتركون في سمات واضحة تميزهم تمامًا عن الناس الدنيويين. ويرى كولن أن التجديد والنهضة سيَحدثان في العالم بشكل عام -وفي تركيا بشكل خاص- عندما يتقدم هؤلاء الناس المثاليون روحيًّا وأخلاقيًّا وفكريًّا لقيادة الإنسانية إلى عصر جديد، من خلال ما يقدّمونه من خدمات وأيضًا ما يمثّلونه من قدوة في حياتهم الخاصة. وبدون هؤلاء الناس، سيستمر المجتمع في التخبّط وسط بحر من الشهوات والأيديولوجيات الانتهازية، ولن يَسْمُوَ الناس في مجتمع كهذا إلى مستوى يجعلهم يستحقون صفة “الإنسانية”. يقول كولن:
“بعض الناس يعيشون دون تفكير، بينما البعض الآخر يفكرون ولكنهم لا يستطيعون وضع أفكارهم حيز التنفيذ. (…) ومن يعيشون دون تفكير يكونون مادة لفلسفات الآخرين، وهم يتنقلون دائمًا من نمط إلى نمط ولا يفتأوون يبدلون قوالبهم وصورهم، ويقضون حياتهم في سباق محموم من الانحرافات في الأفكار والمشاعر، والاضطرابات في الشخصية، وهم ممسوخون بصورهم أو أرواحهم، وليس بمقدورهم أن يرجعوا إلى ذواتهم. (…) هؤلاء يُشْبهون دائمًا بِركة ماء راكد آسن منتن، فبدلا من يبعثوا الحياة فيما حولهم يصبحون أشبه بمستعمرة للفيروسات أو مأوى للجراثيم”.((12))
هذه هي كلمات كولن، ولكنها يمكن بسهولة أن تكون كلمات أفلاطون أو كونفوشيوس أيضًا؛ فكولن هنا يفعل ما سبقه إليه زميلاه في المحاورة من تحديد نوعين من الناس في هذا العالم، وهم المثاليون -أو من يدركون ما هو مثالي ويسْعون إليه- والدنيويون. وما يشترك فيه الدنيويون هو أنهم -عند مستوى معين- ينسون أنهم أناس لهم قيمة. ويكمل كولن فيقول:
“ويبلغ من ضحالة أفكار هؤلاء الناس وسطحية آرائهم أنهم يقلدون كل ما يرون أو يسمعون -تمامًا كالأطفال- يسيرون كالإمّعات هنا وهناك وراء الجموع، ولا يجدون أية فرصة للإنصات إلى أنفسهم أو محاولة التعرف على قيمتهم، بل إنهم لا يدركون أصلاً أن لديهم قيمة تميزهم عن غيرهم، فيقضون حياتهم كعبيد للجسد، عبيد لا يرضون بالتحرر من أحاسيسهم الجسدية، ويجدون أنفسهم -بوعي أو بدون وعي- عالقين في واحد أو أكثر من تلك الفخاخ القاتلة، ويَذبحون أرواحهم مرة بعد مرة، في أكثر أشكال الموت بؤسا”.((13))
وكما هو الحال مع سكان الكهف في قصة أفلاطون، فإن الدنيويين -حسب رأي كولن- يعيشون حياة متمركزة حول المتع الجسدية المحدودة على حساب المتع العليا من النمو الفكري، والارتقاء الروحي، والمساهمة في بناء المجتمع، وهم بذلك يتنكرون لإنسانيتهم ويعيشون كالحيوانات. ويقول كولن فيما يتعلق بالوصول إلى الإنسانية الكاملة:
“إلا أن البشر بعيدون كل البعد عن الوصول إلى ذلك بسبب جسديتهم وشهوانيتهم، بل يمكن القول: إنه عندما يغفل البشر عن أنفسهم أو عن وجودهم وماهيتهم فإنهم قد يصبحون أدنى من المخلوقات الأخرى. غير أن هؤلاء البشر في الوقت نفسه -بعقولهم ومعتقداتهم وضمائرهم وأرواحهم- شهود على الأسرار المقدسة الكامنة بين مسارات الحياة. ولذلك فإنه مهما بدا البشر تافهين، فإنهم يظلون “المثال الأسمى” ويظلون مميَّزين عن غيرهم. والإسلام لا يقدِّر قيمة البشر بطريقة مسك العصا من المنتصف، فهو الدين الوحيد بين كل المعتقدات الذي يَعتبر البشرَ كائناتٍ راقيةً خلقت لرسالة أو لمهمة خاصة، ولذا فقد أمدها الله بإمكانات ومواهب أعلى. فالبشر في الإسلام لهم السيادة لمجرد كونهم بشرًا”.((14))
والشاهد واضح في كلام كولن، حتى إذا شكك البعض في قوله عن نظرة الإسلام المتميزة للإنسان؛ فكما ذُكر في الفصل الأول، ينادي كولن بالكرامة الإنسانية والقيمة الأخلاقية المتأصلة في إطار النظام الفلسفي الديني للإسلام، والذين يعيشون غافلين عن تلك القيمة وذلك الوعد -أو مستخِفِّين بهما- يختارون أن يعيشوا حياة أدنى من الحياة الإنسانية، وتلك للأسف هي الحياة التي يختارها أكثر الناس.
ولكن من بين الجموع الغفيرة، يظهر قلة من الأفراد الاستثنائيين يرون ما هو أبعد من المتع الوقتية الزائلة ومشاغل الحياة الدنيا، وهؤلاء -رغم تنوع وصفهم لدى كونفوشيوس وأفلاطون وكولن- يصلون إلى المثالية الإنسانية، وبالتالي يمثلون القدوة الساطعة لما هو ممكن في عالم الحياة الإنسانية. وبالنسبة للمفكرين الثلاثة، ينعقد الأمل على هؤلاء الناس في تحقيق حياة إنسانية طيبة على المستوى الفردي والاجتماعي أو السياسي، لذا يرى كلٌّ من المفكرين الثلاثة -بطريقته الخاصة- أن هؤلاء الأفراد المثاليين ينبغي أن يأخذوا مكانهم كقادة في المجتمع.
وكما ذكرنا سابقًا، يتميز الإنسان المتفوق لدى كونفوشيوس عن عامة الناس بشخصيته الأخلاقية، وقد أكثر كونفوشيوس وغيره في التراث الإنساني من الحديث عن الفضائل الجوهرية التي تُميّز الإنسان المتفوق وتُجسد إنسانيته العميقة، وهذه الفضائل الجوهرية تسمى “الفضائل الثابتة” في الكونفوشية، وهي تتفاوت من حيث الكم وكذلك من حيث “الكبر” أو “الصغر” بحسب الشخص الذي ينظر إليها، ولكنها تعمل كمجموعة شاملة من الصفات الشخصية التي يمثلها البشر المتفوقون. وهذه الفضائل تشمل الـ”رين” (ren) وهي الإنسانية وحب الخير والطيبة، والـ”لي” (li) وهي الطقوس والآداب العامة واللياقة، والـ”يي” (yi) وتعني الاستقامة والصواب، والـ”زي” (zhi) وتعني الحكمة، والـ”زين” (xin) وتعني الوفاء والموثوقية، و”شينج” (cheng) وتعني الإخلاص، و”زياو” (xiao) وتعني بر الوالدين. وتتواتر تأكيدات كونفوشيوس على كل تلك الفضائل وغيرها في التراث، ولكن أبرزها كانت الـ”رين” والـ”لي” وأهمها على الإطلاق هي الـ”رين” التي اعتبرت جوهر كل الفضائل. فالـ”رين” هي أساس كل الفضائل، ويعلق لورانس ج. تومبسون (Laurence G. Thompson) على ذلك قائلاً: “لقد تم تلخيص الكمال الأخلاقي في كلمة الـ”رين”، وهي تعني بالنسبة لكونفوشيوس درجة من المثالية تبلغ من الارتفاع والسمو أنه لم يجد قط شخصًا تنطبق عليه فعلاً تلك الكلمة”.((15)) وقد كان التركيز على الـ”رين” هو ما ميز الكونفوشية عن أشكال الدين الأخرى التي تقدم مثالية متجذرة في إنكار الذات الاجتماعي أو السياسي، أو الزهد، أو الممارسات المتعلقة بالغذاء، أو الرياضة الروحية (اليوجا) أو الارتقاء النفسي التي تَشيع في الديانات الصينية الأخرى. ويؤكد اسم “تراث الأدباء” (Literati Tradition) -وهو الاسم الذي أُطلق على مذهب كونفوشيوس الذي ينادي بإنتاج أفراد متفوقين أخلاقيًّا وعقليًّا- على بناء الشخصية دون النظر إلى النسب أو السلالة كي توضع تلك الشخصية بعد ذلك في خدمة الدولة. ويعتبر “الرين” المثالية الأخلاقية الأكمل للصلاح والإنسانية وحب الخير، وهي تُغرَس داخل البشر عن طريق “اللي”، والذي يعني ممارسة الطقوس والشعائر. وهناك قصة في كتاب “المقتطفات الأدبية” توضح ذلك المعنى فتقول:
سأل “يَن هُويْ” عن الإنسانية (أي الـ”رين”)، فأجاب المعلِّم (كونفوشيوس): “أن تهب نفسك للطقوس (أي الـ”لي”)؛ فهذه هي الإنسانية. فإذا كرس الحاكم نفسه للطقوس ولو لمدة يوم واحد، فسوف يعود كل ما هو تحت السماء إلى الإنسانية. ألا تجد أن ممارسة الإنسانية مصدرها أولاً في النفس ثم بعد ذلك لدى الآخرين؟” فسأله “ين هُويْ”: “هل يمكنك أن تفسر كيف يكون تكريس النفس للطقوس؟” أجاب المعلِّم: “لا تنظر إلا بالطقوس، ولا تسمع إلا بالطقوس، ولا تتحدث إلا بالطقوس، ولا تتحرك إلا بالطقوس”. قال ين هوي: “إنني لست بمثل هذه البراعة، لكنني سأحاول أن أطبق تلك النصائح”.((16))
الشاهد هنا هو أن التمسك الدائم بجميع أشكال اللياقة والآداب والطقوس في كل بعد من أبعاد الحياة يتطلب انضباطًا، وهذا الانضباط بدوره يستخدمه المرء كي يغرس في نفسه شخصيةً مُحبة للخير والصلاح والإنسانية. فالـ”رين” -بقدر ما ينميها الإنسان في نفسه- توفر الأساس لتنمية كل الفضائل الأخرى لديه من خلال الممارسة الدائمة للـ”لي”، وهي هنا تشبه “الإرادة الصالحة” في نظرية كانط عن الشخصية الأخلاقية (سبق تناولها في الفصل الأول). فبغير الإرادة الصالحة لا يمكن تحقيق أي خير آخر، وكذلك بدون الـ”رين” -أي بدون ميل حقيقي للخير والإنسانية- تصبح الفضائل الأخرى بلا أي أساس.
وعندما يجسِّد الإنسانُ المتفوق الفضائلَ الثابتة ويتحمل دوره في الخدمة المدنية، فإنه يكتسب قوة في المجتمع تكون أخلاقية في الأساس، ويطلق على هذا المفهوم الـ”تي” (te) وتترجم غالبًا بالقوة الأخلاقية (moral force) أو الاستقامة (integrity). وهذه الاستقامة لدى الإنسان المتفوق تهذب وتلهم أولئك المحيطين به بحيث تصبح قيادته لهم امتدادًا لشخصيته الخاصة. ونقرأ النص التالي في كتاب “المقتطفات الأدبية”:
قال المعلِّم (كونفوشيوس): “السر في الحُكم هو الاستقامة (أي الـ”تي”). استعملها؛ وسوف تصبح مثل النجم القطبي الذي يوجد دائمًا في مكانه المناسب، بينما تدور حوله النجوم الأخرى مهابةً وإجلالاً”.((17))
وأضاف المعلِّم: “إذا استخدمت الحُكم (الحكومة) لتريهم الحق، والعقاب كي تبقيهم على جادة الطريق، فسوف يتحول الناس إلى مراوغين، ولن يكون لديهم أي إحساس بتأنيب الضمير. ولكن إذا استخدمت الاستقامة لتريهم الحق، والطقوس كي تبقيهم على الجادة، فسوف ينمو فيهم تأنيب الضمير، وسينظرون دائمًا بعمق في كل شيء”.((18))
قال الحاكم “تشي كانج” وهو يسأل كونفوشيوس عن الحكم: “ماذا لو قتلتُ كل من يخرج عن الحق لكي أضمن أن كل الناس يتبعون الحق؟! هل يفلح ذلك؟”
فأجاب كونفوشيوس: “كيف يمكن أن تحكم عن طريق القتل؟ عليك فقط أن توجه قلبك صوب ما هو فاضل وخيِّر، وسوف يصبح الناس فاضلين وخيِّرين. فالنبلاء لديهم استقامة الرياح (الـ”تي”)، أما الصغار فلديهم استقامة العشب: فعندما تهب الرياح ينحني العشب”.((19))
أراد المعلِّم أن يذهب ليعيش بين القبائل البرية التسع الموجودة في الشرق، فسأله أحدهم: “كيف ستتحمل كل تلك الفظاظة؟” فأجاب المعلِّم: “إذا عاش بينهم شخص نبيل، فكيف تكون الفظاظة مشكلة؟”((20))
الفكرة في هذه الفقرات هي أن الـ”تي” قوة في ذاتها، قوة تكفي للتحكم في سلوك الآخرين عندما تتبدى في حياة إنسان متفوق. فالإنسان المتفوق الذي يظهر الـ”تي” بشكل دائم لا توجد لديه أي مشكلة في حكم الناس في المجتمع، لأنه يلهمهم بالقدوة الحسنة إلى درجة أن الصفات الفاضلة تبدأ في الظهور بداخلهم نتيجة اقتدائهم به، فما يتمتع به من الفضيلة يجعلهم يشعرون بتأنيب الضمير بسبب سلوكياتهم غير الأخلاقية، وسيجدون أنفسهم رغمًا عنهم يتلمسون منه الهداية والفضيلة ويُصلحون من أساليبهم المتدنية دون أن يُضطر لإجبارهم على ذلك. وتنطلق هذه النظرية من قناعة كونفوشيوس بفكرة أن الطبيعة الإنسانية خيِّرة في الأصل، ولم يكن ذلك سذاجة من كونفوشيوس فيما يتعلق بالبشر وإمكانية وجود الشر بداخلهم، فقد كان يدرك ذلك بما يكفي، ولكنه مع ذلك ظل مقتنعًا بأن الطبيعة الخيِّرة للبشر يمكن غرسها بالممارسة الدؤوبة والمتأنية بفضل الصفات المتأصلة فيها والتي تجعلها متقبلة لهذا الغرس. كما أن هذا التقبل يعني أن الطبيعة الإنسانية تستجيب لمظاهر الخير الأخلاقي بإصلاح نفسها -حتى ولو بدرجة بسيطة- في اتجاه ذلك الخير الأخلاقي، تمامًا كما ينحني العشب أمام الرياح وتدور النجوم الصغيرة حول النجم القطبي. فهذه هي قوة الـ”تي”.
ويؤكد كونفوشيوس باستمرار في كتاباته أنه بدون إسهام الأشخاص المتفوقين -الذين يجسدون القدوة في الفضيلة الأخلاقية والعقلية- ينحدر المجتمع إلى الفوضى ويسقط ضحية المادية العفنة والتقيد بالطقوس الجوفاء وضحالة التفكير والفساد الأخلاقي. هكذا كانت نظرة كونفوشيوس إلى المجتمع في عصره، وكانت تعاليمه موجهة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، فكان يرى أنه لا يمكن أن يوجد في المجتمع نظام عام أو تناغم لا يبدأ بالشخصية الداخلية لأفراد على خُلق يساهمون بفضيلتهم الأخلاقية في تعزيز المجتمع من خلال التقدم للقيادة والسيطرة. وعلى ذلك، تعد الكونفوشية نظرية سياسية بقدر ما تمثل أيضًا نظرية أخلاقية أو دينية، كما أنها تُعتبر نظرية إنسانية أو طبيعية تعطي أولوية للأفراد الذين يُلزمون أنفسهم بأن تُجسِّد شخصياتُهم أعلى درجة ممكنة من الإنجاز الإنساني أو قيمة الكمال الأخلاقي والعقلي.
ويطرح أفلاطون -مثل كونفوشيوس- نظرية في التنمية الأخلاقية والحكم السياسي في كتابه “الجمهورية” تتمركز حول وجود إنسان مثالي محب للحكمة أو “فيلسوف”. وتُصوِّر محاورات أفلاطون أستاذَه سقراط كأكبر مثال لذلك الفيلسوف من كل الجوانب، وبالتالي فسقراط -كما يظهر في محاورات أفلاطون- يجسد المثالية الإنسانية، وهو يعلِّم هذه المثالية للشباب الذين يتجمعون حوله. فحياته وأفكاره ترشد تلاميذه، سواء من كانوا يجلسون معه في أثينا القديمة أو من يقرؤون محاورات أفلاطون اليوم.
وتبدو “الذات” (Persona) السقراطية واضحة المعالم في كل محاورات أفلاطون، ولكنها تبدو بشكل أكثر تأثيرًا في محاورات “الاعتذار” (Apology) و”كريتو” (Crito) و”فيدو” (Phaedo)؛ إذ يواجه سقراط المحلَّفين الأثينيين الذين اتهموه بالمروق وإفساد شباب المدينة وانتهوا إلى إدانته، ويستسلم لحكم الإعدام المفروض عليه. وفي السطور الأخيرة الشهيرة من “الفيدو” يشرب سقراط الشراب المسموم الذي قدمه له الحارس ويموت. وفي دفاعه عن نفسه أمام المحلفين ضد الاتهامات الموجهة إليه يُبرز سقراط رؤيته للحياة الإنسانية المثالية، فيبين أفضل أنواع الحياة التي يمكن أن يحياها الإنسان، ويدافع عن نفسه بأنه عاش محاوِلاً فهم تلك الحياة والوصول إليها من أجل نفسه ومن أجل الآخرين أيضًا، ويستمر في “الفيدو” و”الكريتو” في التوضيح وضربِ الأمثلة على هذه الحياة المثلى أثناء زيارات تلامذته له وهو يعيش أواخر أيامه في السجن.
والحكمة من أهم سمات الفيلسوف، كما يشرح سقراط وكما يظهر من الأمثلة التي ضربها؛ فكلمة “فيلسوف” كما هو معلوم تعني “مَن لديه حبَ الحكمة”. إلا أن هذا المعنى تم شرحه بشكل متضارب إلى حد كبير في “الاعتذار”، إذ يقول: إن الفيلسوف يكون حكيمًا لأنه يقر بأنه يعرف القليل جدًّا أو لا يعرف شيئًا، فسقراط هو الإنسان الأكثر حكمة؛ لأنه -على عكس المعلمين والسفسطائيين في عصره- كان يدرك أنه ليس حكيمًا. فهذه هي الحكمة بالضبط: إدراك أوجه القصور في المعرفة الإنسانية، خصوصًا عندما تسقط عملية التعلم في براثن التكبر أو تبلد المشاعر، وتكون نتيجةُ هذا النوع الخاص من الحكمة حياة يعيشها المرء فقط لاكتساب المعرفة والبحث عنها أينما كان وكيفما أمكن. وباختصار، فقد عاش سقراط حياته وأراد الآخرين أن يعيشوا حياتهم في البحث عن الحقيقة، وذلك بالتفحص والاستقصاء الدائم لكل شيء مرة بعد مرة. وعلى ذلك، فالصورة التي يرسمها أفلاطون لمعلمه في كل المحاورات هي صورة رجل مستعد لأن يهجر كل شواغل الحياة في مقابل محاورةٍ واستقصاءٍ متعمّقَين عن طبيعة الأمور ذات القيمة، مثل الحب والجمال والخير والعدل، وغير ذلك. ولا يمل سقراط أبدًا من تلك المحاورات، حتى عندما يكون لديه ما يبدو أنه قناعات محسومة أو راسخة في هذه الأمور، فهو يرغب دائمًا في الاستفسار أكثر وإطالةِ الفحص والتحري واختبارِ كل شيء حتى الاستنتاجات الثابتة. ومن هذا النمط من الحياة جاءت إحدى أشهر مقولات سقراط: “الحياة التي ليس فيها استفسار عن كل شيء لا تستحق أن نحياها”.((21))
كما يجسد سقراط خصائص أخرى للمثالية الإنسانية -أو للفيلسوف- ومنها الاهتمام بالروح أكثر من الجسد، والخوف من الشر أكثر من الخوف من الموت، والتحصن ضد آراء العوام. وهذه النقطة الأخيرة بالذات لها أهمية بالنسبة لموضوعنا هنا، إذ يخبر سقراط كريتو أنه ينبغي أن يعيش حياته طلبًا لرأي الخيِّرين والمطلعين فقط وليس جموع الناس، فالناس لديهم ما لا يعد ولا يحصى من الآراء حول كل شيء، ويميلون إلى التركيز على المكسب المادي العاجل على حساب الحقائق الأزلية، لذا ينبغي على كريتو أن يطلب الرأي والمشورة فقط من القلة الحكيمة. في كل هذه المقولات تقف قناعة أخلاقية عميقة بأن أفضل وأسمى حياة إنسانية هي حياة الفضيلة أو الرقي، وعلاوة على ذلك -كما يوضح سقراط في كتاب “الجمهورية”- فإن هؤلاء الأفراد الذين يمتلكون تلك الفضيلة ينبغي أن يتقدموا لتحمل مسؤولية الدولة، وإلا فإن الفوضى والطغيان هما النتيجة الحتمية.
وتمثل فكرةُ أن الحياة تستقيم عندما تسود الفضيلة موضوعًا ثابتًا في تعاليم سقراط، كما أنها الفكرة المركزية في كتاب “الجمهورية”، فهو يقول: إن “الجزء” الفاضل في أيِّ كيان يجب أن يحكم كل الأجزاء الأخرى حتى يوجد النظام والتناغم والخير في الكيان بكامله. وهذا صحيح على المستويين الفردي والجماعي؛ فحياة الأفراد تستقيم عندما يُحكَمون من خلال الجزء الأسمى والأفضل في أنفسهم، ألا وهو روحهم التي فُطرت على التوافق مع أسمى فضائل الخير والحق والعدل، وبالـمِثل يتحقق للمجتمع النظام والتناغم والعدل عندما يتولى أفراده الأفضلون والأسمَوْن حُكمَ بقية الأفراد، وهؤلاء الأفضلون والأسمَوْن هم الفلاسفة -الأفراد المهذبون أخلاقيًّا الذين تَحدّثْنا عنهم سابقا- الذين يصفهم سقراط لاحقًا بأنهم “الوصاة” على الدولة. ويعترف سقراط أن البعض قد يجد فكرةَ أن الفلاسفة ينبغي أن يصبحوا ملوكًا غير قابلة للتصديق، لكنه مع ذلك يصرّ عليها، فيقول لأحد الشباب الملازمين له، ويُدعَى جلاكون:
“ما لم يصبح الفلاسفة ملوكًا في بلادنا -أو ما لم يصبح الملوك والحكام الموجودون الآن فلاسفة حقيقيين- بحيث تتقارب السلطة السياسية مع الحنكة والفطنة الفلسفية، وما لم يُستبعد مِن تولي الحكم ذوو الطباع الدنية الذين يسعون وراء أحدهما دون الآخر، فأنا أومِن يا عزيزي جلاكون أنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية للمتاعب في بلادنا أو في حياة البشرية كلها. عندئذ فقط، ستدب الحياة في نظريتنا وسترى النور -على الأقل- بقدر ما هو ممكن. الآن ترى لماذا امتنعتُ لفترة طويلة جدًّا عن التحدث علانية في هذا الاقتراح المثير للمتاعب؛ لأنه يعني حقيقة مؤلمة وهي أنه ليس هناك سبيل آخر لتحقيق السعادة، سواء في الحياة الخاصة أو العامة”.((22))
وما يهم في هذه الفقرة هو وصف “ذوي الطباع الدنية” الذي أطلقه سقراط على من يطلبون إما السلطة السياسية أو الفطنة الفلسفية وحدها، وليس الجمع بينهما، ورأيه هنا هو أن الأُولى بدون الأخيرة تؤدي إلى الاستبداد والفساد، بينما الأخيرة بدون الأولى تؤدي إلى الضعف وعدم الفائدة. فمن يمتلكون السلطة السياسية ولكن ليست لديهم فطنة فلسفية حقيقية يستعينون بها، سيحكمون الدولة من منطلق السعي للمكسب الشخصي واستغلال السلطة. ومن يتمتعون بالفطنة الفلسفية ولكن ليست لديهم أي تطلعات لتطبيق معارفهم سياسيًّا سيهدرون طاقاتهم في نزوات وتفاهات فكرية ليس لها أي تطبيق مفيد. إذن، يجب أن يتم الجمع بين هذين المجالين، وأن يتولى الحكمَ الفلاسفة الحقيقيون.
والفلاسفة الحقيقيون -بالطبع- هم مَن وصَفناهم منذ قليل: أولئك الذين يهتمّون أكثر بالحقائق الأزلية وليس بالحقائق الزائلة، والذين يسعون نحو النور وليس نحو ظلمة الكهف، والذين يعيشون مثل أرواحهم الخالدة وليس كالحيوانات التي تأكل وتتناسل كما يُفضِّل معظم الناس. هؤلاء الأفراد وحدهم -الرجال والنساء الذين يعيشون معًا بلا أي اكتراث للثروة الشخصية حتى على مستوى الحياة العائلية- يمكنهم أن يوجهوا دفة الدولة بحيث يسود الخير والنظام والحق في كل شؤونها.(*(23)) وهؤلاء الفلاسفة الحقيقيون يبحثون عن الحقيقة قبل أي شيء آخر، ويبحثون عنها كي يعيشوا بها سواء بشكل فردي أو جماعي، ولا توجد إمكانية لوجود تناغم اجتماعي وسياسي خارج نطاق حكمهم.
ويَعترف سقراط بأن جمهوريته المثالية قد لا تتحقق بالكامل على أرض الواقع، لكنه مع ذلك يصرّ على أن من يعنيهم أمر الْمجتمع يجب أن يحاولوا الوصول إليها قدر المستطاع، وإلا فسيبقى الاستبداد والفوضى هما الخيارين الأخيرين للمجتمع. وقد أدرك كلٌّ من كونْفوشْيوس وسقراط بوضوح في حياتهما أنه إلى أي مدى يمكن أن ينحدر المجتمع عندما يسيطر مَن لا يهتمون بالخير أو الحق على مقاليد السلطة. وما تزال احتمالات الفوضى تلك قائمة منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا. لذا يأتي كولن اليوم ليطرح رؤية لتوجيه المجتمع وإرشاده تُشابه كثيرًا رؤية نظيريه القديمين، فهو يتفق مع كونفوشيوس وسقراط بأن أمل المجتمع يكمن فقط في تأثير “الأفراد المثاليين”.
وتتوازى أفكار كولن عن العالم الإسلامي، وخصوصًا تاريخ الأناضول ومصيره، مع خواطر كونفوشيوس عن الصين القديمة، فكِلا الرجلين يشير إلى فترة ماضية من العظمة الضائعة التي يجب استعادتها الآن. يشير كونفوشيوس بشكل متكرر إلى الحكام والأباطرة القدماء وغيرهم من الأجيال السابقة كأمثلة للنبل والحكمة اللذين كان ينبغي -وقتها- استلهامهما لو كانت الصين ترغب في استعادة مجدها السابق وتجنب التشرذم والطغيان. وكولن أيضًا يتأمل في الماضي المجيد للإمبراطورية العثمانية، يوم كانت الحضارة التركية في أوجها، وكان الإسلام كدين وثقافة يسود العالم سيادة مطلقة. وهو يرى أن عظمة العثمانيين الحقيقية كانت تكمن في التزامهم بالمُثل العليا التي تهدف إلى خير المجتمع في حاضره ومستقبله، وأيضًا في جوهرهم الإسلامي الذي جعلهم يقتدون بالخلفاء الأربعة الراشدين، الذين جاؤوا في أعقاب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى أيضًا أن شخصيات بارزة مثل الفراعنة وقَيصر ونابلْيون، وإن كانت تصرّفاتهم تسيء إلى سمعتهم، فإن أعمالهم لم تكن ذات طبيعة استمرارية؛ لأن الدافع في أعماقهم لم يكن المثل العليا من أجل الإنسانية ومستقبلها، بل الطموح الشخصي والطمع وشهوة القوة. يقول كولن عنهم: “إن الأبهة والحياة الصاخبة لفرعون ونمرود ونابليون وقيصر وأمثالهم والتي فَتنت الكثيرين من الأغرار لم تكن -ولن تكون- واعدة ومبشرة للمستقبل بأي حال من الأحوال؛ لأنهم أناس تعساء وضعوا الحق تحت إمرة القوة، وبحثوا عن الروابط الاجتماعية في محيط المصالح والمنافع الشخصية، وعاشوا حياتهم عبيدًا لا يتوقون إلى التحرر من الأحقاد والأنانية والشهوانية”.((24))
فغياب المثُل العليا والقيم المطلقة من أجل الحاضر والمستقبل هو ما منع أعمال تلك الشخصيات التاريخية من إحداث أي تأثير إيجابي متجدد. لكن هذا في رأي كولن لم يكن ينطبق على الخلفاء الراشدين أو على العثمانيين، فيقول: “في المقابل، قدم الخلفاء الراشدون ومِن بعدِهم العثمانيون أعمالاً جليلة تجاوزت آثارُها هذا العالم إلى العالم الآخر، وكانت من العظمة بحيث إنها صمدت أمام السنين والقرون، طبعًا في نظر مَن لا ينخدع بفترات الخسوف المؤقَّتة. ورغم أنهم عاشوا عمرًا زاخرًا وأكملوا رسالتهم في الحياة ثم رحلوا، ولكنهم لن يغادروا الصدور التي يَحيون فيها بذكرى مآثرهم الجميلة. فما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني “آلبْ أرْسلاَن” و”ملِك شاه” و”الغَازي عُثمان” و”محمّد الفاتح” وغيرهم كثيرين، كأريج البخور، فيبعث طيفهم الآمالَ والبشرى داخل أرواحنا”.((25))
وهناك فارق نوعي بالنسبة إلى كولن بين شخصيات مثل قيصر ونابليون والفراعنة من ناحيةٍ، والفاتح وسُلَيمان القانوني والْخلفاء الراشدين وغيرهم من الناحية الأخرى. هذا الفارق يكمن في تجسيد كلٍّ منهم -أو خضوعه- للمثل العليا من خير وحق وأخلاق وعدل، فهذه المثل العليا هي الأساس الشرعي الوحيد لأي برنامج اجتماعي أو سياسي أو ثقافي يحقق نتائج إيجابية لحاضره ومستقبله. ويرى كولن أن هناك مطالبات بإحياء تلك المثل في تركيا المعاصرة، مع ظهور جيل جديد ملتزم بالمثل العليا، فيقول: “هناك الآن -وفي الطريق أيضًا- أعداد هائلة من حملة العلم والمعرفة والفن والأخلاق والفضيلة هم ورثة القيم التي قام عليها تاريخنا المجيد”.((26))
وقد ركّز كولن في مختلف أعماله على وصف البشر المثاليين في تصوره، ولكنه لم يكن أكثر بلاغة في الوصف مما كان في كتابه (ونحن نقيم صرح الروح)، حيث استعمل فيه مصطلح “الإنسان المثالي” أو “ورثة الأرض” للإشارة إلى الأشخاص الفاضلين عقليًّا وأخلاقيًّا الذين يجسّدون الإنسانية الحقة، وبالتالي يجب أن يقودوا المجتمع حتى يكون مجتمعًا صالِحًا. والفكرة هنا -كما يطرحها كولن- تتلخص في مجموعة من الأشخاص يجسدون ثقافة روحية ويكتسبون مكانة بارزة في الحياة الدنيوية بسبب صلاحهم وورَعهم، وهذه المكانة تظل هبة وتكليفًا لهم من الله، حتى إذا فقدوا استحقاقهم لها نزَعها الله منهم. ويستشهد كولن بآية من القرآن الكريم تشير إلى نصّ من التوراة، يقول الله تعالى في هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾(الأنبياء:105).((27)) ويعلّق كولن قائلاً: “ولا ينبغي أن يتردد امرؤ في توقع مجيء هذا اليوم، وهو وعد الله المؤكّد. ولن تنحصر هذه الوراثـة بالأرض وحدها… ذلك، بأن مَن يـرث الأرض ويحكمها، يحكم أعماق الفضاء والسماء أيضًا. إذن هي حاكمية في الكون كذلك. ولما كانت هذه الحاكمية بالنيابة والخلافة، فحيازة خصال التمثيل التي يريدها صاحبُ السموات والأرض الحق، لازمة وضرورية. بل يصحّ القول: إنما تتحقق تلك الرؤيا، وذلك الرجاء، بقدر إدراك هذه الخصال وتمثُّلها”.((28))
ويواصل كولن فيوضّح أن الحضارة الإسلامية في العصور الماضية كانت تحمل لقب “وراثة الأرض”، لكنها فقدت تلك المكانة بسبب الإخفاقات الداخلية -في عالم القلب والروح-، والخارجية -في عالم العلم الحديث-، وضلّت المجتمعات الإسلامية طريقها روحيًّا وعقليًّا؛ ومن ثَم فَقدت مكانتها كـ”وارثة للأرض”، لتأخذها منها كيانات أخرى في الغرب. ويكرر كولن المناداة باستمرار في هذا الكتاب إلى إحياء الإسلام بمعانيه الروحية والعقلية لكي يعيد نفسه إلى نفسه، حتى تدخل الإنسانية كلها والأرض نفسها في عصر جديد مجيد من التسامح والسلام. ومن خلال مجموعة من الأفراد المتّسمين بالفضيلة والورع، يمكن أن يعود الإسلام وكذلك تركيا -كما يأمل كولن- إلى موقع عالمي بارز لقيادة العالم إلى ذلك العصر الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن كولن في كتابه هذا لم يناد بأي نوع من النشاط السياسي أو الحكومي للوصول إلى هذا العصر الجديد. فكولن ليس رجل سياسة كما أنه ليس منظِّرًا سياسيًا، ولم يناد بجيل جديد من القادة السياسيين على عكس كونفوشيوس وأفلاطون. وهذا فارق جوهري بين كولن وزميلَيه في المحاورة الثلاثية التي نجريها في هذا الفصل وفي الفصل القادم. فأفكار كولن -التي تعتبر تكرارًا لمثل إسلامية أكبر- لا تعتمد على قوة الحكومة من أجل تطبيقها، بل على العكس، يركّز كولن على إعادة تكوين فهم ثقافي وفكري وإنساني ينبع من أناس عاديين ذوي فضل وفضيلة يعيشون حياتهم في سبيل رسالتهم الْمهنيّة والمجتمعية والأسرية. و”السيادة” التي يشير إليها كولن هنا ليست سيادة نخبة من القادة السياسيين على الآخرين، بل هي سيادة وغلبة رؤية حياتية تتّسم بالسلم والعلم والروحانية والتسامح والمحبة، كما أن هذه الرؤية الحياتية تسود نتيجة للأعداد الهائلة من الناس الذين يُثبتون أهليّتهم كورثة للأرض، من خلال ما يتمتعون به من فضيلة وأهلية للخلافة.
ويخصص كولن فصلاً كاملاً من كتاب (ونحن نقيم صرح الروح) لاستعراض صفات ورثة الأرض، وقد تضمن هذا الاستعراض أبلغ تأكيد من كولن على الإنسان المثالي كما يتصورها من منظور إسلامي. فحدد ثماني صفات أساسية لورثة الأرض،((29)) أو كما يسمّيهم في موضع آخر “الإنسان المثالي”، وهذه الصفات هي: الإيمان الكامل، والمحبّة، والتفكير العلمي المستنير بالرؤية الإسلامية، وتقويم الذات، ونقد الرؤى والتصورات الشخصية، والتفكير الحر واحترام حرية الفكر، والضمير الاجتماعي وتفضيل القرار المبني على الشورى، والتفكيرُ المنطقي، والتذوق الفني.
وتبدو هذه القائمة ظاهريًّا مختلفةً تمامًا عن قائمة كونفوشيوس لفضائل الإنسان المتفوق أو عن الفضائل التي وضعها سقْراط، ولكن بإمعان النظر نجد خطوطًا متوازية بين الثلاثة. فالإيمان والمحبّة الكاملان يوجدان في الشخص المثالي عند كولن من منطلق إسلامي نابع من إسلام الوجه لله، أي إن الإيمان والمحبة يأتيان هنا ضمن ذلك الإطار الأوسع للمرجعية الدائمة التي هي الاستسلام والخضوع لله. وذلك الإيمان وتلك المحبة لن ينـزلقا إلى استهداف أشياء مادية أو دنيوية تقود الحضارة إلى طريق المادية والشهوانية، بل يضعان صوب أعينهما دومًا الحقائقَ الأزلية، تمامًا كما يفعل الوصاة الذين تَحدَّث عنهم سقراط.
والتفكير العلمي والمنطقي لورثة الأرض عند كولن يعبر عن وجهة نظر مبنية على القناعة بأن الحقيقة واحدة وأنها لا تتمايز إلى ضروب متباينة من الحقيقة الدينية في مقابل الحقائق العلمية، أو حقائق الإيمان في مقابل حقائق العقل. فالحقيقة بالنسبة لورثة الأرض لا تتجزأ، وهم يسعون لفهم الحقيقة كلها بقوة العلم والرياضيات، ويتحمسون لتعزيز الفهم العلمي للكون كـ”كتاب مقدس” شديد التعقيد من صنع الخالق سبحانه. وهم يشتركون مع أفراد كونفوشيوس المتفوقين في أنهم يبرعون في العديد من مجالات المعرفة وليس في المعرفة “الدينية” فحسب. فورثة الأرض يتصرفون في أمور الحكم وصناعة القرار من منطلق مصلحة المجتمع وليس مجرد المصلحة الشخصية، ويقدرون قيمة الشورى والحوار كأفضل طريق لاتخاذ القرارات الصائبة. وهم يشبهون طبقة الوصاة عند سقراط في أنهم يخضعون أنفسهم للتحليل والاستقصاء فيما بينهم من أجل الخروج بإجماع يصلح للجميع. وهم يجتمعون مع وصاة سقراط وأفراد كونفوشيوس المتفوقين في أنهم يقسون على أنفسهم، ويُلزمون أنفسهم بالتدقيق المستمر والبحث في مدى صحة أفكارهم ورؤاهم الخاصة من أجل تنقية وتنقيح أنفسهم وأفكارهم في سبيل إشباع تعطشهم الدائم للحقيقة والفضيلة. وأخيرًا، فورثة الأرض -مثل الأفراد المتفوقين والوصاة- يتذوقون الجمال أينما وجد، ويدركون أن حرية ممارسة التفكير والابتكار وحدها يمكن أن تجعل الأرواح المتسامية تخلق رؤى جديدة للعالم وللإنسانية، سواء في علم الجمال أم الفلسفة أم الحكم أم أي مجال آخر.
الفارق الجوهري بين ورثة الأرض عند كولن والأفراد المتفوقين عند أفلاطون أو الوصاة عند سقراط، هو أن ورثة الأرض مسلمون يستمدون وجودهم كله ورؤيتهم للعالم من منظور إسلامي، وما يحول دون تحول حكم ورثة الأرض المسلمين إلى استبداد وقمع هو بالضبط ما يحول دون استبداد حكم وصاة سقراط أو أفراد كونفوشيوس المتفوقين، ألا وهو الحرص على صالح المجتمع والاعتراف المطلق بالقيمة المتأصلة لكل البشر نتيجة شبههم بالإله (كما ذكرنا في الفصل الأول). ويصف كولن ورثة الأرض بإسهاب فيقول: “تلك الشخصية تهرول من نصر إلى نصر، ولكن ليس لتخريب البلاد وإقامة العروش على أطلالها، بل لتحريك المشاعر وتنشيط الملكات الإنسانية، وتقويتنا بأحاسيس الحب والرعاية والمروءة التي تجعلنا نحتضن الناس كلهم والأشياء جميعا، ولإعمار الأرجاء المنهدمة، ونفخِ الحياة في الأوصال الميتة، لتتحول إلى حياة ودم يسري في عروق الوجود، وإشعارِنا جميعا بالأذواق الرحيبة لغاية الوجود. هذا الإنسان بطبعه رباني في كل أحواله وبكل ذاته… وهو في مناسبة دائمة مع الوجود باعتباره خليفة الله. وحركاتُه وأفعاله كلها مراقَبة… فلا يقوم بعمل إلاّ بحسِّ مَن يعرضه على التفتيش… حتى يكون الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به… ويكون أسلوبه مترشحا من تأثير بيانه تعالى… ويكون تحت إرادته تعالى “كالميّت في يد الغسال”. وإن إحساسه بعجزه وفقره أمام الله تعالى هو أعظم مصدر للقوة والغنى… فلا يني ولا يفتر من الاستمداد بأحسن وجه من مَعين هذه الخزينة التي لا تنضب ولا تنفد”.((30))
وكما نرى، فورثة الأرض الذين يقدمهم كولن ليسوا غزاة باسم الله أو الإسلام، وليسوا مجاهدين يشنون حربًا ضد الكفار، بل هم أناس بلغوا منتهى الفضيلة والخير والمحبة وهَبوا أنفسهم للمُثل العليا، ويسعون لإيجاد عالم يتمكن فيه جميع الناس من بلوغ أقصى إمكانيتهم البشرية في كل مجالات الحياة، من أكثرها دنيوية إلى أكثرها سموا وعلوًّا، ويقدِّم فيه أفراد المجتمع أنفسهم مثالاً ملهمًا لتلك الإنسانية المتحققة بشكل كامل.
وهؤلاء الأفراد ذوو المثل العليا يمثلون ركنًا أساسيًا في أي مجتمع حي وصالح ومستمر. وبدونهم تضيع المثل، كما يضيع من يمثلونها، وينخرس تراث المجتمع في أحسن الأحوال، ويكون الخير الذي يبدو أنه يحققه هشًّا سريع الذوبان. يقول كولن: “إذا كان المسؤولون الذين يديرون شؤون دولة فاضلة يتم انتخابهم حسب أصالة نفوسهم ومُثلهم العليا وأصالة مشاعرهم، فإن تلك الدولة دولة قوية وعلى أساس متين. أما الحكومة النكدة الحظ فهي الحكومة التي يُحرَم موظفوها من مثل هذه الخصال الحميدة، ولن يكون عمرها طويلاً؛ لأن تصرف هؤلاء الموظفين المفتقرين إلى السجايا الحميدة سينعكس عليها ويكون -عاجلا أو آجلا- لطخة سوداء على جبينها وتفقد مصداقيتها عند جماهير شعبها”((31)).. “إن سيادة القوة مصيرها إلى زوال، أما سيادة الحق والعدل فباقِية أبد الدهر، وحتى لو لم يكونا غالبين اليوم، فسوف ينتصران عن قريب. ولهذا السبب، ينبغي البحث عن السياسة الكبرى في الانحياز إلى جانب الحق والعدل”.((32))
إن كولن -كزميليه في المحاورة- يصرّ على أن خير المجتمع يتوقف بشكل مباشر على خير مَن يحكمونه. كما أن هؤلاء الحكام وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يجسدون هذه الصفات يضحون بكل طموح شخصي من أجل خير الكل، ويهبون أنفسهم تمامًا لخدمة البشرية، ولا يتوقفون أبدًا عن التفكير في المستقبل. وهم يحيطون أنفسهم بمجموعة من القيم الروحية المطلقة، ويقيسون قيمة كل المكاسب العلمية والتقنية في ضوء تلك القيم. يقول كولن عنهم: “الإنسان الجديد، هو إنسان يتألم ويئن، يموت ويحيا من أجل إحياء الحق وإنهاضه. فهو دائما على أهبة الاستعداد للتخلي عن المال والولد والغالي والنفيس، ولن تكون سعادته الشخصية بُغيتَه أو همه أبدا، بل هَمُّه الوحيد ألا يضيع بذرة واحدة من البذور الصالحة التي منحها له الحق تعالى، بل ينثرها كلها بدقة فائقة على سفوح العناية الربانية من أجل مستقبل الأمة القريب والبعيد… ثم يرتقب مُكابِدا آلامَ مخاض جديد، يتلوى ويتأوه ويئن ويقلق، ويبتهل إلى المولى في أمل، يموت ويحيا في اليوم ألف مرة ومرة. فالسير في سبيل الحق والفناء فيه غايته الوحيدة في الحياة، وانفلات هذه الغاية من بين يديه -في نظره- خسارة لا تعوض أبدا. (…) الإنسان الجديد، هو إنسان عميق من حيث جذوره الروحية، متعدد من حيث ما يملكه من كفاءات صالحة للحياة التي يعيش في أحضانها. إنه صاحب القول الفصل في كل الميادين بدءا من العلم إلى الفن ومن التكنولوجيا إلى الميتافيزيقيا، وصاحب خبرة ومراس في كل ما يخص الإنسان والحياة. أجل، إنه عاشق لا ينطفئ ظمؤه إلى العلوم مهما نهل، مولع بالمعرفة ولعًا لا يفتأ يتجدد كل حين، عميق بأبعاده اللدنية التي تعجز العقول عن تصورها.. وهو بهذه الخصال كلها يسير جنبا إلى جنب مع سعداء عصر السعادة وينافس الروحانيين في سباق معراجي جديد كل يوم”.((33))
يصف كولن المثاليين هنا بأنهم أناس يهربون من الإغراءات الدائمة التي ذكرها سقراط في كتاب “الجمهورية”، أي إغراءات التعلق بالمتع الدنيوية والثروة وسبل الراحة الشخصية. فالمثاليون عند كولن -كما الوصاة عند سقراط- لا يستسلمون لتلك الإغراءات؛ لأنهم جُبلوا على السعي الدائم لنيل المتع والحقائق الأبدية على حساب ما هو وقتي وزائل. وهم -كالوصاة أيضًا- لا يرضون أبدًا عن أنفسهم وعن معرفتهم، بل يتحركون دائمًا إلى الأمام، توّاقين إلى آفاق أرحب من المعرفة والفضيلة والخير والحقيقة. ويرى كولن أنه عندما يتشكل المجتمع التركي -والمجتمعات كلها- من أمثال هؤلاء الأفراد أو يتأثر بهم، عندها فقط ستتحول الحضارة الإنسانية إلى الحياة والحيوية والعافية بدلاً من السير نحو الموت والتحلل.
ونكرر هنا أن رؤية كولن للقيادة رؤية واسعة بعيدة كل البعد عن الجانب السياسي؛ فمحاضراته وكتاباته لا تحوي بين طياتها نظام حكم أو نظرية سياسية معينة كما هو الحال مع مذهب كونفوشيوس وأفكار أفلاطون التي ذكرها في “الجمهورية”. فكُولَن داعية وعالِم دين إسلامي وليس عالِمًا أو ناشطًا سياسيًّا، وهو لا يدعو مستمعيه إلى الترشح للمناصب أو السيطرة على مقاليد الحكم، ولا يدعو إلى حل نظم الحكم القائمة. صحيح أن رؤيته للمجتمع تتضمن بالتأكيد أناسًا مثاليين يحتلون مواقع سلطة في الحكومة، إلا أنه في الغالب لا يتكلم بتلك النظرة الضيقة أو المحدودة، بل يتكلم عن قيادة مجتمعية منتشرة في أنحاء المجتمع في مختلف المهن والتخصصات؛ إذ إن ذوي المثل العليا سيسهمون في تشكيل المجتمع بأن يهب كلٌّ منهم نفسه لرسالته التي يؤديها كعالم أو كمعلم أو كرجل أعمال أو كموظف في جهة خدمية أو كوالد أو كموظف عام أو كعامل أو غير ذلك. فالصورة بالأساس هي صورة لقاعدة عريضة من الناس تختار -من خلال العملية الديمقراطية- من يجسدون المثل الفاضلة كي يتولوا خدمة الدولة وتوجيهها. غير أن النتيجة النهائية هي نفسها بالنسبة لكلٍّ مِن كونفوشيوس وأفلاطون وكولن، ألا وهي إيجاد مجتمع صالح ومستقر؛ صار كذلك لأنه يُدار بواسطة أناس يجسدون في أنفسهم أسمى المثل الإنسانية العليا للخير والفضيلة.
إذن، فقد بلْور لنا الفلاسفة الثلاثة المشاركون في المحاورة -في ضوء الرؤية الخاصة بكلٍّ منهم وعصره- سمة أساسية لما هو مطلوب من أجل حياة إنسانية صالحة على المستويين الفردي والجمعي، هذه السمة الأساسية هي الفضيلة: العقلية والأخلاقية. فالناس سيبلغون أقصى -ومن ثم أسعد- ما في الحياة الإنسانية عندما يضعون نصب أعينهم أن يقيموا من أنفسهم أناسًا ذوي فضيلة عقلية وأخلاقية. والمجتمع ككل يبلغ أقصى وأفضل تنمية عندما يوجهه أولئك الأفراد ذوو الفضيلة العقلية والأخلاقية العالية، الذين يُعتبرون الأقدر على رؤية ما فيه الخير للجميع، وليس خير القلة المتميزة أو خير أنفسهم فقط. هؤلاء الناس ذوو الفضيلة سيوجهون المجتمع بحيث يمتلك أفراده فرصًا هائلة لتنمية أنفسهم لبلوغ أقصى ما في إمكانهم من الإمكانات البشرية.
والسؤال الآن هو: مِن أين نأتي بهؤلاء الأفراد ذوي الفضيلة؟ أين نجد تلك الشخصيات القيادية البارزة التي سترشد وجودنا الاجتماعي والجمعي نحو الخير والحق والعدل؟ هل ينـزل هؤلاء الناس علينا من السماء ومعهم عصا سحْرية للحكم؟ أهم كائنات ملائكية تمشي بيننا؟ كلا؛ فهؤلاء الناس هم بشر مثلنا لهم أب وأم وليسوا ملائكة، ويجب أن يتربّوا ويتعلموا لكي يصبحوا نماذج الفضيلة التي يحتاجها المجتمع للتقدم والازدهار. وقد اتفق الفلاسفة الثلاثة على أن التعليم هو الوسيلة التي بها ننمي من بيننا كمجتمع هؤلاء الأفراد ذوي الفضيلة، لذا سنستعرض نظريات التربية والتعليم الخاصة بكلٍّ منهم في الفصل القادم.
(1) Confucius, The Analects, 146. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية)
(2) المصدر السابق، ص 132.
(3) المصدر السابق، ص 176.
(4) المصدر السابق، ص 188-189.
(5) المصدر السابق، ص 189.
(6) Plato, The Republic, 277–8.( أفلاطون، الجمهورية)
(7) المصدر السابق، ص 209-211.
(8) المصدر السابق، ص 212.
(9) Gülen, The Statue of Our Souls, 5ff. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح).
(10) المصدر السابق، ص 125-126.
(11) Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 128–30. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
(12) Gülen, The Statue of Our Souls, 135. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح).
(13) المصدر السابق، ص 135-136.
(14) Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 113. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
(15) Thompson, Chinese Religion, 13. (تومبسون، الدين في الصين).
(16) Confucius, The Analects, 127. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية).
(17) المصدر السابق، ص 11.
(18) المصدر السابق.
(19) المصدر السابق.
(20) المصدر السابق، ص 95.
(21) Plato, The Republic, 41. (أفلاطون، الجمهورية).
(22) المصدر السابق، ص 165.
(23)(*) يؤكد سقراط في موضع آخر من “الجمهورية” أنه بالإضافة إلى كون هؤلاء الأوصياء فلاسفة، فإنه يمكن أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، وأنه لا ينبغي أن تكون لهم ملكية شخصية بل تكون الملكية مشتركة بينهم جميعًا، بما في ذلك الأطفال.
(24) Gülen, The Statue of Our Souls, 124. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
(25) المصدر السابق.
(26) المصدر السابق، ص 119.
(27) المصدر السابق، ص 5.
(28) المصدر السابق.
(29) المصدر السابق، ص 31-42.
(30) المصدر السابق، ص 89.
(31) كولن، الموازين أو أضواء على الطريق، ص 71-72. Gülen, Pearls of Wisdom.
(32) المصدر السابق، ص 73.
(33) Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 822. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)

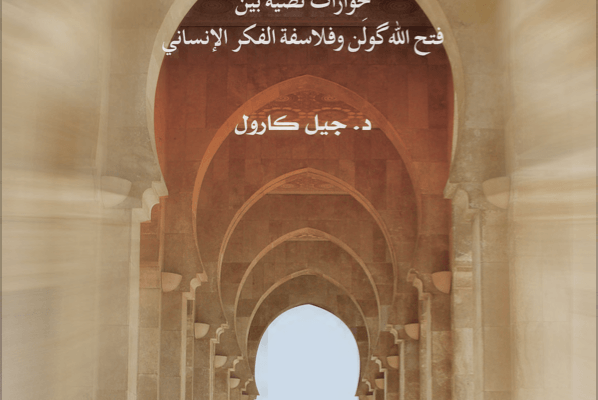
Leave a Reply