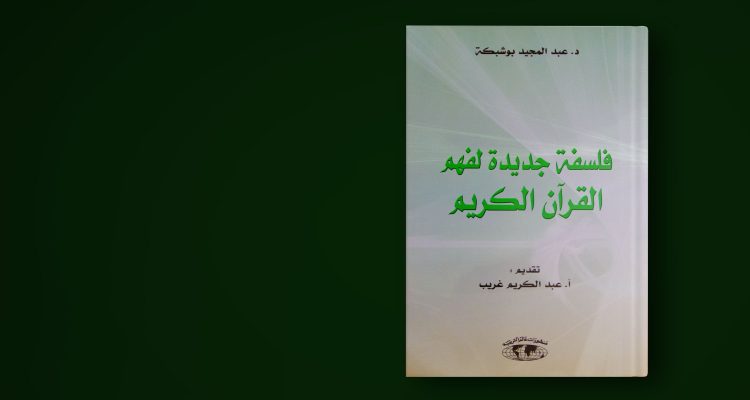نعم نحن أمة النور لأن بين أيدينا نور مبين هو كتاب رب العالمين. إنه كتابُ ومنبع للضوء بحيث يقدح في روحِ مَنْ عشقه واتبعه فكرة الحرية وعزة الكرامة ومفهوم العدالة وروح الأخوة والرغبة في خدمة الآخرين ومعاونتهم والعيش من أجلهم، بحيث يكاد يجعل من الذين آمنوا به، مخلوقات آدمية شبيه بالملائكة، يسعون في الأرض، فينير طريقهم نحو سـعادة الدارين، ثم يفتح أبواب هذه السعادة على مصراعيها أمامهم.
إذا كان القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، فإن فهمه يعد غاية المنى عند المسلمين في كل آن وحين. وكل مسلم يسلم أنه نُور طريقنا وشفاء عِللنا. لكن الكثير من بني قومنا اليوم يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، وهناك عدد لا يحصى من الأفراد والجماعات فضلا عن الكبراء والزعماء، يعانون من طول خريف حزين مليء بالعلل والجراح. “فنحن نعيش اليوم مرحلة من المراحل التي يتكرر فيها التاريخ بعبره. فقد أحاطت بنا المآسي والمصائب والبلايا من كل جانب؛… ولكن رغم كل هذه المظالم والبلايا لا زلنا نرى الساكتين و مسلوبي الإرادة الخائفين حتى من التأوه… ومقابل هذا نرى صنفاً من الظالمين، يظلمون الناس ويغدرون بهم، ثم يتظاهرون بالبكاء والشكوى …. كما أن هناك بعض الكتل الجماهيرية التي نراها غير متوازنة في تصرفاتها، فهي –فئة- على الدوام غاضبة ومحتدة. وهناك أوساط مختلفة كالإدارة الفاسدة و المتحكمة و المحرضة، و اللاهية، والانتهازيون …والذين يرفعون شعار “الحق للقوة” ويستخدمونه حتى النهاية، من أئمة الظلم، والمرتشين والآثمين … وتنظيمات ملعونة أخرى لم يُعط لها اسم بعد… كل هذه الأوساط تدفع الجماهير الغاضبة التي فقدت اتزانها إلى مزيد من أعمال الشدة والعنف. أجل، هناك خريف حزين في كل مكان، والقيم الإنسانية سقطت تحت الأقدام… أما بعض الجهود المبذولة فربما لا تتعدى نطاق الهواية… مؤسساتنا الحيوية التي أودعْنا فيها حاضرنا ومستقبلنا ميتة ولا حياة فيها… إن استمعتَ إلى الدعايات والادعاءات حسبت أننا نكفي لعوالم عدة، بينما تشير الحقائق صارخة بأننا لا نكفي لمدينة صغيرة… لقد تحولنا إلى أكوام بشرية لا قلب لها ولا روح، … أما عدد الذين يعدون الدين والديانة مؤسسة عتيقة وبالية فلا يستهان بهم… المشاعر الدينية خربة في كل مكان، والتدين مُهان… اللامبالاة منتشرة وكذلك السقوط الأخلاقي”.
إن تاريخ أمة النور يعيد نفسه. تأوه و تشرذم، وضعف وتيه، وخوف وكسل، وغرور وأنانية، وفقر وتخلف من جهة، ثم استئساد وتغَوُّل، وظلم وغدر وانتهازية من جهة أخرى، هذا حال أمتنا. ومما زاد من سوء الحال اعتبار الدين الباعث للنور والمخلص لنا من هذه الآفات الظاهرة والباطنة، اعتباره رجعية وتخلفا. فبات حظه بيننا الإهانة ومكانته عندنا الإهمال. هذا حال أمة النور، العيش في الظلام، ظلام الحال وظلام المآل. حال يشكو من كل النائبات، انقلبت ناره إلى رماد تذروه الأيام. ومآل موعود بمشاريع ضبابية ومزركش بمبادرات هاوية. لكن ولأنا أمة النور، لازال تحت رمادنا بقايا جمر تحتاج إلى حكيم يتحمل “فحيح” البشر ولفح الجمر، فينفخ فيها الروح لعل نسغها ينقشع من جديد ثم يضيء كما أضاء أول مرة. فهل من صالح بين الناس يهيم على وجهه طالبا نور القرآن المتلألئ عبر الأزمان؟
يقول الأستاذ كولن مناشدا هذا القرآن هائما وراءه: ” أما نورك الذي كان ينير أرجاءه فقد رحل إلى ما وراء البحار… لا ندري لماذا… ألكي نتعذب ونمتحن؟ تعال أيها النور!..تعال!.. لقد آن أوان انتهاء أحزاننا وآلامنا، فتعال!.. فقد طال فراقك وطـال غروبك عنا… نحن لم ننسك أبداً… في هذا البلد الذي أقفرت أرضه وأظلمت سماؤه لا تـزال هناك معابد يؤمها الفقراء والمساكين… لا يـزال عبيرك يملأ أجواء هذه المعابد… ولا تزال القلوب تستضيء بنور مشاعلك. أيها النور الـذي نـزل في مكة وفاض في المدينة المنورة… ليس من شأنك الاحتجاب، فلتفصح عن وجهك النوراني… انـزع النقاب لكي تـرى العيون -التي حاصرتها مشـاهد القبح- جمالك… ولكي نطوف ملهوفين حول شموعك مرة أخرى”.
نعم لقد اشتدت وحشتنا لنور هذا الكتاب العزيز، بعد غُربة عَمَّقت وحشته وليل طوَّل ظلمته. ألا أيها الليل انجلي فقد لاح الفجر وهلل الصبح برجوع نور القرآن إلينا وانسيابه في قلوبنا وفي عقولنا وبين أضلعنا. حينها تذكرنا كيف فعل بديار كانت مقفرة، وأمة كانت ضالة محتقرة، حينها تذكرنا أن الله على كل شيء قدير، وأن نور كتابه لاشك سيُعمِّر ما انخرب و يُنوِّرُ طريق من ضل. وبذلك سيفيض علينا ومن حوالينا كما فاض على مكة والجزيرة، وتجاوزها إلى كل مصر وجزيرة.
وعلى نفس الدرب سار أعلام كثر فقالوا أقوالا عديدة، عجيبة فريدة، تراوحت بين حقائق علوم الدنيا وأشواق علوم الدين. وهاكم قول الإمام الطبري رحمة الله عليه في قول ربنا جل في علاه: (فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنّورِٱلَّذِيۤ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي فصدّقوا بالله ورسوله أيها المشركون المكذّبون بالبعث، وبإخباره إياكم أنكم مبعوثون من بعد مماتكم، وأنكم من بعد بلائكم تنشرون من قبوركم.
وإليك قول الإمام النسفي: في نفس النسق: (وَٱلنّورِٱلَّذِى أَنزَلْنَا ) يعني القرآن، لأنه يبين حقيقة كل شيء فيهتدي به كما بالنور.
وقال القرطبي الإمام في الجامع لأحكام القرآن: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم}: الإطفاء هو الإخماد، يستعملان في النار، ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور. . ثم أضاف وفي «نوُرَ الله» هنا خمسة أقاويل: أحدها ـ أنه القرآن؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول؛ قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني ـ أنه الإسلام؛ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السُّدِّي. الثالث ـ أنه محمد صلى الله عليه وسلم؛ يريدون هلاكه بالأراجيف؛ قاله الضحاك. الرابع ـ حجج الله ودلائله؛ يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم؛ قاله ابن بحر. الخامس ـ أنه مثَل مضروب؛ أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق؛ حكاه ابن عيسى.
وقال الأستاذ فتح الله كولن:﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ﴾. فنظراً لكون المنافقين يعيشون بين المسلمين ويختلطون بهم لذا يتيسر لهم أحياناً لمحة من نور الإيمان. ولكن النفاق المتغلغل في قلوبهم ورؤوسهم يمنعهم من الاستفادة من هذا النور. أجل! إن هؤلاء المنافقين قد انقلبوا إلى وضع لا يبصرون مع أن عيونهم مفتوحة، إما بسبب عدم الاهتمام بنور المشعلة التي يحملها الرسول الأكرم في يده أو الاستهانة بها، أو بسبب إفساد استعداداتهم الفطرية. ..أما الكفّار فلم يتعرفوا على الإيمان وعلى النور المنبعث منه أبداً… لم يروه أبداً، ولم يدخلوا في جوه القدسي. لذا عندما أحس الكافرون -لهذا السبب أو ذاك- بهذا النور في وجدانهم “باستثناء المعاندين منهم” حاولوا التمسك به وقضاء بقية حياتـهم كمؤمنين مخلصين. ولا شـك أن للفرق بين النور والظلام وبين الإيمان والكفر دوراً كبيراً في هذا”.
إن عدم الأخذ بالأسباب الكونية والإعراض عن التوجيهات الربانية، من أي جهة كانت ، لن يزيد البشرية إلا ضنكا، يستوي في ذلك المؤمن بغيره، نظير ما نشاهده في هذا الزمان وغابره. فالناس يبتعدون ويقتربون من هذا النور المنشود بحسب اقترابهم وبعدهم من مشكاته الحقيقية. ” لهذا عندما نقارن بين تدين الذين يسمعون عن الإسلام ويتعرفون به للمرة الأولى ويؤمنون به ويعيشونه، وبين تدين المسلمين المولودين في البلدان الإسلامية -إلا القلة منهم- يفهم بشكل أوضح صحة ما قلناه أعلاه” .
أما بخصوص كون هذا القرآن العظيم شفاء، فما ألطف ما عبر به الأستاذ كولن في هذا الصدد حين قال: “كيف سـتكون حالنا إن لم تهطل كالغيث، ولم تهدر كالصاعقة، ولم تسحق سحق الصاعقة؟ وكيف ستكون حال الإنسانية؟ وكيف تستفيق هذه الأمة وتنهض؟ وكيف تخطو المدارس إلى الأمام؟ وكيف تتنور المعابد؟ وأين سيجد القلب والروح والعقل ضالتهم؟ وأي شيء يستطيع أن يكون بَلْسَماً لهذه الأرواح البائسة والقلوب المكلومة وشفاء لها؟”.
إن العِلل المترامية الأطراف والتي شلت جسد أمتنا عن الحراك في عدد من المجالات، هي التي تهز المُتحرِّقين من أعلام أمتنا ليُذكِّروا ويؤكدوا على أن الدواء الشافي قريب منا، وأن البلسم لكل الجراح أمام أعيننا.
قال الإمام الطبري: “وقوله تعالى ذكره { وَشِفاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ } يقول: ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال، فيبرىء به داءهم ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به”..
وقال الإمام القرطبي في قوله تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً) : وفي الخبر «من لم يَسْتَشْفِ بالقرآن فلا شفاه الله». وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه. ثم قال: وليس يلزمه هذا، بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعَّض؛ فكأنه قال: وننزل من القرآن شيئاً شفاء؛ ما فيه كله شفاء. الثانية: اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما ـ أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الرّيب، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني ـ شفاء من الأمراض الظاهرة بالرُّقى والتعوّذ ونحوه”.
هكذا نرى كيف أن آراء السلف والخلف تثرى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأننا أمة النور وأمة الشفاء. فكيف لنا بإضاءة مسالكنا المظلمة في كل الاتجاهات حتى نتجاوز بحر الظلمات؟ وأنى لنا بخبير في وصفة ناجعة من كل الأدواء؟