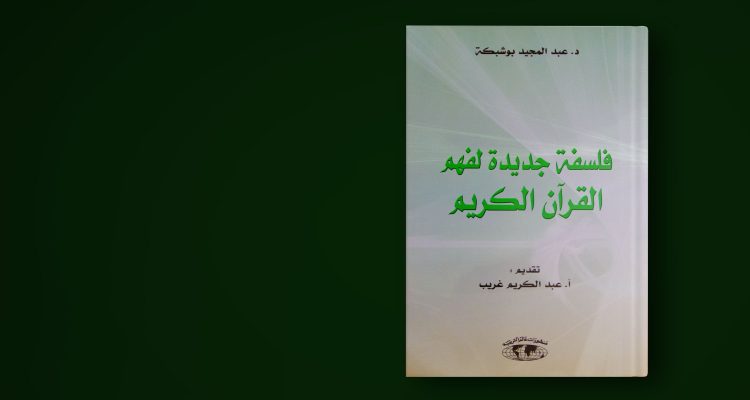بالرغم من الإجماع العجيب والتسليم الغريب بقدرة هذا كتاب الله الرحماني، على إضاءة العقول البشرية مهما كانت حالكة، وشفاء القلوب الإنسانية كيفما كانت مريضة، ناهيك عن تأثيره في الحياة وتجليته للكون. وكل ذلك نتيجة رحمته الواسعة. يقول الأستاذ:”نجد ورود ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ثم ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ كتجل من تجليات هذه الرحمة، فهل هناك رحمة أكبر من تعليم القرآن؟ أجل!… لو لم نبصر أنـوار القرآن، ولو لم تقم رسـائله بتنوير عالمنا لكان الكون بالنسبة إلينـا عالم مأتم عام، ولكانت الكائنات بأجمعها بالنسبة إلينا كالتوابيت فاقدة للحياة ولا تثير عندنا سوى الوحشة والرعب والفزع. لذا فما كان باسـتطاعتنا رؤيـة ومعرفة الوجه الحقيقي والمعنى الحقيقي لأي شيء. لقد استطعنا بفضل أنوار القرآن الكريم معرفة معنى وحكمة كل شيء. وأدركنا أننا أهم أنموذج للوجود. والأمور التي لم يدركها الآخرون باسم العلم أدركناها نحن بنور القرآن فنجونا من الحيرة ومن الخوف. وعندما دققنا الوجود بروح القرآن أدركنا أمورا لم يصل الآخرون إلى مثقال خردل منها، ولم يعرفوا حتى اسمها وعنوانها. لقد أبصرنا بنوره أينما حولنا نظرنا كل شيء بوضوح وجلاء.
نعم وضدا على كل تلك الهبات الربانية فكثير من الناس اليوم لازالوا تائهين في البحث عن طريق الخلاص، وهائمين يتجرعون ألم الجراح، تارة بسبب جهالاتنا الداخلية وأخرى نتيجة تربص خصومنا بنا. فبالرغم من كون جل العلماء والدعاة من أبناء أمتنا يرون الخلاص قريبا، فإن كُلَّا من الخصوم والجاهلين في الخارج والداخل يُحيلونه سرابا، فتزداد بذلك المشقة وتبعد الشُّقَّة.
ويا ما أبدع الأستاذ فتح الله في تصوير مشاهد هذا الواقع المرير، كما فعل غيره من قبله من صناديد العلماء وإلى اليوم، ومن تلك الصور قوله: “..إن الدمامل التي ظهرت أمس في صـور الإهمال والغفلة واللامبالاة وضعف الكفاءة وأحلام التغير، صـارت أوراماً، ثم انتشرت في جوانبنا وأخضعتنا لنفسها، بمضاعفاتها السريعة والمتلاحقة… حتى استناحت خريفاً على كل شريحة من شرائح المجتمع، وسلبت منها ألوانها الأصيلة. فكم مرة تزعزعنا بهذه الأمراض وعشنا سوء الطالع بتغلبها علينا؟ وكم مرة حسبناها حظنا الأسود المحتوم وضوينا وضنينا؟ وكم مرة صرفنا كلمات غير مناسبة ضدها تنفيساً لغضبنا -مع مناقضتها لأسلوبنا-، أو قمنا وقعدنا غضباً إذ لم نجد قولاًمناسباً عنها، فلم نـزد على “لا حول ولا قوة إلا بالله”؟ وفي خضم هذا التلاطم، اكتوى بعضنا في دوامة الأحاسيس القاتلة هذه، واكتفى بعضنا بفضح أخطاء الخائضين في “اللوثيات”.
أمام تناسل الأورام وانتشار الدمامل، وتيه الناس عن الطريق وخوض الجميع مع الخائضين- إلا من رحم الله-، أصبحنا جميعا ننتظر تحقُّق قول الله تعالى:( إن مع العسر يسرا) ونأمل الفرج الرباني والنَّفح المحمدي الذي جاء في تعبيره: ” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا “.
وهاهنا يتحسس كل مسلم حائر من يفتح الباب للنور الرباني حتى يتجدد لأمتنا دينها، وتعود إلى زاهر عهدها؟ وهل من سبيل إلى إزالة الدمامل التي طال عهدها، أملا في ذهاب الأسقام التي تعددت أسبابها بتعدد مجالاتها؟
لا يمكن لمن يدرس فكر ومنهج الأستاذ فتح الله كولن، ويسبر أغواره، ألا يجد نفسه في قلب موضوع التجديدبكل ما تحمله الكلمة من المعاني والدلالات. ويحسن بي في هذا المقام أن أعرج على بعض رجالات التجديد الأفذاذ في العصر الحديث. حيث البحث المستمر عن تلمس النور والشفاء الذي يعتبره الجميع السبيل القويم والمنهج السليم لإرجاع إرث الأمة الضائع مع توالي السنين.
فأذكر من أولئك العظام على سبيل المثال لا الحصر بعض من اشتهروا بالعمل مزودين بالأمل في كشف الحجاب عن النور المفقود وإماطة اللثام عن الدواء الشافي. واخص بالذكر أعلام القرنين الأخيرين، ومنهم مثلا:
• محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (1703م – 1791م) عالم المصلح والداعية المنقح، فارس العقيدة والتوحيد، ورائد الخلف في قافلة السلف. وقد بذل جهودا حثيثة من أجل تلمس نور قدر رحمه الله أن سبيله تصحيح عقيدة الأمة، والذي سيكون البلسم الشافي من عللها والطريق الصحيح للوصول إلى نهضتها.
• وممن جاء بعده جمال الدين الحسيني الأفغاني – ت1897، أحد أعلام الفكر والنهضة البارزين في أواخر
القرن التاسع عشر، حمل لواء التجديد وتقدم الفرسان، و من بلاد الأفغان سار على درب أب حنيفة النعمان. فاجتهد في كل مجال، ودرج في سلم السياسة وزاحم كبار رجالها، فكافح حتى قيض الله له من المخلصين من حمل مشعله وسلك دربه. وهكذا تلمس رحمه الله تعالى درب النور وفتش عن وسائل شفاء الأمة في كل مجالات الحياة، بداية من الدعوة والإرشاد ومرور بالتربية والتعليم وصلا إلى عالم الثقافة والسياسة، وإن لم يقطف ثمار كل تلك الجهود فقد ورث همه إلى ثلة خيرة من تلاميذه والمومنين بدربه.
• ومن نبغاء تلاميذ الشيخ الأفغاني رحمه الله تعالى، محمد عبدهت 1849م ابرز مجددي العصر الحديث،
سار على نفس الدرب و اغترف من علم شيخه الأفغاني طامعا في طلائع النور المحمدي وآملا في تلمس الشفاء الرباني الذي يعد خلاص الأمة من ضيقها ويقظتها من سباتها. وذلك من خلال تجديد فهم الدين والاغتراف من سيرة سيد المرسلين، في نضال المستميت ضد جهل وفقر المسلمين من جهة، ومقارعة قهر ومكائد المستعمرين. فاستطاع حلحلة أوضاع الوطن المسلمين واستفزاز كل فكر حر لنصرة الدين. فأبدع في الفكر وأنتج في الفقه و شارك في السياسة، حتى دوخ الخصوم والمستعمرين. فعمل على تجديد الفكر وتحرير السياسة وتنوير القلوب. ولم يفته رمي سهمه إلى مجال الثقافة و الإعلام حيث أسس جريدة العروة الوثقى، ثم جمعية بنفس الاسم، عله يبلغ فكره إلى القاصي والداني ويجد من المؤيدين من يحمله معه عبء هذا المشروع.
• و لم يخب ظن الشيخ عبده، وإن لم يحصد من ثمار جهوده غير الرجل النبيه الرباني الفقيه محمد رشيدبن علي رضا ت1935م لكفاه فخرا وشرفا. فقد نهل الأستاذ رضا من عيون صافية واغترف من أكياس وافية، فحصد من علوم السلف ومناهج الخلف، ما جعله يهتدي إلى طريق جديد، بوعيه منهج الفكر و التجديد، وإن لم يتملى برؤية الشيخ الأفغاني كما تمنى، إلا أنه فق منهجه عن طريق أستاذه المباشر محمد عبده بعد ما هاجر إليه بمصر، وللهجرة من أجل العلم والتربية، أملا في نور شافي ورغبة في شفاء نوراني، لها من المعاني والتجليات والأهداف السامية ما يستدعي التوقف والتأمل. فمن نتائج هذه الهجرة، أنه تنبه لأهمية الثقافة والإعلام فأصدر جريدة وبعدها مجلة اختار لها أستاذه اسم “المنار” والتي كانت سببا في إشاعة النور وتلمس الشفاء. و في هذا المجلة شرع يوضح ملامح مشروعه الإصلاحي وينشر مقالات تفسيره للقرآن، بعدما ينقحها أستاذه.
• محمد المُختار السُّوسي المغربي ت1963 م المؤرخ الفقيه والأديب، الشاعر، البربري الصوفي. صاحب
التصانيف العديدة والكتب الناذرة ، عارض الفرنسيين حين إصدارهم الظهير البربري، أيام استعمارهم للمغرب وكان أحد رجال الحركة الوطنية الكبار. حاول المختار السوسي رحمه الله تعالى، كغيره من أصحاب الهم والهمم أن يتلمس النور الضائع من أجل شفاء الأمة عبر رؤية عصرية لمشروع إصلاحي واضح المعالم، كان التعليم أساس بنائه وكانت التربية حجر زاويته. وكان يؤمن بأن ذلك هو المنهج السديد لشفاء الأمة من العلل وتخريج جيل النور المحمدي، القادر على تحقيق الاستقلال الفكري والثقافي والعلمي والاقتصادي، وكل ذلك في إطار خصوصيتنا الإسلامية. وقد جمع في منهجه بين النفس التجديدي المعاصر والروح التربوي الصوفي التقليدي. ورغم كونه رحمه الله، قد ترك إنتاجا تربويا وعلميا ضخما ، فإن غياب تلاميذ أكفاء من بعده، قادرين على مواصلة السير على نهجه، كان من بين الأسباب التي وأدت مشروعه الإصلاحي الكبير.
• عبد الحميد ابن باديس ت1940 أحد أعلام الإصلاح في العالم العربي ورائد النهضة الإسلامية بالقطر
الجزائري، ترك الدعة والترف الذي كان أقرب إليه من عنت الإصلاح، حيث تأثر الشيخ كثيرا بحركة الإصلاح في عصره، خاصة “مجلة المنار” للإمام رشيد رضا. كما أخذ عن كبار الشيوخ بالقطر الإفريقي كالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. وبعد تعرفه على رفيق دربه ونضاله فيما بعد الشيخ البشير الإبراهيمي، عملا على توحيد الجهود وتنظيم الصفوف من أجل إصلاح حقيقي. وكغيره من رواد الإصلاح نال حظه من الرحلة والهجرة باحثا عن أنجع السبل لبلوغ النور الرباني الشافي من العلل والسقم البشري . وكانت انطلاقة مشروعه من التربية والتعليم أولا. ثم سلك درب الثقافة والإعلام فأصدر جريدة “المنتقد”. و اهتم كثيرا بإنشاء المدارس والسهر على حسن سيرها. كما كان مبرزا في فقد الدين، ففسّر القرآن الكريم وشرح موطأ الإمام مالك في دروسه اليومية. و توسع همه بالإشراف على جمعية “علماء المسلمين الجزائريين”، و على إدارة مجلة “الشهاب.” وكان خطيبا مفوها وسياسيا محنكا، خالط الزعماء والمصلحين وفاوض السياسيين والمستعمرين. فبلغت الجزائر في عهده درجة متقدمة في التدين والتعليم (لقد بحثتُ قصدًا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب). وهكذا بلغ ابن باديس مبلغا عظيما في سبيل كشف علل المسلمين، وإنارة طريقهم بنور الحق المبين، فجراه الله خيرا إلى يوم الدين.
• محمد إقبال: ت1938م قد يكون لأعلام الإصلاح بالقارة الآسيوية تأثير في فكر وتوجه هذا الرجل العملاق
وخاصة رائد الإصلاح في عهده السيد “أحمد خان بهادرت”1898م لكن اطلاعه الواسع على الثقافة الغربية ومخالطته لأهلها، وتضلعه في لغات عصره مكنه من التفرد بشخصية ناذرة في زمنه. وقد بزغ في نظم الشعر مبكرا، ونبغ في الاقتصاد و التاريخ والسياسة والفلسفة والتربية الوطنية، وألف في كثير منها.
أما منهج الأستاذ إقبال في البحث عن النور الهادي والدواء الشافي فلايباعد غيره من المصلحين. فهو يعتبر بعد المسلمين عن دينهم سبب الويلات التي يعانونها. و لم يفتر عن المقارنة بين المذاهب والفلسفات الغربية المادية والملحدة، وبيان عَوار منهجها وبوار عاقبتها، دون أن يفوته تذكير الناس بماضي المسلمين المجيد وحضارتهم الزاهرة. ولم يمل من نشر هذا الفكر والدعوة إليه أين ما حل وارتحل وبين عامة الناس وخاصتهم، كما روي في قصصه مع الزعيم الإيطالي “موسوليني”. وقد نال حظا أوفى من الهجرة في سبيل دعوته إلى العديد من العواصم والأقطار. وقد أدلى بدلوه من أجل إصلاح مناهج التعليم في بلاده. وهكذا استمر محمد إقبال في الجري كالجواد الأصيل نحو كل إصلاح أصيل، حتى أقعده المرض إلى أن انتقل إلى عفو الله تعالى، مخلفا مكتبة زاخرة في مجال التربية والفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد، وهو لم يتخطى اثنين وثلاثين عامًا من عمره”.
• حسن البَنَّا أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي ت1949م مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسها
بالديار المصرية. بدأ حياته بالتربية والتعليم على غرار جل الأعلام المجددين. وتنقل بين عدد من مدن الحضرة المصرية، فخبر المجتمع وشاركه كثيرا من الجراح والأفراح. ولما بدا له من أمر الدعوة ما استشرف أفاقه ترك مجال الوظيفة الرسمية وتفرغ للوظيفة الربانية. فكان مجال الثقافة والإعلام من أولويات مشروع هذا الهمام عبر إدارته “جريدة الشهاب” شأنه في ذلك ما رمقناه في منهج غيره من الدعاة المجددين. ولأنه خبير بمجال التربية والدين، وجه همته إلى انتقاد سياسة التعليم، وكشف عورة منهجها وسلبياتها بين المصريين. لكن منهجه في إزاحة أستار النور الإلهي وتمثله من أجل شفاء حقاني بدا له من خلال إيلاء كامل العناية للتعليم العام و علاقته بالدين، وفي ذلك قال رحمه الله تعالى:” نرجو أن تهتم الوزارة بالتعليم الديني الاهتمام اللائق بأثره في تهذيب النفوس وتطهير الأرواح، وتجعله كمادة أساسية يتوقف عليها ثلث التربية الكاملة وهي التربية الخلقية”
لم يكتف رحمه الله تعالى بالتعميم، بل كانت للرجل رؤية ثاقبة مفصلة لإصلاح مجال التعليم، تدور رحاها وسط الدين وتستند في أساسها على القرآن الكريم. يقول”…وهناك مشكلة لا بد أن تفكر الوزارة في حلها وهي مشكلة تحفيظ القرآن … لا نريد أن يكون كل متعلم في الأمة يحفظ القرآن فإن هذا لا يتفق مع نشر التعليم الإجباري، ولكن الذي نريده هو أن يحفظ كل متعلم جزءًا من القرآن، وأن تكون هناك طائفة كثيرة تحفظ القرآن كله.
و في المجال السياسي دعا رحمه الله تعالى إلى موجهة الاحتلال الإنجليزي والوقوف في وجه الاستبداد السياسي و دعا وحدة المصريين وتجاوز الصراع الحزبي. كما عمل على بيان ما يجمع السياسة بالدين وإصلاح الوضع من خلال الشريعة السمحة والدين. وكثيرا ما كان يناشد الزعماء والمسؤولين والسياسيين بالعمل على توسيع الحريات وضمان الحقوق من خلال الإصلاحات السياسية الجذرية. أما في المجال الاجتماعي فقد هاله ما ساد بين المصريين من الظواهر السلبية فجند لمواجهة ذلك كل الوسائل الدعوية والخطابية والتربوية والإعلامية. إلا أن مجال التعليم حاز عنده قصب السبق في هذا المضمار. وفي مجال الفكر ناظر وألف في مقومات النهضة المنشودة وموقف الإسلام من الأفكار الهدامة والتيارات المتعددة.ولعل ما ألفه الأستاذ البنا خاصة كتابه “الإصلاح الاجتماعي”.يبين مدى عمق رؤيته وبعد نظره وأصالة مشروعه.
إن الأستاذ البنا لم يجد مطية خيرا من التربية والتعليم لتصريف مشروعه الإصلاحي الباحث عن النور والهدى والطالب للشفاء والنهضة. وذلك ظاهر في كثير من أقواله وكتاباته، كما جاء في مقارنته لوضع أثينا بمصر في ما حل بها من فساد إذ يقول:”قد يُظن أن التهذيب نتيجة من نتائج العلم، والحقيقة أن العلم شيء والتهذيب شيء آخر، وقد يكون الشخص عالمًا وليس مهذبًا وبالعكس، لأن مرجع العلم إلى العقل ومرجع التهذيب إلى الخلق، وهما قوتان مختلفتان من قوى النفس ولكل منهما نوع خاص من التربية، … كانت أثينا مهد العلوم، وعش الفلاسفة، ولم تكن الفضيلة فيها مرعيةً كما هي في إسبرطة التي لم تبلغ شأوَ شقيقتها في العلوم والفنون. إذا تقرر هذا أمكننا القول بأننا وإن كنا تقدمنا تقدمًا علميًّا محسًّا، وخطونا إلى الرقي العلمي خطوات، إلا أننا نلاحظ انحطاطًا عامًّا في المستوى الخلقي، يشمل معظم طبقات الأمة؛ فقد كثُرت الجرائم، وضعف الشعور بالتبعة الأدبية والقانونية، واشتدَّ تيار الخلاعة والتهتك … وكان لكل هذا أثره في فشوِّ روح الإباحية والإلحاد، والاستهتار بالشئون الدينية، والاستخفاف بأدائها… ولا شكَّ أن هذا نتيجة لعصر الانتقال الذي تجتازه مصر الآن، وهو من أخطر الأدوار في حياة الأمم، وأثر من آثار المدنية الحديثة التي نكرع من بحرها…يحدثنا التاريخ بلسان الكاتب اليوناني “أرستوفانس” عن أثينا بعد الحروب الفارسية أن الإلحاد قد فشا، والآداب قد فسدت، وصار الناس أحرارًا في سلوكهم لا يحتشمون ولا يتقيَّدون بنظام أو قانون، وأصبح الأطفال ذوي خبث ودهاء؛ قد فسدت نياتهم، ونضب ماء الحياء من وجوههم، وأصبحت الحلائل جامحات عاصيات مبذرات غير عفيفات، وأصبح البعول وقد أهملوا منازلهم وأغفلوا حقوق الزوجية وعاشوا لأنفسهم لا غير”.
إن لهذا الكلام البليغ و المنهج السديد ما بعده من الآثار. لقد كان منهج الأستاذ البنا رحمه الله أقرب إلى رؤية محمد فتح الله كولن، على مستوى الهم النظري. كما أن مقاربته لوضع المسلمين بأهل أثينا، يشير إلى أن غياب النور الرباني يدخل في مسلك القيم الفاسدة والأخلاق الرذيلة. لكل ذلك فإن التعويل على التربية والتعليم على ما بينهما من اختلاف، ناهيك عن الثقافة والإعلام، ينم عن هم متقارب بين جميع رجال كوكبة الإصلاح.
لاشك أن المتأمل في السيرة العطرة لهؤلاء الأشاوس، سيلحظ تركيزهم على مجالات بعينها، ومحاولاتهم تطويعها والتأثير فيها لتكون مركبا لدفع آلام المجتمع عبر الشفاء الرباني والعمل على إرجاع الأمة إلى زاهر عهدها عن طريق النور القرآني. فبعد إجماعهم على أن الدين القويم هو سبيل نهضة المسلمين، بادروا إلى العناية بثلاث مجالات تعد عصب المجتمع وأجنحة النهضة الشاملة وهي:
1. مجال التربية والتعليم.
2. مجال الثقافة والإعلام.
3. مجال الفكر والسياسة.
لقد سعى كل هؤلاء العلماء إلى البحث عن النور الذي يضيء طريق الأمة ويخرجها من ظلمات أنين التخلف حينا و بريق التقليد حينا، أو ظلم المستعمر أحيانا. ولم يفتهم كذلك أن يجاهدوا باستماتة من أجل البحث عن الدواء الشافي الذي يناسب العلل المفردة والمركبة التي ألمت بشعوبهم. وقد كان النور القرآني والشفاء الرباني محور كل تلك الاجتهادات، وواسطة عقد كل الوصفات. لكن الجروح الغائرة والأمراض المستشرية في الأمة كانت مثل الجبال الشامخات أمام كل الجهود المبذولة. و ان كثيرا من رجال الإصلاح التحق بالرفيق الأعلى قبل أن يرى شيئا من ثمار زروعه الطيبة.
ولكل واحد من تلك المجالات الحيوية في مناهج الدعاة، قصص ومغامرات مع الأستاذ المجدد “محمد فتح الله كولن”. قد نُعرج على ذكر بعضها في الوقت المناسب.