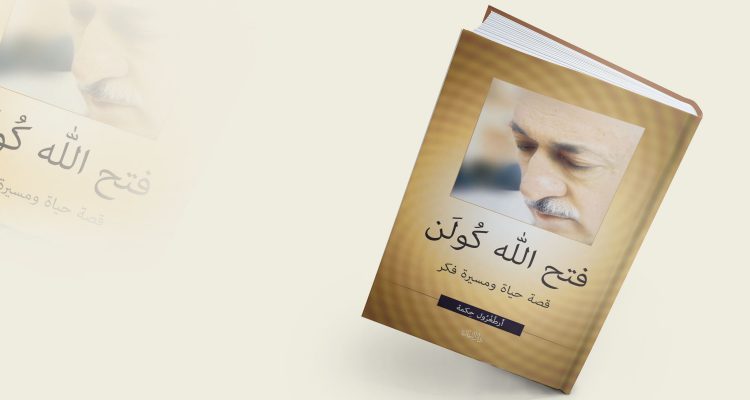ومضى الأستاذ فتح الله في مسيرة الوعظ بعد أن غادر كستانه بزاري. لكنه – وهو القائل: “للأحداث لغة خاصة” – كان يرى أن الدولة على حافَة الهاوية، وفي مذكرات الجيش إلى الحكومة في 12/3/1971 ما يؤكِّد ذلك؛ بدأت الاعتقالات. ولم يكن للأستاذ فتح الله أيّ هدف سياسيّ في حديثه، ولم يتدخّل في أي مسألة سياسيّة، وكان إذا اجتمع بالناس في حوار أو مدارسة بذل وسعه في تجنب أي موضوع يُقلق الناس، ورغم هذا كابد – وهو طليق – أكثر من أصدقائه المعتقلين، يعمل ليل نهار على براءتهم وإطلاق سراحهم؛ ثم اعتُقل في 3/5/1971 بعد نحو شهرين من صدور المذكّرة، يقول عن هذه الفترة الحرجة: “دخلت منزلي فرأيت الأمن السياسيّ قد قلبوه رأسًا على عقب، وجمعوا ما فيه في ردهته، فقالوا لي: أهلًا وسهلًا، ومضوا في التفتيش، لكنهم تظاهروا باللطف، فوجدتهم قد أغلقوا النوافذ، وأسدلوا الستائر؛ صادروا نحو أربعين كتابًا، لكن لم يصادروا أجزاءً من كتب ذات أجزاء تفقد قيمتها بفقد بعضها، وليس فيها واحد يدينني. قلت: “هل سأتأخر، فآكلَ لقيمات؟” أردتُ أن أسدّ مسغبتي، وأن أطّلع على نياتهم، قالوا: “كُل حتى تشبع، فلا ندري متى تعود”. فتناولت شيئًا من الأرز، ثم ذهبوا بي إلى قسم شرطة “تَبَجِيكْ”، فلما وصلنا حلقوا شعري وشاربي، حتى ظننت أنهم سيأتون على حاجبيّ أيضًا، ثم التقطوا لي صورًا من كلّ جانب، وقبل أن أُسَاق طلبتُ ماءً للوضوء، فجاءني عريف بقصعة فيها ماء – لست أدري طاهرًا كان أم لا – فتوضأت، فلما خرجنا صليت العشاء، فاستروحت لأنني أمنت فوت صلاة مفروضة حتى الصباح.
زجّوا بي في حجرة صغيرة، وجردوني من كل شيء حتى القرآن الكريم ودعاء “الجوشن الكبير”، فكنت أقرأ القرآن عن ظهر قلب، أما الجوشن فشقّ عليّ تذكره، فأحزنني كلّ الحزن أنّي لم أحفظه، والحسرة تقتلني يا ليتني حفظته، كانت الحجرة كأنها مخزن ليس فيها سوى رَوْزَنَة أي كُوّة في السقف، ولما زاد العدد استبدلوا بها حجرة كأنها غرفة طعام، فهي مرقدنا الجديد، لكن كان فيها نوافذ للتنفس الجيّد، فقضينا فيها عشرين يومًا… راسلْتُ “إسماعيل بُيُوكْشَلَبي” سرًّا، ليأتيني بالجوشن الكبير، فجاء به قُبيل العصر، فانكببتُ عليه أقرؤه سرًّا بمتعة والدموع تخالجني القراءة، سبحان الله! كأني لم أقرأه من قبل… مكثنا هنا طويلًا، كانت ليالي ألم لكنها ملأى بالأمل، ليلاء لكنها منمنمة بالأضواء؛ عدنا جنودًا بعد عشر سنوات على أداء الخدمة العسكرية؛ فهذا ضابطُ صف حزِقٌ، كلما مرَّ بنا عنَّفنا، ورأى “مصطفى بِيرْلِكْ” وهو تِرْب أبيه يكلّمه مضطجعًا، فأغلظ له في القول: “ألم تؤدِّ الخدمة العسكرية؟! كيف تكلمني هكذا؟”؛ ثم علمنا أنه يضيق بالدين والمتدينين، ولهذا يقسو علينا. كنا نقرأ ونتعبد ونبحث عن سبيل للخروج، وبدأ بعض الوطنيين يصلّون.
ثم علمت أن كل موعظة ألقيتها سُجّلت في ورقات، وكتبوا اسمي بخطٍّ عريض أعلى كلّ ورقة، ولم يخلُ حديث أصدقائي من ذكر اسمي، فعل، وقال… أمرٌ محيّر، فوكيل النيابة يسأل: ما رأيك في هذا كلّه؟؛ فأجبته برباطة جأش: “يبدو أنَّ رجالَ المخابرات لا عمل لهم، فهم يكتبون هذا من وحي خيالهم”.
غضب وكيل النيابة، وقرأ الاعترافات الموقّعة تِبَاعًا، فنظرت في التوقيعات، فعجبت! لا أدري ماذا أقول، فشعرت بمشقة يوم الحساب وأهواله، اعترافات كلّها ملفقة ظلمًا… لم ينصفني أحد ولو بكلمة حتى الآن، فقلت: “لم أفهم شيئًا مما قلت، اختلط الأمر عليّ”.
ضقتُ ذرعًا بالأمر، لقد أدليت بأقوالي من قبل في ثماني ساعات تمامًا في قسم الشرطة، سُجلت أجوبتي في صفحة واحدة لا أكثر، لأن الأسئلة كلها وهمية، فماذا أقول؟ أمَّا أصدقائي فاعترافاتهم مُلزِمة، فقد كتبوها ووقّعوا عليها؛ لقد أرغمنا رجال الأمن على الاعتراف، لكن الأصدقاء لم يبالوا فقالوا الحق ولم تتناقض أقوالهم.
ذكروا بعض الأسماء وقالوا: “هل تعرف هؤلاء؟ كيف عرفتهم؟ ما الكتب التي تقرؤها؟ هل قرأت رسائل النور؟ لم أتوقع هذا السؤال فسؤال واعظ عن أمرٍ كهذا يُعد أمرًا كوميديًّا؛ قلت: قرأت شيئًا منها، سألوا ما الذي قرأته منها، قلت: مثلًا قرأت “الكلمة الثالثة والعشرين” و”رسالة الحشر” وكذا وكذا، وكلّها كتبٌ حوكِمَت وبُرئت ساحتها مرارًا، وما زالوا يسألوني عن الكتب وأنا أسرد لهم أسماء كتب لا يعنيهم أمرها حتى قلت: لا يحضرني غير ما ذكرْت، فكفّوا عن أمر الكتب؛ لم يكن في أقوالي ما يدينني، لكن الأوامر العليا تحتِّم اعتقالي، وهذا ما حدث”.
قضى 21 يومًا في مركز الاعتقال، وشهرًا في سجن “شِرِينْ يَرْ” وستة أشهر ونصفًا في سجن “بادَمْلي”؛ أيام السجن كَلَيالي الاعتقال في الضيق والضنك؛ فعانى من محاولة التأقلم مع هذه الظروف الصعبة، ومن وحشية السجّان التي تؤذي موتى المشاعر، لكن الذي أحزنه أكثر من حزنه مما عانى هو ما لقي جليسه المحامي السيد “بَكر بَرْق” من تحقير، ولما تسمّم لم يعرضوه على طبيب كأنهم يتمنون موته، بل صادروا ما معه من دواء لا غنى عنه، فتضاعفت آلام الحساسية التي كان يعاني منها ولم تعد تُطاق، وما كانوا ينقلونه إلى المستشفى إلا إذا أشفى على الهلاك.
كانت المحاكمة خَشْرمًا ينفُث آلامًا جديدة، أخطرها افتراءات فئة وغدر أخرى تظاهرت بالإخلاص؛ سعت المحكمة بكل سبيل لإدانة المتهمين بلا دليل، ففنَّدوا دعاواها ولم تطلِق سراحهم؛ يا لَهول ما مُنِيَ به الأستاذ فتح الله من غدر الصديق وافتراء العدوّ، لكن كل هذه المعاناة لم تحُل دون اتخاذه السجنَ “مدرسة يوسفية”، أنشأ علاقات طيبة حتى مع اليساريين، ووجدَ في هذا الظرف الخانق أناسًا برهنت فِعالهم على ولائهم واستقامتهم؛ ومن ذكريات اعتقاله أنّ بضعة مجاذيب في غرفته ضايقوه كثيرًا، ورمَوه وأصدقاءه في العقيدة، وقدّموا لهيئة المحكمة معلومات خاطئة عنهم، كان لديهم انحراف عقائديّ خطير، يعتقدون أن جيشًا من الجن آتٍ لينقذهم؛ فحاورهم الأستاذ فتح الله ليصلح عقيدتهم.
في هذه الفترة توفِّي عمّه أنور، فزاد حزنه حزنًا، ثم أُطلق سراحه في 9/11/1972م، وعندما خرج لم يجد مأوى فضاق صدره بذلك، يقول: “لما خرجنا استقبلنا صادق بك، فلما ركبت السيارة تذكرت أنه لا مأوى لي فقلت بكل أسًى: وماذا عساي أن أفعل إذًا؟.