في لقاء علميٍّ مع مدير وكالة جيهان، الأستاذ عبد الحميد بيليجي؛ وبعد حوار ثريٍّ، ومعلومات ضافيةٍ، سخا بها الأستاذ مشكورًا ومأجورًا، سألني عن اهتمامي بمالك بن نبي؛ ولا شك أنَّ توافُق البلد أوحى له بالسؤال، فلمَّا أعلمته بعلاقتي الوطيدةِ بفكره منذ أمد؛ قال: “هل في الإمكان أن نُجري مقارنة بين فكر الأستاذ فتح الله والأستاذ ابن نبي؟”
كان الجواب، بالطبع، إيجابا.
ثم سألني عن أبرز نقاط الافتراق والالتقاء بين الرجلين، فأجبتُه عن الأولى، وأجَّلت الثانية؛ وقلت:
أولا: الوعاء الحضاري، أي الامتداد المكانيُّ والثقافيُّ والسياسيُّ والفكريُّ… هو مختلِف تمام الاختلاف بين الرجلين؛ أي إنَّ التربة ليست واحدة، وكذا المؤثرات الثقافية والفنية والجغرافية.
ثانيا: النسيج الحضاري، أي الامتداد التاريخيُّ للرجلين، هو مختلِف كذلك؛ ويمكن رسم خطَّين أقرب ما يكونان إلى الخطوط المتوازية، بين خطِّ الزمن لمالك بن نبي وخطِّ الزمن لفتح الله كولن.
ومن يومها، وأنا أطوِّر نظريتَيْ “الوعاء الحضاري”، و”النسيج الحضاري”؛ ولقد كتبت فيهما العديد من المقالات، وحاضرت فيهما في العديد من الملتقيات، ولا أزال.
واليوم، بعد عزم الإخوة في “حراء” على بعث “جماعة علمية”، ولو تجوُّزا، تكون جسرا بين “البراديم كولن ومشروع الخدمة” من جهة، والنخبة المثقفة في العالم العربي من جهة ثانية… بعد هذا العزم الأكيد، رأيتُ من المناسِب أن أعود إلى “فكرة المقارنة بين ابن نبي وكُولَن”؛ لكن مع ملاحظتين جوهريتين:
الملاحَظة الأولى: إنني ابتداءً، ومن الناحية المنهجية، أرفض البحوث المقارنة بين كذا وكذا، ذلك أنها غالبا ما تكون “انتقائية” ومحسومَة النتائج مسبقا، فالباحث ينتقي نقاطَ المقارنة، ويحوم حولها، ثم يختزل أحكامًا معيَّنة؛ ولباحثٍ آخر أن ينتقي نقاطا أخرى، ويصلَ من خلالها إلى أحكام أخرى، قد تكون مختلفة كليًّا. فالمقارنة، إذن، بهذا المعنى، وبهذا المنهج التقليديِّ، قاصرة عاجزة عن إبلاغ المراد.
أمَّا الملاحظة الثانية، فهي أنني، ومن الناحية المنهجية كذلك، لا أميل إلى دراسات الأثر، وأقف إلى صفِّ المسيري في هذا الاختيار، ذلك أنَّ أثر كذا في كذا، وأثر فلان على علاَّن، هي أحكام كبيرة جدًّا، ومختزِلة لظاهرة إنسانية مركَّبة من أسبابٍ معقَّدة، إلى ظاهرة متفرَّدة في سببٍ واحد مباشر؛ ومثل هذه البحوث لا تلد، وهي من نوع المصادرة على المطلوب في كثير من الأحيان؛ وليس دائما طبعًا.
ولذا، فإنني، في هذا البحث، سأعتمد “الأحجية” منطلَقا لفهم الظاهرة المقارنة بين فكر الرجلين، وسأعتمد الاستثارة والاستشكال أساسًا، محاوِلا بذلك تفادي المنهج الكلاسيكي في المقارنة والتأثير؛ ولا يعدو عملي أن يكون مجرَّد مدخل ومقدِّمة لما قد يتحوَّل إلى جهد أكثر تنظيمًا وعمقًا.
ولا شكَّ أنَّ العلم باعتباره أحجية (Enigme scientifique، Scientific puzzle)، أو مركَّبا من عدد من الأحاجي، هو من أبرز مظاهر “بنية الثورات العلمية”، عند “توماس كوهن”، في كتابه الذي خصَّص فيه فصلا بعنوان “العلم العادي، علم حلِّ الأحجيات”.
ثم إنَّ علوم الفيزياء، والفلك، والكوسمولوجيا بالخصوص، تطوَّرت، ليس بالصرامة التي يعتقدها البعض، وإنما بالعمليات العقلية، وبالألغاز، والأحجيات؛ وهذا بالذات ما يميِّز فكر أنشتاين مِن غيره، وهذا الذي طوَّر الفيزياء الكمومية، وبخاصَّة “مبدأ الريبة”، الذي شارك في حلِّ أحاجيه: بور، وهايزنبرغ، وغيرهما. ولم تكن أحجية “قطة شرودينجر” خارج هذا الإطار.
أمَّا في العلوم الإنسانية، والدراسات الحضارية، فقلَّ ما يُستعمل هذا النسق من التحليل؛ إلاَّ أنَّ كلاًّ من “هوستن سميث، ومراد هوفمان”، قد فتحا لي الباب واسعا باعتمادهما على ما يشبه الأحجيات، في تحليل أعقد قضايا الحضارة؛ أمَّا الأوَّل ففي كتابه “لماذا الدين ضرورة حتمية؟”، وأمَّا الثاني ففي كتابه “الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود”.
وفي عملي هذا لن أتوانَى عن اعتماد هذا الأسلوب، وهذا المنهج، فإن أصِب فبتوفيق من الله، وإن أخطئ، فذلك لسوء تقديرٍ مني. وحسبي أنَّ الله تعالى علَّمنا في محكم تنزيله كيف نتبنى الأحجية، والصورة الذهنية المفترَضة، وسيلةً وسببا للإقناع؛ قال جلَّ من قائل: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ(الحج:15)، وحسبي بعد ذلك أنَّ الرسول عليه السلام اعتمد الأحجية في الكثير من الأحاديث، منها أحجية السفينة، ومنها أحجية الثلاثة الذين سدَّت عليهم حجرة باب الغار… وغيرها من الأحاجي في سنَّة المصطفى عليه السلام كثير.
الأحاجي
الأحجية الأولى: ابن نبي التركي، وكولن الجزائري!
لو أننا غيَّرنا “الوعاء الحضاري” و”النسيج الحضاري” للعالمين ابن نبي، وفتح الله كولن؛ أي، لو أننا نقلنا كولن إلى الجزائر، في الظروف التي عاشها مالك بن نبي؛ ونقلنا مالك بن نبي إلى تركيا، وعاش الظروف التي عاشها كولن… فكيف يتصرَّف الاثنان؟
وبأخصر عبارة: هل يمكننا أن نتصوَّر ابن نبي تركيًّا أوروبيًّا، سليلاً للعثمانيين؟ وهل يمكن تخيُّل فتح الله جزائريًّا مغربيا عربيًّا، سليلاً للموحِّدين؟ وما هي الفروق التي نخرج بها، بين ما هو كائن، وما هو مفترَض على سبيل الأحجية، بتبديل الأدوار بين العالمين؟ وهل سيتصرَّف ابن نبي تماما مثلما تصرَّف كولن، أم سيكون له سلوك وفكرٌ آخر؟
وكذا الأمر، بالنسبة لكولن الجزائريِّ؛ هل سيؤسِّس مشروع “الخدمة” في الجزائر؟ وهل ستكون الاستجابة مماثلة لما لقيه في تركيا؟
لا أستعجل الجواب، ولكنني أسأل، وأعيد: هل سيكتب كولن مقالا بعنوان “تفاهات جزائرية”، لو أنه عاش ظروف الجزائر غداة الاستقلال؟
وهل سيخطُّ ابن نبي كتابا بعنوان “القدر في ضوء الكتاب والسنة”، ردًّا على المتلاعبين بمفهوم القدر، والمشكِّكين في العدل الإلهي، وأصحاب “اللوثاث والضلالات المشوَّشة”؛ من ذوي الثقافة الحداثية في تركيا آنذاك؟
لا أعرف، ولكنني أحيانا، وأنا أطالع للرجلين أجدهما أقربَ ما يكونان فكرًا وفهمًا؛ وأحيانا أخرى، لا أجد وجهًا للشبه، بين ما يكتبه كولن وما يكتبه ابن نبي؟
فهل يكفي أن نقول: الفرق فقط يكمن في الوعاء الحضاري، وفي النسيج الحضاري؟ أم أنه يظهر كذلك في طبيعة الرجلين، وفي نوعية التكوين… وفي ظروف وأسباب أخرى؛ لا نقدر لها إحصاءا، ولا تقديرا؟
الأحجية الثانية: القابلية للاستعمار، وحوار الحضارات
إنَّ مالك بن نبي ذاق الأمرَّين جرَّاء الاستعمار الفرنسيِّ، ثم على يد أذياله قبل الاستقلال وبعده؛ فكتب عن “الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة”، وطوَّر نظرية “القابلية للاستعمار”، حتى صارت علَما عليه، وماركة مميِّزة لفكره.. أمَّا كُولَن من جهةٍ أخرى، فلم يكن تحت وطأة استعمار خارجيٍّ، بل عانى من انحرافٍ وانجرافٍ داخليٍّ، كاد يؤدِّي بالبلاد إلى المهاوي والمهالك؛ فتصرَّف بأسلوب مغاير؛ إذ كتب عن الحوار، وأسَّس مشاريع في الحوار، يقول الأستاذ محمد أنس أركنه: إننا “نرى أنَّ فتح الله كولن لم يكتف بفتح المؤسَّسات التعليمية والمدارس، بل نراه يتحدَّث عن أهمِّ مشروع اجتماعي وثقافي للمجتمعات الإنسانية المعاصرة، وهو إنشاء حوار بين الحضارات”؛ ولقد ألَّف العديدُ من الكتَّاب أعمالا حول هذه النقطة بالذات، منهم “جون اسبيزوتو، وإحسان إيلماز” في كتابهما “الإسلام وبناء السلم، مبادرات حركة كولن”… وغيرها كثير.
ترى لو أنَّ ابن نبي لم يكن ضمن البلاد المستعمَرة، هل سيهتدي إلى نظرية “القابلية للاستعمار”؟ وهل سيدعو إلى “حوار الحضارات”، كما فعل كُولَن؛ رغم وطأة الاستعمار الظالم على بلده وعلى سائر البلاد العربية؟!
ثم، هل كان الاثنان متناغمين مع الظروف التي مرَّت بهما؟ أم إنَّ أحدهما أو كليهما لديه انحراف ولو يسيرٌ عن الزاوية المطلوبة؟ وكيف نقيس هذا الانحراف لو وُجد؟ ثم كيف ننفيه إن لم يوجد؟
وهل في الإمكان تصوُّر عالِم يجمع بين الشخصيتين في آن واحد؟ فيكتبُ عن ظاهرة الاستعمار، ويصوغ أسس الحوار، في نفس الآن؟ أم إنَّ قدرة المثقَّف والعالم، لا يمكنها مهما بلغت من الكمال أن تتجاوز المؤثرات الزمانية والمكانية، والحالة النفسية والاجتماعية، وبالتالي فالعالِم ابن انتمائه، وهو بلغة المسيري “متحيّز” شاء أم أبى؟
الأحجية الثالثة: أسفل البحر المتوسِّط، وأعلاه!
يحمل مالك بن نبي همَّ البلاد الإسلامية الواقعة أسفلَ البحر الأبيض المتوسِّط، ولذا نجده يكتب عن “فكرة الأفرو أسيوية، في ضوء مؤتمر باندونغ”، ويكتب “تأمُّلات”، وكذا “بين الرشاد والتيه”، و”في مهبِّ المعركة”… وغيرها من الدراسات التي تتناول في الأساس إشكالات حضارية، تمسُّ بالخصوص البلادَ المستعمَرة في مواجهتها مع البلاد المستعمِرة؛ مع التنبُّه إلى أنَّ الأسباب الذاتيةَ هي الفيصلُ، وأنَّ الأسباب الخارجية ثانويةٌ وتابعة لا غير.
أمَّا كولن، فيحمل هموم تركيا ما بعدَ العثمانيين أساسًا، ثم مِن خلالها كلَّ البلاد التي تلتصق بتركيا، بخاصَّة “البلقان”، وبلدان “أوراسيا”؛ ولا أدلَّ على ذلك من منتدى “أوراسيا” في “وقف الصحفيين والكتاب”.
ثم إنَّ كولن، وبخاصَّة بعد زيارته المشهورة إلى بلاد الغرب، سنة 1997م، وخطابِه الشهير الذي بكى فيه لتخاذلِنا عن تبليغ دين الله للعالمين، ثم بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999م راح بعد كلِّ ذلك يوجِّه البوصلَة نحو الغرب، وهذا ما يفسِّر انتشار مشاريع “الخدمة” في أمريكا، وكندا، وأستراليا، وأوروبا… بخلاف الدول العربية، التي لا تزال تتعامل باحتشام مع هذه المشاريع.
ولا أقول هنا، إنَّ ابن نبي لا يحمل همَّ العالم الغربيِّ والشماليِّ، ولا عن كولن إنه لا يحمل همَّ البلاد الواقعة في خطِّ “طنجة جكرتا”، وبالخصوص البلاد العربية؛ ولكنَّ الحديثَ طبعا عن الأولوية، وعن الأسبقية، وعن نقطة الارتكاز في الفكر، والتركيز في الحركية.
ومن الغريب أنَّ سهم الانتقال بين ابن نبي وكولن كان في اتجاه معاكس، إذ بينما انتقل الأوَّل -فكريا- مِن الشمال إلى الجنوب، أي من فرنسا وألمانيا إلى الجزائر، ومنها إلى مصر وسورية؛ نجدُ أنَّ الثاني انتقل من الجنوب إلى الشمال، أي من تركيا إلى أمريكا؛ فهل لهذا الانتقال الأثرُ الكبير على مسار فكرهما؟
أيُّ الفكرين أصلحُ للعالم العربيِّ اليومَ؛ وبخاصَّة في عهد الثورات على الداخل، بعدما عرف العالم العربيُّ الثورات على المستعمر الخارجي؟
هل هو فكر مالك بن نبي، الذي ساند “الاطِّراد الثوري”، وكتب في فقه الثورة، وعن “الأخلاق والثورة”، وعن “التقلبات في عصر جديد”؛ وهو الذي قال: “إنَّ الثورة قد تتغير إلى “لا ثورة”، بل قد تصبح “ضدَّ الثورة”، بطريقة واضحة خفية”، وقال: “إذا لم نحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدِّمات ومسلَّمات الثورة، فسوف لا نفقد “عِقالا” فقط، بل نفقد الروح الثورية ذاتها”؟
أم إنَّ فكر كولن هو الأجدر بالتبني، وهو الذي رفض جملة وتفصيلا كلَّ هدم لا ينتهي بالبناء، وتحدَّث عن الأمواج الغائرة العميقة، في مقابل الأمواج الطافحة العقيمة، ووجَّه مصطلح الثورة توجيها مختلفا، فقال: “ارْفَعْ شعار الثورة ضدَّ كلِّ مألوف، واهتِف كما هتف الرومي “هلمَّ إليَّ يا إنسان!”، ثم ادفِن نفسك في غياهب النسيان… نادِ كما نادى بديع الزمان “وا إنسانيتاه!”، ثم امضِ ولا تفكِّر بسعادتك الشخصية… أجل، اِنْسَ رغد الحياة، انْس البيت والولد، واسلك درب أهل السموِّ الواصِلين لتكونَ من الناجين”… إلى أن يقول: “مجانينَ أريد، حفنةً من المجانين… يثورون على كل المعايير المألوفة، يتجاوزون كلَّ المقاييس المعروفة”؟.
تُرى، هل يمكن أن نجمع بين الفكرتين والمشروعين؟ وهل هما من قبيل الأفكار المتكاملة المتعاضِدة، والمشاريع المتناغمة المتناسقة؟ أم إنهما متناقضان متعارضان؟ أم إنَّ فيهما شيئًا من هذا، وشيئًا من ذاك؟ فما هو هذا الشيء، وكيف يمكن فهمه وتمثله؟
أنا، هنا، لا أكتبُ للمفكر والمثقَّف والباحث والمحلِّل فقط؛ ولكن أضع في ذهني صورةَ شابٍّ عربيٍّ، في مراحله الأولى من الجامعة، وهو يكاد لا يتلمَّس الحقيقة، ولا يُبين في التعبير عنها؛ فهو لهذا يبحث عن “سداد المسلك” بلغة نموذج الرشد، فهل الحلُّ والجواب في موضوع الثورات يكمن فيما ورد عند مالك بن نبي، أم فيما جاء عند فتح الله كولن، أم هو مزيج بين هذا وذاك؟
وأنا، هنا، كذلك، لا أفترضُ، ولكنَّها واقعةُ حال، فثمَّة طلبة علم من الجزائر تشرَّبوا فكرَ الأستاذين، وعايشوا بعقولهم وقلوبهم الفتن التي تعصف على بلاد الإسلام. فهم بالتالي قلقون معرفيا، مستشكلون منهجيا، مستعدُّون نفسيا، متوقِّدون فكريا، ينتظرون التوجيه والإرشاد، ورسم خطِّ السير بحكمة وحنكة وذكاء.
الأحجية الرابعة: تبادُل الزيارة بين ابن نبي وكولن!
في صباح ربيعيٍّ هادئ، زار مالك بن نبي فتح الله كولن، وهو في الطابق الخامس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن طالع جلَّ كتبه المنشورة باللغتين العربية والفرنسية؛ ثم إنَّ “الأستاذَ”، تيسَّرت له السبلُ، وقد طالع مالك بن نبي منذ أمدٍ، أي في السبعينيات من القرن الماضي، فعاود الكرَّة هذه المرَّة، وطالع ما وقع بين يديه من مؤلَّفات مالك بن نبي، وبعدها زاره إلى الجزائر، وطرَق عليه بابه.
ما هي أوَّل كلمةٍ تلفَّظ بها الواحد تجاه الآخر؟ وما هي الصفة التي وصف بها ابن نبي كولن، والصفةُ التي وصف بها كولن ابن نبي؟ ثم ما هي أبرز نقاط القوَّة التي اكتشفها كلُّ واحد منهما في فكر الآخر، وفي تمثُّلات فكره في الواقع؟ وما هي نقاط الضعف؟ ثم ما هو رأي ابن نبي في “الخدمة”، كما هي عليه الآن؟ وما هو أبرز نقدٍ ممكن أن يصدر من كليهما تجاه الآخر، فكرًا وحركيةً؟
ألن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمامهما، فيعرضان وجهات النظر فيها؟ أليس في الإمكان أن يجتهدا في إنشاء اتحاد عالمي للعلماء؟ وكيف تكون مواصفات هذا الاتحاد؟ وأين يكون مقرُّه؟ وما هي مهمَّته؟ وما هو دور كلِّ واحد منهما فيه؟ ومَن -يا ترى- سيلتحق بهما؟
ألن يصف مالك بن نبي فتحَ الله بما يشبه هذا الوصف البليغ: “لم يكن الرجل [أي فتح الله] يتحدَّث عن ذات الله، كما صوَّرها علمُ الكلام، أي عن اللهِ العقليِّ، بل كان يتحدَّث عن الله الفعَّالِ لما يريد، المتجلِّي على عباده بالرحمة والقهر، تماما كما كان المسلمون الأوَّلون يستشعرون حضوره فيما بينهم، ونفحتَه الماديةَ في بدر وحنين. فالفكرة القرآنية تتجلَّي هنا [عند فتح الله] بأثرها المباشر على الضمير، وبتأثيرها في الأناسي والأشياء”.
ثم ألن يصف فتحُ الله بالمقابل صديقه وصنوَه مالكا، بهذه العبارات الرقيقة: “إنَّه [أي مالك بن نبي] في خطِّ الحياة الممتدِّ على مدى فصولها من الحسِّ إلى الفكر، ثم إلى الحياة العملية، يتنفَّس النظام دوما، بحسِّ البناء والإنشاء أبدا. إنه وليُّ الحقِّ اللدنيِّ، الذي يُعِدُّ “قادة أركان” الروح، ومهندسي العقل، وعمَّالَ الفكر… ينفُخ بلا كلل نفَسَ البناء والإعمار فيمن حوله، ويرشِد أعوانه إلى سبل عمران الخرائب”؟.
ألا يكون وصف ابن نبي لكُولَن باختصار، أنه: المجدِّد بالإيمان والقرآن. ثم، ألا يكون وصف كولن لمالك بن نبي، باختصار، أنه: مهندس الفكر والحركية.
الأحجية الخامسة: نحو جماعة علمية افتراضية
ألا يمكننا -بعد جملة من المطالعات- أن نقرِّر حكما، يحتاج إلى إثبات أكثر، وليكن مجرَّد افتراض، قد يتحوَّل إلى نظرية متكاملة، ونقولَ في هذا الحكم: إنَّ كولن قد فصَّل فيما أجمل فيه ابن نبي، وإنَّ ابن نبي قد فصَّل فيما أجمل فيه كولن.
وبالتالي، فإنَّ جمع فكرِ الواحد منهما إلى فكر الآخَر، لا شكَّ سيولِّد بناءً حضاريًّا مثاليًّا؛ وبخاصَّة إذا أضفنا إليهما بعضَ الأسماء المتميِّزة، مثل: إقبال، وبيجوفيتش، ومهاتير، والمسيري، وشريعاتي، وجيفري لانغ؛ وقلنا حينها: إنَّ هؤلاء يكوِّنون “جماعةً علميَّة”، بمعناها الاصطلاحي، حتى وإن لم يكتب لهم أن يعملوا على صعيدٍ واحد.
والمعلوم أنَّ “الجماعة العلمية” تؤسَّس على ضوء “أزمة معرفية”، وعلى خُطى “همٍّ حضاريٍّ مشترَك”، يعجز “النموذج والبراديم المهيمِن” عن الإجابة عنها، ثم تشتد هذه الأزمة، ويكبر هذا الهمُّ؛ فيشارك في الإجابة عليه أعضاء “الجماعة العلميَّة”، إلى أن يبزغ “البراديم البديل”، وينالَ المكانة والهيبة والقبول؛ ثم ما يلبث أن يتحوَّل إلى “نموذج مهيمِن” بعد حين… وهكذا؟
ولقد قصدت هذا المزج، بين هذه المعالم الفكرية في العالم الإسلامي، يوم كتبت مقالي: “الحفر بحثا عن المنظومة”، وانتهيت بعد عملية الحفر إلى تأسيس مرجعية متناغمة، تبدأ بابن نبي، وتنتهي بكولن.
هل في المقدور، ضمن علاقتنا نحن الباحثين المنتمين إلى مختلف “الأوعية الحضارية، والأنسجة الحضارية”، أن نطرح “صورة” لجماعة علمية تتكوَّن من الأعلام المذكورة أسماؤهم ابتداء، وتنتقل منهم إلى من سار على خطِّهم، ثم نحسِنُ بعد ذلك عرضَ هذه الصورة، والدفاعَ عنها، لا باعتبارها الأفضل والأمثل، ولكن باعتبارها محاولة من أنجح المحاولات؛ ونكون بذلك قد أسدينا معروفا لأمَّتنا، دون أن نغرق في “الشخصنَة”، ودون أن نسوِّق “للكاريزماتية”، و”الزعامة الفردية”؛ وهو أمرٌ يمجُّه الرجلان، محلَّ البحث والمقارنة، ولهما في ذلك نصوص كثيرة.
أمَّا مالك بن نبي، وهو الذي شقي دفاعًا عن فكره، وتنعَّم العالم الإسلامي بنورياته ولا يزال، فيقول: “وهكذا ننتقل من وهمٍّ لنتخبَّط في وهم، ولا ندري كم من السنين سوف نقضِّيها لندرك عجز الأشياء الوحيدة عن حلِّ المشكلات… إنما لا يجوز لنا أن يظلَّ سيرنا نحو الحضارة فوضويًّا يستغلُّه الرجل الواحد، أو يضلِّله الشيء الواحد، بل ليكن سيرنا علميًّا عقليًّا حتى نرى أنَّ الحضارة ليست أجزاء مبعثرة ملفَّقة، ولا مظاهِر خلاَّبة، وليست الشيءَ الوحيد، بل هي جوهرٌ ينتظم جميع أشيائها وأفكارها وأرواحها ومظاهرها، وقطبٌ يتجه نحوه تاريخ الإنسانية”.
وأمَّا كولن، الذي تفانى وتفنَّن في نكران ذاته، فقد أبدع في هذا المضمار وكتب من جملة ما كتب مقالا بعنوان “نكران الذات والمدد الرباني”، مما جاء فيه: “ينبغي أن نقنع “أنفسنا” أنه ليس لنا يدٌ في حصول هذا الخير العميم. فالنجاح كل النجاح لطف من الله وفضل من لدنه وإحسان. فإذا آمنّا بذلك فقد جنّبنا أنفسَنا شوائبَ الشرك، وأنجيناها من الأوهام التي تظَل النفسُ تَضُخّها في دواخلنا لكي تضخّم أنانيتنا. بل يحسن أن نقول: “في الحقيقة، لو لم أُقحِمْ نفسي في هذا الأمر، لوجد له رجالا خيرا مني في إخلاصهم وصدق تمثيلهم، ولقطعتْ القافلةُ مسافات واسعةً أضعافَ ما قطعتْه حتى اليوم. وا أسفاه، فلولا كدورة نفسي لتجلّى المددُ الإلهي وفق صفائه المقدس على الخدمة الإيمانية. واحسرتاه، فقد ارتطمت تجلياته بفيروسات أنانيتي وتحطمت على ضعفي وسيئاتي. أجل بسببي أنا تعثرنا وتأخرنا عن المواقع التي قصدناها، وابتعدنا عن المراقي التي حلمنا بها”. بل ينبغي تكرار هذا السؤال: يا نفس، كم إنسانا قتلتِ حتى اليوم!؟.. كم إنسانا كان يبحث عن الحقيقة فتعثّر بك وفقدها إلى الأبد!؟”.
إذن، الفكرة والمقترح مؤسَّسان ابتداء في فكرِ الرجلين؛ ويبقى لنا، نحن الخلف، أن نحسن التصرُّف، ونُحدث الآليات الفعَّالة لذلك، فنكونَ بذلك قد أجبنا على إحدى أعقد الأحجيات في إشكالية الحضارة اليوم.
خاتمة: لكَ أو لأخيك أو للذئب!
عقد هذا البحث مقارنةً أولية بين فكر العالمين المجدِّدين: مالك بن نبي وفتح الله كولن؛ وهي في الأساس تعمل على ترسيخ منطلقات لاستفادة العالم العربي من تجربة الخدمة، ومن فكر الأستاذ، بأسلوب سلس متقبَّل، دون أن يُحدث ضجة، أو أن يعرَض على سبيل الوصاية؛ إذ كلُّ هذه الأساليب منافية لروح البراديم كولن؛ تلك الروح المبنية ابتداء على “الشفقة”، وعلى “الرحمة”، وعلى “الحكمة”، وعلى “المرحلية”، من غير إغفال “التخطيط”، و”الحركية”، و”الفعل”، و”الفعالية”؛ ولكلِّ عنوان من هذه العناوين أصوله من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والسيرة النبوية العطرة؛ ثم إنَّ لها أمثلة في التراث الإسلامي العريق، وفي تجربة البشرية بكلِّ مشاربها إلى يوم الناس هذا؛ ولقد كتب الأستاذ في كلِّ عنوان من تلكم العناوين مقالات، وألقى محاضرات، ونحت مفاهيم، وأبدع آليات؛ حتى صارت علامةً مسجَّلة أو “ماركة” على الخدمة، إذا ذكرت تُذكِّرت، وإذا غابت انتفت أن تكون هي هي.
ولذا أرى من المناسب أن أستنبط جملة من الأفكار، والقواعد، والقوانين، والخطوات العملية، والتطبيقات، والبرامج… لعلَّها تسهم، ولو بنزر يسير في إذابة بعض الجليد الوهميِّ بين شمال البحر الأبيض المتوسط المسلم، وجنوبه المسلم؛ بعيدًا عن العقد التاريخية المفتعَلة، والصور النمطية المفبرَكة، والأحكام القبلية الملغَّمة؛ وسنكتشف أخيرا أنَّ هذه التجربة هي تجربتنا، وأنها لنا، وأننا لها، وأنها من ذاتنا، ومن خصوصياتنا، لا يفرقنا عنها فارق.
ولقد قال أبو عبيد الله الزواوي لخير الدين بربروس، يوم عزَم على مغادرة الجزائر، بعدما ساهم في حمايتها من الإسبان، قال له: “الجزائر لك، أو لأخيك، أو للذئب”؛ مشيرا بذلك إلى الغارات الصليبية على شمال إفريقيا؛ واليوم كلُّ بلد من بلاد المسلمين هو مثل شاة هزيلة معرَّضة لأنياب الذئاب ومخالبها، إذا هي لم تلزم الجماعة، وإذا لم تعتصم بحبل الله جنبا إلى جنب مع البلاد الأخرى؛ ولقد صدق الله العظيم القائل: وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ(الأَنْفَال:46)، وصدق الرسول الكريم القائل: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»(رواه أبو داود).
وجملة النقاط المستنبطة هي:
1-إذا أجريت مقارنات بين فتح الله كولن وغيره من علماء ومفكري ومجددي العالم الإسلامي، لتكن في إطار الوعاء الحضاري، والنسيج الحضاري، أي باعتبار السياق؛ وإلاَّ كانت مبتورة ظالمة.
2-يرفض في المقارنة اعتماد المنهج المختزل الانتقائيِّ، وكذا منهج دراسات الأثر؛ بل الواجب هو البحث عن مناهج أكثر فعالية وحركية وعلمية.
3-يجب الاجتهاد، إلى إنشاء “جماعة علمية”، تكون جسرا بين “البراديم كولن ومشروع الخدمة” من جهة، والنخبة المثقفة في العالم العربي من جهة ثانية.
4-نقترح اعتماد منهج “الأحجية العلمية”، أو ما يشبهه، مما يدفع إلى استثارة السؤال، وتحريك الإشكال.
5-في المقارنة بين عالمين أو أكثر، نحاول أن نستبدل الأدوار بينهم، وننظر في الأسباب الداخلية والخارجية التي أسهمت في صقل مواهبهم، وفي بلورة مواقفهم؛ بهذا الأسلوب يمكننا فهمُ الغامض والمخفيِّ من أسباب الفكر والحركية.
6-نقترح إعداد بحثٍ أكاديمي بعنوان: “مالك بن نبي التركي، وفتح الله كولن الجزائري”، ولا شكَّ أنه سيكون مثيرًا ومفيدًا وفعَّالا.
7-بين نظرية القابلية للاستعمار، لمالك بن نبي؛ وحوار الحضارات، الذي أسسه فتح الله كولن؛ ما يشبه التعارض، أو على الأقل، الصعوبة في الجمع بينهما؛ فهل في الإمكان إجراء بحوث تقارن بين الفكرتين، وترجِّح أيهما أليق للمسلمين في هذا العصر، بالذات؟
8-بين فكر ابن بني، المؤسِّس لفقه الثورة؛، وفكر كولن، الداعي إلى ثورات من نوع جديد، نسأل: أيُّ الفكرين أصلح للعالم العربي اليومَ؛ وبخاصة في عهد الثورات على الداخل؟
9-من الحكمة أن نجتهد في عرض فكر فتح الله بصورة يفهمها الشاب المسلم ويستوعبها، وأن لا نبقى محلِّقين في سماء التنظير، مخاطبين المثقفين والعلماء فقط؛ من هنا تأتي الدعوة إلى أعمال وكتابات ومشاريع تيسيريةٍ توضيحية عميقة، بشتى اللغات والأساليب، تخاطب هؤلاء الشباب: القلقين معرفيا، المستشكلين منهجيا، المستعدّين نفسيا، المتوقِّدين فكريا، الذين ينتظرون التوجيه والإرشاد، ورسم خطِّ السير بحكمة وحنكة وذكاء.
10-إنَّ كولن قد فصَّل فيما أجمل فيه ابن نبي، وإنَّ ابن نبي قد فصَّل فيما أجمل فيه كولن: هذا حكم أولي، بل هو شبه أطروحة تولَّدت من التفاعل المستمرِّ مع الفكرين؛ ولذا أجده بحثا عميقا، يعِد بنتائج مفيدة وبديعة، لو كتب الله إنجازه.
11-عود على بدأ: المنتظر على ضوء هذه المقارنة المختلِفة، أن ننتهي برسم صورة لجماعةٍ علمية، ووضعِ أسس لعملها، وللخطوط العريضة التي تجمعها. وإلاَّ، فالعلم ما لم يكن اجتهادا لن يعدو أن يكون محض ادِّعاء، والأمَّةُ ما لم يَصُغ فكرَها، ويخططْ مسيرها ومصيرها، رجالٌ علماء مخلصون، هي عرضة لكلِّ الهزات والنكبات والويلات.

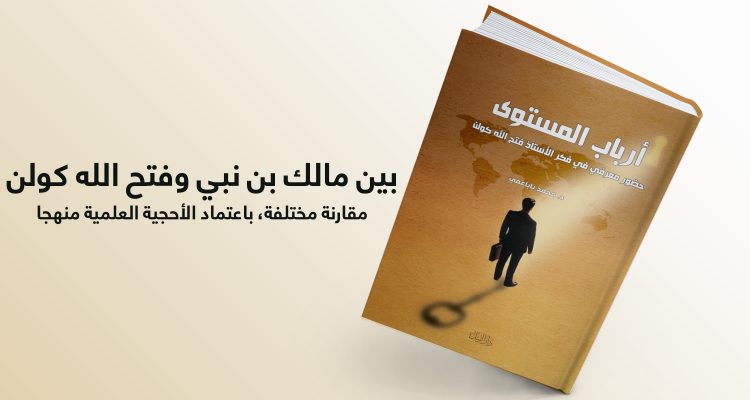
Leave a Reply