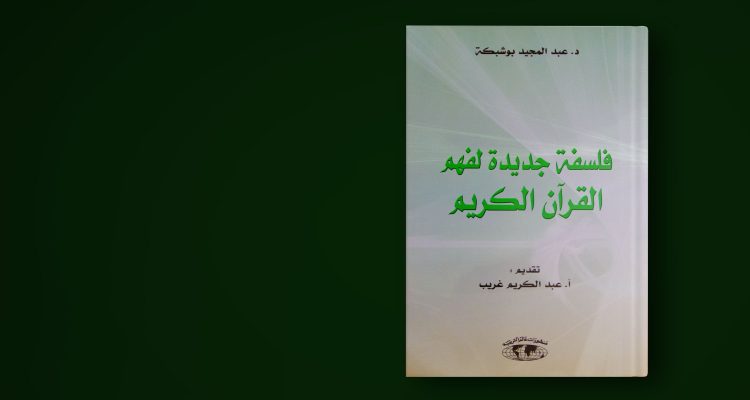تألق كثير من العلماء خلال تفسيرهم للقرآن الكريم ومحاولة كشفهم لبعض أسراره كل في مجاله. فمنهم من أبدع في المعاني ومنهم من جود المباني وغيرهم اهتم بالإشارة وهناك من دبج العبارة ومنهم ومنهم…
لكن صاحبنا محمد فتح الله حاز من كل فن طرف حتى جاوز الأقران وعظٌم السلف. وكم كان انبهاري شديدا حين سمعت أحد الأخيار من تلاميذ الأستاذ ينقل عنه قوله:”يجب تفسير القرآن في كل خمس وعشرين سنة(25 سنة)”. نعم إذا كان القرآن صالح لكل زمان ومكان كما أجمع على ذلك خلف الأمة بعد سلفها، فكيف للناس أن ينهلوا من معينه إذا لم يفسروه ويفهموه؟ وكيف للناس أن يستفيدوا منه إذا لم تكن تلك الفهوم والتفاسير موافقة لعصرهم متجاوبة مع طموحهم ملامسة لهمومهم؟
إنني وأنا أتجول بين ما تيسر لي مما أثر عن الأستاذ في هذا الصدد، لاحظت أن للأستاذ فتح الله رؤية تجديدية خاصة لفهم القرآن الكريم وتفسيره.
وهذه الرؤية يمكن تلمسها عبر طريقين اثنين. الطريق الأول خاص يظهر لنا السبل التي تنير رؤية الأستاذ لكتاب الله تعالى. والطريق الثاني عام قد يشترك فيه الأستاذ مع العديد من المفسرين في هذا الدرب وإن كانت له خصوصياته.
أما الطريق الخاص فيستنير فيه الأستاذ كولن بأربعة توجهات كبرى وهي:
الأول :التقوى شرط الاستفادة من القرآن:
قد يبدو هذا الأمر عاديا حينما نقرأه في صفحات الكتب أو نسمعه من أفواه العلماء، لكن الكثير منا قد يتبلد إحساسه ولا يتوقف لحظة عند هذه المعاني العميقة التي تجلجل في ثنايا آي الذكر الحكيم، حين نمر عليها مرور الكرام. لذلك وصلنا إلى ما نرى وما نعلم جميعا من الجهل والظلم التخلف والفرقة وغير ذلك من الصفات التي لاتشرفنا. وقليلا ما نتذكر أن هذه الآيات الكريمة هي نفس ها التي نزلت على جيل الصحابة الكرام، إلا أنها غيرت أحوالهم وحسنت أخلاقهم ورققت قلوبهم وجعلتهم صدرا في عالمهم بعد ما كانوا ذيلا. إنها الآيات نفسها ولكن هل نحن اليوم نحيا بالقرآن كما كانوا؟ وهل نرعاه كما رعوه؟ وهل تقشعر جلودنا لسماعه كما كانت أحوالهم؟ وهل وهل…إنه التقوى الذي سكن قلوبهم واختلط بدمائهم.
يقول الأستاذ كولن: “على القارئ أن يسدد نظره ويلقى سمعه نحو القرآن، وأن يتوجه إلى القرآن الكريم
بكيانه كله، إذ من المحال الاستفادة من القرآن على الوجه المطلوب باتباع سبيل آخر، حيث إن من لا ينظم أطواره وفق هذا النسق لا يستطيع أن يرى الجهة المعجزة المنورة للقرآن، فلا يميز كلام الله عن كلام إنسانٍ ما. ومن هبط إلى هذا الدرك لا يرجى منه أن يؤدي عملاً ما باسم القرآن، لأن القرآن يعقب بعد قوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ بقوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾. أي إنه كلام رب العالمين، لا ريب فيه، ولكن لا يستفيد منه على الوجه المطلوب إلاّ المتقون. والمتقون هم أفضل الناس معرفة بالشريعة الفطرية؛ فكما لا يكون المهمل متقياً، لا يستفيد من القرآن أيضاً، حيث إن قلبه قد مات، والآية الكريمة تبين ذلك: ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ﴾ سورة محمد الآية20.”
الثاني: تجاوز التقليد والشعارات الجامدة:
إذا كان القرآن قد حسن أحوال من سبقونا، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ورفع شأنهم بين العالمين، فلأنهم تجاوزا ما وجدوا عليه آبائهم من تقاليد بالية، وأفكار محدودة وعقائد مشلولة، وغير ذلك مما ران على قلوبهم. ونحن اليوم وقد أصبحت الأرض غير الأرض والناس غير الناس، وغمرتنا من العاهات ما لا قبل للسابقين بها، واستجدت في حياتنا من الأقضية ما لا أثر لرأي سلفنا الأمجاد فيها، أيعقل بعد كل هذا أن نتردد في السعي الجاد والسريع عن الحلول الناجعة لكل هذه التحديات بله مناقشة جواز الاجتهاد؟ إلى متى سنعُض على المأثور من الأفكار والثقافات والعلوم والمناهج؟ في وقت تجاوزتنا مجتمعات وشعوب كانت إلى الأمس القريب عالة علينا في كل شيء؟ إن كل ذلك لا يستقيم إلا بفهم جديد للقرآن الكريم.
من أجل ذلك ثار الأستاذ فتح الله في وجه هذا الواقع ليذكرنا بأن القرآن الكريم بذكره أسس الحوادث الطبيعية و الشريعة الفطرية والتأكيد عليها، قامبدور الرائد للعلم وللتفكير الحر. كما أن آيات عديدة في القرآن الكريم مثل (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) تشير بوضوح إلى “العلوم التجريبية” و”العلم العقلاني”في الأوامر الإلهية التكوينية. وهذان المثالان كانا يشكلان أسس التفكير الحر والعلم الحديث في العهد القريب لأوروبا. حيث كانت الكنيسة قد أسست ثقافة تقليدية متوارثة عن الآباء يمكن أن نطلق عليها “ثقافة الأسلاف” أو “ثقافة الآباء”. وإذا كانت ثقافة ذات قيم ثابتة وجامدة… وحسب رأي فتح الله كولن، فإن على رأس ما انتقده القرآن الكريم، هو الظن والتخمين والتقليد والشعارات الجامدة. (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) . وهكذا نرى أن القرآن يرفض –هنا وفي مواضع أخرى عديدة- مثل هذه السيكولانية الشعاراتية، ومثل هذا الفهم لثقافة الأسلاف، ويدعو –بدلا من هذا- إلى البحث و التفكير والتأمل…. ثم يقف طويلا على التطورات الفكرية والعلمية التي شهدتها القرون الأولى للإسلام انطلاقا من زاوية نظرته العلمية هذه. وطوال القرون الثلاثة الأولى استعمل المفكرون المسلمون الفكر العقلاني المستند إلى التجارب، واستطاعوا تسجيل نجاحات مبكرة في العديد من فروع العلم أكثر مما استطاعته أوروبا. وكان هذا مؤشرا على خاصية حضارية الإسلامية وطابعها المميز. وبعد أن يتناول فتح الله كولن هذا الموضوع باختصار، يشير إلى أنه لا يوجد في الإسلام أي أساس للصراع بين الدين والعلم لا تاريخيا ولا فكريا. ويعد مثل هذا الاتهام ظلما كبيرا للإسلام ومخالفته للحقائق التاريخية.
الثالث: المزاوجة بين التأمل في آيات الله في الأنفس والآفاق وآياته في القرآن.
إن المزاوجة بين آيات الله في الأنفس و الآفاق من جهة وبين آيات الله في كتاب المقروء من جهة ثانية، هو السبيل الأمثل لفهم مراد الله تعالى من آي الذكر الحكيم فهما صحيحا متكاملا. وإلا فإن التيه عن المراد وفقد المقصود سيكون حليفنا. يقول الأستاذ:” إن أول شرط لا يستغنى عنه المبلّغ قط هو تطبيقه الآيات الكونية الظاهرة في الآفاق والأنفس على الآيات القرآنية المتلوّة، ومن ثم صياغة مركب منهما. وبمقدار نجاحه في هذا الميدان يوفَّق في تبليغه وإرشاده. وبخلافه لا شيء إلاّ الإسراف له ولمخاطبيه. نعم، إن المبلّغ يتصف بكامل كيانه بالصفات الإسلامية، وجميعُ أطواره وأحواله تدل على حيازته لها. وإن القدرة على تحليل الآيات الآفاقيةوالأنفسية وصياغة تركيب منهما لا تفارق المبلّغ، فضلاً عن الاتصاف باللطف والنـزاهة والشفقة والنظام وأمثالها من الصفات التي تجعل المؤمن مؤمناً حقاً .
الرابع: معرفة مجريات العصر:
مهما حاولت بيان قدرة الأستاذ كولن العجيبة على تمثل هذه القاعدة، فلن أفلح في تبليغ ما أشعر به من انبهار بعزيمة هذا الأستاذ الكبير وقوة شكيمته. إن المطلع ولو على جزء من اهتماماته في كل مجالات الحياة، وما ينوء به من أمل رجوع أمتنا إلى زاهر عهودها، لن يخالفني الرأي بأن الأستاذ كولن يعد نموذجا للمسلم المطلع على مجريات العصر، والحامل بين أضلعه آهات المعاناة وأنين المصائب التي تكالبت على الأمة من كل حدب وصوب. إلا أن سعة الاطلاع على مجريات العصر لم تنسهذا الرجل التعويل الكلي على الذات من أجل البناء من جديد. وهذا التعويل هو الذي يترجمه في كل مناسبة بدعوته إلى النهل من منابع الأمة ومصادرها وعلى رأسها الكتاب والسنة. لكن محل الشاهد عندي في كل ذلك هو ما نقل عن الأستاذ في المقولة التي لاأمل تكرارها: “يجب أن يعمل الناس على تفسير القرآن الكريم كل خمس وعشرين سنة”،ففي هذا المعنى تصريح بما نجده من اختلاف عملي في كثير من التفاسير. ولعل روح كل العصر ومستجداته وما يتبع ذلك من تجدد قضيا الناس وتعدد حاجاتهم، يفرض على من يتصدر الأمة من علمائها أن يجيبوا على تلك التحديات والقضايا المستجدة. وهكذا يصبح فقهاء الأمة ومفسرو القرآن أمام تحدي تجديد فهم الدين وما يرتبط به من علوم أصيلة أو خادمة لهذا التجديد.
والخلاصة أن المتصدي لفهم القرآن الكريم وتفسيره لابد له من مباشرة ذلك عبر ما يحقق الفهم والتفهيم، الشيء الذي يتعذر في غياب أدوات العصر وعلومه. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله :” يجب أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم،بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه….ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهممعانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فيفن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم و به نجاتهموسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم” .
o صعوبة تحديد المعاني مشكلة قديمة جديدة:
إذا كان الناس يختلفون ويتفاوتون في فهم النصوص البشرية رغم بساطتها وسطحيتها، فما بالنا بالنصوص السماوية. وإذا أجمع القدماء والمعاصرون على إعجاز نصوص القرآن الكريم لفظا ومعنى، فلأن ذلك الإعجاز وصف أزلي سيبقى باهرا متحديا كل الخلائق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذاك لا غرو أن يستفيض البحث في معاني الألفاظ ودلالاتها وخاصة ما يتعلق بمعاني ودلالات الخطاب القرآني. وهكذا تعد أعمال المفسرين وغيرهم من الباحثين منذ نزول الوحي إلى اليوم ميدانا خصبا للتنافس والاجتهاد في فهم مرامي ومقاصد هذا الخطاب الرباني.
نعم إن علماء الدلالة المحدثون يرون أن صعوبة تحديد المعنى مشكلة أزلية وهي التي كثيرا ما تثير الفتن، لأن الألفاظ قد تؤول من قبل المتلقي إلى معان غير التي أرادها المتكلم، لذا يحدث الخلاف بسبب عدم فهم المعنى.
والأستاذ كولن من المدققين في قضايا الدلالة و المستوعبينلمآلات التهاون فيها، يقول الأستاذ: ” الكلمة أهم واسطة لانتقال الأفكار من ذهن إلى آخر، ومن قلب إلى آخر. والذين يحسنون استعمال هذه الواسطة من أرباب الفكر يستطيعون جمع أنصار عديدين للأفكار التي يريدون إيداعها في القلوب وفي الأرواح، فيصلون بأفكارهم إلى الخلود. أما الذين لا يحسنون هذا ولا يستطيعونه فإنهم يقضون أعمارهم في معاناة فكرية ثم يرحلون عن هذه الدنيا دون أن يتركوا أثراً فيها.”
ومؤيدات ذلك عديدة في كتابات وآراء العلماء من أهل هذا الفن، يقول العلامة الجرجاني في انتقاده لبعض المفسرين تحت عنوان “فصل في تهور بعض المفسرين” 🙁 هذه مسألة قد كنت عملتها قديما وقد كتبتها هاهنا لأن لها اتصالا بهذا الذي صار بنا القول إليه قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي لمن كان أعمل قلبه فيما خلق القلب له من التدبر والتفكر والنظر فيما ينبغي أن ينظر فيه فهذا على أن يجعل الذي لا يعي ولا يسمع ولا ينظر ولا يتفكر كأنه قد عدم القلب من حيث عدم الانتفاع به وفاته الذي هو فائدة القلب والمطلوب منهكما جعل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤديان إليه ولا يحصل من رؤية ما يرى وسماع ما يسمع على فائدة بمنزلة من لا سمع له ولا بصر فأما تفسير من يفسره على أنه بمعنى من كان له عقل فإنه إنما يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة فأما أن يؤخذ به على هذا الظاهر حتى كأن القلب اسم للعقل كما يتوهمه أهل الحشو ومن لا يعرف مخارج الكلام فمحال باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من الآية وإلى تحريف الكلام عن صورته وإزالة المعنى عن جهته وذاك أن المراد به الحث على النظر والتقريع على تركه وذم من يخل به ويغفل عنه ولا يحصل ذلك إلا بالطريق الذي قدمته…)
o ألم يأت الأستاذ فتح الله بجديد :
وقد سمعت بعض من يقول إن ما قام به الأستاذ فتح الله لا يعدو أن يكون تكرار ونقل لما قاله علماء ومصلحون سابقون. لكني أدعي أن الأمر شديد الاختلاف. فهو من جهة لم يأت بالأقوال نفسها وإنما أتى بمستجدات كثيرة ليس هاهنا بسط الكلام فيها، والأهم من ذلك تميزه بسوق للمعاني الكبيرة وتنبيهه إلى دلالات جمعت بين محاسن أعمال المصلحين السابقين، وعلوم وتخصصات وثقافات اللاحقين من كل فلسفة ودين، ناهيك عن المنهج السديد والأسلوب الواقعي الفريد، درني واستيعاب الأستاذ فتح الله لشتى علوم العصر وتمكنه من علوم الشرع. وكم راقني في هذا السياق تدقيق الجرجاني في الفصل بين الأقوال حين قال:
(…ولا يغرنك قول الناس: قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه، فإنه تسامح منهم. والمراد أنه أدى الغرض فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل ها هنا إلا ما عقلته هناك وحتى يكون حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهتين في عينك كالسوارين و الشنفين ففي غاية الإحالة وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة وهي أن تكون الألفاظ مختلفة المعاني إذا فرقت و متفقتها إذا جمعت وألف منها كلام وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو قعد وجلس ولكن فيما فهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخر نحو أن تنظر في قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) وقول الناس:( قتل البعض إحياء للجميع) فإنه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا إنهما عبارتان معبرهما واحد فليس هذا القول قولا منهم يمكن الأخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم من الآخر.)
غوص الجرجاني في هذه الأبعاد للتنبيه على مختلف دلالات الخطاب يوحي بالانتباه المبكر إلى علم الدلالة الذي يعتقد بعد الناس أنه علم جديد. والحال أن علماء اللغة وسلاطين البيان لم يفُتهم هذا الأمر منذ زمان. كما أنه لم يفت الأستاذ فتح الله الذي قال وهو يوجه كلامه نحو الخطاب الأدبي: ” العنصر الأساسي في الأدب هو المعنى. لذا يجب أن تكون الكلمات المذكورة قليلة وقصيرة وغنية بالمعاني. و مع أن البعض حاولوا شرح هذا الأمر كما تناوله القدماء بمواضيع البيان والبديع، أي بفنون التشبيه والاستعارة والكناية والتلميح والجناس…الخ إلا أنني أرى أننا يجب أن نبحث عن الكلام العميق عند المفكرين من ذوي القلوب الملهمة التي تحيط بالوجود وتعرف كيف تتسع قلوبها للوجود كله، وذوي الخيال الواسع الذين نجحوا في رؤية الدنيا والآخرة وجهين لحقيقة واحدة، والذين يملكون إيماناً عميقاً وفكراً تركيبياً قوياً…”.
فالأستاذ فتح الله أستطاع أن يأسر عقول المتخصصين فضلا عن عموم الناس والمهتمين، بمهاراته العالية و المتنوعة في مختلف فنون المعرفة، وقبل هذا وذلك سيل عارم من الحب والصدق والإخلاص والثقة في مشروعه التجديدي الذي يقوده بشكل يثير الاستغراب. فالرجل حين يفسر آي القرآن الكريم، أو يشرح نصوص الحديث النبوي العظيم، يتكلم وكله ثقة في ما يقول، ذلك لقوة إيمانه بوعد الله ورسوله للمؤمنين.
أما عمق كلام الجرجاني وهو صلب حديثنا في هذا المبحث، والذي يعد مناط نظرية النظم، فيتمحور حول تصنيفه للخطاب وتمييزه بين دلالة الألفاظ وبين دلالة المعاني وقد جلى ذلك حين قال: (فصل الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل…” إلى أن قال:
“وإذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر.)
و في سياق دلالات الخطاب القرآني يقول الإمام الزركشي: أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر و التفكر: واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر، أو يكون راجعا إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض”.
o الأستاذ كولن والمعنى:
قبل السباحة في بحر كلام الأستاذ فتح الله، بدا لي من المفيد استحضار قول العلامة الجرجاني ونصه: (فأما تفسير من يفسره- يقصد قوله تعالى<إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب.> – على أنه بمعنى من كان له عقل فإنه إنما يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة. فأما أن يُؤخذ به على هذا الظاهر حتى كأن “القلب” اسم “للعقل” كما يتوهمه-أهل- الحشو ومن لا يعرف مخارج الكلام، فمحال باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من الآية، وإلى تحريف الكلام عن صورته وإزالة المعنى عن جهته. وذاك أن المراد به الحث على النظر والتقريع على تركه، وذم من يخل به ويغفل عنه. ولا يحصل ذلك إلا بالطريق الذي قدمته…).
أما بخصوص توظيف الأستاذ إلى هذا الأسلوب الدلالي العميق، فقد وجدته سامقا شأنه في ذلك ما يرومهفي كل كتاباته. وما دام حديثنا يخص كشف المعاني القرآنية وتوضيح بعض المرامي الرحمانية، فإننا سنلتفت إلى هذا عبر أضواء الأستاذ حول بعض تلك الآي.
فإذا كان لفظ الدلالة – بالفتح الدال وكسرها- يأتي في جل الكتابات مرادفا للمعنى فإن استعمالاتها من طرف الأستاذ كولن في هذا الصدد كثيرة. ولا أظنني مفرطا إن قلت أن أهل هذا الفن مطالبون بدراسات جريئة وعميقة للكشف عن إبداعات هذا الرجلالغزيرة في هذا المجال، فسيفاجئون بخصوبة حقولها وعمقها وجدتها.
يقول الأستاذ وهو يتأمل معاني الخطاب القرآني:( بسبب هذه المعاني، وكذلك بسبب معان لا نعلمها أقسم الله تعالى بمواقع النجوم الذي قال عنه رب العالمين إنه قسم عظيم. ونحن نؤمن بالمعاني التي لا نعلمها تماماً كما نؤمن بالمعاني التي نعلمها. لذا نؤمن من كل قلوبنا ونصدق بأنه ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾
إن توظيف الأستاذ فتح الله لكافة المستويات الدلالية في هذه الأضواء القرآنية لا ينم عن عمق الفهم الذي يميزه في جل أعماله المادية والمعنوية فحسب، بل يشير إلى قوة استيعاب للأديان و الأفكار والثقافات، بقدر استيعابه للتحديات وتميَزه في الرؤية النوعية للحلول المقترحة والمنهج الدقيق والتنزيل الراقي.
قد نلحظ نوعا من الخفوت في المستوى النحوي الوظيفي في هذا الكتاب، خلافا لما هو عليه في كتابه “النور الخالد”أو كتابه “ترانيم روح وأشجان قلب” لكن قوة المستوى المعجمي نجده عند الأستاذ غنيا فسيحا يزاحم فيه أهل هذا الفن من العارفين، بل إن تميزه بالدقة أعطى “للمنتوج الكولاني” طابعا خاصا لا تخطئه الأذن حين تسمعه ولا العين حين تراه.
أما المستوى الدلالي الاجتماعي وما إليه من المسرح اللغوي فالأستاذ فارسه. وإنك تراه يصول بين السياقات ويجول وسط المعاني وكأنه يغترف من بحر لا ينضب. ولعل لسان الأستاذ الأعجمي العربي، قد أكسبه من المهارات ما غابت عن عدد من أقرانه المصلحين. كما أن استيعابه الكبير للدين الإسلامي وفهمه التجديدي له، مكنه من تقدير باقي المعتقدات ووضعها في مكانة خاصة، ثم يقوم من خلال كل ذلك بالتفهيم والتوصيف والتنزيل للأفكار والمشاريع في كل المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والتربوية والفنية، تنزيلا حير الألباب لطفا وحكمة وفعالية. ولا تخطئ عين المتتبع فضلا عن المحب محاولات التمثل الكبيرة للأخلاق النبوة وسيرة الصحابة الكرام، في كل أعمال الأستاذ فتح الله، ناهيكم عن سيرته.
كل تلكم العناصر المذكورة وغيرها، أعطت لأعمال الأستاذ كولن، المعنوية عموما والمادية خصوصا،طابعا تجديديا “كولانيا” بامتياز. وليس كتاب “أضواء القرآنية” إلا قبسة من هذا العمل النوعي الكبير، حيث لم شتات بعض أفكار الأستاذ ورؤيته لبعض آي الذكر الحكيم و بيان منهجه في فهم الخطاب القرآني العظيم. هذا الخطاب الذي أعجز الأولين والآخرين وسيبقى إلى أن يشاء رب العالمين.
هذا الخطاب المقدس الذي توالت الكتابات واجتمعت الفهوم من أجل تقريبه للناس أجمعين، هذا الخطاب الإنساني الذي كان وسيبقى الملاذ الآمن للبشرية من همومها وأحزانها وأزماتها في كل بلد وحين، تفوق الأستاذ فتح الله في بيان دلالاته وأبدع في بسط سياقاته، ليصبح مادة الانطلاق وبيت القصيد في حل كثير من الأزمات.
لقد استطاع أن يحلق بعيدا ليربط بين دلالات السياق المختلفة، ودلالات المعاني القريبة والبعيدة،المعجمية منها والتركيبية و الاجتماعية، ليحاصرك في النهاية بمسلمات عقلية أو روحية وإن شئت، إنسانية كبيرة و بمعاني ربانية عظيمة لا تملك إلا الخضوع لها. متوسلا في كل ذلك بآيات الله العظمى المنثورة في كتابه أو المنظورة في ملكوته.
فتأمل قوله في سياق الجواب على سؤال حول قول الله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾:
“في الحقيقة أن خطاب الله سبحانه وتكلّمه مع المخلوقات متنوع جدّاً ومختلف جداً. فنحن هنا نتكلم بطراز خاص وبشكل معين، وعلاوة على ذلك فلَنا طرز كلام، لحواسنا الداخلية والخارجية، ظاهراً وباطناً، ولنا تكلّم عقلي وروحي، ولنا نمط من كلام نفسي ولفظي، وكثيراً ما نتكلم بهذه الألسنة ونحاول أن نفهّم الآخرين الذين يفهمونها.. فلِلقلْب لسان خاص به. فالقلب يتكلم ولكن لا يُشعَر به. فإذا قيل لنا، ماذا تتكلمون في باطنكم، نقول: كذا وكذا. ونسرد ما تكلمناه في أنفسنا. وهذا تكلّم نفسي. وأحياناً نتكلم في رؤيانا ونفهم من الآخرين أيضاً، ولكن لا يشعر به أي شخص بجنبنا. ثم ننقل الكلام بحذافيره إلى الآخرين. وهذا طراز آخر من الكلام… ”
الأستاذ دائما يجول بك في كثير من الحقول المعرفية وعبرها أحيانا في ثنايا قضايا فلسفية، وقد تجد نفسك في عمق معان يفضي إليها تساوق الكلام أو بيان الخطاب، حينها قد تعجز عن فهم مراد الأستاذ بله تصنيف منهجه. فتأمل قوله في نفس المكان:
“وهناك أشخاص يعرض على أنظارهم في عالم اليقظة ما في عالم المثال من لوحات ويتكلمون مع أشخاص في عالم المثال. وربما بعض المادِّيين لا يصدّقون هذا ويقولون إنه “هَلْوسة” (Hallüsinasyon) لندعهم وشأنهم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض على نظره النبوي السامي لوحات مثالية من عالم البرزخ وعالم المثال وهو بدوره ينقل ما شاهده وفهمه وأحسّه إلى الآخرين. وهذا نوع آخر من الكلام. أما الوحي فكلام من نوع آخر كلياً. إذ كان الوحي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان غيره يشعر به ولا يفهمه، فلو كان هذا شيئاً ماديّاً يُسمع بالأذُن لَشعر به القريبون منه صلى الله عليه وسلم. والحال كان يأتيه الوحي وهو واضع رأسه على ركبة إحدى زوجاته أو واضع ركبته المباركة على ركبة أحد الصحب الكرام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم الوحي من دون أن يشعر به أحد غيره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلّغ ذلك الوحي حرْفيّاً إليهم. وهذا صوت بطرْز آخر وكلام بطرز آخر…”
إن التوسل بدلالات السياق حينا وبدلالات التراكيب حينا آخر وبدلالات الألفاظ أحينا تفسح أمام السامع والقارئ مجالات للتخمين والفهم واسعة. فالأستاذ كولن ينطلق بك في عالم المعقولات حتى تظنها هدفه المنشود كما جاء في قوله: “…فالقرآن الكريم يخاطب المشركين المعاصرين لسيدنا (صلى الله عليه وسلم) مرة بعد مرة بلسان العقل، ويوسع آفاقهم بلسان المنطق، ويحقنهم بالمعقول بقوة المحاكمة المنطقية، ويعيد عليهم صفحات من ديمومة التكرر التاريخي، ويضعضع -بسرد الأمثال- لا منطقيةَ الشرك في تلك الأيام إلى جانب الفكر الإلحادي في قابل الأيام، ويدعو إلى التعقل في كل الأمور.” ثم يعرج بك في عالم الروح حتى تؤمن بأنه غايته المثلى، إلا أن منهجه ليس هذا أو ذاك بل هي طريقة محبوكة تعطي لكلام الأستاذ كولن معاني غزيرة، ولمنهجه خصوصية ناذرة. فاستمع إليه إذ يقول :
“يرد الإلهام إلى قلب الولي، فيُهمَس في قلبه شيء، وهذا طرز آخر من الكلام مثلما هو في لغة مورس “التلغراف” حيث يستطيع الموظف المختص تحليل ما يبثه هذا الجهاز من شفرات وإشارات. وقد تلقى بعض الأمور في قلب الوليّ، وهو بدوره يستخرج منها معاني شتى. فمثلاً: يقول الولي: فلان بن فلان على الباب، ويفتحون الباب فإذا بالشخص المذكور أمامهم. وهذا طرز آخر من الكلام. وهناك التلباثي (Telephati): فعُلماء اليوم يهيئون بحساباتهم وتجاربهم أنه سيأتي يوم يمكنهم أن يتخاطبوا بالتليباثي. وهذا شكل آخر من الكلام. وتوجه القلب للقلب ووصول كلام الإنسان به بعضهم لبعض من الداخل بيان بطرز آخر.”
لعل معايشة الأستاذ لجيلين أو عصرين تعاركت فيهما الاختيارات والفلسفات وتنافست في الدفاع عن مشاريعها، أعطى للأستاذ حسا مرهفا تجاه فلسفة الإيمان وقضاياه. كما أن نهله من الثقافة الغربية وتمكنه من مناهجها أهله ليخوض وبجدارة غمار بحر من الدلالات والأبعاد لا ساحل له، لكن بمنهج إنساني فريد. “… إن ما يشاهده الإنسان ويشعر به في عالم المثال وعالم البرزخ أو في عالم الأرواح، يخطئ الناس إذا ما قاسوا تلك الأمور بموازين هذا العالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «العبد إذا وُضع في قبْره وتُوُلي وذَهب أصحابُه حتىّ إنه ليَسْمع قَرْع نِعالهم، أَتاه ملَكان فأَقعداه، فيقولان له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرّجل محمدٍ صلى الله عليه وسلم. تُرى إلى أي شيء يوجَّه السؤال؟ فسواء سئل جسده أو روحه، فالنتيجة لا تتغير. فحتّى لو شعر الميت بهذا الكلام، فالحاضرون حوله لا يشعرون به قطعاً. وحتى لو وضعوا آلة مسجّلة في القبر فلا يمكنهم أن يسمعوا شيئاً قط، ذلك لأن المكالَمة تجري في أبعاد أخرى وليست من طراز أبعادكم، كالأبعاد التي توصّل إليها أَلْبَرت أينْشتاين (Einstein) وغيره، البعد الرابع والخامس وأمثالها من الأبعاد. كذلك المسألة تتبدل بتبدل المكان، وتبرز أمامكم بهوية أخرى؛ لذا فـ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ كلام الله للروح بكلام خاص بها. ويلزم ألاّ أنتظر أن أدرك تأثير هذا الكلام أو أحفظه. بل يمكن أن أعيه بشكل إحساس منبعث من الوجدان. فنحن نستشعر هذا بوجداننا على شكل إلهامات.”
قد يكون للفهم الدقيق جدواه في توجيه الألفاظ وسبر أغوار دلالات السياقات،لكن الإيمان العميق بالقضايا والشعور المرهف بأبعادها قد يحيلها عوالم أخرى تغري بالدرس والتأمل في دلالات يتعانق فيها عالم السياق وعالم اللفظ حتى يدخلان عالم بلا حدود :”…قال لي أحد الناس أثناء إيضاحي لهذه المسألة: إنني لم أشعر بهذا. قلت له: وأنا شعرتُ به، فإن لم تشعر به فأنت وشأنك. لأنني أتذكر جيّداً استشعاري به وإذا ما سُئلت “بأي شيء شعرت به” أُجيب: “بالتوْق إلى الأبَد المغروز فيّ”. لقد سمعت هذا الصوت برغباتي غير المتناهية رغم أني مُتناهٍ. وفي الحقيقة أنني لا أستطيع إدراك الباري عز وجل لأنني محدود مقيّد، فكيف أُدرك المطلقَ غيرَ المحدود! ولكن أدرك عدم المقيد والمطلق بما فيّ من رغبة وتوْق نحوه. فحشَرة محدودة في هذا العالم المحدود تعيش في عالمها المحدود وحياتها المحدودة، ثم تموت. والأشياء الداخلة في حياتها هي الأخرى محدودة. وأنا مثلها في عالم محدود، ولكن أفكر في الـ”لا محدود” و”غير المتناهي”. ففيّ رغبة نحو الأبَد، أحمل في روحي التوْق إلى الجنة ورؤية جمال الله. وحتى لو تملكتُ الدنيا كلَّها لا يزول همّي هذا. ولهذا قلت “أحسستُ به”، لأن فيّ هذه الحال.فأياً كان الوجدان، فهو يترنم بذكر الله بكلياته وأقسامه ولا يكذب قط. فعندما تعطونه ما يرغب فيه يسكن ويطمئن. ولهذا لا يجد القلب الذي هو لطيفةٌ ربانيةٌ سكينتَه إلاّ إذا وجد الوجدان سكينته وطمأنينته. وإشارة لهذا تقول الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد: 2.
فالأستاذ هنا تجاوز شرح ظاهر النص إلى ما يحمله النص من المعاني العظيمة التي تلوح في الأفاق من خلال التذوق والإحساس اللامتناهي. وبذلك تصير دلالات الألفاظ أو السياقات الظاهرة المحدودة عند بعض الناس دليلا على معاني غزيرة عند أناس آخرين. ولم يكتف هذا الرجل في بيانه بالتجريد لتوضيح المعاني العظيمة التي يحملها الخطاب الإلهي، بل تعداه باستحضار الأدلة الواقعية للإقناع بالأبعاد المعنوية المتعددة للألفاظ الظاهرة السطحية. فاستمع إليه وهو يستأنس –كعادته- بالعلوم والفلسفة، طاويا مسافات بينه وبين العديد من رجال التفسير، مصالحا بين حقول علمية لازال كثير من الناس يؤمن بتخاصمها. فتأمل قوله: (وهناك أمر آخر فـ”برجسون” (Bergson) وأمثاله من الفلاسفة تركوا جميع الأدلة العقلية والنقلية في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى واستعملوا وجدانهم وحده دليلاً على ذلك. حتى يقول “كانت” (Kant) في إحدى المرات: “إنني تركت جميع معلوماتي وراء ظهري كي أعرف الله معرفة تليق بعظمته”. بينما “برجسون” نجده يريد أن يسلك هذا الطريق. ودليله الوحيد هو الوجدان. فالوجدان يضطرب ويقلق كثيراً من إنكار الله سبحانه، فلا يسكن ولا يطمئن إلاّ بالإيمان بالله. والإنسان عندما يستمع إلى صوت الوجدان الصادر من الأعماق، يشعر دوماً بوجود معبود أزليّ وأبدي. فهذه الحال وهذا الأداء هو الجواب بـ﴿بَلَى﴾ الذي عبّر عن نفسه بكلمات صامته في وجدان الإنسان، جواباً على سؤاله تعالى ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾. فأيما إنسان إذا ما راقب ولاحظ بدقة، سيجد ذلك الصدى يصعد من أعماق روحه. وإلاّ لو يبحث عنه في العقل أو الجسد، يقع في التناقض. نعم إنه موجود في وجدان كل أحد، إلاّ أن إثباته يخص ميدانه هو..)
ويقول الشيخ رشيد رضا حول أهمية التوغل في المعاني والدلالات وتجاوز الظاهر والمنقول من الآراء: “…وَلَيْتَ أَهْلَ الْعِنَايَةِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَعْنًى تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ أَفْهَامُهُمْ فِي الْعِلْمِ بِمَعَانِي الْكِتَابِ، ثُمَّ يَبُثُّونَهُ فِي النَّاسِ وَيَحْمِلُونَهُمْ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا صِنَاعَةً يُفَاخِرُونَ بِالتَّفَنُّنِ فِيهَا ، وَيُمَارُونَ فِيهَا مَنْ يُبَارِيهِمْ فِي طَلَبِهَا، وَلَا يَخْرُجُونَ لِإِظْهَارِ الْبَرَاعَةِ فِي تَحْصِيلِهَا عَنْ حَدِّ الْإِكْثَارِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَاخْتِرَاعِ الْوُجُوهِ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَالْإِغْرَابِ فِي الْإِبْعَادِ عَنْ مَقَاصِدِ التَّنْزِيلِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَسْأَلُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَمَا فَهِمُوهُ وَإِنَّمَا يَسْأَلُنَا عَنْ كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ لِإِرْشَادِنَا وَهِدَايَتِنَا، وَعَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ”.
إن التوسل إلى الأهداف الكبيرة التي يرنو إليها الأستاذ كولن جعله يرتع في حياض الألفاظ و وسط دروب المعاني ليهديكإلى دلالات ومعاني قد تبدو ظاهرة في بعض الأحيان، لكن السياقات الاجتماعية قد تحول بيننا وبين كثير مما يبدو واضحا عند الأستاذ، فيجلعه هو مدبجا بمنهجه الخاص الذي يجمع فيه بين التعبير الدقيق واللفظ الرقيق والمعنى العميق. فاستمع إليه وهو يتحسر وينادي على القرآن الكريم، وكأنه يريد إقامة الحجة على الناس:
“العالم الذي لا توجد أنت فيه عالم قُصّت فيه أجنحة الإرادة. وضربت الفوضى أطنابها في عالم الأحاسيس، وتحولت فيه العواطف البشرية إلى مستنقع. أما الموازين العقلية فدون ضوابط، والمنطق مهرج والعلم حماقة. في مثل هذا العالم يكون من العبث البحث عن قيم إنسانية وينخدع كل من يركن إلى هذا البحث. لا…تعال!… تعال!… أرسل نفحة عطر من أنفاسك، وشتت جميع مقالب الشيطان وألاعيبه، ودُلّنا على طريق التوبة التي تم إرشاد آدم عليه السلام إليها”