في هذه الأيام المطلة على أيام الحبور، إذ يستنشق فجرها أنفاس العيد، نجد في الواقع نوبات مرض ومعضلات تبدو مستعصية على الحل. وإن العلل الاجتماعية وأمراض الأمة الجسيمة، والآفات الطبيعية، وما يشبه هذه الأزمات التي تستشري في جسد المجتمعات لا تعالج بتدابير يومية قصيرة الباع. فإن معالجة أزمات واسعة الآثار كهذه منوطة بشيوع البصيرة والعلم والحكمة في المجتمع. وعلى نقيض ذلك، الاشتغال بمعالجتها بسياسات المناورة اليومية التي لا غاية لها ولا أفق فيها ليس إلا هدراً للزمن. ونعلم من أمسنا ويومنا أن رجال الروح والمعنى والبصيرة قد حلّوا عُقَد أعصى المعضلات والأزمات بيسرٍ لا يستوعبه خيالنا، وذلك بسعة آفاقهم وعلو هممهم، وبتحريك قسم من مصادر قوة اليوم لحساب المستقبل. وكثيراً ما حسبنا تدابيرهم الفذة فوق قدرة البشر وأصابنا الدهش والشَّدَه منها. والواقع أن ما قاموا به هو ما يقوم به كل موفق من الرجال… ألا وهو استنفاد كل الطاقات والقدرات التي وهبها لهم الحق تعالى وبأحسن وجه مفيد.
التحرر من قيود الزمان
نعم، أولئك ينشغلون بحساب الغد مع اليوم ليل نهار، ويستعملون الإمكانات والحركيات الحاضرة أحجاراً لإنشاء الجسور الموصلة إلى الغد، ويجدون في حناجرهم غصص نَقْل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة… يبتلعون حسابات هذا النقل غصة بعد غصة، لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر، بل بالتحرر من قيود الزمان… إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل، والقدرة على تحليله وتقويمه، بالصفاء والنقاء نفسه. هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن، وفهمَ محتوى المستقبل روحاً ومعنى، يجدر أن نسَمّيه بغاية المنى والمثالية التي نتوق إليها، إذ لا يُتصور أن يتغلب من لا تتسع آفاقه هذا الاتساع على معضلات ومشاكل كهذه، ولا أن يَعِدنا بشيء ذي بال لبناء المستقبل. إن الفخامة والعظمة والحياة الصاخبة لفرعون ونمرود ونابليون وقيصر وأمثالهم لم تقدم شيئاً باسم المستقبل -مهما كبرت أعمالهم في عيون قوم يحسنون الظن بلا تمحيص- بل إن ذلك محال، لأنهم وضعوا الحق تحت إمرة القوة، وشدوا الروابط الاجتماعية حول المنافع، وقضوا أعمارهم عبيداً للنفسانية عبودية لا ترتضي عتقا.
إن العلل الاجتماعية وأمراض الأمة الجسيمة، والآفات الطبيعية، وما يشبه هذه الأزمات التي تستشري في جسد المجتمعات لا تعالج بتدابير يومية قصيرة الباع
والحال أن الذين جعلوا الأناضول وطناً -وابتداءً من الخلفاء الراشدين- خلفوا آثاراً تجتاز باعتبار نتائجها الدُّنَى لتصل إلى العقبى وتتحدى العصور، في نظر الذين لا ينخدعون بالخسوف والكسوف المؤقت. نعم، عاش هؤلاء عمراً زاخراً ثم رحلوا، ولكن لن يغادروا الصدور التي يحيون فيها بذكرى مآثرهم الجميلة. وما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني “آلب أرسلان” و”ملك شاه” و”الغازي عثمان” و”محمد الفاتح”، وتسيل الآمال والبشرى من غايات خيالهم وأملهم إلى أرواحنا.
لقد سحق القيصر حلم روما من أجل هواه ورغبته، وحبس نابليون آمال فرنسا الكبرى في شِباك أطماعه فقتلها، وافترس هتلر أحلام ألمانيا الكبرى بمغامراته فقضى عليها بالموت. لكن فكر هذه الأمة المتفتحَ على الديمومة والتمادي، والمتّصفة بطولاتُه بالتكامل والاستمرارية، بقي مصاناً من كل إسفاف، ومعززاً كراية تُفدَى بالأرواح، سواء في الانتصار أو الانقهار. محمد الفاتح فتح إسطنبول تحت تلك الراية ودَوّى صرخة في آفاق الغرب. وسليمان القانوني رحل إلى “الأبعاد” مالئاً عينيه من خفقات ذلك اللواء الوارف على سفوح الغرب. وأبطال “جناق قلعة” كتبوا بدمائهم ملحمة مثل ملحمة “بدر” باسمه، ووفّى ابن الأناضول دَيْن الوفاء الأخير له، وهو محاصَر بألف قحط وقحط، فَزَأَرَ كرة أخرى زئير قلبِ تاريخنا المجيد: “أبدية المدة!..”(1).
سمات رجل الفكر
يَبْلُغُ الفكرُ على يد رجل الفكر مقاماً فوق المقامات، ويصير سحراً للظفر بعد الظفر، وللنجاح بعد النجاح. فإن لم يكن ممثلو الفكر أهلاً لحمله، فيَبْعُد ذلك الفكر أن يكون راية، ويغدو رمزاً صغيراً يجمع حوله سفسافَ صيحاتِ المطامع الدنيئة. إن رموزاً صغيرة كهذه قد تجمع حولها أولاد الأزقة وتقودهم إلى أهداف وغايات من لُعَب. لكنها لن تروِي غليل المشاعر في أعماق أمتنا المجيدة.
إن رجل الفكر بطل للحب قبل كل شيء. فهو يحب الله حباً كحب مجنون، فيحس في ظل أجنحة الحب هذا بوشائج وثيقة تربطه مع الكائنات. فيحضن بشفقةٍ كلَّ إنسان، وكل شيء… ويضم إلى صدره وطنه وابن وطنه بحب يبلغ حد العشق… ويداعب ويشم الأطفال كبراعم للمستقبل… ويبعث في الشباب روح الاستحالة إلى إنسان مثالي، إذ يحثهم على بلوغ الغايات السامية… ويُكرم ذوي الشيبة بأخلص التوقير والاحترام… وينقب عن سبل للحوار مع الجميع… ويقارب بين شرائح المجتمع المختلفة بمدّ جسور مبتكرة فوق المهاوي السحيقة الفاصلة بينها، ويضطرم حراً من أجل الملاءمة التامة بين الشرائح المتوافقة نسبياً.
ورجل الفكر الحقيقي هو من أهل الحكمة أيضاً. فهو من وجهةٍ يستوعب كل شيء بدُنيا عقلِه المحيطة سائحاً ومستطلعاً، ومن وجهة أخرى يزن كل شيء بموازين القلب المقدِّرة حق التقدير، ويمررها عبر مقاييس المحاسبة والمراقبة، ويعجنها في معجنة المحاكمة، ويصورها، ويقارن في كل وقت بين ضياء العقل ونور القلب كفرسي رهان في المضمار.
ورجل الفكر أنموذج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه. يضحي بكل ما وهبه الله، ومن غير تلكؤ وتذبذب، في سبيل أهدافه، وأول أهدافه كسب رضاء الله… ولا يخاف ولا يخشى من شيء، ولا يهب قلبه إلا لله وحده… ولا يبالي برغب إلى السعادة، ولا بقلق من شقاء. لأنه بطل أسطوري للمعنى إلى درجة لا يأبه فيها بالاحتراق في نار جهنم، ما دام فكره ووطنه سامقاً وعاليا.
ورجل الفكر الراقي يستشعر التوقير للقيم التي وَهب لها قلبه استشعاراً عميقاً كعمق المراقبة، ويمارسه بنشوة كنشوة العبادة، ويعيش دائماً رجل عشق وحماس لا يفتران. ويعلم كيف يضحي في سبيل فكره بالنفس والحبيب، والمال والجاه، والأهل والعيال، واليوم والغد، في آن كلمح البصر ومن غير توان، ويرجح دائماً وجهة فكره السامي مع مراعاة الحق والحقيقة بتدقيقٍ يشطر الشعرة أربعين شطراً. وهو حاكم على نفسه، ومحكوم بيد الحقيقة، وغير مبالٍ بالمقام والمنصب، وخائض في كفاح مستمر في أعماق قلبه معتبرا الشهرة والطمع وحب النفس والرغب إلى الراحة وأمثال هذه الأمور سماً قاتلاً. ولذلك يفوز أبداً في ميادين الظفر، ويحول مواقع الهزيمة ساحات تدريب فني للفوز والنجاح.
وهو في سلوكه طريقَ السامقين مشدود شداً وثيقاً بموازين الحق تعالى… حتى إذا صدمته عواصف الرغبات استقوى واشتد فيه حب الحق، وإذا توجه إليه طوفان الحقد والبغض، أثار في روحه فوارات الحب والشفقة… وكم نعمةٍ يهفو إليها عامة البشر يتجاوز هو عنها ماضياً في سبيله، وكم نقمةٍ يتصدى لها بصدره. وإذ نتخيله بآفاقه الحقيقية التي تذهل العقول، يطوف أمام عيوننا أطياف العزائم النبوية، وتنهمر على أحاسيسنا صور بشر فوق البشر من وَلَجات الأبواب التي تُفَرِّجها التداعياتُ، ويفعم بيت خيالنا بالبطولات التاريخية… يطفح ويفيض، فيرتعش بوفاء وإخلاص عقبة بن نافع في صحارى أفريقيا، ويذهل لشجاعة وحماس طارق بن زياد الذي يخلف وراءه “برج هرقل”(2) أثراً بعد عين، ويتطلع دهشاً إلى عزم وإقدام محمد الفاتح، ويُقَبّل السيف الذي أبى الاستسلام في “بَلَونة”، ويسلم -تعظيماً- على أُسود “جناق قلعة” الذين استقبلوا انفلاق المدافع والقنابل فوق رؤوسهم بالبشر والسرور.
يَبْلُغُ الفكرُ على يد رجل الفكر مقاماً فوق المقامات، ويصير سحراً للظفر بعد الظفر، وللنجاح بعد النجاح. فإن لم يكن ممثلو الفكر أهلاً لحمله، فيَبْعُد ذلك الفكر أن يكون راية، ويغدو رمزاً صغيراً يجمع حوله سفسافَ صيحاتِ المطامع الدنيئة
عظماء القلب والروح
ولسنا بحاجة اليوم إلى هذا وذاك، بل إلى أمثال هؤلاء من رجال الأفق الرحيب المثاليين بشخصياتهم السامقة. وسيتحقق في السنوات القابلة انبعاث أمتنا وبناؤها من جديد على يد هؤلاء من أهل الروح والمعنى ورجال الفكر السامق. هؤلاء الشجعان الذين خميرة وجودهم هو الإيمان والعشق والحكمة والبصيرة، لم ينحنوا أبداً أمام زخم الهجمات الداخلية والخارجية على مر القرون التسعة أو العشرة الأخيرة، ولم يتزعزعوا. ربما انكمشوا شيئاً قليلاً أو ضاقوا، لكنهم اكتسبوا صلابة البنية، فتماسك قوامهم إلى درجة كافية لتصفية الحساب مع المستقبل. وهم اليوم جاهزون لاستلام “النوبة” بقوة الروح الخارقة للعادة، يتطلعون إلى العصر بأبصارهم في ترقب نشط.
نعم، في القرون الأخيرة، شهد العشق والحكمة والبصيرة وحس المسؤولية ضموراً وانكماشا، وجاءت المسائل اليومية الطفيفة لتقعد في مكان فكر “الأمة”. فلا يمكن الادعاء -بداهة- بحصول “تجديد” في هذه المرحلة. وما طرح في الساحة باسم “التجديد” في هذه المرحلة لا يتجاوز التقليد الوضيع والدبلجة. هذه النمطية التي تلبست بسببها فكرة “القومية” بلباس الفسق وتهدمت روح “الأمة” كاملة قد أضرت أكثر مما نفعت. وبينما كانت الأمة تنـزف بسبب التخريب والهدم الواقع في جسمها لم يُعرف الداء الحقيقي، ولم تُكتشف طرق المداواة، وأصابت المعالجات الخاطئة جموع الناس بالشلل. ولا زالت آثار نوبات الحمّى لمرض القرون الأخيرة تشعرنا بدوام العلة، لاستمرار فورانه الدافع “عن المركز”.
لذلك، سنقع اليوم أيضاً كما في أمسنا في خطأ بعد خطأ ونحن نبحث عن دواء، وسنصاب بنوبات أشد خطرا، وسنعجز عن الانفلات من دائرة الأزمات الفاسدة، ما لم نتبصّر في الأسباب الحقيقية للمعضلات، ولم نعالج عللنا الفردية والعائلية والاجتماعية بحذاقة الحكيم، ولم نخرج من مستنقع اللوثيات الذي نضطرب فيه منذ عصور.
ولئن أصَرّ الذين يمسكون بالعنان على عنادهم الدائم عدة قرون، فنحن نؤمن يقينا بأن أجيال الفكر المثالية المتوجهين نحو المستقبل بحسهم وفكرهم وعملهم الحركي، المحبين لرسالتهم ووطنهم وإنسانهم بدرجة العشق، المتوترين كوتر القوس في انشدادهم إلى الخدمة والشعور بالمسؤولية، ستجتاز العقبات كلها وتنشئ تكوينات جديدة. فلا بد أن يسري العشق الذي في جنباتهم وحبُّهم للخدمة، إلى شرائح مجتمعهم كلها، فتشب براعم أينما سرى. وإذ يلغي هذا الفكر الواقعَ المادي والجسماني القائم، ويطرحه جانباً، لا بد أن ينقش كرة أخرى ديباج روحه الذاتي، حسب رؤيته الخاصة إلى العالم، وببرنامج حركته الذاتي.
_______________
الهوامش
(1) يومئ المؤلف بـ”أبدية المدة” إلى معان ثرة مكنونة أو ظاهرة، ذات أبعاد عديدة. ولعلنا نفيد في إيضاح بُعد من الأبعاد إن نبهنا إلى أن دول الإسلام العظمى في التاريخ كالدولة العباسية نعتت بدوام العز والسعد إلى يوم القيامة. وكانت الدولة العثمانية تنعت بـ”الدولة العَلِيّة الأبدية المدة”. فهنا إشارة إلى هذا البُعد، زيادة على إيماءات أخرى مثل أن الأمل في النهضة لم ينفَد، وأن الدين خالد، وأن طبع الفداء لن ينقطع، ولعل النهوض يبدأ من هذه البلاد. و”جناق قلعة” موضع شهد هذه المعركة الشهيرة في التاريخ، سطر فيها الجيش العثماني ملاحم فذة ورد جيش الحلفاء على أعقابه في الحرب العالمية الأولى، وذلك كان في 18 مارس 1915. (المترجم)
(2) المقصود جبل طارق. ( المترجم)
_______________
* الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغلو.

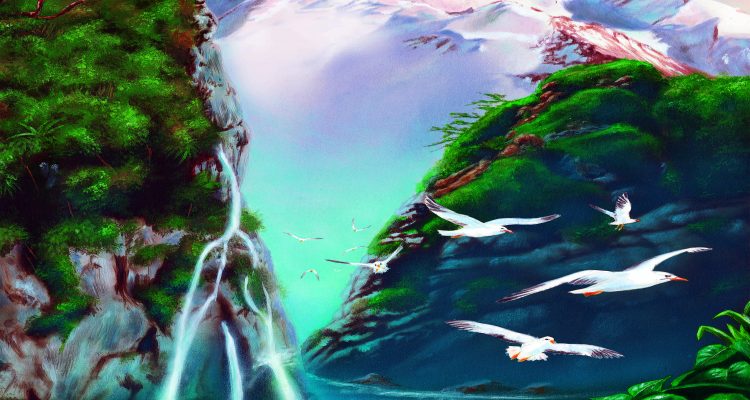
Leave a Reply