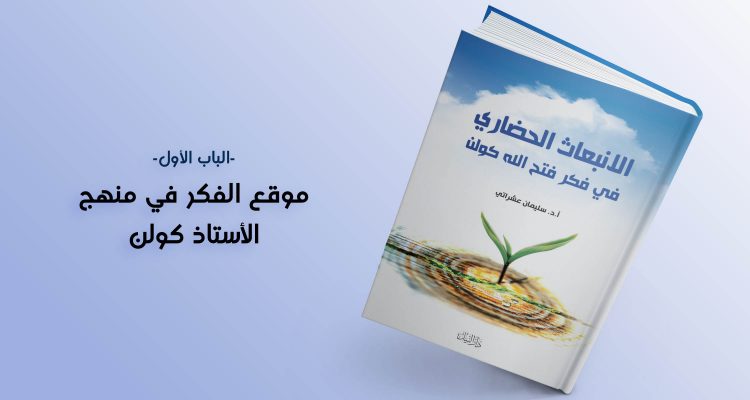امتدت شجرة الفكر الإسلامي ضمن بنية عضوية لها أصل ثابت هو القرآن والسنة، ولها فروع نمائية تتمثل في حاصل التوليدات التشريعية التي ظل يستنبطها فقهاء المدنية وعلماء الاجتماع وأرباب النظر العقلي المسلمون من خلال تَرَصُّد المستجد من القضايا الحياتية، وتمحيص القيم والنوازل، حلالها من حرامها.
الصيرورة المدنية جعلت التفكير الإسلامي يمضي في وجهات حيوية متشعبة، تحكمه الشروط التاريخية والمقومات المدنية والنزعات الروحية والمذهبية، الأمر الذي أكسب هذا التفكير “الإسلامي” هويته الثرية المتّسمة بالتعدد، إذ أضحى فكرًا أفرزته مدَنية عظيمة ازدهرت قرونا، واستوعبت روافد المعارف العالمية من خلال استقطاب وتوطين ومفاعلة الناجز العقلي والنظري في المدَنيات الأخرى، سواء منها تلك التي عاصرت مدنية الإسلام أو التي سبقتها.
لا ريب أن كونية الدين الإسلامي هي أساس هذا التفتّح الفكري الذي يميّز الاجتهاد الإسلامي، إذ إنه اجتهاد وليد شريعة جاءت لتشمل الناس كافةً، وفي مختلف أوطانهم وأعصارهم، وتغطّي مقتضيات التجدد المدَني، فلذا تأصلت فيه المرونة بقدر ما ترسّخت له روح التحوط وحفظ الضوابط والأسس.
حين نتحدث عن الفكر الإسلامي، فإننا نقصد هذا التفعيل النظري والتطبيقي الذي مارسه العقل الإسلامي في شتى مناحي المعرفة وحقولها، واستنجز وأثل محاصيل وذخائر معتبرة، شكّلت تراث الأمة ورصيدها الذي انْبنَت عليه ثقافتها، وتَشَكَّل وجدانُها. فبعد أن كانت ثقافة العرب شعرية، أضحت للأمة بحلول الإسلام وانتشاره عبر القارات، علومًا أسّس لها الدين الإسلامي، ووسّع من ألوانها وأجناسها المعرفية تعدد الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الإسلام، وانخرطت فيه انخراط انتماء وعطاء، فكان الحاصل هو هذا التراث الزاخر الذي كان ذات حين يمثل -وفي شتى المجالات- سقف المعارف والعلوم والفنون الذي بلغته البشرية، والمرجع التوثيقي المحال عليه في المعرفة الإنسانية في تلك العهود، إذ ازدهرت تلك المعارف والفنون والعلوم، بازدهار الحضارة الإسلامية نفسها.
على أن هوية هذا الفكر “الإسلامي” لا يمكن أن تنحصر في نطاق أصوله الأم (القرآن والسنة وما انبثق عنهما من تأصيلات)؛ لأن النماء الذي عرفه العقل الإسلامي عبر العهود، كان نماء ديناميا لافتا. فحتّى الدخيل (الاسرائيليات والثقافة اليونانية والهندية وغيرها) قد تماسّ مع هذا الفكر، وشكل بُعدًا من أبعاد إحالاته، ولو بِسَوْق الأمثلة والعبر. من هنا ينبغي الاعتراف بأن هوية الفكر الإسلامي تستجمع بنية متجذعة هي جداره الأصيل، وعاموده القويم، من حيث تنامت الفروع، وتكاثرت الغصون، أشبه بالشجرة، لها قائم مكين، وأدواح متكاثفة وممتدّة في مختلف الاتّجاهات.
وفيما ظل الفقه الإسلامي يمارس مهمة تمحيص ومَعْيَرَة النوازل الاجتماعية والتعاملات المدنية من وجهة نظر الشرع، حاول الفكر الإسلامي أن يتطارح التصاميم والخطاطات والحدود السقفية التي تسوغها الشريعة، وتنسجم مع المقاصد الرئيسة التي تؤطّر المسار الحضاري في مضيه عبر سيولة الأزمنة والأمكنة وتحولات الحياة.
وإذا ما أردنا أن نضع تعريفًا مبسّطا لكل من مَنْشَطَيْ الفكرِ والفقهِ، قلنا: إن الفكر هو الفاعلية الذهنية التي تستهدف فهم الحياة والوجود، واستقراء الوقائع الموصولة بالإنسان، ماضيه وحاضره ومستقبله، باعتباره (الإنسان) ماهية وجودية فردية وجمعية، مهيّأةً للتحولات والتحديات المصيرية. وإن الغاية من وراء ذلك الفهم هي بناء رؤى معرفية تسهم في ضبط الظواهر (الاجتماعية والمدنية والوجودية..)، بقصد تَهْييئ نوع من السيطرة أو الأمان للإنسان في رحلته في هذا الكون.
وبالمقابل نقول في تعريف الفقه أنه حقل مصادرة الحوادث الحياتية والأنشطة المدنية والتعاملية، ووضع الضوابط الملائمة لها من وجهة نظر شرعية الزامية.
وحتى نكون موضوعيين في هذا الصدد، علينا أن نسجّل أن منْزلة الفقه في سُلَّم المباحث والمقاربات الإسلامية قديما، قد ترجّحت ولبثت تجنّح -باطراد- نحو التفوّق والعلوّ بالقياس إلى كفّة المفكر، وتزامن ذلك مع تثاقل وتائر السير والنماء في الحضارة الإسلامية، حيث سادت عقلية الكساد والتكفّف على الحياة في كافة الحقول المادية والمعنوية.
كان الفقه يعرَّف بأنه العلم، وكاد مصطلح العلم أن يختص بالتشريع، لما بين الاجتهاد وبين مدونة الكتاب والسنة من ترابط عضوي لاحم، إذ الأصل أن لا ممارسة اجتهادية إلاّ بنصّ أو ما ينوب عنه من قياس واستحسان وما إلى ذلك.
ومثلما ترجحت مكانة الفقيه قديمًا، وتأصّلت له صدارة الفتوى والتوجيه الشرعي في العهود الإسلامية الماضية، تتميّز اليوم منزلة المفكر، ويحظي بعلو الشأن لدى الأوساط الحية، رغم الانبخاس العام الذي نراه يشمل القيم النبيلة، نتيجة ارتباط الأمم والشعوب بحضارة مهيمنة، لا تفتأ تتَوَحُّل وتغرق في حمإ سياسات التهتك والسقوط في بوائق التحلل والجشع والاستهلاكية.
إن التلاطمات الثقافية الكونية، والوهن المدني شبه العقيم الذي عليه مجتمعاتنا المسلمة، يجعلان وجدان هذه الأمة أشد ظمأ إلى التأصيل، وأكثر شوقا إلى التميز؛ لأن ضمير الأمة المؤصلة بتعاليم عقيدتها، مهما ضغطته التردياتُ، يظل دائما يصطنع، وبوازع من التأبي، ما وسعه اصطناعه من أسباب الارتباط بالجذور، إنْ على مستوى الثقافة، أو على مستوى العقيدة، أو على مستوى بقية منابع الهوية.
يلتقي اليوم المشربُ الفقهي بالمشرب الفكري، ويشكّلان مسيلا واحدًا تُستَقى منه القواعد الاسترشادية التي تكفل شرطَ التحرزِ، ومضمونية المسار، واطرادية التطوّر، وصنع التاريخ.
مفكر العصر الحاضر، عصر الرهان على التموقعات المستقبلية الحاسمة، أَكثر استيعابًا لمعطيات وقته، وأكثرُ إدراكًا لمقتضيات مرحلته، وأعمقُ وعْيًا بالمتطلّبات التي تستلزمها سلامة النهج ورشدية الحراك والتوجه.
المفكر اليوم، هو فيلسوف بأصالة الاشتغال العقلي الذي يتعاطاه.. فقيه بحتمية المراس الضمني الاجتهادي الذي يزاوله.. خبير استراتيجي بحكم الاهتمام الاستشرافي الأوكد الذي يربطه بالمستقبل والمصير.
وحين نتحدّث عن المفكر فتح الله كولن، فإننا نتحدث عن واجهة اجتهادية معاصرة، أهّلتْها مسيرتها الكدحية أن تلفت الأنظار وتستقطب الجهود بكفاءاتها النفاذية، ورهاناتها الشمولية، وعطاءاتها العملية، ومحظوظيتها الصلاحية.
في أبستمولوجيا الفكر الحركي
لا مشاحة في أن لكل مَنْشَط فكريٍّ غايةً ينشدها ووظيفية يتوخاها، أقلُّها تفسير ظاهرة ما، أو تفحص إِشكال بعينه، أو تأمل حيثية من الحيثيات الواقعية أو التصورية. فحتّى التفكير في المطلق وفي اللاّموضوع، يقصد متعاطيه إِشباع نَهَمٍ داخلي، أو إِسكات حيرة جاثمة، أو الاستعاضة عن ميوعة الواقع الحيّ بواقع آخر افتراضي تجنح الذهنيةُ إلى ارتياده، لِعِلَّةٍ من العلل، أو تحت باعث من البواعث الملحّة.
وإذا كانت شُعب الفكر قد تنوّعت مناهجها، وتعدّدت مشاربها، فلا شكّ أن هناك اتّجاهين يُعتبران أظهر الاتجاهات الْتصاقًا بالإنسان، وأشدّهما إلحاحًا عليه لطابعهما العملي المتجاوب مع ما جُبلت عليه النفوس البشرية من ذاتية ومن منازع أنانية نفعية. والاتجاهان هما الفكر البراغْماتي والفكر الدوغْماتي.
الفكر البراغماتي مثل الفكر الدوغماتي، كلاهما تسود نهجَه اندفاعةُ النعرة العارضة، وتخدع دُعاتَه الاستثارة الحشودية المنفعلة، وتسكرهم أعراض الوقفة والنجاح الموْسمي الزائل؛ إذ يشغلهم الغرور عن أن يتبصروا ويقرأوا للعاقبة حسابها، لأن ما يتولد من مناهج وسياسات تفرزها رؤى استئثارية مسعورة، وتراهات استعلائية رعناء، وفلسفات مجرّدة من الأخلاق الكريمة، لا يمكن أن يدوم؛ إذ ما أن تزايل رعيلَ الروادِ فورةُ الحماس، حتى يستتب الفتورُ وتعمّ الرتابة والتسيّب المفضي حتما إلى العقم والبؤس المعنوي، وتنطفئ الحمية.
البراغْماتية تحكمها عقليةُ النُّهْزةٍ، وروحُ الظفر المتعجل، والمقاصد الاستئثارية. البراغماتية -في العصر الحديث- وليدة المكْيافيلية، ومجالها ليس الحقل السياسي فحسب، وإنما تشمل الأخلاق والأواصر والقيم عامّة. إن المكيافيلية شجرة شؤم، أنبتت غابة كاملة من المناهج الذرائعية والمعارف المعاكسة للمنطق السوي والحسّ السليم.
وبدورها الدوغمائية تعني الانسياق الأعمى وراء الفكرة الجاهزة، والخطّ المرسوم، والإذعان للأمر الفوقي. إنها تقوم على خطة تفريغ عقل الفرد من دينامية النظر، وتجريده من الحق في التقدير والاختيار؛ لأن العقل حين يعلق في شَرَك الدوغْمائية، يجد نفسه يقف موقف المتلقّي المنصاع، المنتظر للتعليمات.
هناك بافْلوفيّة تشرط الحراك الدوغْمائي، فللمثير استجابة، وللاستجابة باعث، والحركة والسكون يضبطهما النظام المسيِّر، والجموع من ثمة مستلبة، لا رأي لها إلا ما يرى الفرعون المتربب، وإلا ما تقرّره مشيئته وحساباته وأنانيته، وبذلك تدخل الحياة في الدائرة المغلقة، حيث لا تجدُّد هناك، ولا إبداع، ولا مسؤولية، بل التراجع والسلبية والموات.
في ظل الدوغمائية يوجَدُ مصدرٌ أعلى للشحن والتعبئة، يُنزله الدوغمائي منزلة القداسة، ينقاد لتعليماته التي هي ذاتها من طبيعة سريعة التلف والاستهلاك ولا أفق متجدد أمامها، ينفذها الفرد المنخرط (أو المحتوى) بحرفية، أي بآلية اتباعية، إذ الفكر حين يتأدْلج يضحى أداءات متكلّسة، هي قوالب جوفاء أكثر منها تربة تنبت الزرع، وهو طوابع تنمط الرؤية أكثر منها روحا تحرر الذهن والإرادة، وتعاليم تجمّد المواهب أكثر منها دافعية تنشط الملكات، وتحفّز على الإبداع.
وإذا كانت الدوغْمائية تعني الخضوع الصارم للأمرية التنظيمية -حزبًا، أو سلطةً، أو معتقدًا فلسفيًّا-، فإن البراغماتية -حين تتحلل من الضابط الأخلاقي- سرعان ما تتخطى نطاق التزامها التحرّري (دعه يعمل، دعه يمر)، لتتحول -هي الأخرى- إلى آلية عمياء لاصطناع الفرص، وتصيد النهز، والرهان على المصلحة وحدها، وتحقيقها بكل الوسائل. فمنطق الحياة بالنسبة للبراغْماتية يقوم على فكر التوسع في الهيمنة والاحتياز، وهو ما أسّس للرأسمالية الغربية، إذ أفضى بها التوحش، إلى حدٍّ باتت معه تخبط إلى الكسب خبط عشواء، فلا يسلم من ضراوتها مجتمع.
الفكر الإيماني
يقابل الدوغمائية والبراغماتية، فكر ثالث، هو الفكر الإيماني؛ لأنّ الإيمان يقتضي اليقين، أي الاعتقاد بالْماوراء (لا بالسلطة الماثلة عيانا)، ثم الالتزام والمسؤولية، فهو -من ثمة- تواثُق وانخراط إراديّان كذلك، لكن من غير مقصدية كسبية أو اعتبارية، إلا الثواب عند الله.
والفكر الإيماني اتباعي بالضرورة، لأن النهر لا ينقطع عن مَنابعه. وإن خطورة الاتباع واقعة لا محالة متى انْحبس الفكر في الماضويّة بالصورة الشكلية والحدود الوضعية (الاجتهادية) التي رست عليها.
يغدو الفكر الإيماني فكرًا منغلقا، سلبيًّا، حين يقتصر على التواصل المجّاني مع وديعة الأسلاف وآثارهم، دون الخروج عن ذلك المستوى العاطفي، أو تجاوزه من حيث الفهم والتفعيل.
وإن أكثر ما نرى عليه علاقتنا بالتراث، ليندرج ضمن هذا النوع من الفكر الانكفائي، إذ لا تكاد هذه العلاقة تخرج عن حد الإعجاب والتغنّي بمنجزاته، دونما إِعمالٍ للتمحيص، أو توسيعٍ لدائرة التمثّل والتعمق والتوظيف الفعال؛ فتضحى -من ثمة- العلاقة بالأثر سلبية، خالية من أي تثمير مفيد، إذ إن انحيازنا للتراث على ذلك النحو، لا يستند إلى معرفة حقيقية به، بل عن مجرد ادّعاء وتمويه وتغطية عن الجهل. فما أشبهنا -والحال تلك- بالدلاّل، همُّه أن يبيع البزة، ويأخذ حقّه من ثمنها.
ويكون الفكر الإيماني متفتحا، فعالا، حين يغدو نشاطا يستوعب إلى جانب ذخائر الأمّة وتراثها الروحي والعقلي، جماعَ منجزاتِ وفلسفاتِ وتاريخيةِ المعرفة البشرية، ويعي أطوار ومسار المدَنيات والديانات في مُضِيِّها بالإنسان، وطيّها الأشواط والأدوار التاريحية المتعاقبة.. فيتغذّى (الفكر) بكل ذلك، ويهضمه، وينمّي منه رؤية حيوية تتحرك في اتّجاه تعزيز الهوية، وتطوير قابليلتها وجهوزيتها.
والفكر الإيماني المتفتح لا يقتصر على هذا البعد الاستخصابي الذي يجنيه العقل نتيجة التفاعل الإيجابي مع مدود الثقافات والمعارف الكونية التي يتبادل معها التجاذبات، بل إنه يكتسب النجاعة حين يكيف قواه على هضم تلك المدود، وتأصيلها وإدماجها في حقول معارفه، لأجل توسيع أرضية أصالته، وتنويع مغارسها، وتسليح الروح والاجتهاد والرؤية بها، وتحقيق الإقلاع وإعادة الدينامية للمحركات العاطلة أو المعاقة نتيجة التردّي الشنيع والقعود المزمن عن الدور الحضاري.
الفلسفة الفكرية لدى كُولن
يَمَّمَ الفكرُ الإيماني في دعوة فتح الله كولن وجهَهُ صراحةً نحو الحياة والواقع والمدنية، محدثًا قطيعة باتَّة مع الفكر البالي الذي كرّسته ذهنية الاستقالة التي أقامت الهوة السحيقة بين المسلمين والحياة، حين انحرفت تلك الذهنية بهم عن جادة التعمير، وجعلتهم يستكينون لروح استسلامية دخيلة عن الإسلام.
ينْبع واجب الدعوة إلى الله، في منهج كولن، من منظور واقعي، موضوعي، تجديدي، لا غبار عليه؛ إذ يتكيف مع شروط الحداثة الفكرية، ومكاسب التطور التكنولوجي، وبيداغوجية التفاعل الأممي المعاصر.. لذلك هو يعتمد على خطة الانتشار في الأرض، وتعريف الآخرين بالإسلام، من خلال بثّ ألوان العون والاستثمار والتحسيس. فالتوسّع في الدعوة والتبليغ هو أوّلاً وقبل كل شيء توسّع في البناء الْمَرافقي والترقّي المادي الملموس الذي به تتحقق قيم الإسلام الروحية ومثله المعنوية، وتظهر آثارها الإحسانية المزكّاة على الأرض نتائج يلمسها الناس، ويستفيدون منها، فيقعون من ثمة في عشق الإسلام، والانخراط في جغرافيته.
إنها منهجية تستلهم روح السيرة النبوية، إذ إن الرسول r كافح حتى النفَس الأخير من أجل إرساء عقيدة البناء، وترسيخ القدم في الأرض، وتعزيز الموقع: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ، فَلْيَغْرِسْهَا»؛ وتجسيد شعار القرآن: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾(مُحَمَّد:7)؛ وممارسة فعل التجدّد: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾(الرَّعْد:12).. إنها فلسفة حياتية تطبق اللاّزمة القرآنية الأبرز التي طفقت على مدار سور المصحف، تنوّه بأهل الفوز: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
تفكير كولن ينسجم مع النظرة الشرعية المقرة للإنسان بمسؤوليته في هذا الوجود، إنه فكر يتخطى إشكالية “الجبر والخيار” التي طالما شغلت القدامى وبلبلتهم، فلبثوا يدورون في الحلقة المفرغة.
لقد اعتمد المفكر كُولَن نظرية المسؤولية التي أقرتْ للإنسان، ليس فقط مساحة من الحرية على صعيد تصريف أفعاله، وتحديد خياراته، ولكنها أسهمته أيضا في تدبير تاريخية هذا الكون، باعتباره خليفة الله في الأرض: “يمكن حمل الخلافة المهداة من الله تعالى للإنسان، على أساس أن الله أعطى الإنسان حقّ التدخل بنسبة ما، وبمقياس ما، في جميع مناحي الوجود والحوادث”.
ولقد تحدد -بظهور الإسلام- إطار المسؤولية الأخلاقية الكونية التي أناطها الحق بأهل الإسلام، إذ جعلهم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من الوعي بهذا الإلزام الريادي الشرعي، يبني الأستاذ كولن نظرته إلى المستقبل، ويرسي أسس فكر شمولي، وقواعد تصور نهضوي، تؤول فيه المقادة إلى أمّة تؤهلها عقيدتها الكونية بالضرورة لأن تكون حكَمًا وإِمامًا على العالمين.
فالفكر الإيماني عند كولن ليس نشاطًا نظريًّا تمحكيا، ولا هو استغراق تمرسي بالميتافيزيق البحت المنقطع عن الحياة، وإنما الفكر عنده هو استصلاح عملي، وتخطيط حضاري شمولي، واستشراف تمثلي مستقبلي. الفكر والعمل عنده وجهان لعملة واحدة، وقاعدة النهضة تنطلق في فلسفته من تجنيد الروح وربطها جذريا بمبادئ الشريعة؛ إذ المرامي الأساسية هي بناء الإنسان الحرّ المسؤول، ومن خلال الإنسان بناء المدنية التي تعيد للإسلام والإنسان عزّته، وتفتح في وجه البشَرية آفاق التفاهم والتعاضد باعتبارهم عباد الله جميعا.
إن مبدأ خيرية الأمة في فكر كولن، مبدأ مُعَلَّقٌ (مشروط) وله مقتضيات، إذ لا تحوزه الأمّة ما لم يتحول فيها هذا الوصف الربّاني إلى سجيّة دينامية فارزة، وذلك بأن يكون مقرونًا بمقتضياته من الأهلية والجدارة، فلا خيرية لأمة عاجزة وقاصرة عن النهوض بشرف التكليف الإلهي حيال الكون والعالمين.
من هنا كان التمرّس بالواقع، والعمل على تنفيذ البرامج النهضوية والمخططات المدنية، لاسيما في المرحلة الراهنة، هو التجسيد العمَلي لصفة الخيرية التي وسم الخالق بها أمة الإسلام. ومن هنا أيضا قام الاجتهاد عند كولن على تقديم البعد الخدمي في الدعوة، وجعْله مظهرًا من مظاهر خلوص الإيمان، وعنوانًا من عناوين إثبات اليقين.
إن الفكر عند كولن شرطٌ وجوديّ وإيماني، مِحكُّه ومصداقيته هي النفاذُ في الواقع، والتوسع في بذل الخيرات، والإثمار الملموس في الإنسان ومن خلاله.
وليس المفكر -بحسب كولن- مَن استلبته التيارات الوافدة، وتَيَّهَتْهُ الفرضياتُ العقيمة المنقطعة عن الواقع، والمشيحة عن أن ترى تفسخات هذا الواقع فتبحث لها عن العلاج؛ إنما المفكّر مَن شق نهجه مؤطرا بالدين، وملتزمًا بمنهج الإيمان، ومتسلحا برؤية تخدم الإنسانية. فهذا المفكّر -لا محالة- سيجد جهوده تؤتي أكلها مهما شط المسار. فدائرة المسؤولية الإنسانية ترفض أن يكون الفكر فيها مواقف صورية، أو شعارات طوباويّة يُشهرها الإنسان أو يرفعها في المناسباتِ، واجهةً دعائية لا غير، بل إنها (دائرة المسؤولية) تجعل الفكر مبدءًا تنفيذيًّا، وجهدا ناجزا، وذا مردودية تعود بالخير على المجتمعات والبشرية عامة؛ إذ لا يثمر الفكر، ولا تتحقق الفكرة وتترشّد، إلا ضمن سياق تطبيقي تغدو بها الفرضيةُ أو الْمَثل، اعتقادًا، فخيارًا، ففعْلاً ناجزا، ولا أهمّية أو قيمة اعتبارية لفكر هلامي لا يتجسّد في الواقع الحياتي، ولا يطوّر المجتمع نحو الأصلح.
الدين ومخاطر الوقوع في الفكر الدوغْمائي
يغدو الدين دوغمائيّة متى تورّطت مبادئُه ومثلُه في العرقية والتعصب الفئويّ والفكري، وفي الانغلاق العقدي والانعزال الْجِيُوبوليتي.. ولا يُبَرِّئُ الدينَ -أيّ دين- من مطعن الدوغمائية إلا نزاهة تعاليمه، وتساميه إلى الآفاق التي تجعل من مبادئه قيَما تخصّ الإنسانية قاطبة، وتحض على الأخوّة والتعاون ونبذ المفاسد.
إن الدين الذي لا يشرع جناحيه ليضمّ البشرية كلها، وينظر إليها على أساس وحدة الجنس -الآدمية- ووحدة الربّ والمنطلق والمصير، هو دين قوميّ منغلق، انعزالي. فهو من ثمة يمثّل أكمل صور الدوغمائية، لأن منظومة المبادئ حين ينحصر نطاقها قوميًّا ومجتمعيا، تغدو أيديولوجية أو وعاءً لبناء الأيديولوحية؛ إذ يغدو من أول أولياتها تضخيم الاعتبار القومي حصرًا، وهو ما يترتّب عنه التمايز والتنابذ، لأن ثقافة العنجهية والاعتداد بالذاتية العرقية التي تنشأ عليها الأيديولوجيات (العقائد القومية) توطّد لدى أصحابها قاعدة الكيل بمكيالين، وبذلك تخرج روحيتها عن نطاق الإنسانية، إلى نطاق ضرب الإنسانية والاستهتار بقداسة الجنس الآدمي المكرَّم.
لقد انهدرت مبادئ الإخاء الإنساني نتيجة تغليب الأيديولوجيات في العلاقات بين البشَر. فسيادة الأيديولوجيات تتنافى مع مسطرة المساواة التي تقتضيها الروح الإنسانية، إذ يترتّب عن الأيديولوجيات شتّى الانحرافات والتعارضات التي تقضي على عوامل الترابط والتواشج التي تنادي بها الديانات السماوية (الحقّ).
إن العقيدة التي تمجد العرق والسلالة والقومية على حساب الجنس والآدمية، عقيدة تفتئت على الله رب العالمين، وتزرع بذور التنابذ بين الأقوام، وتصادر الطريق إلى الله.
طريقتان متعارضتان يسلكهما كل من الدين السماوي والدين المؤدلج، الأول: يضع في الاعتبار الإنسانية والكائنات قاطبة، لأن مصدر الإيمان فيه ربوبية تشمل برحمتها العالمين جميعا. والثاني: يضع في الاعتبار الشأن القومي والسلالة العرقية، الأمر الذي يتقزم معه مفهوم الربوبية ذاته، إذ يغدو الربّ ربًّا للعرق وحدهم دون سواهم، رب ينبذ بقية ما خلقت يداه.
والمؤكّد أن الدين مكون روحي وقيمي أُمٌّ، تفتح الأجيالُ عيونها عليه، فتنساق في التطبع به والتكيّف عليه. بهذه الاحتوائية التي للدين يكون (الدين) أرسخ المقوّمات التي تواجه الإنسان مهما كانت علاقته بالعقيدة، إذ حتّى الذي يقضي حياته جاحدا، يظلّ يحمل في مواجده آثار البيئة العقدية التي ولد فيها وشبّ عليها، ذلك لأن الدين مفاعل قيمي وروحي يؤثر على النفس، ويفتح الحوار باكرا معها بكيفية أو أخرى، وهو ما يهيّئ الفرد للاستجابة، لاسيما إذا كان ذا استعداد وجْداني، فيضحى حرصه -من ثمة- مركزًا على تحقيق التطابق مع شرائط الدين والانضباط مع قواعده، الأمر الذي يجعل من المتدين المثالي كائنا (مستلبا) بالدين، “فانيًا” فيه، ما لم يكن له بصيرة يقظة تقوّي صلته بالحياة وبمقاصد الوجود والمابعد.
وبما أن الديانات تتعدد في هذا الكون، وبما أنّها شكّلت منذ القديم مجالاً حيويا لتفعيل القيم وقولبة المعايير، فإنه لأمر طبيعيّ أن نجد من هذه الديانات ما هو أصيل، مصون بالحرفية التي أنزل عليها، شأن الإسلام، الدين الحق، الذي حاز شرط المصونية.. ونجد منها ما هو محور، محرف، تعترف حتى بعض نصوصه بما طرأ على نصوصه من تزوير.
بين الدين والأيديولوجية
تُرى فيمَ تختلف الأيديولوجية بمظهرها السياسي عن الدين الحق؟ وهل الإنسان المتديّن إنسان متأدلج بالفعل؟
قلنا إن الأيديولوجية تتميز بالصبغة الاعتدادية، وبالمخصوصية العرقية، والوطنية، والفكرية؛ أمّا الدين الحق فإنه شمولي الروحية، يتعالى عن المخصوصية، إذ ينفتح على العالمية، فهو إنساني بتطبيقاته واجتهاداته، من هنا يضحى الفرد المتدين (بالدين الحق) فردًا إنسانيًّا في روحه وأخلاقه وقناعاته، وإذا لم يستطع أن يبلغ هذا المستوى من التسامي، ظلّ تديّنه صوريًّا، ناقصًا. من هنا وجدنا المتديّن بدين الإسلام كائنًا إنسانيًّا بالقوّة والفعل، ليس لأنه ينيط وجدانه بحبّ الأمّة فحسب، (مفهوم الأمة في الإسلام مفهوم استيعابيّ يتّسع للأقوام والأمم والجماعات، بغضّ النظر عن أعرافها وسلالاتها وألوانها وألسنتها)، ولكن لأنه يستوعب بإيمانه باقي الديانات التي توحّد الإله (المطلق) ربّ العالمين، بل ويشفق حتى على عبَدة الوثنيات، كما تذهب إليه بعض الاجتهادات الإسلامية.
لقد تميّز الإسلام بطابعه الأممي، حيث لا يقصر الله U ربوبيته على عرق مخصوص، وحيث إن المخاطَب في الإسلام هو الإنسان مطلقًا ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾(الانْفِطَار:6-8)؛ وحيث إنّ سمة “مسلم” تطلق -في الحقيقة القرآنية- على كلّ مَن يتّبع نهج التوحيد الذي شقّ طريقه أبو الأنبياء إبراهيم u، وتَوّجه خاتمُ المصطفين محمد r. لذا كان -وسيكون- الإسلام بالنسبة للبشَرية هو الدين الأرحب الذي سيظلّ مفتوحا في وجه الأمم بسماحته وأصالة ضوابطه؛ ولذا أيضا كانت الدعوة والتبليغ من واجبات المسلم مهما كان مستواه، ينهض بها ما وجد إلى ذلك سبيلاً، لا لأجل تحقيق مطمح عرقي، أو مأرب كسبي، أو مقصد اعتباري، وإنما رحمة للعالمين ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾(الأنبياء:107)، فالمخاطب هنا هو النبي r وهو -بالتبعية الإيمانية- كلّ فرد من أمّته تَمثَّلَ العقيدةَ، وبلَغ درجة الإحسان.
العقيدة الأيديولوجية تعتمد مدوّنة ترجح الكيانات والخصوصيات الفئويّة المغلقة، وتعطيها الأولوية على ما سواها، بينما المدونة الدينية القدسية تضع الإنسان -مطلقا- في صدارة توجهاتها، وتحدد مشروطية إنسانيته على صعيدَين اثنين.
الصعيد الأول: إرساء علاقة العبودية مع الله رب العالمين، الأمر الذي يرسخ حرية الإنسان وعدم خضوعه لأيّ قوة أخرى في الكون مادية ومعنوية، إلا قوّة الله، فهو الموجد والرازق والمحيي والمميت Y.
الصعيد الثاني: تأكيد المآل الأخروي للمخلوق البشَري، الأمر الذي يجعل الإنسان يعيش الدنيا بوصاية أخلاقية حيال الكون، ومن غير ما تهافت أو تهتك، إلا إذا زاغ وضلّ واعتبر تجربة الوجود تجربة عبث لا طائل من ورائها. فبالإيمان يستشعر الإنسان أنه مسافر، وأنه لا محالة سيعود إلى موطنه، فهو -من ثمة- أحرص على أن يرجع غانِمًا.
إنّ مِن شأن إرساء هذه الروحية الأخروية في الضمير الإنساني، أن يجعل الإنسان يعيش الحياة بفكر مسؤول وروح محتسبة، وهذا من خلال إيقانه من أنّ رحلته الدنيوية هي مجرّد مقدمة لاستقرار أبَدي، مصيري، يتلقى فيه الجزاء عما قدّم من عمل (صالح أو غير صالح).
ومن الواضح أن كِلا المدوّنتين الأيديولوجية، والدينية (الحقّ)، تُحَكِّم سلطانَها في الأتباع؛ إذ الصبغة المرجعية لمضامينهما التوجيهية تجعل الأتباع في موقف مَن يجسّد الإلزامات لا مَن يتصرف فيها، وإن فوقية التعاليم توجب عليهم التسليم والتقيد بالحدود.
على أن الفارق الجوهري هو أن المدونة الأيديولوجية تشرطها الرؤية القيمية المنغلقة، فتظلّ معاقة عن التفتّح على الآخرين. فهذه الرؤية حتى لو حاولت أن تتطور في اتّجاه إنساني سمح، فستظل عرضة للتفكك، لأن كل مسعى يهدف إلى التخفف من الصبغة الأصولية يغدو علّة انشقاق بين الأتباع، ينتهي بالمجددين إما بالخروج عن مبادئ الأيديولوجية، وإما بالتكمّش والبقاء في شكل مجاميع محصورة المساحة، لا تأثير لها، ومصيرها مجهول.
لكن الأمر مع العقيدة الدينية الحق (الإسلام) يختلف، إذ سواء أثبت الأتباع في عقيدتهم على حرفيه النصوص والْتزموا بصميم أصوليتها (تشددوا)، أم توسّعوا في استقرائها -إيجابيًّا- واجتهدوا في استنطاقها تيسيرا وتسهيلا، فإن الناتج في الأحوال جميعًا واحد، إذ إن مبادئ العقيدة الإسلامية مبادئ إنسانية، ومُثله مُثلٌ تكريمية، الآدمي بمقتضاها مشرّف من قِبَل الله، مستخلف في الكون، يستمدّ قوته من قوة الله خالق الخلق، ومسطرة الجزاء والعقاب تسري على الآدميين جميعا بمنطق واحد ومعيار مشترك.
الخلاف بين المتشدد في الإسلام والمُتسَهِّل، ليس حول مبدإ الانتماء إلى العبودية لله (فالرّب رب العالمين)، إنما الخلاف حول مستوى ودرجة الالتزام بمبادئ شرع الله. وإن الدعوات التكفيرية هي تطرّف لا يعبّر عن جوهر الآية ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(الكَافِرون:6).
وعلى العكس من ذلك فإن الْمُوسَويّة تمنع الانتماء التعبّدي مبدءا، فلا يحقّ استيفاء مقام التهوّد إلا لمن استوفى شرط العرقية (يهوديّة الأم)، لأن وراء المعطى الديني شرطا أيديولوجيًّا، عنصريًّا، وبذلك تختلّ المعادلة ويضيع البعد الإنساني فيها.
إن الأيديولوجية توجّه النظر والوجدان نحو أهداف السلالة والحزب والعُصبة، وتربط الحشود بمنحى فكري أصم، وتُفعِّل ضميرهم نحو إكبار الذات الجمعية، بعد أن تضفي على تلك الذات صفات الامتياز والمخصوصية، بينما العقيدة الحق توجّه الروح والقلب والضمير نحو تعظيم الله خالق الخلق والأكوان، وتغرس في الأتباع مبدأ تلازم واجب تعظيم الخالق مع وجوب تعظيم خلقه وإيلاء الرحمة والرأفة لمخلوقاته كافة.
وقد تأخذ الأيديولوجية صبغة استغلالية شمولية، فتدين بمنطق القوّة والهيمنة والانتهازية، وهو ما تجترحه العولمة في ثوبها الغربي الأصولي (الكتابي المحافظ).
ولقد استفاض الأستاذ كولن في استقصاء الفوارق التي تميز الدين الإسلامي وتفرده عن الأيديولوجيات الدنيوية، وسجّل مواطن الاختلاف بينهما في كثير من مكتوباته كما سنعرض لذلك بعد قليل.
إن مقاصد الأيديولوجية -في التحليل الأخير- هي مقاصد دنيوية نفعية، تمايزية. إنها ترجّح العاجلة على الآجلة، والحصريّ على الشمولي، فيما مقاصد القرآن أخروية، احتسابيّة، شمولية، فالعمل الصالح في الحياة يكفل سعادتي الدنيا والآخرة.. ولا أهمّية لمكاسب الحياة إلا على قدر ما تُجَسِّدُ من مصْداقية الإيمان بالله والعمل الصالح الذي يستهدف المخلوقات جميعًا، ولا يميّز بين العباد، ذلك لأن رؤية المسلم للحياة رؤية موصولة بالآخرة وبالغيب والمابعد، من هنا كانت واقعة الوجود بالنسبة للمسلم مسترسلة، أبَدية، تبدأ بالحياة الدنيا، دار العمل، وتنتهي بالدار الآخرة، دار الحصاد.
البعد الأخروي بُعد فاصل وفارق بين المدوّنتَين الأيديولوجية والقرآنية، وإذا كان لفظ “الآخرة” قد تكرر في النص القرآني بصورة ضافية، فهو شبه غائب في أسفار العهد القديم.
الأيديولوجية تحتسب المكاسب الدنيوية، فهي تقيس نجاحاتها بما يتحقق لها في مضمار الرأسمال والنفوذ والهيمنة في الأرض (السلطان الأرضي).
العقيدة القرآنية تحتسب نجاحاتها بمقدار ما ترصده للآخرة من ثواب، دون أن تتهاون أو تفرط في مكاسب الدنيا من الحظوظ الحلال (وإخلالها بهذا الشرط سبب لها الحطة والضعف والتقهقر الذي نعيش نتائجه اليوم)؛ إذ إن الاستثمار للآخرة يتحقّق بالكدح الدنيويّ، ولا غرابة أن يقرن القرآن الإيمان بالعمل الصالح في لازمة مركزية من لوازم النص القرآني: ﴿اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
وإن الإيمان الذي يعْنيه القرآن هو الإيمان بالربّ خالق الأكوان (الربّ الذي لا حاجب دونه، ولا حاجر، ولا وصيّ). وكذلك يعني بـ”العمل الصالح” كلّ جهد تتحقق به مأمورية الاستخلاف في الأرض، أي مسؤولية الإنسان حيال أخيه الإنسان وحيال الموجودات طرا، إذ حتى البيئة وما يعمرها من عوالم حيّة، يجب أن تشملها مسؤولية الإنسان، متى ما سما إلى مطمح تَبَوُّء مكانة الاستخلاف في الأرض.
مقومات فكر كولن
ثلاث مصادر تؤسّس لفكر الأستاذ كولن:
1-القرآن والسنة وما يستتبعهما من سيرة السلف الصالح، بما في ذلك الزاد الصوفي.
2-الرافد المعرفي الكوني والثقافة العالمية المعاصرة.
3-التاريخ ومسار الحضارات وأطوار المدنيات.
من الواضح أن المصدر الأول يوطّد في مواجد الفرد وشخصيته روح الإيمان وفلسفة التوحيد، إذ القرآن (الكتاب الجامع)، لا ينفك يشدد على مسألة التوحيد، ويؤكد مبدئيتها، ويجعل منها الثابت المركزي في متونه، إذ الإيمان بالله الواحد الأحد يرسخ في النفس منطق وحدة الغيب والشهود، ذلك أن الإنسان إذا ما قدَّر نِعم هذا الكون (المشهود)، أحسن حمدها واستثمارها، وآمن -ضرورةً- بكمال وعظمة موجد هذا الكون المتكامل؛ فإذا آمن بالموجد غير المرئي، أيقن -لا محالة- بأن هناك الْمابَعد، واكتسب من ثمة روح الاحتساب ومراقبة الذات، الأمر الذي يهيّئه بامتياز لأن يعيش إنسانيته على أرفع مستوى من التجرّد والعطاء والنزاهة.
ومن شأن الزاد الصوفي -ضمن حدود الرافد الأول لفكر الأستاذ كولن- أن يُرَقِّيَ في الروح قدرةَ استشراف آفاق الماوراء التي كرّستها النصوص القدسية؛ إذ إن التمرّس بنهج التصوف تمرسٌ بالمعرفة فوق العقلية، فلكأن حقل التصوف يشكّل المضمار الوجداني الأمثل لتقمص مبادئ التوحيد وأبعادها الغيبية. ذلك لأن التصوف -في تعريف أصحابه- هو سلوك التجرّد والترقّي الروحي، وصولاً إلى الصفاء والكمال، وإذنْ فإن التصوف موصول في جوهره بروح الإيمان، إذ ركيزة الإيمان هي التوحيد والإقرار للخالق بالقدرة والمطلقيّة.
وأما الرافد الكوني والثقافة العالمية المعاصرة، فيمكن القول إن الطبيعة التجريبية التي تميّز هذا الرافد قد عززت في رؤية الأستاذ جانب النظر العملي إلى الأشياء والمعطيات الحسية.
على أن الأستاذ كولن قد كيّفَ في عقله قابلية هضم وتمَثُّل وتأصيل المعارف الكونية، بحيث باتت المعطياتُ والنتائج التي يستمدّها من هذا الرافد، تصاغ على نحو إيماني، تزايلها معه شوائب التوحّش التي تكون تغذّت عليها من تربة الإلحاد التي استنبتَتْها.
ولقد أفاد الأستاذ كولن -جراء ملابسته هذه الثقافة المادّية المعاصرة- من الجانب الإجرائي، التنفيذي، الذي يميّزها، إذ إن ما ورثته العقلية المسلمة عن قرون التخلف والاحتباس، هو ركود الفكر ورسوف التفكير في دائرة مغلقة لا تكاد تخرج عن نطاق حقول تداولية، تعبّدية، ترقيعية؛ وهو ما وطد انقطاع العقل المسلم منذ الباكر، عن نهج التجريب والبحث التطبيقي ومعالجة المجالات الحيوية المرتبطة بالحياة والإنتاج والتجهز والتجدد.
إن هذا الطابع الخصيب هو ما يميّز ثقافة الأستاذ كولن التي انفتحت على علوم العصر بشطرَيها العلْمي والأدبي، فلذا كانت عُدَّة التفكير لدَيه مكْتملة في آلياتها، متوازنة في تسديدها، ونافذة في توجهاتها.
والمؤكد أن ما يَسّر على فكر الأستاذ كولن أن يُطَوِّعَ الناجزَ المعرفي والعلمي الذي توفّره الثقافة الكونية المعاصرة، هو هضمُه لتراث السلَف، وتمرسُه بروح العقيدة الإسلامية (عبادةً وتفلسفًا)، وفهمُه للقرآن والسنة، وتناغمُ مواجده مع كنوزهما، لاسيما على صعيد الاسترشاد العقلي والترقي القلبي.
إن الهوية الفكرية للأستاذ كولن جمعت إلى السمة الروحية الوجدانية، السمة المنطقية الإجرائية؛ من هنا جاء التوليف متوازنًا، والتركيب شموليًّا، وجاءت النظرة جامعةً، لا تعتدُّ ببعد على حساب بقية الأبعاد في تقويمها للأشياء وتقديرها للأحداث والمعطيات، ولا تستبقي محاصيل النظر والفكر في حالة إرجاء، معطلة، وبعيدة عن مناطاتها العملية والتنفيذية المثمرة.
التراث الإسلامي وأصالة الاقتراب العقلي
لا ريب أن المقاربة العقلانية أسست للدرس المعرفي الإسلامي في مراحل نشأته وتطوره الأولى، وطبعتْه على نطاق جلي ومُؤصَّل؛ فالشريعة الإسلامية بما هي عقيدة روحية اقتضت أن يكون السبيل إليها سبيل الإقرار القلبي، معززا بالإقرار الإثباتي. ولعلّ الطابع التمحيصي الذي انبنى عليه منهج التأويل في حقل التفسير، واعتمدته إجرائية العدل والتجريح في قراءة الحديث النبوي الشريف مثلاً، هو أحد الشواهد على مدى ارتكاز الفكر الإسلامي في مرحلة التأسيس على مبادئ المنطق والعقلنة.
إن شجرة العلوم التي نمت في تربة الحضارة الإسلامية، قد استندت في شتى مغارسها المعرفية على العقل. على أن نهج الرواية والنقل قد شكّل أيضًا مظهرًا آخر من مظاهر الاستيثاق التي اعتمدتها الثقافة الإسلامية في تفاعلها مع المنحى الميتافيزيقي الجلي في منظومة المعارف الإسلامية، لكن الاستفاضة وعدم التحوط في التعويل على هذا النهج (الرواية والنقل)، قد نتجت عنه تسربات أساءت إلى العقيدة، وشوشت على روح الاعتقاد المبرء من الدلس؛ إذ فتح باب ترجيح الظن والتخيل، بل والتوهم في مجالات البحث والمقاربة المعرفية، وهو ما حاد بالرؤية عن جادة السداد العقلي، بحيث صارت المحاصيل في أغلبها مدوناتٍ انكفائية، انسدّت أمامها آفاق الإبداع.
ولقد نشأ التصوف وسعى إلى أن يكفل للبيئة المعرفية الإسلامية انبعاثًا تجدديًّا، غير أنه هو أيضا فشل ولوّثته روح الخرافة التي وقع فيها، لاسيما بعد أن أضحى يُشكِّل المعين الرئيسي للثقافة الشعبية ومصدر قيمها، ومادة التداول لتمثلاتها، فجرفت ذهنيتُهُ البِدْعِية مساحةً واسعة من مكاسب العقلنة التي تأصلت للفكر الإسلامي على مدى قرون من الازدهار (الثلاث قرون الأولى).
ولقد ظهرت محاولات استنقاذٍ عقلي قادَها أعلامٌ منهم ابن رشد وآخرون، إلا أنّهم استرفدوا لمشروعهم التجديدي متون المنجز الإغريقي، وحاولوا أن يتفاعلوا معها بمنطق انتخالي لِما شابها من أسطورة وشرك، غير أن نتائج ذلك التفاعل كانت محدودة، أو حصرية في دائرة الوسط النخبوي لا غير، لأن الناهضين بها لم يراهنوا على إحداث القطيعة والخروج من شرْنقة فكر الأقدمين، ذلك لأن التعاليم الأرسططاليسية ظلّت في نظر النخبة المسلمة المتعقْلنة، تتصدَّر السلَّم المعرفي الإنساني، وهكذا توطدت عوامل الاحتباس في الفكر الإسلامي، وساد شعار “ليس في الإمكان أبدع مما كان”، وأناخت قرون الانحطاط بكلكلها على العقل فقيدته، وخرجت الأمّة من الحلبة، وقبعت طويلا في موقف الغائب عن التاريخ، إلى أن قيض الله من الحوادث ما آذن ببزوغ فجر نهضة إسلامية معاصرة مباركة، تعد باستعادة الصحوة، وباستصلاح آثار الانحطاط، واستزراع الأرض بما يجدد الحياة.
في هذا الإطار يحتلّ الأستاذ كولن موقعًا مفْصليًّا وديناميًّا ومُسَرِّعا من خطا هذا الحراك الإحيائي البطيء الذي انخرط فيه عالمُنا الإسلامي منذ مُوَفَّى القرن الثامن عشر.
والمؤكد أن الأمة لم تبخس حظ البحث الفكري الفلسفي إلا لأنها وجدت نفسها تتوفر على كتاب منزل تجاوز بها حال الحيرة والتساؤل الميتافيزيقي الذي طالما رست عنده الفلسفات القديمة.
فالقرآن أجاب عن تساؤلات الإنسان بخصوص إشكالية المنشأ والمصير، وأبان أصل الوجود، والقوة الموجدة له، والمُسيِّرة لأكوانه وعوالمه، ووضح الغاية من وراء هذا الوجود.. وكل ذلك أسس لقاعدة الإيمان، إذ إن الإيمان في الإسلام موصول أصالة بعالم الميتافيزيق. وإن قوَام هذا الإيمان هو الإقرار بألوهية الرب الصمَد، والتصديق بوجود عوالم وحقائق فوق العقل (عالم الملائكة ومبدئيّة القضاء خيْره وشرّه، والاعتقاد باليوم الآخر، والبعث، والحساب، والجنة والنار، إلخ..). من هنا تجافى المسلمون عن الفلسلفة، إذ اعتبروها حقل الشكّ والحيرة الوجودية واللايقين، خاصة وأنهم اطّلعوا على شواهد الفلسفة الإغريقية التي انغمست في الافتراض والوثَنية وتربيب الأجرام والأفلاك، ذلك لأن صدق إيمان المسلم يقتضي -ابتداء- نفْي الشك الوجودي، والإقرار بالعبودية للخالق، والأخذ بالاستنارة التي كفّلها القرآن والسنة في تجلية المغاليق الوجودية الكبرى التي لبث الإنسان يجهلها ويتأرق لأجل معرفة كنْهها وماورائيتها؛ من هنا استغنى المسلمون في تلك العهود عن الفلسفة في طرازها القديم، بل واسترابوا منها، وتخوّفوا من مغبة تعاطيها، لما شابها من وثنية، وما توجسوه منها، من بلبلة فكرية تتأذى بها سلامة المعتقد.
ولقد انعكس هذا التحرز من الفلسفة على نظرتهم إلى علْم المنطق كذلك، إذ اشتجر حوله هو أيضا جدلٌ؛ فمِن مقرٍّ له بالجدوى والمشروعية من حيث التمكين للدين والمحاججة عليه، ومن مُحَرِّم له باعتباره مدخلا إلى الفلسفة وشريكا لها في الأثر، من حيث هو علم فذْلكي يرتبط (أكثر) بأوضاع تَفَشِّي ثقافةِ الشكِّ وتَدَنِّي منسوبِ الإيمان، ولذا كان غلْقُ بابه يعني غلقَ بعض أبواب التشكّك، وسدًّا للثغرات التي يمكن أن يفضي إليها فنّ المساجلات العقدية.
ومن المؤكد أن موقف عالم (مرجعي) مثل أبي حامد العزالي من كلٍّ من علمَيْ الفلسفة والمنطق يكشف عن الإشكال الذي كان الفكر الإسلامي يعرفه في تلك العهود (القرن الرابع وما بعده)، فقد سفَّه الغزالي الفلسفة واعتبرها علم التهافت، فيما اعتمد فنّ المنطق واعتبره من صميم آليات الإسناد العقلي التي يقتضيها بلوغ الإيمان اليقيني.
ولا ريب أن النهضة الإسلامية المعاصرة قد عدَّلت من هذه الرؤية حيال منظومة العلوم، وتجاوزت منطق الاقصاء الذي أضرّ بشجرة المعارف الإسلامية نتيجة الاشتغال شبه الحصري بفقه الفرائض وبفرائض السلوك (الزهد)، إذ عملت (النهضة) بجد وجهد كبيرين على استيعاب المعارف العصرية، وإعادة الاعتبار للعقل المفكّر، ولم تبخس من المناهج إلا ما يمسّ بالدين ويتحلل من تعاليمه.
من هذا المآل الإحيائي، التوسعي، انطلقت النهضة الإسلامية المعاصرة، وضمن هذا الجو التفتحي التأصيلي، سار الأعلام يحصفون الرؤية من جديد، ويوصلون ذهن الأمة بمفاعيل العقل تارة أخرى، بقصد تحقيق الإقلاع. وإن موقع الأستاذ كولن في هذا الحراك النهضوي لبارزٌ، ومتميّز، إذ أوشك أن يكون الأوحد في العصر الحديث ممن قرن الفكر بالعمل، وجعل الكلمة حين تصدر، تصدر وهي محملة ببرنامج تطبيقي؛ فلقد أقام -كما أسلفنا- فلسفته على الملازمة بين الفعل والفكر، وجعل الفكر عملاً، والعمل فكرًا.
هكذا تتفرد الفلسفة الكولنية بكونها تستند على عقل نبت على أرضية القرآن والسنة، واستقى مَلِيًّا من أنهر الصالحين، وترعرع متواصلا مع علوم العصر، فكان له من الإنجازات في حقل التفكير التطبيقي الممنهج ما سنحاول رصد بعض جوانبه في هذا المبحث.
قراءة في فكر كولن
لا تتحقق النهضة -بنظر الأستاذ كولن- إلا على مخطط علمي واستراتيجي مُحكم، ولا تتحدد الاستراتيجية إلا على أرضية من فكر مستنير رسخت قناعاته، واستقرّت دعائمه، وتوطدت خياراته، واستكمل مقومات تعبئته وانطلاقته في اتجاه تنفيذ الأهداف المتوخاة، وبلوغ الغايات المراهن عليها.
لن يكتب النجاح لأي استراتيجية ما لم تكن تستند على فكر محصَّف، وعزيمة قاطعة، وتصميم متبصر في الرؤية والتوقعات. ولكل فكر خلاَّق احتياطٌ من المعارف والقيم والضوابط تجنبه العُطلة، وتتجاوز به الطوارئ والعوائق وحوادث الطريق. ولا تتمايز الأعمال الناجزة، والمهام النافدة، إلا بالتخطيط المحكم الذي تتم فيه. وكل صرح مادي أو معنوي استكمل بنيته، واستوى على دعائم الكمال، لا يولد إلا في كنف تفكيرٍ سديد، وتَرَوٍّ قويم.
تلك هي بعض المبادئ والأبعاد التي يرتكز عليها فكر الأستاذ كولن. وقبل أن نستمر في تجليتها، علينا أن نتساءل: ما الفكر؟
الفكر كما يستشف من كتابات الأستاذ كولن هو القوّة المعنوية التي يصرفها الفرد لأجل تمَثُّل الوقائع الذهنية وتوليدها، وفقه المسائل الحياتية واستنباط قواعد تدبيرها، وتخيل الوضعيات الوجودية حاضرها ومتوقّعها، وتهييئ أسباب تكييفها. إنه الفاعلية العقلية التي نواجه بها الحياة في أبسط مستوياتها وفي أعقد استشكالاتها على سواء، فنديرها على نحو بناء.. بل إن الفكر هو الكفاءة التي تنشأ للفرد عبر مراحل تَدرُّجه في العمر، وتَمَرُّسِه بالتلْقينات والتجارب، حيث يكتسب من أسباب التمهُّر العقلي والمراس التطبيقي ما يُمَكِّنه من التحكم في شؤون حياته ومجتمعه، والسير بها على منحى من الإيجابية بصورة يتوطد له معها الرّضى والإيجابية.
ولما كان الفكر شُعَبَا شتَّى، وديناميات متباينة، كان المردود المتولد عن كل صنف من هذه الشعب متفاوتًا، نوعًا وكمًّا.
قد يتأطَّر الفكرُ بحدود ضيّقة، فيُركِّز على المنافع الشخصية والمطالب الذاتية (ومنها المطالب الأسرية)، وتلك هي حال فكر وتفكير العامة والعموم. وقد يتأطر الفكر بهموم جمعية وانشغالات إنسانية مصيرية، وهو عندئذ فكر الخاصة والرموز، وتفكير الصفوة والفرديات.
فكر الآلية، وفكر التمرس
والفكر المفيد يضع في أولوياته تخطي التحديات، إذ الحياة ابتلاء ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾(الْمُلْك:2)، ولذا تحرص المؤسسات التربوية عند الأمم الحية، على تنشئة ملكة التفكير في المجتمع، بحيث تغتني رؤية الأفراد والجماعات، وتقتدر على المواجهة وإيجاد الحلول للإشكالات، أنّى كانت طبيعتها. ولا تنضُج القدرة الفكرية إلا في ضوء تفتّح الفرد على بيئته، وتشرُّب خصائص ثقافته، ووعي مقومات هويته.
ولا يخلو إنسان من حظ تفكيري، إنما التّفاوت قائم بين الناس من حيث الحظوظ الذهنية؛ فمِنْهم الفرد الساذج والبسيط، ومنهم الفرد الوسط الذكاء، ومنهم الرجيح المتبصر، ذي الحجى… ولا بدّ أن رأْس الهرَم يمثّله الصفوة، وأن قاعدته العريضة هي من بسطاء الناس، وعامّتهم.
الفرد البسيط ينشط تفكيره على وقع الدافع الفطري، إذ الشطر الأوسع من شؤوننا الحياتية نمارسه بما يشبه العادة والانسياق، الأمر الذي ينعكس على فكرنا، إذ يؤول إلى حال من السكون تضحى معه الحياة انتظاما آليا، بعيدا عن التجدد والانقلاب.
وتأثيرات البيئة، وآثار التعليم، وأجواء المهن والوظائف (أي الثقافة عامة)، تتحكم في نماء الفكر وتطوره.. وكل فرد يحمل من عوامل التأهل والتفكير على قدر ما له من استعدادات، ووفق ما يلابسه من مؤثرات خارجية.
على أن في الناس موهوبين ألْمعيين، مِيزتُهم النبوغُ في الفكر، والقدرة على الرؤية، والكفاءة في الاستبصار والتعقّل.. ولا ريب أن قادة الجموع وساقة المدود، إنما تأهّلوا للقيادة، وترشحوا للزعامة بما حازوا من سجايا ذاتية، وملكات ذهنية، ودافعيات روحية جعلَتْهم أقدر مِن سواهم على ممارسة فعل التقدير والتدبير والإدارة واستحصال النتائج.
الفكر النافذ ينتشل الأفراد والجماعات والأمم من حال البؤس الروحي والمادي التي توقعهم فيها ترديات الحياة ونكسات التاريخ الناتجة عن غلبة الركود والاحتباس المدني.
ولا ريب أن مِن أبرز عوامل الاحتباس عن التطور والحياة، الانحراف عن قوانين الاجتماع، والجهل أو تجاهل نواميس الكون، وإغفال المقتضيات الروحية المنورة للبصيرة، والمفتحة للبصر على النهج التعميري القويم.
والمفكّر الملْهم طبيب بالقوة والفعل، يعمد إلى الاستشراءات المزْمنة والتفاقمات المستفحلة، فيتصدى لها بالعلاج، كلّفه ذلك ما كلّفه من سهر وتضْحيات. وسنرى كيف ظلّ الأستاذ كولن يركّز -في معرض رسمه للخطّة الاستنقاذية التي تضمنها مشروعه النهضوي- على دور أطبّاء الروح، ويشدد على حتمية توفير الطواقم منهم للمضي باليقظة إلى منتهاها.
هناك بيداغوجية صارمة تقوم على قواعد وقوانين وإجراءات تراعَى -لُزوما- في تنفيذ المخطط البنائي الشامل. ولما كان فكر النهضة شموليًّا، يغطّي مستويات الحياة والمدنية بشتّى فروعها، كان بالضرورة فكرا يقرن العلاج بالبناء، ويضع في رؤيته البعد الزماني الذي يقتضيه الرهان؛ إذ بالمهارة نفسها التي يُثمِّرُ القدراتِ ويوفر الإمكاناتِ، يحرص على أن يضبط وتيرة البناء، فيُسرِّع الخطا ما أمكنه التسريع، ويتريّث عند الاقتضاء ما لزم التريث.
يترتّبُ الموقفُ الفعال درجاتٍ على سلَّم التجسد والنفاذ، فهو يأخذ -إزاء أوضاع الاختلال- إما صورة فعل مصحِّح، أو كلمة منددة، أو شعور رافض، وهي الرتب الثلاث التي فصّل بها النبي r مسؤولية المفكر، وحدّد دَوره وواجباته حيال الواقع الحياتي حين تختلّ مقوماته، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».
الفكرة قناعة مضمرة، فإذا ما أضحت طليقة صارت كلمة وخطابا. ومعلوم أن مقاصد الخطاب القريبة هي بلوغ درجة التأثير وحيازة الوجاهة ولفت الانتباه، لأن الخطاب فعالية اجتماعية تواصلية تغليبية، فما نطرحه وما نساجل من أجله نريده أن يكون الأظهر والأوجه.
الكلمة في حالة بقائها حبيسة الضمير، تظلّ أعلق بالنوايا، فهي في حاجة إلى مزيد من الامتلاء، والتشبع، والاشتحان (النضج)، لتبلغ مستوى الانبثاق الذي يخرجها من نطاق الكمون إلى حيز الفعل، ويحوّلها إلى صرخة مدوية وصوت مسموع.
وحين تضحى الفكرة حدثا، فإنها تخرج في صورة خطاب مناهض للوضع المتردي، مُؤذِنٍ بالتحول والتغيُّر. بين المصلح وفكره علاقة تماهٍ قصوى، وقوة الفكرة الإصلاحية تستمد نفاذها وديناميتها من شخصية المفكر وسداده.
مفكر البرج العاجي يمارس تفكيره بما يشبه الهواية والترف، إذ إنه يشتغل بمنأى عن الواقع. لكأنه يؤمن أن النشاط التأملي، التعقلي، لا يجد مجاله الحيوي إلا بالخوض في التجريديات، والماورائيات. فهو والحال هذه، يصطنع تهويمات افتراضية مفصولة عن الواقع، أشبه بالـ”دون كيشوت “في معاركه الهوائية. (نجد هذه النزعة تتجسد أيضا في حقل الابداع، مثلا، في مذهب الفن للفن).
إن مفكر برج العاجي يتطارح فرضياته من غير ما تواصل مع المجتمع والحياة العاجَّة بالأوزار والغارقة في الأوحال، فهو من ثمة يرسل فكرًا لا سبيل له إلى تعديل الأوضاع الزرية والاختلالات المؤلمة التي يعيشها المجتمع والأمّة.. إنه فكرٌ مُنبَتٌّ عن تربة الواقع، لا يقدر على إسعاف هذا الواقع.
المصلح الخيري (العضوي) يفاعل الأوضاع من منطلق معرفة تامّة بتلك الأوضاع، وملابسة عميقة لما يثقلها من تردٍّ ومعاناة؛ فبذلك التفاعل الموضوعي الحصيف يتم التجاوب بينه وبين الفئات، ويتحقق الشرط التحولي المأمول.
ولو تساءلنا عن سر الطاقة التي يختزنها الفكر الإصلاحي، والتي تمكّنه من أحداث التغيير، لقلْنا: إن الفكرة حين تتولّد في قلبٍ ملتهب بالشوق، تضحى نداءً تجييشيًّا، له سلطان ينفذ إلى الصفوة باعتبارها الجهة الأكثر قابلية للوعي، ومنها يسري الأثر إلى باقي الفئات الحيّة، يحشدها ويجندها وراء خط السير الذي يحدده البرنامج، وترسمه الخطة.
ما تنهض به الجموع في مجال الإنجاز الاجتماعي والتحول المدني، منوط بروح الفكرة الإصلاحية المستنفِرة للقوى، والمجنِّدة للفئات على جبهة البناء والترميم. فالفكرة بهذا الاعتبار، هي المخزون الطاقوي الذي يؤسس للإنجازات، ويدير التحوّلات، ويكفل للعملية البنائية قوة الدفع اللازمة لها، استيفاء لغاياتها.
تتماهى الفكرة في شخص صاحبها (المصلح) فيضحى هو هي، وهي هو؛ الأمر الذي يجعل تأثيرها في الأوساط حيويا، إذ الجموع المنخرطة في الخدمة تجد نفسها -وهي تنفذ برامج النهضة- تعيش حالة من التَّماس العضوي مع شخص المصلح الذي يتحول في الضمير العام إلى شخص اعتباري، أشبه بالشمس تبزغ على كل صقع، وتنشر دفْئها في كل أفُق. فإكبار الجموع لشخص المصلح، يترجم من قبل الأتباع فاعلية في الأداء، إذ يضحى البذل والتفاني والإخلاص والمصداقية هي الأسس التي تطبع العمل، وتميّز وتائره.
بهذا الاعتبار تروج أفكار الصالحين الأفذاذ والكارزمات الشهمة عبر الأرجاء، وتتجاوز نطاق حدودها البيئية والجيوسياسة، وتصير فكرا إنسانيًّا يلقى المقبولية فى الأنحاء كافة.. وإن التجربة الفكرية التي ينجزها اليوم الأستاذ كولن وما تلقاه هذه التجربة من تقدير، وما تحظى به من تنويه وجاذبية، وما نراها تحققه من انتشار خارج المجتمع التركي نفسه، من خلال تبنّي منهجها من قبل دوائر متزايدة من مثقّفي مجتمعات عربية وإسلامية، بل ومن استقطابات متكاثرة من خارج العالم الإسلامي، لَدليلٌ على أن الفكر الإصلاحي حين يتولد على أرضية روحية واجتماعية ومدنية متساوقة الدعائم والأبعاد، يغدو كسبًا إنسانيًّا يُقابَل بالتثمين أنّى انتهت آثاره ونتائجه.
لقد قامت فلسفة الأستاذ كولن على الإيمان بأنْ عمل المفكر عملٌ بنائيّ بالأساس، يسدد في اتجاه الإصلاح والتجديد، الأمر الذي يقتضي من هذا المفكر حظوظا من الكفاءة والاقتدار معززة بمدود من توفيقات الله..
إن المفكر في تجربة الخدمة والتغيير، يجد نفسه أشبه بمن يعالج بالكيّ، فهو يتقصد -في حسم وأناة- مواطنَ الداء بالذات، لأجل استئصال العلة، وضمان البرء، واسترداد العافية.
وإن الغاية الكبرى للمصلح المسلم في العصر الراهن هي أن يستزرع في الحياة من جديد فكر إنشاء المُقََوِّمَ المرفقي الحضاري المؤصل.. فمن خلال إيجاد العدة الثقافية والمرفقية الأصيلة، نتمكن من إزاحة ما يعمّ حياتنا المدنية والاجتماعية المِلِّية من مظاهر الأسلبة والتغريب التي تحاصرنا من كل جانب، والتي تأخذ صورة فواعل تجهيزية وتثقيفية أجنبية تحتل الساحة القومية، بلا منافس، وبتقبل أعمى من قِبَلِنا، ودونما إحساس بالفداحة.
إن جهود المفكر المصلح تنهض في الآن ذاته بمهمّة دفع الغزو من جهة، وإحلال مولدات الأصالة محله من جهة ثانية. إنها معركة حاسمة في مجال تحدّي الذات والرهان على تحقيق النموذج الأصيل، واستعادة زمام المبادرة في مضمار الخلق والإبداع والتميُّز المدني.
وحتى يستكمل المفكر أركان الإمامة والتأهّل في شخصه، لا بدّ أن تستغرقه مراحل الانصهار واكتساب القابليات التي تجعل منه إنسانًا روحانيًّا يعي الواقع ويستشرف المستقبل ويقدِّر للترديات مقاديرها من العلاج، كي يتاح للأمّة أن تتخطى حقبة الوهن، وتتجاوز إلى الحياة الأحفل، والوضع الأكرم.
لقد رسم الأستاذ كُولَن الأساس الارتقائيّ الذي لا مناص للمفكّر المصلح من أن ينطلق منه كي تترشّد على يديه المشاريع، وتزدهر تحت رايته المنجزات؛ إذ جعل القرآن هو القاعدة التي ينبغي أن يتّخذها كل عامل -يحلم بأن يكون من خدّام الأمّة- منهجًا ومرجعا ومرشدا وملهما له في مشاريعه.
ولما كان “القرآن هو قمّة الفكر المتين والصحيح”، كان على كل صاحب فكر سليم أن يتمرّس بتوجيهات هذا الكتاب السماوي، ليتطبّع على روح القرآن ولتتشرّب مواجده رحيق القرآن؛ فالقرآن “هو صوت الملكوت الذي يخاطب فكر الإنس والجنّ ومشاعرهما”، وإن مطلقية تعاليم القرآن جعلت حكمته نضرة على الدوام، “فهو الكتاب الذي استطاع أن يقف منذ نزوله في وجه جميع الأعاصير والعواصف.. فما أن يرتفع صوت القرآن حتى نشعر وكأنه نزل الآن من السماء “، إنه “فيض من العلم الذي يشكّل الحدود النهائية للإدراك البشَري”.
وإن التدثر بشعار القرآن يفسح أمام العقل والفطرة والملكات مَدًى لا يُحَدُّ من الرحابة الفكرية والانفتاح الذهني والشعوري، إذ القرآن لا يعزلك في أيديولوجية ضيّقة أو “دوغْم” يجافي القيم الإنسانية، ويتنكر لمثل الخير والمحبّة والسلام.
إن المدد التنويري الذي يفيده أولو الألباب جراء تفاعلهم مع القرآن، ينعكس على المواجدِ صفاءَ روحٍ، وعلى القلب جلاءَ بصيرةٍ، وعلى العقل رهافةَ مدارك، فـ”مَنْ فهِمَ القرآنَ حقّ الفهم، تصبح البحار الواسعة كقطرةِ ماءٍ أمام ما يرد إلى صدره من إلهام، والعقل الذي تنَوَّرَ بنوره تتحول الشمس تجاهه إلى مجرّد شمعة”.
إن القرآن يُعَدُّ أعظم فضاء عروجي، تتهيّأ فيه للروح إمكانات لامُتناهية من المغانم الفكرية والشعورية، بحيث يسوح سالكُه في أقاليم عجيبة من الآيات المبهرات، إذ “ينتقل من الدهشة إلى الذهول، ومن الذهول إلى برّ من العواطف المتلاطة”، وبتلك المستويات من التلقين والتعبئة يتحقّق التشكل الروحي والقلبي للفرد الداعية.
فالقرآن يعيد عجن النفوس النجيبة ذات القابلية للإثمار؛ فهو “يتناول الطالب الذي جذبه نحوه، فيعجنه ويجدّد شحنه بالأنوار”؛ والمقبلون على القرآن “الذين يَدَعون أنفسهم بكل أحاسيسهم ومشاعرهم وقلوبهم وقابلية إدراكهم تَسْبَح في جَوِّه الذي لا مثيل له، سرعان ما تتغير عواطفهم وأفكارهم، ويحس كل واحد منهم بأنه قد تغيّر بمقياس معين، وأنه أصبح يعيش في عالم آخر”.
لقد أوجد القرآن -زمن البعثة- فيالق من الصحابة صهر أرواحهم وشكَّل نفوسَهم على وفق معاييره السماوية، فأضحوا هوية قرآنية، يجسّدون بسلوكهم روح القرآن، ويترجمون مثله ومعانيه، فشقّوا بالإنسانية طريقًا مشْرقا سطعت فيه على الأصقاع أنوار الحكمة والعقل والعزة.
لقد تخطت الإنسانية بفضل تعاليم القرآن مهاوي السفه العقلي والشرك الروحي، فحتى أقطاب الفكر الفلْسفي القدامى ممن اعتبرتهم الإنسانية معلّميها وسادة فكرها (من أمثال المعلم الأول أرسْطو ومَن نحا منحاه)، ظلّت أعمالهم ونظرياتهم، تدين بالربوبية لطواقم من آلهة توهموا أن الخير والشرّ بيدها.. ثم بعث الله محمدًا r إلى العالمين برسالة تشيع الاستفاقة والنور، فما لبث الفكر الإنساني أن تحرّر من الميثولوجيا، إذ أبان أن ما ظل يُعْبَدُ من عناصر الطبيعة، إن هي إلا أشياء مسخّرات.
لقد أرسى القرآن مبدأ التوحيد (القاعدة الصارمة لبناء المنطق)، وعلََّّم البشريةَ كيف تتخطّى مزلق الميثولوجيا والاعتقاد الخاطئ، فأزال عن العقل لوثة الشرك، ووعت مدارك الإنسانية شناعات الضلال، و”فقهت أسرار العبودية”، واستذاقت فضائل التوحيد.
بانتشار الأنوار المحمّدية في الآفاق تهاوى صرح الميثولوجيا الأممية القديمة، وتحطمت منظومة الآلهة (آلهة القطاعات)، إله الخير، وإله الشرّ، وإله الضرّ، وإله النفْع، وإله الحبّ، وإله الخمر، وإله الخصب، وإله القحط، وإله النار، وإله العواصف، إلى ما هنالك من تخاريف أوجدها العقل الإنساني الباحث عن السند الروحي، وبدلاً من أن يهتدي إلى الرشد، وقع في الزيف؛ إذ فاته أن الاعتقاد في تعدد الأرباب واختلاف مشاربها تصورٌ باطل، لا يقره إلا عقل أسطوري، تَوَهُّمي.
لقد مَوْضعَ القرآن الرؤية إلى الكون، وجلَّى للإنسان طبيعة وجوده، وحدّد مصدر هذا الوجود: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾(الانْفِطَار:6-8)، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ اْلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾(العَلَق:2).. وتَحوَّلَ بالفكر من سجالية الدّيالَكْتيك ومنطق الحتمية والآلية العمياء، إلى أولية القدر (العلّة الأولى) ومبدئية المشيئة الإلهية: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(الْمُلْك:1).
وإن ما ظلّ يعصف بالمدنيات ويسفِّه معارفَها ومناهجها في مجالات الاجتماع والاقتصاد والطبيعة وما سواها، لخير دليل على أن البعد الماورائيّ الغائب عن مداركنا هو الأسّ الذي تخضع له الأشياء، وترسو عليه الترتيبات. وإن ما نشهده اليوم من تهاوي أنظمة اقتصادنا وماليتنا الدولية، وطفوح كيل الكوارث بنا، لهو بعض ما تريد الإرادة الإلهية أن تؤدّبنا به، بعد الاعتداد العقلي الأصمّ الذي انْجرفنا وراءه على حساب نصيب الروح في معادلة الوجود.
لم يزعزع القرآن عقيدة الشرك في الأرض فحسب، ولكنه أرسى قواعد بناء الفرد الكريم ودعائم المجتمع الفاضل. ولقد أثمرت جهود الرسول r في مرحلة التنْزيل، إذ ظهر الإنسان المسلم الذي استوفى مقوّمات الصلاح، فكان ذلك النتاج الحضاري النوعي الرائع الذي تحقق بفضل انتشار الإسلام، وسطوع شمسه في الآفاق، في وقت من الزمن القياسي.
ومثلما صاغ القرآن في الأولين جيلاً من الصحابة أحالهم “أبطالا في عالم القلب والروح” وجعل منهم “مُجتمعًا متميّزًا مباركا”، كذلك سيَصيغ في الآخرين سلاسل من أجيال خيار، يتتابعون في حقل البناء، ويتنافسون في مضمار العطاء وتحقيق المكرمات. “إن درجة الكمال التي وصلت إليها الأجيال التي نشأت في جوّ القرآن النوراني كانت معجزة قائمة بذاتها.. لا يمكن العثور على أيّ مثال لهم في مستواهم من ناحية التديّن والتفكير وأفق الفكر والخلق”.
ومن المؤكد أن الإسلام قد أناط بالروح -ومن ثمة- بالفكرة، مهمة الفعل والنفاذ؛ فحين تتحفز الروح وتستكمل تعبئتها، تتحول الفكرة إلى حركة وحدث وإنْجاز. لقد هيأ القرآن للمسلم -والإنسان عامة- ما يحوِّرُ روحه، ويشفِّفُ قلبه؛ إذ لفته إلى أهمّية نشدان الحصانة الروحية لأجل التهيّئ للعروج والرقيّ الإيماني. فمن خلال سدّ أبواب الشهوات، وكفِّ مطالب البدَن والغرائز، تتفرّغ الروح للنشاط الخلاّق، والفكر المفيد، والعطاء المتجدد.
بتوطين النفس على التقلل في مستهلكاتها، تتخفف الروح، وتُحَلِّق في أقاليم المافَوق. على أن من أهم الركائز التي تتحول بها المادة روحًا والروح مادةً، هو الاستغراق في العبادة، تَهييئًا للنّفس أن ترشد وتستوي، فتمتلك الطاقة اللاّزمة لصنع الباهر من الإنجازات.
إن الإيمان العميق يُمَكِّنُ المادةَ (الجسد) من أن تتقمّص الروح، ويُمكِّن الروحَ (الفكرة) من أن تتقمّص المادة، وبذلك تستحيل الفكرة يدًا تبني، وظهرًا ينقل، وجارفة تَحفر، وجموعا تُنجز، وهيْئات تتابع وتُمَوِّنُ..
هذا بعض ما تمثل به الأستاذ كولن دَور رافعة القرآن، في تحقيق الفرد الفاعل، والمجتمع الناهض.
مكانة الفكر في رؤية كولن
الفكر عملية عقلية تؤسس للحدث الإنساني، تسبقه أحيانا، أو تصاحبه، أو تتبعه، كنَوع من الملابسة الذاتية والتحرز الإجرائي والمنطقي الذي تستلزمه عملية التواصل، حتى لا يدخل الفرد في تناقض مع ذاته، وحتى يحقق هدفه وينجز مهمّة التعامل بإيجابية. فما يفكر فيه الإنسان يعيشه متلبسا به عقليًّا وكيانيًّا، فإذا كان الأمر التفكيري من جنس الأفعال الواقعية، انْساق الجسد والإرادة إلى تحقيقه عمليًّا؛ وإن كان ذهنيًّا، انساق الذهن إلى تمثله أو استخطاره على نحو ما.
يسجّل الأستاذ كولن نوعَين من الفكر يتعاطاهما الإنسان، ويحكمان نظرته إلى الحياة، وعلاقته بالكون والوجود:
1- الفكر الأصمّ، ويقصد به ذلك الفكر وليد العقل المفصول عن الغيب.
2-والفكر الرحب، وليد العقل المتواشج مع الميتافيزيقا.
أو إنْ شئْنا القول إن الأستاذ يميّز بين لونين ومنهجين من الفكر: الفكر الحسي، والفكر الروحي. الأول مغلق على ذاته، معتد بالمادة ومرتد إليها، مجانف للروح؛ والثاني موصول بالمادة معتد بالروح، معتقد في الغيب، إذ يرى أن عالم الشهود هو امتداد للماوراء، وأن الدنيا مَزْرعة للآخرة.
بفضل استنارة الفكر الفاعل، تُولَد المدنياتُ وتتجدّد الحياة، لأن الفكر البنّاء يَتقصّدُ الغايات الملموسة والمنافع الناجزة، إذ يترسم من الفرَضيات والمخططات ما هو قابل للتطبيق، فهو من ثمة فكر واقعي، استراتيجي، يُوجِّه الأنظار والإرادات إلى الكيفيات والمسالك التي تجعل أعقد المشاريع، وأشقّ الرهانات، وأكثرها إيغالا في الخيال والرومانسية، قابلاً للتحقق والتنفيد.
فأوّلية الأهداف التي يسدد نحوها الفكر الفعال هي بناء الإنسان، وأهمّ الجوانب التي يركّز عليها الجهد البنائي هو الارتقاء بالروح. ذلك لأن الإنسان هو الفاعل الأول والآخر في كل مواجهة إنجازية تترقى بها شروط المدنية، وتتسع مرافق العمران.
وللفكر صبغة عضوية، نمائية، لأنه هو كذلك يُستزرَعُ في الأرض، ويستوي مع الزمن، ويُؤتي ثماره حين الاستحصاد. وإذا ما استغْرقَتِ الفكرَ التهويماتُ الفانْتازيّة والسياحات الميتافيزيفية المفصولة عن الواقع، فسيتوحَّل في الذهانية، والوهم، والعقم، وسوء المآل.
الفكر العقيم يفضي إلى السيبة، وفي التسيّب موات المدَنية. والأمّة الإسلامية أطاح بها وضع العقم الفكري الذي عاشته بعد القرن الرابع، وجرَّف أكثر ما استنجزته من مآثر وضيئة، إذ دخلت الأمة في طور الانقسامات، وتناحُر العصب، واستنْزاف الموارد (المعنوية والمادية).. وانْضاف إلى ذلك احترافُ قصّاصو المسجد مهمّة التزهيد البليد، والتشنيع بالحياة وتَتْفِيهها، الأمر الذي وطّد روحية الكفاف والكسل والانسداد.
الفكر البنّاء محرّك مركزي للحياة، لأنه يبصِّر بالإمكاناتِ والقدرات، ويَفتح في وجه الإنسان مجالات العمل والتجدّد. تَخْضَرُّ مروجُ الفكرِ وتستجمع نضارتَها متى استقت من نهر الشريعة الرقْراق، إذ تنفُضُ عنها رمادَ الجهل وانعدام الهدَف.
لقد استطالت رقدة الأمّة، ونالت منها قرونُ عاشَتْها في كابُوسيّة الاستسلام والانتظار والانْهزام. انْخذلت الأمّة أول الأمر حين تفرّقت في عقيدتها شيَعًا، وذهبت الفرق يُكفِّر بعضُها بعضًا، ضاربة عرض الحائط بالهدف التوحيدي الذي تأسّست عليه الشريعة ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾(آلِ عِمْرَان:103).. وكان منهاج السنّة النبوية وانفساح مساحة القدوة والعمل بتطبيقاتها عامل ترابط وجمْع، لكن الحطة الروحية والتعصب المذهبي وضحالة الفكر وقصر النظر فشت في الأوساط، فحوّلت الوحدة تشرذمًا، والقوة وهنًا، والجمع بددًا، وانحدرت الذهنية الخاوية إلى الهاوية وباتت -ضلالا- تحترف التكفير والتفسيق.
ثم انهزمت الأمّة تحت ضربات الأمّية والفقر والأوبئة، إذ إن دوران رَحَى الفتن يوقف عجَلة النماء، ويتلف المحاصيل، ويصيِّرُ الأرض بلقعا لا تُنبت إلا الشّوك والحسك. ثم زحفت القوى الأجنبية الحاقدة واحتلّت الديار، وانقهر سادة الأمس، وصاروا في وضع الحطة، يدفعون الجِزْية عن يدٍ وهم صاغرون.تلك هي معالم مسيرة الانحطاط كما سجلها التاريخ على الأمة.
وحيال هذه التركة الشنيعة من الانتكاسات والاندحارات، ينهض الفكر المسلم المعاصر من خلال رموز آلت إليهم النوبة في تولي أمر الإمامة الروحية والوصاية المدنية والمعنوية، وانبروا يراهنون على الانبعاث والغد السعيد وإعادة الأمور إلى نصابها كرةً أخرى.. رموز وعوا الدروس واستوعبوا العبر.. عُدَّتُهم وعتادهم في هذا الرهان، الإيمان بالله واليقين من أنهم هم الأمّة التي هيّأها الله لصنع الخيرات وتحقيق المكرمات.. شعارهم الخالد: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾(آلِ عِمْرَان:110).
ومما لا ريب فيه أن على رأس هؤلاء الرموز يقف اليوم الأستاذ كولن منارة فكرية تلهم الأمل واليقين في النجح، وتبثُّ الأضواء. لقد حاز الإكبار وانصاعت له الإرادات والرجال، بما تميزت به سيرته العصماء من تبتّل وثراء روحي وقرآنية، وما اتّسمت به مشاريعه وبرامجه النهضويّة من شمول ورشدانية. ولا أدلّ على ذلك من أن بعضَ قطاعاتِها قد آذن بالإثمار والإيناع.
إن الفكر الذي يتّسم به الأستاذ كولن في إرساء دعائم النهضة، فكر منهجي معطاء. لقد اشتمل بفضل روحه القرآنية، على عناصر التجنيد والترشيد والتحدّي، واستمدّ من شريعة الإسلام السمحة القواعد والقوانين التي تتأهّل بلا منازع لإقامة المدنية المرشدة، وتأطيرها وهيكلة توسعاتها المادّية والمعنوية، والسير بها في اتّجاه يخدم الإنسانية.. إنه فكر كوني أسس على التقوى، لا يفرّق بين الأجناس والأمم، ويتوخّى الخير والصلاح للعالمين.
ومثلما أثبت الفكر القرآني في الماضي، سيثبت مستقبلا عبقريته في البناء وتحقيق الازدهار الذي لا يكبو ولا ينبو ما استقام الإنسان على الطريقة، واستمسك بالعروة الوثقى. ذلك لأن الحضارة تدوم وتنبني بالفكر المتوازن المرتكز على دعامتي الروح والمادة، وإذا خلت الحضارة من الروحانية ضمر فيها معين الرحمانية، وانعطفت بالإنسان نحو الضلال، وانحبست به العجلة في دائرة الصغار والقصور، وباءت فتوحاته ومدنياته بالكساد والثبور.
الحياة الفاضلة هي التي يقترن فيها الشكر بالذكر بالفكر، وإلاّ انحدرت بالمجتمعات إلى درك البهيمية وانعدام المثل.
من هنا كان على الإنسان أن يجعل في مقدمة أهدافه الحياتية بناءَ صرحِ فكره كي يكتمل إيمانه، فلا إيمان بلا تفكُّر وتأمُّل وتدبُّر. والفكر السليم فكر تتمازج فيه الدعامة الدنيوية والدعامة الأخروية على السواء، إذ خلق الله الآدميّين ليعبدوه وليعمروا الأرض والكون كي تتوطّد شروط الحمد وتزدهر رحاب المحامد. فالعمل الصالح عيْنُ العبادة لأنه تصديق للقلب. أما الزهد السلبي والتنصل من الواجبات، فمحظور في الشرع، ومجانف لروح العقيدة التي طفقت تقرن في المتن القرآني شرطَي الإيمان والعمل الصالح، قاعدةً لبلوغ درجة الامتثال والكمال.
والحال نفسها بالنسبة للمجتمعات، فهي مطالبة ببناء فكرها، والترقّي به، وذلك يقتضيها أن تشدد على العناية بالارتكازين الروحي والمادي، الدنيوي والأخروي معًا، حتى لا تختلّ المسيرة التعميرية التي أناط الله أمرها بنا، لأن التعمير من منظور الإسلام هو الركن التطبيقي للعبادة.
الأهداف والغايات التي سدد نحوها كولن
بناء الإنسان المسلم هو غاية الغايات التي تستهدفها بيداغوجية الأحياء التي يتبعها الأستاذ كولن، إذ بواسطة جهود الإنسان وبيده وعقله تتغيّر الأوضاع نحو الأحسن شريطة أن يكون الفكر سليمًا والرؤية مرشدة والتقديرات موزونة.
والإنسان شاد المدنيات الفسيحة وهو يجهل طريق الإيمان الحق، حيث لبث يتعبّد بحسه وانْجذابه إلى قيم الإعلاء بوازع الفطرة الروحية فيه فقط، وذهب في التوسّع بالكمالات المرفقية كل مذهب دون أن يقر بألوهية الخالق الفرد رب العالمين، دافعُه في صنع ذلك التعمير الفطرةُ والنّزوع نحو الأرقى والأكمل. ولا ريب أنه توفَّقَ إلى أن يفعل كل ذلك بفضل ما أودع الله فيه من انجذاب جِبِلِّي نحو الحسَن، وتلك هي الميزة الفارقة التي امتاز بها الإنسان عما سواه من المخلوقات، إذ كمّل الله خلقته بما أودع فيه من روحه. وبتلك النفثة الروحية فتئ الإنسان -ضالاّ ومهتديا- يحقّق ما يحقق من الإنجازات الباهرة. إنه الكائن الوحيد الممارس للتعمير والتحضير، لأن الله هيّأه بالفطرة السوية لفعل الخير، وجعَله الجنس الأرقى الذي تنتهي إليه تعاليم السماء بواسطة المصطفَين من الأنبياء والرسل، تُرَشِّدُه وتهديه سواء السبيل.
والمؤكد أن جلّ ما أنجزه الإنسان في عصور ما قبل عهد الرسالات السماوية قد باد واندثر وبقيت آثاره شاهدة للدارسين. وليست العلّة تكمن في تلاحق الدهور، وتتتابع العصور، وكرور الزمن الذي يأتي على كل جديد، ويُفني كل حديث، إنما العلّة أن المدنيات التي تشذ عن الحق والفطرة السليمة، تبلى وتهرم وينالها الزوال، هكذا لقّننا القرآن.
من هنا ندرك لِمَ امّحتْ آثارُ -حتى- الأمم الكتابية أو تلك التي أنشأت مدنياتها على هدْي من نبوة سماوية أو رسالة منزلة، ثم بادت آثار ما أنجزت ولم يكتب له الدوام.. لا لسبب إلا لأنّها حادت عن الجادة، فسرى عليها قانون الحق.. إنه تفسير بسيط، لكنه عين الواقع الذي تؤكده شواهد التاريخ.
وإن الشاهد التاريخي الحي عندنا هو ما أصاب تراث بني إسرائيل وقد تعهّدتهم السماء بمدود لا تحصى من الرسل والأنبياء، ووجّهتهم نحو العقيدة الحق، ودرَّجتهم من حياة التبدي إلى التعمير وإنشاء الممالك والمدنية، لكن المسيرة انتهت بهم إلى التشرذم والتفرق في الأرض، وبادت مدنيّتهم وآثارهم، وكأنهم مُسِحوا من الأرض التي عمروها. والسر في ذلك أن الانحراف عن تعاليم الدين السماوي الذي لبث المجتمع اليهودي يعاود المضي فيه، انتهي بهم إلى أن يلقوا مصير ما لقيت الأمم الْمفَرِّطة في حق الله، وما كان للجنس أن يبقى وتستمر سلالته لو لم تكن فيهم طائفة ظلّوا على الموثق، فكتب الله لليهودية بهم البقاء.
لقد توخّت الرسائل السماوية وفي مقدمتها الرسالة الخاتمة -الإسلام- أن تلقّن الإنسان شروط الاستقرار المدني والدوام الحضاري، ليس بالوعد بإقامة مملكة الله على الأرض، ولكن بتعريف الإنسان بالعوامل الضامنة للاسترسال في الزمان والمكان، تلك الشروط المتمثلة في مزاولة العمل الصالح القائم على دعائم الشرع الحنيف، تعميرا للكون، واستبحارا في زرع الخيرات، والمضيّ على الدرب الإيماني، إلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومَن عليها، وعندئذ يقف الإنسان موقف المحاسب أمام ربّه، فإما نعيمًا مقيما وإما عذابًا مخلدًا.
إن التجرد من الإيمان العقدي (السماوي) لا يقعد بالإنسان عن البناء والترقّي المادي، إنما مغبة المضي في الاستنامة إلى مدنية اللاّإيمان بالله والانخداع بها، مغبةٌ وخيمة، ومصيرُها فنائي، كارثي، درامي. وإن مسار مدنية العصر الراهن، المعتدَّة بتكنولوجيتها وبفتوح العلم المتواصلة، لا يفتأ يشير لكل ذي عينين، بالمصير المشؤوم الذي تنقاد إليه الإنسانية رغم البقية الباقية من الجسور التي لا تزال تربط أوساطا متناقصة في المجتمعات المتطورة، بالدين، إذ الخطر آتٍ من قِبَلِ الرجحان المطَّرد لكفة الكفر على كفة الإيمان، الأمر الذي سينتهي حتما باتساع الهوة بين طريق الرشد (المهجور) وبين طريق الضلال الذي تسلكه المدنية اللاّدينية، وهو ما سيجعلها تخرج نهائيًّا عن الجادة، وترتطم بالصخرة، وتلقى مصير الأمم البائدة.
إن أهمية الإيمان بالخالق، واتباع تعاليمه، تضمن دوام عافية الإنسان الروحية، شرط السكينة والاستقرار، وتضمن كذلك سلامة مدنيته واسترسال الحياة على خط من السكينة والحفظ الإلهي لا تشقى معه الإنسانية.
وطالما جنح العقوق بالإنسان إلى الكفر، واسترسلت به المدنية المتفحشة، وألْهَتْهُ مباهجُها حينا، لكن الازدهار كان ينتهي دائما بالتراجع، وكان مصير الغرور أبدا إلى الانكسار. وإن من دأب الزمان أن يجُرّ أذياله على ما شاد الظالمون وأعلوا من أسوار.
وها مدنية الإسلام في ألفيّتها الثانية، قد مرت بأطوار من الرثاثة والضمور، ثم ها هي ذي تنبعث كالفجر من بين ثنايا الظلام، رقّت كشعرة الحرير ولم تنقطع، والعلة أنها مدنية نهضت على دعامة الإيمان بالله، فهي حتما تتعافى بعافية الدين، وهي أيضا تَختلّ باختلال العقيدة وتراجع حرارتها في الضمائر. لقد كتب الله أن تكون أمة الإسلام هي أمة البقاء والخلود لأنها الأمّة التي انغرست فيها روح العقيدة السماوية بأصالة، وذلك بحُكم الخاتمية، بحيث لا يمكن أن تنفكّ عنا شريعة الله التي ارتضاها للعالمين، فالموثق جعلنا الحداة الهداة.
نحن هم حملة الوحي وصانعي طبوع البرّ والإحسان بما أناطنا الله من شرف تبليغ أزكى رسالاته إلى الأرض وإلى العالمين. فمدَنيتنا القرآنية لا تحول، وهي محفوظة بنصّ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(الحِجْر:9).
الإرث القدسي المتوارث
إن الإيمان بالله -كما يرى الأستاذ كولن- هو حجَر الزاوية في بناء النهضات وصَوْن المدَنيات. وإن دور الرادة والقادة أمر حاسم في تأهيب الجماهير، والمضيّ بهم على طريق اليقظة والعمل. ولا يكون الفرد مؤهّلا للقيادة ما لم تكن له أسهم رابحة في بورصة الإيمان ومخافة الله.
لبث كولن يستقرئ سجل الانعطافات التاريخية المجيدة، تلك التي كتبت فيها الأمّة التركية صفحات من العزة والمآثر، فرآها جميعا تتحقق على يد أفذاذ صهرهم الدين الحنيف في بوتقته المطهِّرة، واستصفتهم العبادة الخالصة، وجعلتهم خُلَّصًا مثل ذوْبِ الإبريز. رتبة سامقة من التحوّل الروحي أدركوها، وانطلقوا بها، يحملون الراية، ويصنعون العزّ.
لقد لعبت التنشئة الدينية دورًا بارزًا في تخريج أولئك الأفذاذ قادةً عباقرةً. ارتقت بهم أعمالهم الجهادية والفكرية والتعميرية إلى منْزلة من السموّ، بات بها كلٌّ منهم ملمحا في الهوية الجمعية، وعلامة حيّة في ضمير الأمة، وعينة ألماسية في تراثها التليد.
فأثر التنشئة الإسلامية وصقْلُها لأروح أولئك القادة، أثر بارز، وخَتْمُها لمهجهم ختم جلي، إذ إن ترقرق ماء الإيمان بأعماقهم رجح فيهم الشمم، وعزز ملكة التأبي، وحدد لديهم الذهنية والتفكير، وقوَّى قابلية التدبير، وأرهف فيهم عزيمة الإنجاز، فباتوا استراتيجيّين من طراز خاص.
وأهمّ الحظوظ التي تهبها الحياة والتاريخ للشعوب والأمم، أن تضع على رأسها الرجل التّقي، الفذّ، يقطع بها الأشواط، وينجز المآثر. والمؤكد أن قوة الفرد -مهما كان حجمها- لا تصنع التاريخ بمفردها، إنما الجموع المرشدة بالقيادة الحكيمة هي التي تحقق الوثبات. وحدهم الأنبياء تسددهم العناية الإلهية فترسم لهم طريق الاستقطاب، وتملأ قلوبهم بما يثبّتهم ويجعلهم أقدر على المكابدة وتجاوز الامتحانات. إنما قوة الأفذاذ أهل العزم، حين تتوطّد، تغدو بمثابة الشمس.. لطفها يشمل المدى ويصيب الجموع، فتشتحن القلوب بالطاقة، وتتأهب، وتتحرك إلى الفعل والبناء.
لا مشاحَّة في أن تأجُّجَ الإيمان في روح أولي العزم من صُناع التاريخ محطة توليد، تغذّي المَواطن كلها بالنور. وأهم سمة تميز الشخصية التاريخية المؤمنة، الدهاء في القيادة، والمرابطة على فعل الصالحات.
وحقيقة الدهاء أنه اقتدار غير محدود على تَرَسُّم الخطط واستشراف الطرق والمخارج والكيفيات التي تضمن الغنم والنجاح في الرهانات.. وحين تتأصل ملكة التفكير في الفرد -والجماعة- يضحى في الإمكان التفلّت من أي مأزق يطرأ، والتخلّص من أي ضاغط يعرض؛ إذ ليست العبقرية إلا هذا اليسر الذي ننفذ به جليل التصورات، ونَحْفُر باهر النقوش. وحيثما دار القلم في يد العبقري لاحت له في عين البصيرة كاتالوغات لا تعد من المشاهد والصور والتشكيلات المعبرة.. “العبقري صاحب فطرة خارقة يجمع في روحه قوى تتحمل فوق أكتافها أمورا كثيرة بموهبة إلهية، وبسائق وشائق لدنّي، فيحتضن بها حاجات محيطه الظاهرية والباطنية والروحية والاجتماعية بأعمق أغوارها، وأوسع حدودها”.. العبقرية فانْتازيا تنتزع منا الدهش في أي وضع بدت، وعلى أي هيئة ظهرت. ومثلما يتهيأ الفرد للرفعة والتفوق بالسجايا والتنشئة، تتهيأ الأمم بدورها للمجد والعظمة بالتربية وتوطين الإنسان على التجنُّد المتواصل واقتحام المخاطر في وجه كل مفخرة..
كولن وحديثه عن أمة القرآن
ومن الترفيعات التي خص الله بها الأمة المسلمة أنْ جعلها أمة القرآن، حيث كان لها في هذا الكتاب القدسي المحفوظ أعظم حاضن، وأفقه مربٍّ، وأزكى موجِّه.. من هنا لبثت الدعوة إلى الاستفاقة تراهن لتحقيق النجح في كل عصر على تعاليم القرآن، وطفقت التجارب والجولات والتمحيصات تتكلّل بالنصر كلما كانت آصرة الاستناد على القرآن قوية، والرابطة معه مستحكمة.
ولعل الشمولية التي لبثت الأجيال تشهد بها للقرآن العظيم، (والتي هي أحد أبرز وجوه إعجازه)، تكمن في هذا التحفيز البيداغوجي الجلي الذي تمارسه مخاطباته على القارئ المسلم، دفعًا له للتّأمل والتفكير وبناء العقل الاستقرائي المحلل للظواهر، والمتفحّص للقوانين.
فمن مفاتيح المتن القرآني المتواترة التي راوحت سياقاتُها بين التنبيه والحضّ والتعريض والتقريع، قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(الأَنْعَام:32)، ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(الأَنْعَام:152)، ﴿أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ﴾(الأَنْعَام:50)، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾(يُوسُف:109)، إلى آخر ما هنالك من مواقف تخاطب العقل وتعلي منْزلة الفكر وتنوّه بالتفكير.. من هنا كانت الأمّة المسلمة أمة مفكرة بالقوة، ولولا ما عرض لها من عوامل الجهل والتفريط والحيدة عن جوهر القرآن وفهْمه حقّ الفهم، لظلّت أمّة الفكر والتفكير بالفعل والصدق.
في هذا الصدد يقول الأستاذ كولن: “التفكر دم الحياة الإسلامية”، وإذا “انعدم التفكير، أظلم القلبُ واضطربت الروح، وتحولت الحياة الإسلامية إلى موات هامد”.
والتفكير في شرعة الإسلام عبادة، لأن الإسلام جعل التأمّل في الأكوان واستقراء الظواهر وفهْم الطبيعة، سبيلاً إلى ترسيخ الإيمان، ومنهاجا لاستنْزال بركة اليقين، “التفكر (الإيماني في الكون) يكون موضع واردات ذات بركة”.
لقد لقّن الإسلام مبادئ العقيدة، فأنزل سور التوحيد، وكرّر آيات الوحدانية ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾(الإِخْلاَص:1)، ﴿اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾(البَقَرَة:255).. ثم أوجب على المؤمن أن يستقرئ معالم الوحدانية والتوحيد في مظاهر الطبيعة ومجالي الكون من حوله، فكان من ثمة هناك “تفكير ينتهي إلى الله، وتفكير يبدأ به عز وجل”، وفي الحالين، يكون الفرد المتفكر على موعد مع التوفيقات، كالأرض تزدهر وتخرج ما في بطنها، سواء أأبكرها الغيث أم جاءها مُعْقِبًا.
ولا ريب أن أهل البصيرة الإيمانية يلمسون بكل يسر الروح التنويرية التي تجسدت فيها تعاليم القرآن، والكيفية المنطقية التي عرضت بها تسديداته، يقول الأستاذ كولن: “إن الذين يعملون في ساحة العلم والعرفان والحكمة، يطالعون هذا الكتاب العظيم بكل رغبة ولذّة، ويشهدون بأنه يشرح أسرار الوجود والأمور الدقيقة الموجودة في روح الطبيعة، ويضعها أمام أنظارهم”.
فالقرآن يُخرج الظواهر بمنهجه التوضيحي السهل، ويشرح المقاصد بالإيماء إلى ما بين العوالم الشاخصة والأخرى الخفية من صلة، ولا يقف عند ظاهر فيزيكيّتها، ويفتح أمام الذهن حقائق تنهدم بها أوهامٌ وطّدتها الدهور، ويقيم مكانها وَعْيًا جليًّا تتموضع به المعرفة الغيبية وتأخذ نصابها الصحيح، الأمر الذي يجعل منه (القرآن) مُعَلِّما للعقل، ومرشدا للروح، وملقنا لأساليب التفكير، “إن القرآن هو الذي يتناول كلّ جزء من أجزاء الوجود بعمق، فيوضّحها، ويشرح غاياتها ومحتوياتها وأسسها بشكل لا مجال فيه لأيّ تردّد أو شبهة”. ذلك لأن القرآن “يتناول (..) الحياة القلبية والروحية والفكرية للإنسان، وينظمها، ويريه أسمى الغايات والأهداف، ثم يأخذ بيده ويوصله إلى هذه الأهداف”.
إن هذا التدرّج المنهجي الكشفي هو الامتياز التسديدي الذي خُص به القرآن، إذ إن شمولية تلقيناته لا تنتهي عند أفق المعرفة العينية أو الحدسية التي يتساوى الناس جميعا في استبانتها، إنما هو يمضي بالعقل إلى الحدّ الأولي، إذ يضعه وجهًا لوجه أمام المعرفة القدسية الماورائية، بترشيده إلى معرفة الفاعل الكلّي، أي الخالق رب السماوات والأرض، الأمر الذي يجعل الإنسان -بهذه المعرفة- يستعيد حرّيته وينْعتق من أوهامٍ ظلّت تقيّده وتجعله روحًا شريدا يتعبد الأشياء والظواهر.. فعندما يمضي القرآن -مثلا- في التنبيه إلى حقيقة منظومة المجرّات والكواكب (الشمس والقمر والنجوم)، ويؤكد وظيفتها التسخيرية، فإنه يلقن الإنسان حقيقتين ساميتين في الآن ذاته:
1-تأكيد شيْئيّة هذه الموجودات التي طالما عبدها الإنسان وأنزلها منْزلة القداسة.
2-التعريف بفيزيكيّتها، باعتبارها جزءًا من الكون، من خلال تحديد وظيفتها في الحياة وحفظ الطبيعة.
وفي هذا وذاك إيعاز بالإفضال التي أنعم بها على من أوجده، والمسؤولية التي أناطها به، وهي الإيمان بالله وتعمير الكون بالصالحات.
بمثل هذه الترشيدات التي لقّنها القرآن للناس، فتح الثغرة التي سرعان ما تزلزلت لها صروح من الجهالة والشرك والضلال، إذ أتاح للعقل البشري أن يهتك حجب الوهم والزيف، ويفتح عينيه على الحقيقة الموضوعية، وبذلك عبَد الناس الله الواحد مخلصين له الدين، وأنشأوا من جديد علاقتهم بالكون وعناصره، ولَحَدوا إلى الأبد ثقافة التعدّد والشرك.
ومن المؤكد أن أبرز مكسب تحقق للبشرية بفضل نزول القرآن، هو تعديل رؤية الإنسان إلى نفسه، إذ أعاد القرآن موضعة الإنسان وأقرّ مركزيته في الكون، وجعله المستخلف في الأرض، وبهدا التعديل في مُسَلَّمات العقل البشري، تحول فكر الإنسان إلى طور الفاعلية والتحرر المسؤول، فلم يعد الإنسان خاضعًا لأرباب الوهم، أو للطبيعة الصماء، أو للعلل الخفية والأسباب المجهولة التي ظلّت تبلبل فكره وتؤرق روحه.. بل غدا الإنسان سيدًا لمصيره ضِمْنَ نطاق علاقة تديّن للخالق الأوْحد ربّ العالمين بالعبودية، وبذلك توفرت عوامل توحيد الرؤية الإنسانية إزاء الكون، وإزاء المصير المشترك، ورست دعائم الطمأنية للإنسان.. كما اتّضحت جليًّا محاذير عقيدة الكفر بالله، تلك العقيدة التي تجرّ حتما إلى أيديولوجية تأليه الإنسان (والهيمنة الفردية والجماعية). وإن عقيدة موت الإله التي تزعمها النتشوية مثلاً، والتي تتضمن عقيدة ربوبية الإنسان، هي تخريج معاصر لفكر تأليه المخلوق التي عاشتها الإنسانية في الأزمنة القديمة.
ومعلوم أن العقل دينامية تفكيرية من طبيعتها تعميم ونشر مكاسبها من المعرفة والقبسات والاستنتاجات التي تتاح لها، دعما لمداركها، وتجديدا ليقينها ومسلّماتها، وهو ما تهيأ للعقل الإسلامي بعد أن فاعلتْه تعاليم القرآن، إذ أطلقته من عقاله، فبات يسرح حرًّا في الآفاق، مستنير الأحكام، متثبتا في جنْي الاستنتاجات.
ذلك لأن القرآن العظيم يخدم روح الإنسان وفكره، فيطهّره من الشرك ويهيئه للتسديد السليم، ولم يتأتَّ للمسلمين الأوائل أن يفتحوا الامبراطوريات ويوطّنوا كلمة الله فيها، إلا لأن القرآن جدّدهم روحيًّا، وطبعهم فكريًّا ووجدانيًّا، فتهيّأوا على ذلك النحو لأنْ يكونوا ليسوا فحسب فاتحين، بل “هداة البشرية والمرشدين إلى الحضارة القرآنية”.
بآدابه وأخلاقه آخى القرآن بين الشعوب، ولحم أواصرهم، إنه “كتاب يقدح في أرواح من عشقه فكرة الحرية، ومفهوم العدالة، وروح الأخوة، والرغبة في مساعدة الآخرين، والعيش من أجلهم”.
ولا تفتأ الأطوار تكشف عن عظمة مبادئه وتساوقها مع روح الإنسان، مهما امتدّت بهذا الإنسان الارتقاءاتُ العلْمية والتدرجات المدَنية، ولا بدع أن نرى العصر الراهن كما يقول الأستاذ كولن قد بدأ يتّجه نحو القرآن بسرعة أكبر مما كنا نتوقع أو نتصوّر، وإن هذا التفتح الأممي على الإسلام، باتت مؤشراته لا تخفى على كل ذي عينين، بل لقد بات الإقبال على الإسلام -وإن كان بعد بسيطا- يؤرّق أعداء الدين.
وإن من دواعي الانجذاب إليه -راهنا ومستقبلا- “أنه كتاب إرشاد، يَسير أمام الذين فتحوا أعينهم على الحقيقة بهدايته، ويأخذ بأيديهم ليسيح بهم وراء الآفاق، ووراء هذا العالم.. وينفح في الضمائر الطاهرة نفحات الخير في كل آن”. فهو مدوّنة حقوقية سماويّة ترسي الحق الذي لا مكان معه لإجحاف؛ ومَضْبطةُ قيمٍ وأخلاق تستصفي السلوك، وتلجم الأنانية، وتكسر الغرور، وتعلّم الإنسان كيف يكون متواضعًا ومؤاخيا للطبيعة وما يعمرها من أنواع الأجناس.. إنه كتاب جامع للكتب، مُقِرٌّ بنبوءة الرسل أجمعين.
لقد “ربّى -إلى جانب أبداننا وأجسادنا- قلوبَنا وأرواحنا وعقولنا وضمائرنا، وهيّأنا لنكون إنسان المستقبل، بعد أن أرانا الذرى الموجودة وراء الشواهق المادّية والمعنوية”. ولن نستكمل جهوزيتنا إلا بالاعتداد به، فنقرؤه ونتفكر فيه ونفيد منه مثل ما أفاد طلاّبه الأوائل، إذ هو “كتاب يدعو إلى العلم والبحث العلمي، وإلى التأمّل، والى النظام في التفكير، وإلى قراءة كتاب الكون وفهْم أسرار الوجود”.
حقًّا “إن القرآن هو عيْن الإنسان للتفرّج على الخلود”، وإن “حكمةَ تنْزيل القرآن هي إِنشاء نمط جديد من هذا الإنسان الحالي الموجود، والنفوذ إلى القلوب التي لا يمكن لغيره النفوذ فيها، وإنشاء حاكمية الإيمان فيها، وإظهار وتعيين طرق الخلود والبقاء أمام الإنسان الفاني.. وجعله يستطيع التفرج من نافذةِ قلبه ووجدانه على الخلود، وعلى السعادة الخالدة، وهو لم ينتقل بعد إلى العالم الآخر”.
هكذا تحددت نظرة الأستاذ كولن للقرآن، إذ اعتبره أهمّ مقومات بناء التفكير الإيماني الفعّال، وأبرز مرجعية تصقل تفكير كلِّ مَنْ يتفتح عليه ويغرس فيه روح الفطنة والنباهة والإيمان الذي لا تتهوّش معه الحياة ولا تفقد به المعاني الجوهرية دلالتها وقيمها.. ولذا راح كولن يحذّر من مغبة سوء تعاملنا مع القرآن، قراءةً وفهمًا وتطبيقًا؛ إذ لم ينحدر بنا إلى الهاوية إلا ما طرأ على فهمنا لنصوص الشريعة من تهاتف وتسطيح سافرين، حيث انتكست الذهنية الإسلامية وباتت تتلقّى مقررات التنزيل على أنها مجرّد سرديات بلا مقاصد أبدية.
لقد تدارس نصوصه بوصفها مجاليَ قدسية حافزة للتدبّر العقلي، ومادة للتفتيق الفكري، تفتح معانيها وأساليب طرحها منافذَ الذهن، وتُقوِّي ملكات الاستقراء والتأمل. فالأستاذ كولن يؤمن بأن الله قد أوجد من خلال محكم تنزيله مدوّنة كتابية تثميرية، تتغذى بإدلاءاتها الروح، وتَترحَّبُ بمدلولاتها عوالمُ القلبِ، وتشرق بإيحاءاتها ومضمراتها شموسُ الوجدان، وتنمو بإيعازاتها طاقات الإنسان الفكرية، وتَنْشَطُ قابلياتُ الاستنارة العقلية، فتتّسع بذلك مداركُهُ في الاتجاه المنطقي الصحيح الذي يتأهّل به الإنسان للحياة العامرة بالمكارم والخيرات.
تفاعل كولن مع روح القرآن باستنارة فكرية متجددة، ورأى فيه المحرك الأقدس الذي راعى مقتضيات الإنسان الآنية والمطلقة.