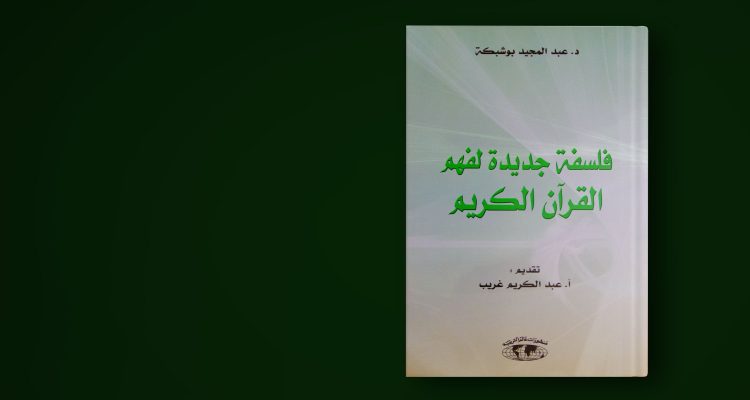منذ أن عرف الأستاذ “فتح الله كولن” الطريق واكتشف المفتاح شرع في الإيضاح، في كل المجالات والبطاح، فوظف لذلك من الوسائل ما ابتهج به الزمان ولاح. فهو لم يُفصلالقول في هذه الأضواء القرآنية، وإنما هي فقط مجرد مقتطفات حقانية من أجوبته الارتجالية على الأسئلة التي طرحت في مجالس ومسامرات مختلفة وحسب مناسباتها . فما بالك لو أن الرجل وشح ذلك بشيء من التفصيل كما فعل أقرانه في هذا الدرب الأصيل. نعم لقد وضع يده على الجرح وفقه الدواء، حتى عده كثير منالناس من أجود أطباء هذا الزمان.
ويسعفنا في ذلك ما نقل عن بعض الأفاضل من تلاميذ الأستاذ كولن، الذين أبلغونا أن الأستاذ “فتح الله” عاكف في السنوات الأخيرة عبر دروسه إلى طلابه، على تفسير القرآن الكريم تفسيرا كاملا، وأنه تجاوز في ذلك نصف القرآن الكريم. و من خلال استيضاحي عن منهج الأستاذ في هذا الأسلوبالتفسيري فهمت أنه:
أولا: يستمع إلى أقوال عدد من المفسرين في الآية عن طريق من يحضر جلساته من تلاميذه. وليث شعري، أي التفاسير هذه التي عول عليها؟ واستمتع بتقليب صفحاتها ومحاورة فكرية لأصحابها؟ و ما هي توجهاتهم المختارة في تفاسيرهم؟ وإلى أي عصر من العصور هم ينتمون؟ أهم من فطاحل العلم الأجِلاء، أم من الذين حازوا العلم وزاحموا أصحاب الدعوة؟ أم …أم …هذا ما سنتعرف عليه حين يأذن الله تعالى بأجله.
ثانيا: ثم يشرع الأستاذ في الشرح والتعليق على تلك الأقوال، شارحا حينا ومستدركا حينا ومضيفا أحيانا. ولاشك أنها وقفات كما عودنا الأستاذ، وكما سنبين نماذجها في كتابه موضوع بحثنا، تجمع بين ندرة المعاني وروعة المباني، الشيء الذي يجعل القارئ أسيرا لهذا المنهج الرصين.
ليس هذا فحسب بل إن الأستاذ كولن أصبحت لديه قناعة بضرورة تجديد التفسير من حين لآخر، فقد قال لي بعض الثقات من تلاميذه أنه يقول: “على الناس أن يجتهدوا في تفسير القرآن كل خمس وعشرين سنة”.
هكذا أحببت أن أرصع مقدمتي بما فهمته من إشارات الأستاذ في هذا الصدد، وأدبجها بما بلغني من عباراته التي لا تعدو أن تكون غيضا من فيض فكره العميق ومنهجه الدقيق في فهم وتفسير كلام رب العالمين. وقبل إماطة اللثام عن جانب من الطريق الذي اختاره الأستاذ لفهم وتفسير القرآن العظيم، أستسمح القارئ الكريم في دخول هذا الصرح عبر الأدراج الموالية، حتى يكون موضوع الكتاب في سياقه ومجاله:
– الدرج الأول: في معنى التفسير و الحاجة إليه:
– قال الراغب: الفسر: إظهار المعنى المعقول، ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفسرة. والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقال: تفسير الرؤيا وتأويلها. قال تعالى: وأحسن تفسيرا.
و التأويل من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا، ففي العلم نحو: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. –
– وقال السيوطي: التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف. ويقال هو مقلوب السفر تقول أسفر الصبح إذا أضاء. وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، وقيل من الإيالة وهي السياسة كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه.
– ونقل السيوطي عن الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله.
و عنه عن أبي طالب التغلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل مثاله قوله تعالى:( إن ربك لبالمرصاد) تفسيره أنه من الرصد يقال رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة.
– وقال الأصبهاني اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره. والتأويل أكثره في الجمل.
– وقال أبو حيان التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب.
– وقال الزركشي التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغه والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفه أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
– وقال الطبري: قال ابن عباس: التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ: وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسير لاَ يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لاَ يعلمه إلا الله تعالى ذكره. وقال و هذا الوجهُ الرابع الذي ذكره ابن عباس: مِنْ أنّ أحدًا لاَ يُعذر بجهالته، معنى غيرُ الإبانة عن وُجوه مَطالب تأويله. وإنما هو خبرٌ عن أنّ من تأويله ما لاَ يجوز لأحد الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ في إسناده نظر.
وعنه عن عبد الله بن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنـزل القرآن على أربعة أحرفٍ: حلالٌ وحرامٌ لاَ يُعذَر أحدٌ بالجهالة به، وتفسيرٌ تفسِّره العرب، وتفسيرٌ تفسِّره العلماء، ومتشابهٌ لاَ يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادَّعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. وأضاف الطبري: قد قلنا فيما مَضى من كتابنا هذا في وُجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجهٍ ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحَجبَ علمه عن جميع خلقه، وهو أوقاتُ ما كانَ من آجال الأمور الحادثة، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل: وقت قيام الساعة، ووقت نـزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك. والوجه الثاني: ما خصَّ الله بعلم تأويله نبيَّه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجةُ، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويلَه. والثالث منها: ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نـزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يُوصَل إلى علم ذلك إلا من قِبَلهم.
– لو حاولنا تلخيص ما سلف و سبر أغوار هذه التعريفات لوجدنا جلها متفق في الجوهر ومختلف في المظهر: فقول الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. ومن أقوال السيوطي: التفسير هو البيان والكشف. والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. وهو مضمون قول الماتريدي التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. أما تعريف الأصبهاني أن التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره. والتأويل أكثره في الجمل وهذا شبيه بكلام الراغب في التأويل. و تعريف أبي حيان للتفسير ينسجم مع تعريف الراغب. و قول الزركشي لم يخرج عن كون التفسير بيان وكشف للمعاني كما قال السيوطي والأصبهاني، إلا أنه زاد الأمر تفصيلا في الغايات والأدوات وذلك مراده ببيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات. أما الإمام الطبري فاستفاد من قول ابن عباس مع شيء من الإجمال.
– التفسير الذي نقصده:
إن التكلم في التفسير ليس بالأمر السهل، وربما كان من أصعب الأمور وأهمها، وما كل صعب يترك. ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه، ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها:
أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية ،يشتمل على معارف عالية، ومطالب سامية لا يُشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية، والعقول الصافية، وإن الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال الفائضين من حضرة الكمال ما يأخذ بتلبيبه، ويكاد يحول دون مطلوبه، ولكن الله تعالى خفف علينا أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه، لأنه إنما أنزل الكتاب نورا وهدى، مبينا لناس شرائعه وأحكامه، ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه. والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من المباحث تابع له وأداة أو وسيلة لتحصيله.
ولقد أجمع علماء الأمة على أن هداية الناس إلى سواء السبيل هي المقصد الأسمى للقرآن الكريم، وقد ورد ذلك بالإجمال والتفصيل في عدد من آي الذكر الحكيم نذكر منها للتمثيل لا الحصر:
– (ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ )/ البقرة 2.
– (شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيۤ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ)/ البقرة 185.
– (وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)/ الأعراف 52.
– ( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ)/الأعراف198.
– (هَـٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)/ الأعراف 203.
– (يٰأَيُّهَاٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)/ يونس57.
– ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰوَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)/ يوسف 111.
– ( وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِيٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)/ النحل 64.
– (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰلِلْمُسْلِمِينَ)/ النحل 89.
– ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ)/ النحل 102.
– (وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤمِنِينَ)/ النمل 77.
وقد أعجبني صاحب المنار في منهجه المختار حين أكد فقال:
للتفسير مراتب أدناها : أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير ، وهذه هي التي قلنا إنها متيسرة لكل أحد،(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ). وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة ، غير مكتف بقول فلان وفهم فلان، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك لفظ “التأويل”.
ثانيها:الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة. وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته، مع التفطن لنكته ومحاسنه ، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة . ..
ثالثها: علم أحوال البشر ، فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب ، وبين فيه ما لم يبينه في
غيره .بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإلهية في البشر ، قص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها . فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم .. ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه . قال الأستاذ الإمام : أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين) وهو لا يعرف أحوال البشر، وكيف اتحدوا، وكيف تفرقوا ؟ وما معنى تلك الواحدة التي كانوا عليها ؟
رابعها : العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن ، فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث به لهدايتهم وإسعادهم. وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة، أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه ؟
خامسها: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشئون دنيويهاوأخرويها.
– الاختلاف في التفسير:
إن المتأمل في نشأة الخلاف في التفسير سيلحظ علاماته منذ زمن الرعيل الأول الذين نزل بينهم وعاشوا تنزلاته. وكل من وقف على أقوالهم في هذه الفترة سيلحظ أن اختلافهم في التفسير القرآن الكريم وفهمه لا يعدو أن يكون اختلاف تنوع ليس إلا.
إن التفصيل في الروايات والبحث في الأسانيد في موضوع تفسيري قد يخرجه عن مقصده الأسمى وهو هداية الأمة وإصلاح حالها. ويوجد من المفسرين من انشغلوا بقضايا فرعية بالنسبة للتفسير، حتى تفننوا في بيانها أكثر من توفقهم في تفسير آي الذكر الحكيم، و فصل الكلام في هذا الموضوع كثير من الأعلام.
و قدأصل شيخ الإسلام ابن تيمية للنظر في آي القرآن الكريم بالتنبيه إلى أهمية الفهم الممنهج القاضي باستحضار المباني والمعاني، وهذا ما نبه عليه ثلة من العلماء غير ابن تيمية، لكن الرجل ههنا، لفت الانتباه إلى قضايا أخرى باتت تحتل مكانة خاصة في تحليل عامة النصوص، فما بالك بالنص القرآني؟ ومن ذلك تنبيهه إلى النص من حيث قدسيته وثبوته. ومنها استحضار لغة النص القرآني. ورغم ما تحمله من دلالات الإعجاز، فلا ينبغي حصر الفهوم كلها في الفهم العربي لأن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم ولكنه لكافة الناس. وبذلك فللأعاجم الحق أيضا في النظر والتأمل والفهم لهذا الكلام الرباني. يقول رحمه الله تعالى:
“إن الاختلاف فى التفسير على نوعين منه مامستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محققوالمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم… فهذه الأمور طريق العلم بهاالنقل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهوما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسيرالصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظالقرآن عليها و الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان منالناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالةوالبيان و الآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهمأن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.”
وفي نفس السياق يرى الإمام الزركشي أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد. والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي…وأما الثالث، وهم رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم… وجب الاجتهاد. والثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق.”
وفي إشارة إلى ما ينبغي على من يريد التصدي لتفسير القرآن الكريم، يدقق الزركشي بالتنبيه على ضرورة الالتفات إلىأفراد الألفاظ وتراكيبها أيضا. أما أفراد الألفاظ فمن وجوه ثلاثة: من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها، وهو يتعلق بعلم اللغة. ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلف، وهو من علم التصريف. ثم من جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول، إليها وهو من علم الاشتقاق. وأما تركيب الألفاظ فمن وجوه أربعة: الأول باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث أنها مؤدية أصل
المعنى وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو.الثاني باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادة معنى المعنى، أعني لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء، وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني. الثالث باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها، وباعتبار الحقيقة والمجاز، والاستعارة والكناية والتشبيه، وهو ما يتعلق بعلم البيان. الرابع باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله، وهو يتعلق بعلم البديع.
هكذا يؤكد رحمه الله تعالى على أمر مهم يخص الألفاظ القرآنية في حالتين. الأولى حالة الألفاظ حين تكون مفردة،ينبه إلى ضرورة التأمل في ثلاث علوم: علم اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق. أما الحالة الثانية وهي الألفاظ المركبة، فتنبه بخصوصها إلى إعمال النظر في أربعة علوم: علم النحو وعلم المعاني وعلم البديع وعلم البيان.
– الحاجة إلى التفسير:
لا تفوتني في هذا المقام الإشادة بما خلص إليه سلف أمتنا الأعلام في قضايا فهم و تفسير القرآن، لكن وبالتأمل في غيض ما أفاضوه في هذا السياق، إجماعهم على أن الهدف من إنزال الكتب هو هداية الناس وإرجاعهم إلى جادة الصواب، وما دون ذلك وما فوقه ليس إلا وسائط لتحقيق هذه الغاية السامية.
من أجل ذلك فإن بلوغ المرام هو تصيد المناهج السديدة والوسائط البليغة لتحقيق ذلك الأهداف، ومن ثمة فالنجاح رهين قربنا أو بعدنا من الهدى والضلال، صلب الموضوع القرآني ومناط تنزيل هذا الكتاب الرحماني و الرسالة المصطفوية. والخلاصة أن كلا من العلوم واللغات و المباني والمعاني، والعبارات والإشارات والتراكيب والألفاظ والأساليب والسياقات والمناسبات و غيرها… ليست إلا وسائط قد تنضاف إليها غيرها لتحقيق ذات الهدف الأسمى “هداية الناس كافة ” إلى سواء السبيل، كما تؤكد ذلك العديد من آي القرآن الكريم.
وبذلك تفاوت خاصة الناس وعامتهم في فهم وتفهيم كلام الله لعباده. فقد يتألق عالم في مجال أو مكان أو زمن معين، وقد نجد منهم من يسر الله له أسباب النجاح في التفوق في تفهيم وتفسير كلامه، بشكل ملفت قد يتجاوز فيه شرط المكان أو الزمان أو اللسان.
أما بخصوص الحاجة إلى التفسير فيقول جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: ” أما وجه الحاجة إليه فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أن الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه ، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه أنزل كتابه علىلغتهم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: أحدها كمال فضيلة المصنف فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز فربما عسر فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له. وثانيها إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لها اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. وثالثها احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه وقد يقع في التصانيف مالا يخلو عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المبهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك.
وأجدني مستعجلا للإقرار بوجود رجال أفذاذ من السلف والخلف قد برزوا في ذلك وخلدوا ذكرهم بفهومهم وتفسيراتهم القيمة، ومن بين هؤلاء رجل بلغ من ذلك مبلغا ونال في كثير من أقطار العالم المعاصر كل الاحترام، إنه صاحبنا العلامة محمد فتح الله صاحب كتاب “أضواء قرآنية ” موضوع تأملاتنا.
قد يتساءل بعض الناس عن السبب الكامن وراء هذا الاحتفاء العجيب بتفسير القرآن الكريم، فأقول بأن ذاك هم قديم جديد لدى عامة الناس وخاصتهم، يتعلق بكتاب الله تعالى من ثلاث جهات. جهة موضوعه وهي كلام الله تعالى وهو خير كلام. وجهة غرضه وهي هداية الناس إلى السعادة في الدارين. وجهة الحاجة الملحة إلى فهم معانيه. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ” فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى.” وقال أيضا: “وذلك أن الله قال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وقال (أفلا يتدبرون القرآن) وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم.”
– الأستاذ كولن والحاجة إلى التفسير:
لقد قلت في ما سبق مما نقلته عن أكثر من واحد من تلاميذ الأستاذ فتح الله كولن أن هذا الرجل عاكف في هذه الفترة على تفسير القرآن الكريم تفسيرا كاملا، وأنه بلغ في ذلك تقريبا سورة الكهف. إن الأستاذ كولن أصبحت لديه قناعة بضرورة تجديد التفسير، فهو يقول: “على الناس أن يجتهدوا في تفسير القرآن كل خمس وعشرين سنة”. وهذه قناعة لاشك أن لها قرائن كثيرة في صفوف العلماء تؤكد صحتها. من ذلك ما نراه من اختلاف بين المفسرين وتطور آراءهم مع مرور السنين والأعوام وحسب تقدم العلوم في كل مجال ومكان.
من أجل ذلك كانت للأستاذ فتح الله وقفات متميزة في كثير من الآيات الكريمة، وقفات تنم عن حس رهيف حيال كلام الله تعالى، إلى الحد الذي يوهم القارئ والسامع بأنه المعني الوحيد بهذا الخطاب الرباني، بل يستدرجك وأنت تتابع عباراته المنسابة للإحساس بالذنب والتقصير في الواجب إلى الحد الذي تكاد تتقمص شخصيته. كل ذلك عبر الجري بك في دهاليز المعاني وردهات المباني، مخترقا بك مسافات التاريخ حينا ومعرجا بك في سماء العلوم أحيانا، لا تنتهي من فقرة إلا وتلهث وراء الأخرى باحثا عن المزيد. وعبر كل هذه المراحل والأساليب تجدك أمام معاني قرآنية مثيرة وآيات ربانية عظيمة ما كنت لتنتبه إليها لولا هذا المنهج الأخاذ، في تفهيم وتفسير القرآن الكريم.
الدرج الثاني: التفسير عند بعض رجال الإصلاح:
نظرا لخصوصية الموضوع وتشعبه فقد آثرت ألا أثقل على القارئ الكريم بالدخول في بحر علم التفسير والمفسرين، أملا في استفادة عموم القراء الكرام من المكتوب، ثم طمعا في الوصول إلى هدف هذا المكتوب، وهو إشراك العموم فهم منهج هذا الكتاب القيم للأستاذ محمد فتح الله كولن “أضواء قرآنية” انسجاما مع منهج صاحبه الذي تجنبالغوص في عالم التفسير أو الدخول في خلافات وآرائهم المفسرين.
من أجل ذلك فقد قدرت أن يكون التمثيلبنموذجين اثنين من الأعلام، لما رأيت من تقارب بين منهجيهما وهدفيهما مع منهج الأستاذ كولن وهدفه، خاصة فيما يتقاسمونه جميعا من هموم هذه الأمة، وسعيهم المشكور في بناء جيل فريد لاسترجاع الإرث الضائع.
هذين العلمين هما الشيخ الإمام رشيد رضا والأستاذ العبقري حسن البنا، رحمة الله تعالى عليهم وعلى كل خدام الإيمان.
1. الشيخ رشيد رضا و تفسير المنار .
لقد جاء تفسير المنار نتيجة إقناع الأمام رشيد رضا لشيخه محمد عبده أن يكتب تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم، يعكس هاجسه في الإصلاح والتجديد. ولما تردد الشيخ عبدو في الأمر لعدم جدواه، اقترح عليه أن يكتب تفسيراً يقتصر فيه على حاجة العصر، ويترك كل ما هو موجود في كتب التفسير السابقة، وهو عين منهج الأستاذ كولن. يقول الإمام رضا محاولا إقناع شيخه: “إن الزمان لا يخلو ممنْ يقدِّر كلام الإصلاح قدره، وإن كانوا قليلين، وسيزيد عددهم يوماً فيوما، فالكتابة تكون مرشداً لهم في سيرهم. وإنَّ الكلام الحق، وإنْ قلَّ الآخذ به، والعارف بشأنه لا بدَّ أن يُحفظ، وينمو بمصادفة المباءة المناسبة له”.
وبدأ بالفعل إلقاء دروسه في التفسير بالأزهر الشريف ابتداءً من سنة (1899م)، وانتهى منه سنة (1905م) قُبَيل وفاة عبده، مبتدئاً من بداية القرآن الكريم، إلى قوله تعالى {وكان الله بكلِّ شيءٍ محيطاً} الآية 125 من سورة النساء.
ومن سمات منهج محمد عبده في التفسير “أن يتوسع فيما أغفله، أو قصَّر فيه المفسرون، و أن يختصر فيما ذكروه من مباحث الألفاظ والإعراب و البلاغة، و كان ينطلق كثيرا من عبارات تفسير الجلالين نظرا لاختصارها، فينتقدها أحيانا، ثم يتكلم في الآية بما فتح الله عليه”.
وكان رشيد رضا في أثناء دروس شيخه عبده يدوّن أهم ما يسمعه منه، فبدأ ينشر ما جمعه ابتداءً من سنة (1900م)، وذلك في المجلد الثالث من مجلة “المنار”.
ولم يكتف الأستاذ رضا بالنقل عن شيخه، بل كانت له زيادات كثيرة، وفي الغالب كان يميز بين أقواله و شيخه بقوله: “وأقول”، “وأنا أقول”، “وأزيد الآن”.
وبعد سنة (1905م) تاريخ وفاة شيخه،استقلَّ رشيد رضا بالتفسير، وكان ينوي القيام بتفسيرٍ كامل للقرآن الكريم، كما في كلامه في خاتمة عدد من أجزاء تفسيره، لكن منية الله وافته حين بلغ قول الله تعالى: {ربِّ قد آتَيتَني من المُلك وعلَّمتني من تأويلِ الأحاديثِ فاطِرَ السمواتِ والأرضِ أنتَ وليِّ في الدُّنيا والآخرةِ توفَّني مُسلِماً وأَلحِقني بالصالحينَ} (يوسف: 101).
– منهج رشيد رضا في تفسير المنار :
لابد من التنبيه إلى أن تفسير المنار كان في الأصل عبارة عن دروس شفهية، كان محمد عبده يلقيها على جمهور من الطلبة والمثقفين المصريين في الجامع الأزهر، ثم ويعرضه على شيخه فيقوم بعد ذلك بنشرها في مجلته المنار ابتداءً من الجزء السادس بداية منذ سنة (1900 م) ثم يعيد نشره في مجلد مستقل. ثم إن اختلاف المستهدفين والمكان والزمان، كله لاشك ساهم في عدم ضبط حدود المنهج الحقيقي الذي ميز تفسير المنار عن غيره من التفاسير.
لكن معالم منهجه قد أحال عليها بنفسه حين قال: “… وإنني لما استقللتُ بالعمل بعد وفاته، خالفتُ منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية، والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة”.
يمكن أن نفهم من هذا النص أنَّ رشيد رضا قام بعد استقلاله بالتفسير بتجديد النظر في المجال اللغوي، والعقلي عما تميزا به في منهج شيخه من جهة، ثم من جهة ثانية بالاعتماد على نصوص القرآن والسنةً و أقوال السلف ناهيك عن حضور المجال الفقهي، و الكلامي. وقد عول في ذلك على مصادر في الأثر مهمة منها تفسير الطبري و البغوي و ابن كثير و السيوطي ومن اللغويين على تفسير الكشاف و لسان العرب ومقاييس اللغة لابن فارس، رحمة الله عليهم جميعا.
كل تلك التحولات المنهجية في تفسير هذا الرجل المهموم بحال الأمة، تؤكد أن الشيخ رضا كان يبحث عن درب جديد في التعليم والتبليغ يقبله غالبية الناس ويتفاعلون منعه، أملا في خلق تيار إصلاحي قوي قادر على حلحلة الموضع المتردي للأمة والعمل على استرداد ما ضاع من إرث مجيد.
ولقد كان لهذا المنهج التجديدي الذي ميزه في عصره عن أقرانه، كبير الأثر فيما لاقاه ولازال من اعتراضات واحتجاجات وتطاول. ولاشك أن وجود الرجل في عالم لجي من الأفكار والمعتقدات والثقافات، قد أوقعه في جملة اجتهادات، لقيت اعتراض عدد من أهل العلم حتى في زماننا. فالرجل كما بين هو في منهجه محتار بين إتباع طريقة شيخه العقلية، وبين الانسياق وراء أعلام التقليد الذين أثبتت مناهجهما عجزها المطبق عن التغيير والمواجهة. وفي ظل الخوف من المنهجين المتطرفين أوجد لنفسه دربا جديدا يجمع بين المحاسن التي راقته في مناهج غيره. ورغم كل ذلك فقد لاقى الرجل انتقادات من كل الأطراف تقريبا.
– ومن معالم هذا الطريق:
1 – حرص الإمام رضا في تفسيره على إبراز الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية.
2. ذكره للآية التي يفسّرها مع ذكر معظم الآيات التي تتحدث عن الموضوع، فيكون بهذا المنهج من أوائل من تنبَّه لأهمية التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
3. اعتناؤه رحمه الله تعالى، بذكر أسباب النزول.
4. اهتمامه بذكر القراءات القرآنية.
5. كان حريصاً على ذكر النصوص النبوية في الآية و التعليق عليها و أسانيدها، و رواتها، وذكر مصادرها.
6. لم يتوسَّع في نقل أقوال النحاة، وعلماء البلاغة في إعراب الآيات.
7. التركيز على مكامن الهداية في الآي المفسرة، انسجاما مع منهجه واعتقاده بأن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد قبل كل شيء.
8. إكثاره من النقول في المجلدات الأخيرة من تفسيره عن عدد من العلماء أمثال: كتب ابن حزم والغزالي وفخر الدين الرازي وابن تيمية ، وابن قيِّم الجوزية وابن كثير.
9.لم يحسم الإمام رضا في موقفه إزاء تفسير آيات الصفات الشيء الذي جر عليه اتهامات وانتقادات جمة.
10.لم يكن يتحرَّج من مناقشة ونقد شيخه في بعض آرائه، وخاصة في المسائل العقدية.
11 . ربطه رحمه الله تفسير الآيات ومضمونها بواقع المسلمين ومشاكلهم السياسية والاجتماعية، واتخذ من ذلك وسيلة لتنبيه المسلمين، وتذكيرهم بواجباتهم و الرجوع إلى دينهم، مع انتقاد علماء عصره المقلدين.
12. في نهاية كل سورة كان يختتم كلامه بخلا صات للأحكام والقواعد والمقاصد التي ميزتها. 9
13. و أهم ميزة منهج الإمام رضا تذكيره في نهاية كل سورة بالسنن الإلهية في الخلق وفي الكون.
ونظرا لأرائه اللاذعة في حق المقلدين كما فصل فيها القول في تفسيره، فقد نال نصيبا وافرا من الانتقادات من عدة جهات. كما إن تأويله لبعض الآيات و تفسيره لبعض المعجزات جر عليه وابلا من الانتقادات، وصلت إلى حد اتهامه بإنكار الجن والملائكة ورد بعض الأحاديث الصحيحة.
2. حسن البنا والتفسير:
لم ينزل القرآن من علياء السماء على قلب محمد ليكون تميمة يحتجب بها، أو أورادا تقرأ على المقابر وفي المآتم، أو ليكتب في السطور ويحفظ في الصدور، أو ليحمل أوراقا و يهمل أخلاقا، أو ليحفظ كلاما ويهجر أحكاما.. وإنما نزل ليهدي البشرية إلى السعادة والخير {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم}
هكذا يفهم الأستاذ حسن البنا القرآن الكريم. لقد استطاع الأستاذ حسن البنا أن يعيش القرآن حقيقة وواقعا ويتجاوز مجرد التبرك والاحتفالية.
فهو يرى أن أفضل الطرق لفهم كتاب الله تعالى هو طريق القلب. وقد أجاب حين سئل رحمه الله تعالى عن أفضل التفاسير، وما أقرب الطرق لفهم القرآن؟ قال: قلبك، فقلب المؤمن لاشك هو أفضل التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى، وأقرب طرائق الفهم أن يقرأ القارئ بتدبر وخشوع، وأن يستلهم الله الرشد والسداد، ويجمع شوارد فكره حين التلاوة، وأن يلم مع ذلك بالسيرة النبوية المطهرة، ويُعنى بنوع خاص بأسباب النزول وارتباطها بمواضعها من هذه السيرة، فسيجد في ذلك أكبر العون على الفهم الصحيح السليم، وإذا قرأ في كتب التفسير بعد ذلك، فللوقوف على معنى لفظ دق عليه، أو تركيب خفي أمامه معناه، أو استزادة من ثقافة تعينه على الفهم الصحيح لكتاب الله. فهي مساعدات على الفهم، والفهم بعد ذلك إشراق ينقدح ضوؤه في صميم القلب. ولا شك أن من أخذ بهذه الطريقة سيجد اثرها بعد حين في نفسه ملكة تجعل الفهم من سجيته، ونورا يستضيء به في دنياه وآخرته إنشاء الله.”
وهذا هو المنهج نفسه الذي سلكه الأستاذ البنا في تفسير سورة البقرة. قد يبدو لغير المطلعين على فكر وثقافة الأستاذ البنا أنه اهتم كثيرا بالجزئيات كما يردد بعض خصومه، لكنا حين سبر أغوار مشروع هذا الرجل سنجد أنه كان قرآني الشكل والمضمون. فقد تعلق بداية بالقواعد الكبرى التي خطها القرآن الكريم كمنهج للحياة قبل أن يهتم بجزئيات تنزيلها على أرض الواقع. ويكفينا دليلا أن يشتغل بعض كبار الفكر والدعوة المعاصرين من تلاميذه ببيان ذلك. فهذا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يؤلف كتابا بعنوان ” دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين” وقليل من يعلم أن الكتاب ليس إلا ترجمة من تلميذ نجيب لما تضمنته رسالة الأستاذ البنا حول التعاليم من خلال الأصول العشرين، التي دعا فيها إلى وحدة المسلمين على منهج ثقافي وفكري شامل. ونفس الصنيع قام به رجل العصر وتلميذ الأستاذ البنا الدكتور يوسف القرضاوي في إطار شرح الأصول العشرين أيضا لأستاذه البنا عبر تأليف كتاب”نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام” وبهذا الصنيع نلحظ التأثير البالغ الذي تركه الأستاذ البنا في جيل بكامله ورث العلم والعمل عن أستاذ كبير كان القرآن ديدنه وسننه منهاجه.
إن غراس القرآن الكريم ترك لدى الأستاذ البنا ثمارا جمة في عدد من أعماله وتوجيهاته، لاشك أن ذلك الغراس ما كان ليكرم أهله لو لم يكن أصيل الجذور طيب المنبع. نعم إن كل ذلك جاء نتيجة جهد جهيد لتصحيح الإيمان وتجديد الاعتقاد انطلاقا من تفسير ما جاء في القرآن وتفهيم ما تضمنه من بيان. وهاك قوله في تفسير هذا الأمر:”سنقصد في الكتابة على بحوث خذا الفن –العقيدة- غن شاء الله تعالى على أمرين أساسيين، أولهما:الاعتماد على طريقة القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، في توصيل العقائد الدينية إلى النفوس واستيلائها على المشاعر والقلوب بدون تعمق في الألفاظ وتشعب في البحوث، أو إيراد لآراء والمذاهب، أو خوض في مصطلحات الفلاسفة والمناطقة والكلاميين والجدليين وتلك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وثانيها: العناية ببيان آثار هذه العقائد في النفوس ليعلم القارئ أين نفسه من درجة استيلاء العقيدة الإسلامية عليها،فإن كانت متأثرة بها، حمد الله على نعمته، وإن كانت هذه الآثار ضعيفة في نفسه، عمل على علاجها وتقوية إيمانها، فقد كانت العقائد عند أسلافنا عواطف مستقرة في القلوب والمشاعر، مستولية على النفوس، فلما أن صارت عندنا جدلا وكىما ضعف إيمان الأمة، وتسرب إلى دينها الخلل والوهن.
هذا المنهج العميق في تجديد الفهم للدين وتربية الأجيال عليه يعد زبدة المناهج الإصلاحية وعمودها الفقري. لأن الانطلاق من العقيدة الصحية والتعويل على الإيمان الكامل هو السبيل الأمثل للبناء الصحيح خاصة حينما يتعلق الأمر ببناء الإنسان. ولعل من ثمار هذا المنهج العميق ما رمقناه في الديار المصرية المباركة من أعلام مبرزين في شتى مجالات المعرفة، ومنها ما تميزت به تلكم الديار من نهضة إسلامية مباركة وصلت براعيمها عددا من البقاع.
– الأستاذ حسن البنا و كتب التفسير :
لعل الفكر الموسوعي للأستاذ دفعه لينهل من كل التفاسير التي وقعت بين يديه والتي كان واضح الإحالة عليها في جل دروسه وكتاباته تستند إليها. ولاشك أن حاجة العصر وتحديات الواقع تجره إلى التفاسير الحديثة ك “تفسير المنار” لإمام رشيد رضا، لكن ذلك لم يمنعه من الغوص بعيدا في تفاسير القدامى أمثال جامع البيان للإمام الطبري وزاد المسير للإمام ابن الجوزي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وتفسير القرآن العظيم لابن كثير…
إلا أن كل ذلك لا يمنعه من التنبيه على ما يبدو له من مزالق بعضها أو إفراط آخرين في تحميل القرآن الكريم ما لا يتحمله من المعاني البعيدة أو التفسيرات الغريبة، كما في ملاحظاته على كتاب” جواهر القرآن” للإمام الغزالي أو “تفسير الجواهر” للأستاذ طنطاوي جوهري، أو ما كان يصدر من طه حسين.
ولا يفوتني التنويه إلى أن سعي الأستاذ البنا في مجال الدعوة وخدمة الناس حاز تعاطفا واسعا وجلب ارتياحا كبيرا إلى نفوس كثير من المومنين، وذلك لما عرف به من أسلوب قرآني في خفض الجناح والدعوة إلى نبذ الفرقة والخلاف ووحدة الصفوف.
– ومن معالم هذا الطريق:
o العناية بالتفسير الموضوعي:
لقد تناول المفسرون القرآن من زوايا مختلفة وفسروه بطرائق عدة كل بما أفاء الله عليم من العلم والفهم. وهكذا وجدنا كتبا غاية في الجودة والإتقان في نواحي عدة من مجالات القرآن. ومن ذلك: “أحكام القرآن” و”مشكل القرآن” و”مجاز القرآن” و”إعراب القرآن” و”معاني القرآن” و “الأمثال في القرآن” و”الأخلاق في القرآن” و “الإنسان في القرآن”… وغيرها.
ولما كان فهم القرآن وتفسيره محور كل تجديد لفهم الدين فقد انبرى الأستاذ البنا، وفق ما شاع في عصره من اهتمام الباحثين والعلماء بهذا اللون من التفسير، إلى الإلقاء بحجته إلى الناس في هذا المضمار وذلك من خلال دروسه ” حديث الثلاثاء” حيث تناول فيها مواضيع شتى منها: حقوق الألوهية في القرآن – الكون غير المنظور في القرآن- الإنسان في القرآن- المرأة في القرآن- الرسالات العامة في القرآن- الجزاء في القرآن…وغيرها.
وقد بغض النظر عن ملاحظات وانتقادات بعض العلماء لمنهج الأستاذ البنا، فإن للرجل بعد نظر في الموضوع الإصلاحي استطاع من خلاله أن يخلف جيلا كبيرا من التلاميذ والمحبين لازالوا يتدارسون وينزلون فكر الأستاذ البنا في عدد من المجالات.
ومن الذين تتبعوا منهج الشيخ البنا نجد الأستاذ “طعيمة” قد رصد منهجه في تفسيره الموضوعي في عدد من القضايا فسجل ما يلي:
1. استيعاب الأستاذ البنا الشديد لمواضع الموضوع المتناول في القرآن الكريم، واستقراؤه للآيات واستشهاده بها بطلاقة.
2. أن الأستاذ اختار موضوعات يحتاج إليها المجتمع، وتفرض نفسها على عقول الناس، وخاصة الشباب منهم، في فترة انجذب الشباب إلى الأفكار الغربية وتأثروا بها.
3. أنه كان يسقط كل النماذج التي يتناولها على الواقع” …وبعد فهذه عبرة للشرق ليوم والتاريخ يعيد نفسه، وإن داوود الشرق لرابض بالمرصاد لجالوت الغرب لو وجد الأنصار المومنين فهلا؟..”
o التفسير بالأثر:
وذلك لإسناد آرائه بما أثر من أحاديث مشرفة وأخبار موثقة كما في تفسيره لسورة الحجرات
وسورة المجادلة.
o التفسير الواقعي:
– لقد كان هم الأستاذ البنا ما يرومه من أهداف كبيرة في واقع عمت فيه البلايا وانتشرت
الانحرافات وكثرت الاختلافات، فكل ذلك كان يتوسل إليه بما سبق من علوم الأثر، حتى يتسنى له تصحيح الواقع. ومن ثمة فإن المقصد الأساس في ذلك النبراس هو الواقع، لذلك كان تفسيره تفسيرا واقعيا بامتياز.
o المسحة الفقهية:
لاشك أن غزو الفكر والثقافة الغربية لمجتمع مسلم، سيخلف من الأفعال والسلوك ما يحتاج إلىبيان مواقف الشرع منها. وغير خاف على كل لبيب أن أمور الشرع منها ما هو ثابت لا يتأثر بتقدم الزمن ولا بتحول المكان، ومنها المتغير حسب أقضية الناس ومستجدات الحياة، والأستاذ البنا غير مخير في إبداء رأيه وجواب سائليه في الثابت والمتغير، كما أنه لا سبيل إلى نقل الثابت من آراء الشرع كما نقلها الخلف عن السلف، أما المتغير منها فقد أبدع وأجاد في كثير مما طرح عليه. بهذا المنهج لا يمكن لتفسير الأستاذ البنا إلا أن يتضمن من المساحات الفقهية ما يجعل صاحبه أستاذا مربيا وفقيها معاصرا.
أما أدوات التفسير عند الأستاذ فهي بادية للعيان من خلال ما سلف ذكره وبان. حيث أختلط فيها التفسير الأثري بما ضمه من شواهد قرآنية و بيانات نبوية بما رصده الباحثون من آثار فقهية وتحقيقات علمية عصرية، تخلل كل ذلك ملاحظات واقعية وتوجيهات إيمانية جعلت منه لونا من التفسير جديدا، و طعما لمذاق عنوانه الإمام حسن البنا الشهيد.
الدرج الثالث: التفسير الإشاري :
للحديث عن التفسير الإشاري تجدر الإشارة إلى أن التصوف نظرى يقوم على البحث والدراسة، و عملي يقوم على الزهد والتفانى في الطاعة. وعليه فالتفسير الصوفى ينقسم إلى تفسير صوفىنظرى، وتفسير صوفى فيضي أو إشارى، و يعتبر الأستاذ محيى الدين بن عربي شيخ هذه الطريقة في التفسير كما يتجلى ذلك في ما نسب إليه من كتب كالفتوحات المكية، والفصوص.
فالتفسير الصوفى النظري قد يخرج بالقرآن عن هدفه الذي يرمى إليه، فإذا كان القرآن يقصد هدفاً معيناً بنصوصه وآياته، فالصوفي أيضا يحدد هدفاً معيناً لأبحاثه ونظرياته. وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد، ولهذا يضطر الصوفى إلى تفسير أهداف القرآن وفق ما يقصده هو ويرمى إليه، محاولا تأصيل نظرياته وأبحاثه ، وبهذا الصنيع يكون الصوفى قد خدم فلسفته التصوفية. علما أن هذا المنهج كان ولا يزال ديدن عدد ممن فسروا القرآن.
أما التفسير الإشاري أو الفيضي فهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك.
وعلى هذا يكون الفرق بين التفسير الصوفى الإشاري والتفسير الصوفى النظري أن التفسير الصوفى النظري، ينبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفى أولاً، ثم يُنزل القرآن عليها بعد ذلك. أما التفسير الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية، بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفى نفسه حتى يصل إلى درجة تعن له فيها إشارات العبارات وما تحمله الآيات من المعاني. وأما التفسير الصوفى النظري، فيرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من المعاني، وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تُحمل الآية عليه. وفي التفسير الإشاري لا يرى الصوفى أنه كل ما يُراد من الآية، بل يقول أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويُراد منها أولاً وقبل كل شيء، وذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره.
في ذلك يقول الإمام الشاطبي: “وكون الباطن هو المراد من الخطاب، يشترط فيه شرطانأحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ، ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا، فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب، لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق …و أما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء”.
ويقول أيضا: ” الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر، إذا صحت على كمال شروطها، فهي على ضربين: أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات; فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف; فهو غير صحيح أو غير كامل، حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك. والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها ويتبعه الاعتبار في القرآن….فإن كان الأول; فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك; فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم، ولأن الاعتبار القرآني قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد; فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على مجاريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه; فإنه كله جار على ما تقضي به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل. وإن كان الثاني; فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول; فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن; فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة; فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا; فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص; فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه به المربي، وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله، فكون القلب جارا ذا قربى والجار الجنب هو النفس الطبيعي، إلى سائر ما ذكر; يصح تنزيله اعتباريا مطلقا، فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس براسخ. .. وأيضا; فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد، وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد; فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي…. وللغزالي في مشكاة الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء، وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة; فتأملها هناك والله الموفق للصواب.
قد يتساءل القارئ الكريم هل للتفسير الإشاري أصل شرعي يقوم عليه، أم هو أمر جَدَّ بعد ظهور المتصوفة وذيوعطريقتهم؟ خاصة بعدما تكلم في هذا الأمر كل من هب ودب؟
لم يكن التفسير الإشاري بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم، بل هو أمر معروف من لدن نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه القرآن، ونبَّه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا به. أما إشارة القرآن إليه، ففي قوله تعالى: {فَمَالِ هَـٰؤُلاۤءِٱلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} ، وقوله أيضاً: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً} ، وقوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أقفالها} فهذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن له ظاهر وباطن. وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى حيث ينعى على الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً، ويحضهم على التدبر في آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام، أو حضهم على فهم ظاهره، لأن القوم عرب، والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شكّ، وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، وحضَّهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده، وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم.
وأما تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك في قوله: “لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع” . وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “القرآن تحت العرش، له ظهر وبطن يُحاج العباد” .
ففي هذين الحديثين تصريح بأن للقرآن له ظاهر وباطن، ولكن ما هو الظاهر وما هو الباطن؟
اختلف العلماء في بيان ذلك وأشهر ما قيل فى معنى الظاهر والباطن أن الظاهر اللفظ، والباطن التأويل. وقال أبو عبيدة: إن القَصص التي قصَّها الله تعالى عن الأُمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأوَّلين، وحديث حَدَّث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحل بهم مثل ما حلَّ بهم . ولكن هذا خاص بالقَصص، والحديث يعم كل آية من آيات القرآن.
وحكى ابن النقيب قولاً ثالثا: وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق.
وأما قوله في الحديث الأول: “ولكل حرف حد”، أي منتهى فيما أراد الله من معناه، أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. وقوله: “ولكل حد مطلع”، قيل لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يُتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به.
وأما الصحابة فقد نُقِل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري وقالوا به، ومن الروايات الدالة على أنهم يعرفون ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحَّاك عن ابن عباس أنه قال: “إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تُبلغ غايته، فمَن أوغل فيه برفق نجا، ومَن أخبر فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومُحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجَالِسُوا به العلماء، وجَانِبُوا به السفهاء”.
وروى عن أبى الدرداء أنه قال: “لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوهاً”.
وعن ابن مسعود أنه قال: “مَن أراد العلم فليَثَوِّر القرآن فإن فيه علم الأوَّلين والآخرين”.
وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. وأما الروايات الدالة على أنهم فسَّروا القرآن تفسيراً إشارياً، فمنها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: “كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه فقال: لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَن حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قوله تعالى: {إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِوَٱلْفَتْحُ} .. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكداك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال: {إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِوَٱلْفَتْحُ} وذلك علامة أجلك، {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً} .. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مَا تقول”.
نعم إن بعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر، أما ابن عباس وعمر، فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر، هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق الإشارة.
وأيضاً ما ورد لما نزل قوله تعالى فى الآية [3] من سورة المائدة: {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلٰمَ دِيناً} .. فرح الصحابة وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: ما بعد الكمال إلا النقص، مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج ابن أبى شيبة: “أن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما يبكيك”؟ قال: أبكاني أنَّا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إلا نقص، فقال عليه الصلاة والسلام: “صدقت”.
فعمر رضي الله عنه أدرك المعنى الإشاري: وهو نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرَّه النبي على فهمه هذا، وأما باقي الصحابة، فقد فرحوا بنزول الآية، لأنهم لم يفهموا أكثر من المعنى الظاهر لها.
هذه الأدلة مجتمعة تؤكد لنا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن .. ظهر يفهمه كل مَن يعرف اللِّسان العربي وبطن لا يفهمه إلاأصحاب الموهبة وأرباب البصائر. غير أن المعاني الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركنا القاصرة، بل هي أمر فوق ما نظن وأعظم مما نتصور، لذلك يختلف الناس في فهمها والله تعالى أعلم.
والخلاصة أن التفسير الإشاري يُقبل بشروط: منها أن لا يكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم
القرآني الكريم. ومنها أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. وثالثها أن لا يعارضه دليل شرعي أو عقلي. وأخيرا وإضافة إلى المعنى الباطن لابد من التسليم بالمعنى الظاهر أولاً، إذ الظاهر طريق الباطن.
– الأستاذ كولن و التفسير الإشاري:
يقول الأستاذ كولن في هذا الصدد كلاما نفيسا أقتبس منه ما يلي: “يوجه القرآن خطابه للإنس وللجن أجمعين. يأمرهم وينهاهم ويضع بعض المحرمات أمامهم، وينقل كلامهم وكلام الشياطين. وهو في كل هذا معجز على الدوام. ولا يكمن إعجاز القرآن هنا في مجرد النقل، بل في كيفية هذا النقل، والعناصر والصور والنقوش التي يستعملها ويختارها. والناحية الإعجازية الأخرى فيه هي أن هذه الأخبار التي ينقلها غيبية.
أجل! فقبل كل شيء فإن اختيار القرآن للعناصر والأدوات اختيار رائع وخارق للعادة. ثم إن القرآن يستعمل هذه العناصر والأدوات في أسلوب مختلف معجز لا يمكن الوصول إليه ولا حتى مقاربته. أسلوب يخرج عن طاقة الإنس والجن. ولكن لكي ندرك هذه الناحية علينا النظر إلى آيات القرآن نظرة واسعة وشاملة، ولكي نوضح هذا الإعجاز علينا إعطاء بعض الأمثلة وبعض التفاصيل: كثيراً ما نحس بأحاسيس ومشاعر في أعماق أرواحنا، ولكننا نعجز عن التعبير عنها، عند ذلك نئن تحت ألم العجز… أجل! هناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير بدقة عن أحاسيسهم العميقة عندما يتحدثون أو يكتبون فيطوون قلوبهم على آلام هذا العجز…فإن تناولنا القرآن من هذه الزاوية نستطيع أن نقول: سواء أتكلم القرآن بلسان الشيطان أو الجن أو الملك أو فرعون أو نمرود أو شدّاد فإن الأسلوب المستخدم في البيان والإفصاح يعود للقرآن تماماً. وهذا الأسلوب خارق للعادة إلى درجة أن بابه يظل مفتوحاً لجميع المعاني الإشارية والرمزية، ويكون صالحاً لتفاسير واسعة، ولا يوجد أي بيان آخر يستطيع التعبير عن غايته بهذا الأسلوب ولا استعمال مثل هذه الأدوات والعناصر والصور والأشكال بهذه الروعة المعجزة…أي … لكل كلام توجهات مختلفة نحو اللطائف الربانية في الإنسان كالقلب والسر والخفي والأخفى، حيث يستهدف الوصول إلى هذه اللطائف. فإن كان فيه تناقضات بين هذه المراتب من ناحية المعنى دل ذلك على نقص في هذا الكلام. وهذا النقص موجود -بنسب مختلفة- في البيان البشري بأجمعه. أما القرآن فبريء من مثل هذا النقص ومنـزّه عنه. وهنا يرد شيء آخر كذلك، وهو إن كانت المعاني الواردة إلى القلب قد نخلت وصفيت من خلال التخيل والتصور والتعقل وحافظت على نفسها ووصلت إلى مرحلة اللفظ والإفصاح عُدّ هذا بياناً ممتازاً. أحياناً لا يستطيع الكلام تجاوز هذه المراتب دون تغيير وتبديل، فيبقى في إطار الحديث للنفس، وتفوته فرصة الوصول إلى مرحلة اللفظ والتعبير الخارجي. أما تعبير علام الغيوب -الذي يعلم السر وأخفى- عن هذا الحديث النفسي الصامت فمسألة أخرى لا نريد الخوض فيها، لأننا نريد هنا الاقتصار فقط على الكلام الملفوظ…”
إن هذا الكلام العميق من الأستاذ كولن دليل على أن فهوم الناس للقرآن الكريم تتفاوت بتفاوت الأساليب القرآنية والأدوات المستعملة والصور المنقولة والأحداث المقروءة، والناس في فهم ذلك درجات. إن الحقائق القرآنية واللطائف الرحمانية تشتمل على الظاهر والباطن والجلي والخفي والأخفى، فإن عجز البشر عن الوصول إلى تلك المعاني وتذوق تلك اللطائف فعليه أن يتهم نفسه، أما القرآن فبريء من كل ما ينتاب كلام الناس من الغموض والنقصان.
إن شغف الأستاذ كولن بالقرآن الكريم جعله يهفو إلى ما غاب عن كثير من المفسرين من إشارات ربانية ولطائف حقانية أضفت على شروحه وتفاسيره لآي القرآن الكريم طعما لا يقنع منه من تذوقه، وذلك في كل كتبه بخصوص آي القران الحكيم. ونظرا لعدم تمكنيمن الاطلاع على ما أنتجه الأستاذ من تفسير –قيل أنه وصل فيه منتصف القرآن- فإني سأعول على ما تيسر بين يدي، وهو كتابه “أضواء قرآنية” كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.