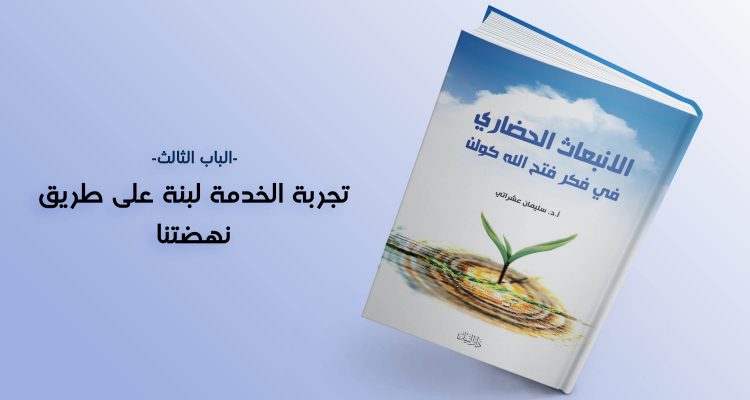بسقوط جدار برلين دخلت الإنسانية في طور تاريخي وحضاري فارق؛ قلة هي الدول التي أدركت يومها ذلك التحول النوعي الحاسم. وفيما كانت بعض بلداننا العربية تستشعر أن الغطاء سقط من على رأسها فجأة بسقوط الاتحاد السوفيتي، كانت دول أخرى ترى أنها انتهت إلى المرحلة التي فقدت معها ما كان لها من قُرب عند المعسكر الغربي، المعسكر الغالب.
القطبية آذنت الناس بهيمنة الرأسمالية على العالم مطلقًا، والتحالفات فقدت معناها، بات فتح الحدود في وجه بضاعة وفكر وإملاءات السيد الجديد هي وحدها الطريقة التي تكفل كسب ودّه.
كانت دولنا في تلك الأثناء كمملكة النمل حين يداهمها المحراث في تربة الحقل، بل لقد كانت أشبه بالحريم ساعة ينتهي إليهن نعي معيلهن، فهن شائشات بائسات يبحثن عن بعل جديد أو خادن، يسد مسد السيد الهالك.
يومها كان كولن يعلن في جموع المصلين من على المنبر، أن فجرًا جديدًا قد وُلد، وأن على العاملين الجادين أن ينطلقوا بلا تردد في الآفاق. فطريق العولمة الذي شرَّعتْهُ تلك الكَسْرةُ المذهلة لن يظل طويلاً مفتوحًا في وجه كل سالك. يومها تداعى الأبطال من كل حدب، وشرَع كلُّ واحدٍ يستخرج ما ادخر ويلقي به في الأرض، وجاء المهندس بشهادته وخبرته، والمقاول بمعاوله وشاحنته العتيقة، وصاحب الورشة بإسهامات عُماله، وتقدم رب المصنع بعقوده، والتحق الطبيب يحمل سماعةً وحُقَن بنسيلين يَصْحَبُها معه في حقيبته دائمًا للطوارئ، والمعلم المتقاعد والممرّض، والطالب، وخرّيج الجامعة.. كلهم وقفوا في ساحة المسجد يستمعون إلى كولن، وهو يهيب بالعاملين إلى العمل، وكل يكتتب بما في كسْبه.. كان هناك كهل فلاح يحل بيد خشنة حزامه على ما دسَّ فيه من مبلغ، وآخر يستخرج من كمّه حفنة من الليرات، وبعضهم ورقة دولار، وتتابعت أكثر من يد تلقي إلى الكومة بشيك من العملة.. أولئك كانوا عمالاً وأرباب مرافق ومؤسسات عادوا من مواطنهم بالمهجر، فصادف أن سمعوا الدعوة، فلبّوا بلا توانٍ. أولئك كانوا تلاميذ قدامى، أو أتباعًا عرفوا صوت كولن في الأشرطة المهربة، فوضعتهم كلماته على الطريق، والتحقوا بالركب بنية خالصة وتوبة عميقة.
وتقدم كولن فشق بعصاه كومة المال نصفين، ثم بحركة عمودية شقّها ثانية فصارت أربعة أحواز، وتقدم الناس، كل طائفة حملت حوزة، وسارت تضرب في الأرض، وتُيَمِّمُ وجهَها شطْرَ قارة من قارات الأرض.. كانت حركة الخدمة قد انطلقت، بتلك الخطوات البسيطة. كان مشروع بناء الحضارة قد بدأ.
ونحن نبني حضارتنا
حين نقرأ عنوان هذا الكتاب، يلفتنا تصدُّر حرف الواو في العبارة، ويستطيع القارئ أن يتأول للواو محلاً نحويًّا ينسجم مع قصد الخطاب؛ إذ يمكن القول: إنها واو الاستئناف، أو الابتداء، ويمكن القول: إنها واو الحال، أو أنها للمعية، أو أداة نسق عاطفة.. إلى ما هنالك من إمكانات تحتملها القراءة التقديرية للجملة.. لكنَّ أَوْجَهَ التقديرات -بحسبنا- هو أن الواو في هذا العنوان واو الاستغراق؛ إذ إن النسق هنا يفيد -وبصورة أوضح- المباشرة والانخراط والاسترسال. فالحدث (حدث البناء) قد شُرع فيه، وهو مستمر، يستغرق الفاعلين ويشغلهم، فهم ملتبسون به التباسًا عضويًّا لا فكاك عنه؛ إذ اشتمال الفعل في الجملة على فاعل ظاهر (نحن)، وآخر مضمر في الفعل (نبني)، له إفادة التأكيد والاستغراق والمناجزة.. وربما شاكل هذا الخطابُ آية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾(الْمُؤْمِنُون:4) من حيث الأداء والإبانة عن معنى الملازمة والاستغراق.
لا شك أن للعنوان بهذه الصيغة مرامي تصريحية جلية، فقد أخذ سمة البيان الإعلامي، واستوعب قيمة العرض والخطبة، حتى لكأن الدلالة الضمنية فيه تقول: ها نحن باشرنا البناء، وإن الجهود لتستغرقنا في إنجاز صرح الحضارة، وها نحن نسير بنفس الاجتهاد والتفوق الذي أنجزناها به من قبل.
ومن المؤكد أن القارئ المتابع لكتابات كولن، يتداعى بسهولة إلى ذهنه عنوان كتاب آخر، صِنْوٌ لهذا وقسيم له في الموضوع، هو (ونحن نبني صرح الروح)؛ إذ الكتابان يلحّان ويلفتان إلى أن هناك انطلاقة تشييد ميمونة قد بدأت، ينهض بها فيالق الخدمة، حاديهم في ذلك الإيمان والاستماتةُ.. انطلاقة تعمير، تستهدف وضع الأسس الروحية والأدبية لنهضة تسترد بها الأمة ما سُلب منها بالأمس من سبق وعز.
العولمة والعولمة المضادة
حين انطلقت القوى والكيانات الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات والقوى الاحتكارية، وراحت تُرسي سلطانها على الأرض تحت عنوان العولمة، انطلقت بالتوازي زُمَر من شباب الخدمة ورجالها الطيبين، يسعون هم أيضًا إلى أن يضعوا أرجلهم على الطريق، ويبدأوا في اغتراس بذور الخدمة عبر الأقطار والأصقاع التي وصلوها كطلائع مسلمة تملك من المال قدرًا ضئيلاً، وخبرتها في التثمير محدودة، ولكن لها طفوح إيماني قوي يجعلهم يتقبلون تحمُّل التحديات، ويعملون على تخطّيها بالصبر والتدبير والاستعانة بالله.
لقد كانوا تعلموا في دروس الوعظ والتوجيه التي داوموا عليها سنوات وسنوات في حلقة أستاذهم كولن ومجالسه وخطبه، أن الأعمال الكبرى في التاريخ بدأت صغيرة، بل بدأت في صورة أفكار، ثم تحولت بالإصرار والعزيمة إلى برامج وخطط ومنشآت حازت موقعها في تاريخ الإنسانية.
كان كولن يدرك أن الرأسمالية التي انفسح لها الطريق عريضًا، ستحمل للمجتمعات مزيدًا من شرور الربا والاحتكار والابتزاز. وكلها أمراض وإن واتاها الظرف الجديد، وساعدها على التوسع والازدهار، فإن ذلك لن يدوم ولن يستمر إلا لبعض الوقت؛ لأن نظم التعامل الجائرة والقائمة على أخلاقيات النهب والاستئثار، مآلها إلى السقوط، وأنه كما سقط النظام الشيوعي لخروجه عن حدود الفطرة، ومخالفته روح المنطق الاجتماعي السوي، لا محالة سيسقط النظام الرأسمالي الذي يرتكز هو أيضًا على طبيعة شرسة تنافي مبادئ العدل والتعاون التي أرساها الله قاعدةً للاجتماع البشري، وشددت عليها رسالات السماء، وهي توجّه الإنسان نحو الجادة القويمة.
المآل المشؤوم
لم يكن منطق الأشياء يحتمل أن تجاري تلك المجموعاتُ العزلاءُ من طلائع شباب الخدمة ترساناتٍ عالمية لها النفوذ والصولة والإمكانات اللامحدودة على التمدد في الأرض، وفي أقطار السماء، لكن كولن، العقل المجهّز لتلك الطلائع الخدمية، والمقحم لهم في الميدان، كان متيقنًا من أنه يقوم بما يقوم به، في إطار فهم نوراني، يؤكد له أن ساعة النهوض قد أزفت، فالقوى الشيوعية التي ظلت سادرة في غلواء تجبرها قد انهدت بلا مقاومة، مُؤْذِنَةً بتحقق وعد الله لعباده المؤمنين المستضعفين بأنه سيورثهم الأرض، بل لقد كان كولن واثقًا من أن المصير الدماري نفسه ستعرفه كل قوة باغية أخرى على وجه الأرض.
طالما كانت خطبه المتنبئة بالمآل المشؤوم للطغاة ممن حادُّوا الله واستهانوا بالروح، تثير السخرية، بل وتسبب له الملاحقات. لقد ظلت معاناته تتزايد؛ نتيجة رفضه أن ينساق في نهج الإنكار.. وكلما أمعنوا في العمل على قهره وتصفيته، أمعن هو في الجهاد والمناضلة، لا تزيده مظاهر التربب إلا قوة وإيمانًا بأن النصر قريب، بل لقد لبث يتوقع أن خراب المعسكرين كان يتسارع ويقترب من أجله باطراد وتصاعد قوتهما الضاربة، وتمادي الأنظمة الأيديولوجية المرتبطة بهما في البغي والعدوان. وكان أمرًا طبيعيًّا أن يقرأ كولن في واقعة سقوط الاتحاد السوفيتي أول نُذُر الله المتحققة، لذا لم يتردد في تجييش ما أمكن أن يحثه من تلاميذ ومحبين، وأن يدفع بهم نحو الآفاق، في اتجاه صنع عولمة من نوع جديد، عولمة لم يكن لها- قطعًا- ما تعتد به، قياسًا إلى عدة وعتاد وسيطرة القوى العالمية التي تنافست فيما بينها على اقتسام الأرض واحتكار السوق، لكن كولن كان يدرك أنه بتلك الزُّمَر القليلة كان يدشن المسيرة التي طالما حلم بها وحلمت الأجيال المقموعة من أهل الإيمان. كان يعي بامتياز مغزى قصة سباق الأرنب والسلحفاة.
كيف يقرأ كولن الأحداث؟
كان الإيمان بالله أول مصدر يستقرئ به كولن الأحداث، ويقرأ الوقائع، ويفقه حراك المدنيات وتطوراتها..
لقد لبث يستخرج من قصص القرآن ومن سير الأنبياء ومن أسفار التاريخ ما يؤكد له حتمية انهيار إمبراطوريات البغي، لذا لبثت دروسه وخُطبه وبياناته وتوصياته تصبّ في هذا الاتجاه، وترسخ في ضمير الشباب والأحباب عقيدة قرب مجيء الفرج، حتى إذا ما تهاوى جزء من سلطان الأيديولوجية المادية، كانت الفراسة الإيمانية التي يتمتع بها كولن مهيأة لأن تُصدِر التوجيه المناسب في الوقت المناسب، فكان من نتيجة ذلك الإجراء الفذ أن تحولت به أفواج من المؤمنين إلى الآفاق، ينشرون الإيمان، ويبثون الدعوة، ويقدمون الخدمة للعالمين.
لا ريب أن كولن وهو يُقْدِمُ على اتخاذ ذلك القرار، كان يستحضر خطوات الرسول r وهي تتسلل بين الأعداء الشاهرين سلاحهم، تتحسس طريقها تحت جُنْح الليل، تمضي إلى المَهْجَر؛ لتواجه إمبراطوريات الأرض من روم وفرس وحبش وسند وهند.
وبقدر ما كان كولن يعرف أن عُدته في استشراف المستقبل واستبصار المسار التاريخي للبشرية كانت عُدة يقينية؛ لأنها استمداد من قوانين الله كما رسمتها آيات القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وأنه بذلك كان متيقنًا من إفلاس وتبدد شمل المدنية المعاصرة التي طالما ردَّد على الناس أنها مدنية انتهت إلى السقف الذي تَوَعَّدَ اللهُ عنه بالعقاب اللازب.. على ذات القدر واليقين كان كولن يؤمن بأهمية الانطلاقة التي أعلن عنها، والحملات التي جهّزها ودفع بها إلى الآفاق.
دعوة كولن… عوائق وحقائق
لقد كان يعرف أن الحركة التي وفَّقه الله إلى استحداثها عشية تلك الانعطافة، والتي بدأ في التجهيز لها على مدى عقود حالكة اشتدت فيها قبضة الطغيان، تُضيقُ الخناقَ على الإيمان، وتحارب رموزَه، كانت حركةً دفَعَ بها الله إلى الوجود ولا رادّ لأمر الله؛ ذلك لأن كولن يعتبر أن خطته الخدمية هي حراك مسترسل في الزمن، وإن خفي عن الأعين، انتهت إليه موجة الدفع المنبعثة من أعماق التاريخ، فأنعشته وبعثت فيه الروح.. تلك الموجة الولود التي حصلت على يد صاحب الرسالة الأشرف r وصحابته المكرمين، وشاء الله لها أن تستمر في الزمان، تتجدد على يد الأجيال المتلاحقة كلما تهيأت أسباب اليقظة وانتهت إليهم مدود الروح المنبعثة من عهود العز، فينهضون ويستأنفون السير، ويمضون على سبيلٍ يشاء الله أن يوطّده لدينه ولأمته خادمة الإنسانية.
سدّد كولن حيث أخفق الماديون والاستراتيجيون المغترون بأيديولوجياتهم، والعَمُون بقوانين الجدلية والحتمية والتحدي، وبتوهمات دوغمائية ربطوا بها فهمهم للتاريخ، فلم يعودوا معها يلتفتون إلى الأبعاد القدرية التي هي جزء راسخ في ماهية الوجود وحياة البشر وسير الأحداث واسترسال أطوار التاريخ.
لقد ظل كولن متيقنًا من أن حركته الدعوية التي بدأت بسيطة، وغِرَّة، وغير ذات طَوْل، سيترتب عنها النماء المتزايد، والتوسع المتسارع، والبركات المترادفات التي ستغدو بها قوة تنويرية وبنائية تشق طريقها بالدعوة إلى الحقيقة والسلام، وستطال روافدها الخيرية كل صقع وبقعة من العالم، وستصل إلى الناس كافة.
وحررت العولمة وسائل التواصل البشري والإعلامي وعدَّدت أسبابه، وقرَّبت الشُّقّة بين الأقطار، وساهم ذلك في فتح العيون على ما كانت الأيديولوجيات تُخفيه. فرأى الشقيق شقيقه وعرف موطنه وحدوده، وأحسَّ فجأة بالعاطفة -التي غوَّرتْها عهودُ الطيشِ والتردي- تنبعث في الأعماق وتشدّ النسب (الروحي) إلى نسبه، واللُّحمة إلى لُحمتها، وحلت بالديار العربية والإسلامية الأفواج الأولى من رجال الخدمة، وانطلقت حركة تعمير يديرها عمَلةٌ ومسيرون آتون من ديار الآسِتانة، والتقاهم الناس في الورشات وأماكن العمل، وتعرفوا عليهم في المساجد والبيوت، وانعقدت شراكات اقتصادية وتجارية ساهمت في الانتعاشة، وفُتحت مدارس ومؤسسات تعليم سرعان ما عرفت التزاحم على أبوابها، وطابت نفوس شباب أتراك ممن نزلوا عمالاً ومتدربين (على الخدمة)، ولمسوا الطبع المشترك والأخلاق المتقاسمة مع من حلوا بينهم من إخوة الدين والملة، فانفتحوا على البيئة وتعددت القرانات.. طور آخر تتجدد به حياة مشتركة عاشها العرب والأتراك قرونًا متلاحقة تحت راية واحدة يسدون الثغور حماية للبيضة والشرف.
لم ير أولياء الأمر عقليةَ الإجرام وثقافةَ المافيا تنتقل مع هذه الأفواج التركية إلى الوطن، ولا رأوا تصعيدًا لموجة فتح مقاصف ومرافق سياحة تفيض على المجتمع بمبيعاتها من الخمر، وبأخلاقها من الخلاعة والتردي المعنوي.. وبدل من ذلك رأوا رجالاً يستغرقهم العمل، وأخلاقًا تسمها العفة، بل رأوا حركة ثقافية تجارية مرشَّدة تتزايد، وأواصر إخاء تنعقد، ووشائج قربي تتوطد.
الطرق التي فتحتها الأنظمة تجاه تركيا، والمواصلات النشطة معها، والتسهيلات التي باتت تتيح للآلاف من الشباب والرجال والنساء أن يزوروا تركيا، بل وأن ينزلوها مسترزقين من تجارة الشنطة، لم تُشعْ في المجتمع ما أُمِّل لها أن تشيعه من أخلاق لادينية، وتحرر متغرب، وميوعة متسفلة، وإنما رأوها تنقل إلى الناس سلوكًا يجسّد الهمة في العمل، ومعاني الكفاح، وحسن التصرف، والاعتماد على النفس، وهي قيم تفتح أمام الفرد والجماعة باب التقويم البنّاء، والنقد الذكي، والوعي بحقيقة الانغلاق الاقتصادي والتجاري والسياسي الذي عليه المجتمع والوطن.
كانت تلك الجموع من المواطنين العرب الذين يزورون تركيا يلمسون حقيقة التغيير والنهضة والاعتداد بالنفس الذي يسود بلاد الأناضول، وهي أحوال بقدر ما تُبهِج الأفئدة، تثير الحسرة والتوجع لغيابها في أوطانهم.
ولم يَفُتْهم أن يدركوا أن السياسة في تلك البلاد كانت تصنع كل يوم إنجازًا، وكان يديرها أحزاب منتخبة، وكان الإسلام من خلال رموز الدعوة والإصلاح يتصدر الحراك الاجتماعي، وكان الساسة المسلمون يحققون كل حين من النجاحات والرهانات ما تخجل به القوى المتغربة التي طالما عَزَتْ إلى العنصر المسلم العجز والتخلف، بل وطفقت ترميه بالتحجر ومعاداة المدنية.
هكذا جاءت النتائج المترتبة على خطة ربط الصلة مع تركيا، فبدل أن تكون تلك الصلة مددًا يدحر روح التطلع والتدين والشعور بالذاتية، راحت تلك الصلة تقوّي سجايا الأصالة والعمل والتثمير.
لا ريب أن دارس التاريخ في المستقبل سيسجل تأثيرًا ملموسًا ليقظة الأتراك الراهنة على الأمة العربية، تلك اليقظة التي أسَّس لها الفكر الإسلامي المعاصر، لاسيما فكر النورسي وكولن، ونشّطها أتباعهما، ونقلوها حية في صورة فكر ومشاريع خدمة وإنتاج وتثمير.
ومن المؤكد أن نهضة تركيا الراهنة تجد في سياسة التقارب مع العرب والمسلمين نفس الفوائد التي يجدها كل شعب جراء انفتاحه على بقية أشقائه من شعوب الأمة؛ إذ إن الأتراك من خلال دعم التقارب مع الأمة العربية والإسلامية يعملون على توجيه المسيرة في اتجاه يعاكس ما ظلت موجهة نحوه خلال عقود من التغريب، والسير في أرضية مدنية وتاريخية مضللة.
إن حركة الخدمة، وهي تسعى لأن تمد لها فروعًا في بلاد المسلمين، (علمًا بأنها حركة دعوية مفتوحة على بلاد العالم) لا تريد أن تستلب الأهواء والضمائر، ولا أن تستغوي الفئات والأوساط على نحو ما تفعل الأيديولوجيات حين تراهن على اصطناع أجنحة وتيارات تضمن بها التدخل والتحكم والتأثير في الأوطان.
كلا، إنما هي ترغب في أن تعزّز الوجهة بجعل جذور الشعب التركي تضرب من جديد في تربة البلاد التي ترتبط معها روحيًّا وحضاريًّا، إنه نوع من تهريب المواجد والمشاعر والأحاسيس نحو الحظيرة الأصلية، وإعادة اغتراس الهوية في أرضية الملة، أرضية دار الإسلام. وإن اعتماد أسلوب التواصل المباشر الذي تتبعه حركة رجال الخدمة يضمن اختزال المراحل؛ ذلك لأن مما يركز عليه كولن في مجال ضمان التوفق والتفوق، هو الإجادة المتناهية في استغلال الزمن، وإن اِحكام اللُّحمة مع المحيط الأصلي يقتضي في عصر السباق المتهيِّج، والعولمة العارمة، ضمانَ السبقِ والمسارعة في إرساء الأسس والدعائم على الأرض، وإقامة مشاريع النفع المشترك الملموس، والإفادة التي لا يستغرقها الانتظار والتلبث المجاني، ففي كل توانٍ فرصٌ ضائعة، ومجالاتٌ تُفتَقَدُ.
حراء الرمز
إن تأسيس أول وسيط ثقافي إعلامي باللغة العربية، في تركيا، في زمن العولمة، نقصد مجلة حراء، لَيحمل الكثير من الدلالات، أقلها أنه جاء يعيد الصلة الوجدانية والروحية مع أهم مقومات الأصالة أي لغة القرآن. فمجلة حراء هي مَعْلَمٌ رمزي بكل ما تشير إليه دلالة الرمزية.. واعتماد كولن لهذه الدورية التواصلية، يندرج في خطة الحرص على تفعيل علاقة التقارب والتواشج بين تركيا والأقطار العربية ليس فقط على صعيد المشاريع والمؤسسات ذات الطابع الخدمي والاقتصادي والثقافي، وإنما تقوية ذلك بالداعم المعنوي؛ حيث يلعب العامل الرمزي دور استقطاب وحفز معتبر.
إن استصدار حراء العربية اللسان في تركيا، جاء تتويجًا لمراحل مديدة من النضال والصبر خاضها أبناء الأمة الأصلاء هناك، وبذلوا أعمارهم لأجل كسب النصر في معركة استرداد الهوية الروحية والانتماء الحضاري. لقد أبى التغريبيون إلا أن يجهزوا على الحرف العربي في تركيا، فجاءت اليقظة التي آثرها كُولن لتعيد الأمر إلى نصابه، فكان في إصدار (حراء) إشارة معبرة وإعلانًا فصيحًا على أن الفجر قد أشرق من جديد.
هناك يحث على التجمع والترابط الأخوي المِلِّي تبديه الحركة رؤية كولن؛ لأنها تدرك أن العالم يتقوى باصطناع الانتماءات، فكيف لا تمارس الأمة -ذات الروحية الواحدة، والتاريخ المشترك- حقها في الوحدة كي تواجه مخاطر الابتلاع. إن العولمة هي البالوعة الاقتصادية والثقافية الخطيرة التي تتهدد الضعفاء والمتفرقين، وإن الأمم التي تنخرط في نظام العولمة بلا عُدّة ولا تحصُّن بالقوة، تعرّض ذاتها للانمحاء.
إعادة تركيب كيان الأمة
إن إعادة تركيب كيان الأمة لا يعني بالنسبة للمفكر كولن افتكاك زعامة تغدو بها تركيا على رأس الأقطار والأوطان، كلا إن الغاية هي التمكين للأمة أن تحتمي حين تتجمع في كيان قوي، من دواهي الضياع الذي عانته تركيا وسائر البلاد والإسلامية الأخرى على شرِّ ما عانت أمة من طوائل المحق والتبعية والهوان.
التغريب الذي داهم تركيا نكَّلَ في العمق بالشعور القومي والكرامة الوطنية. لقد تحولت العثمانية نتيجة المخادعات إلى رجل أوروبا المريض، ثم أُطيح بمجدها، ثم أُلحقت تابعًا للأطلسي، ثم حين تفكك المعسكر الشرقي وُضعت على الهامش في قائمة الانتظار.. تلك هي بعض ما يستشعره الإنسان التركي الأصيل حين يسترجع وقائع الثمانين عامًا الأخيرة من تاريخ بلاده، وذلك ما يجعله يُبدِي كل هذه اللهفة على العودة إلى الديار.
لقد خرج بقناعة لا مراء فيها، استمدها من تحليل سديد للمآل الذي عرفته التحالفات على إثر انتهاء الحرب الباردة، واستمدها أيضًا من تقدير سليم لمتطلبات العولمة، وهي أن المطمح الأيديولوجي لم يعد الغاية التي تراهن عليها الأمم؛ إذ الأيديولوجيات تتبدل وتتفكك ولا تدوم، فهي مجرد نار حصيد، تلتهب ثم تخبو. وإن السياسة الحكيمة هي التي تبني استراتيجيتها على شروط ومقومات ثابتة لا تنال منها التغيرات، ولما كانت الرابطة المتينة والثابتة والمتجددة في كل عهد، هي رابطة الانتماء العضوي، والتجانس الحضاري، والأخوة الروحية التي لا تنفصم، والمؤهلة بالحكمة والتدابير لأن تذود عن الحظيرة والكيان والمصالح المشتركة، كان أمرًا طبيعيًّا أن تمد النهضة التركية الحالية يدها إلى الأشقاء.
فالأتراك بعد أن استعادوا وعيهم المِلِّي، باتوا متيقنين من أنه لن يكون لتركيا مستقبل ما لم تتحصن في كيان قومي كبير، وضمن امتداد جيوسياسي بحجم فضاء أقطار الأمة، فهي أضحت قوة اقتصادية يُحسَب لها الحساب، ولكي تكفل الاستمرار لنموها، والدوام لتقدمها، ورواج إنتاجها المتزايد، ولكي تضمن وفرة الاحتياط والمقدرات، لا بد أن تندمج في بنية وفي كينونة عضوية أصلية هي كينونة الأمة الإسلامية.
ولا يغيب عن المتفحص أن ما تدعو إليه تركيا اليوم وتلح عليه، من إقامة قواعد بناء وترابط واندماج ومشاركة، هو مطلب يخدم سائر أقطار الأمة؛ لما يوفره للجميع من أسباب المَنَعة، ومن الإمكانيات المساعدة على النمو والقوة.
وإذا كنا لا نزال نرى عدم الاستجابة لدعوات الوحدة والتشارك، وتقوية عوامل التقارب بين البلاد الإسلامية؛ فذلك لأن النظم المتخلفة لا يخدمها الاندماج.
إن الرؤية التوحيدية التي تلح عليها كتابات كولن، ترمي إلى بث الوعي في الأوساط المسلمة، والمستنيرة خاصة، وتحسيسها بالمنهج التكاملي الذي يضمن شروط صون الأمة والنهوض بها.
والمؤكد أن تركيا -بحكم سبقها إلى الاستفاقة الراهنة، نتيجة الخبرة التي اكتسبتها من خلال تلاصقها بالغرب جغرافيًّا وتفاعليًّا، وما استفادته من دروس ووعي بفعل الضربات القاسية التي أصابتها وهي تقف على أبواب الغرب تنتظر الاعتراف بعضويتها، وفي ضوء إدراك ما تتيحه العولمة لمن يحسن استغلال الفرص.. إلى ما هنالك من إرث تاريخي ومن جدارة حضارية ترى نفسها في موقع من يبادر إلى التحرك في اتجاه الدعوة إلى الالتجمع ولمِّ الشمل.
إن بيداغوجية التحسيس بالإمكانيات والمكاسب التي ستجنيها الأمة من بناء سياسة التجمع والتحالف والتقاسم المصلحي، تهدف إلى بيان سبل التقوية، والاحتماء بالأسوار المنيعة التي يكفلها تفعيل روابط الانتماء والإخاء، إن اللطمات التي طفق الغرب يوجهها لتركيا ردًّا على طلبها الانضمام إلى حظيرتها، تجد الرد الطبيعي والسديد في التحول بالخيار الانتمائي إلى مجراه الحضاري الأصلي، وإن الإشراقة الإسلامية التي انبلجت في تركيا اليوم والتي ينشّطها رجال الخدمة بإدارة روحية للداعية كولن، لَتعمل باستماتة صادقة في هذا الاتجاه.
نظرة كولن إلى الحضارة
لا يمكن لمفكر معاصر في منزلة كولن، ينتمي إلى مدنية ازدهرت قرونًا، ويعيش أطوارًا وتفاقمات حضارة راهنة، أن ينظر بذات التصور الذي ينظر به إلى الحضارة مفكرٌ آخر ينتسب إلى مدنية العصر الحالي، ويتابع تحولاتها من داخل صلبها؛ ذلك لأن كولن حتمًا سيجد نفسه -ربما تحت شعور الفداحة والفجيعة- يُقَوِّمُ معنى الحضارة في ضوء ما استقصاه من أسباب وعوامل سقوط حضارته، وما يستقرئ به اليوم واقع الحضارة الراهنة وهي تمضي أمام عينيه كسفينة يقودها ربان غير حكيم.
حدث اندحار الإنسان المسلم عندما انتهى التردي الفكري والقيمي به إلى وضع انحطاطي جرّده من مكاسبه الريادية الكبرى، وأضاع منه المَقَادة، وحوّله إلى مخلوق استسلامي، وهوى به وبحضارته إلى الدرك.
لا ريب أن حَيْدة الإنسان المسلم عن معالم الطريق كما قررها القرآن والشرع، كانت علة ذلك الاندحار.
وتدهورت المدنية المعاصرة، وأسفََّتْ بالإنسان من حيث شاءت أن تعلو به؛ إذ إن قطاعًا معتبرًا من الفكر المعاصر نزغ بالإنسان الغربي نزوغًا منكرًا، بحيث جعل من منطق القوة والاستغلال أساس المسطرة الأخلاقية، والقاعدة التي يبني عليها سياسته ومعاملاته حيال البشرية والكون عامة.
فالإنسان الغربي المعاصر ارتد به منطق الاغترار الأيديولوجي والجموح الفكري إلى مستوى التربُّبِ الذي كانت عليه آلهة يونان، تلك الماهيات الوهمية التي جهّزها الاعتقاد الضال بالقدرة الخارقة، لكنه لم يعصمها من النزوة، فعدمت شرط النزاهة والعلو القدسي، فلذلك طفقت تعيش المأساة مع ذاتها وفي علاقتها بالكون وما يعمره من قوى مضادة (أرباب).
وظلت حال الإنسان الغربي -على مدار مسافة طويلة من الزمن المعاصر- هي حال آلهة أسلافه اليونان قديمًا؛ إذ تجبَّر واستعلى، واجتهد ليكون على كل شيء قديرًا، لكنه رغم المكاسب ظل يتصرف بسلوك الآدمي المتوحش، وبطيشه.
وعلى العكس من ذلك فقد استنام الإنسان المسلم لعوامل فكرية وثقافية وروحية محبِطة، قعدت به عن إتمام مقاصد الإسلام في نشر رسالته إلى العالمين، فنكَّس همته وأذعن للامتهان، وانحدرت به المكانة إلى مستوى لا تقر به إلا عين الأعداء.
ومن الطبيعي أن الحضارة التي تستند إلى هذين النموذجين: نموذج الإنسان (المتأله)، ونموذج الإنسان (المستسلم)، هي حضارة انحدارية، مآلهما الانهيار. ولذا وجدنا كولن وهو يترسم صورة البناء الحضاري المأمول، يموقع الإنسان -بوصفه ارتكازًا مبدئيًّا لا مناص منه- في قلب أي تخطيط، ويُحِلُّهُ في صميم أي تأسيس جديد لحضارة مبرأة من استسلامية الزمن الماضي، ومن جبروتية حضارة الراهن.
إنه يضع الإنسان في المكان الذي وضعه فيه الإسلام، أي أعاده إلى مكانة الاستخلاف. من هنا رأينا كولن وهو يُنَظِّرُ لبناء الحضارة، ينيط المهمة والآمال بالإنسان القرآني، المقِرّ لله بالعبودية، المؤمن بأنه إنما وُجد ليكون خليفة ربِّه في الأرض، المعترِف بأن أساس استحقاق ذلك الاعتماد، هو الموثق والتعاقد على الإيمان بالله، والعبودية له وحده.
لا بد للإنسان القرآني المرشح لبعث الحضارة، أو إعادة تأسيسها من جديد، أن يتحرك على هدى ثلاثة شروط مبدئية: الإيمان والهدف والزمن، هذا القانون الذي يضعه كولن أساسًا لبناء المدنية السوية التي تتخطى بالبشر المزالق الكبرى والإعضالات الجمة التي يواجهها العالم اليوم حتى وهو يعيش ازدهارًا باهرًا بلغته حضارة التكنولوجيا والتطور التجهيزي والفتوحات العلمية التي تتصاعد نتائجها في مجالات الحياة المختلفة.
وإذا كان كولن قد جعل الإيمان صدارةً لشروط النهضة؛ فذلك لأنه يدرك أن البيئات والمجتمعات لا تعاني من نقص على مستوى وفرة العنصر البشري، فالتطور الصحي اليوم كفل الاحتياط، بل الكثافات السكانية التي باتت ظاهرة كونية شبه عامة في المجتمعات. إنما الذي ينقص هو الفاعلية الإيمانية الأصيلة، من هنا اقتضى الأمر على كل تخطيط أن يضع في طليعة اهتماماته مطلب توفير العنصر البشري المشبّع بالإيمان.
وإذا كان الإيمان في بداية أمره هو ميل، ثم تعلّق، فلا ريب أن الأيديولوجيات لها هي كذلك استقطاب يتحول بالبروباغوندا إلى إيمان، لكن الإيمان الذي يقصد إليه كولن، نوعي، يتجاوز عاطفة المذهبيات؛ إذ أثبتت السيكولوجية الأيديولوجية أن المشاعر الجيّاشة في ظل الأنظمة الشمولية لا تكاد تتجدد، وأن الرهانات الأيديولوجية تتطلع حتمًا إلى الجزاء الملموس، فلذلك هي عرضة للإحباط، بل والانهيار عند مواجهة القصور أو الخيبة.
إنما الإيمان الديني، الحق، هو الذي يتأهل للتجنيد والتجييش المستمر، وينتزع التهليل سواء في حالة الفوز أو الانكسار. فالبشر وإن تأهلوا سيكولوجيًّا لأن ينخرطوا بقلوبهم في رهانات دنيوية إلى أبعد حد، وأن يبذلوا التضحيات من أجل كسبها، إلا أن الدافعية لديهم تتغير حتمًا في مرحلة من المراحل، وتتراجع الصفوف، وتتناقص الحشود بتناقص فيض الحماسة أو افتقاد المُحرِّضات والجزاءات، وهذا ما يؤول بالأيديولوجيات عادة إلى الفشل والانهيار.
عكس ما يكون عليه الأمر حين يكون الحافز والدافع هو الدين السامي، فإن إرادة الاستمرار وراء الأهداف السامية تظل حية، وحتى إن عرض لها ما يعطلها أو يقلل من سرعتها. فالمقاصد العليا لا تموت في النفوس، ومن المؤكد أن كثيرًا من مُثُل الأيديولوجية وشعاراتها حين تُرَاجَع وتُقوَّم بالعقل السليم، يحملنا تَبَيُّنُ انحرافِها الموضوعي ومجافاتها للطبيعة الإنسانية، على الخجل، عكس الحال مع الدين القويم؛ إذ تظل مثاليته ورفعة مبادئه وسمو شعاراته، ثابتة متألقة بوهج قدسيتها في الأرواح، ولا تنتكس إلا النفوس الخسيسة أو المهينة عن إكبار الكمالات، وإن اعتزازنا بالشهداء مثلاً، آتٍ من هذه العلاقة التي تجعلنا نعظّم مَن ماتوا في سبيل المُثُل العظيمة، بغض النظر عن تحقق الأهداف أو بقائها في حالة انتظار، وبهذه الرابطة الإعلائية الثابتة التي تربط الإنسان بالمثل القدسية نرى روحية الدين تتجدد مع الأجيال، وذلك هو بالضبط ما يجعل منه المحرك الذي لا يتوقف عن توليد الطاقة، وضمان سيولتها.
من هنا تتخوف النظم الدنيوية المعاصرة من انبعاث الإسلام، بل وإنها لمتأكدة من حصول انبعاثه لا محالة؛ لإدراكها أن مكمن قوته قائم في ذاته، ومُتَأَتٍّ من سرّ هذه الصبغة الروحية العضوية التي يسري بها نوره في الأجيال، ومن هذه القدرة التي يمتلكها، والمهيأة على الدوام لتجديد الهمم حتى بعد تكرار الانتكاس؛ إذ يظل الدافع إليها حيًّا لا تختلف المشاعر نحوه من عهد إلى عهد، مهما عراها من البلاء أو الغفلة؛ لأن الروح الإنسانية جُبلت على الانحياز إلى الحق، فهي من جبِلَّتها تلك تسعى إلى تجسيد مظاهر الخير التي هي عنوان على الانصياع الفطري لوازع تعمير الأرض الذي فطرنا الله عليه، وعلى النهوض بمأمورية الشهود على العالمين: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾(آلِ عِمْرَان:110).
هذا النوع من الإيمان العلوي الذي يربط الإنسان بمُثُل السماء، هو كيمياء النجاحات التي تسعد بها الإنسانية. بالإيمان الديني الحق نبني الإنسان الصالح، المؤهل لأن يتجند في الصف، ويتطوع بما يملك. الإنسان النوعي، القَدَري، الذي خرَّجه القرآن، وصبغ أعماقه بصبغته، هو إنسان الحضارة، الإنسان الذي يراهن على وجوده كولن، وينيط به فتوحات المستقبل الكريم. إن تفعيل الدين، واغتراس روحه في النفوس والبيئات، هو السبيل إلى خلق القوى المؤهلة والمرشحة للعمل والبناء.
بداية الدعوة وتكوين الإنسان الفاعل
تحدثنا سيرة كولن أنه في مطلع شبابه، وبحافز ما كان يسكن فؤاده من تطلع وإحسان، شرع في استقطاب أفراد تلاميذ إلى حلقته التنويرية، يعينهم على دروسهم، ويفتح بالحكمة صدورهم للإيمان. ولقد بدأت التجربة محفوفة بكثير من المشاق، واقتضت أحمالاً من الصبر والروية، ثم مع السنوات بدأت المجاميع تبرز، وتطوّر أسلوب التواصل، وازدادت الحلقات عددًا، ثم شبَّ التلاميذ وصاروا أكفاء، وتحولوا بدورهم إلى وسائط تلْقين ودعوةٍ، ثم نفذت الدعوة إلى الأسر والبيوت وأماكن العمل، وسرت بعد ذلك كما يسري الماء في الأرض، أينما مَرَّ أمرع.
كم كانت طويلة المسافة الزمنية بين جلوس أول طفل في حلقة الأستاذ، وبين اكتمال جهوزية الطوابير من رجال الخدمة، وخروجهم إلى الأرض، وانتشارهم في الآفاق يضعون بكل حزم وتؤدة وصبر أسسًا لحضارة الغد السعيد.
لا ريب أن كولن وهو يتحدث عن عمر المرجان، وعن زمن التبلُّور، إنما كان يشير إلى شيء مما عاناه في تجربة التواصل تلك التي بدأت بجلسة عقدها مع تلميذ سار به إلى المسجد؛ ليكون أول المكتتبين، وانتهت جهود الاستقطاب بانتظام حلقة، ثم بأخرى، ثم بحلقات، ثم بذيوع الكلمة الطيبة في الآفاق، وبعد أطوار تكاثرت الجموع، وولدت الخدمة.
في البداية لا بد من البدْء، وقد تكون البداية فكرة يتلقفها ذو حظ من أهل الفاعلية، فيستنبتها ويهيئها للإثمار، أو قد يكون فردًا تسكنه جذوة عشق، فهي لا تني تنقدح في روحه، وتشق به درب التمحيصات، وتتقلب به من طور إلى طور، أشبه بخطوات الأنبياء حين تسوقهم إرادة الله إلى حيث يبعثون.
ومن الفرد يكون الاثنان، ثم الثلاثة، ثم الجماعة، ويد الله أبدًا مع الجماعة.
الطليعة المؤمنة تمارس جهدها في زرع المحيط بالقيم المُؤهِّبة والأخلاق المُعِدّة للصلاح. تبدأ المستصلحات محدودة، ثم بتكاثرها يتزايد التواصل بين مفارزِها، ويغدو التواصل تفاعلاً عاموديًّا في الاتجاهين، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، ثم تتهيأ عوامل التأسيس وإقامة مشاريع الإثمار، فتصير الحركة التنويرية حراكًا للتخطيط والتعمير والتصنيع وعرض الخدمات، الأمر الذي يخلق مجتمع النماء والبركة والاستقطاب والخيرية؛ إذ كل تحسن يطرأ على أحوال الأمة، ينعكس بالإيجاب على نظرة بني البشر إلى الدين الإسلامي.
المدرسة، الإنسان، الحضارة
اعتدنا أن نرى آراء أهل الفكر والسياسة تنيط -ببساطة وآلية- مهمة بناء المستقبل إلى المدرسة، وتقرنه بها. ومن المؤكد أن اطراد هذه الرؤية بهذا الشكل السطحي، ينمُّ عن روح التملص من عبء وضع التمثل، وإبراز الكيفية التي تجعل من المدرسة -فعلاً- أداة البناء.
والحال أن الأمة الإسلامية قد مضى على ما اصطُلح على نهضتها أزيد من القرنين، حققت خلال ذلك مكاسب في التعليم والتمدرس، لكنها ها هي ما زالت تستورد كل حاجاتها، وما زالت متموقعة في القاع، على الرغم من حضور المدرسة في الحياة الاجتماعية بشكل ملموس.
لقد خرجت بلاد كثيرة من التخلف، ولم يستغرق رهانها على النهضة سوى بضعة عقود على الأكثر.. فنهضة اليابان مثلاً، التي سبقتها بعض بلادنا الإسلامية بالانخراط في الحراك البنائي، قد تكرست منذ مراحل؛ بحيث باتت اليوم قوة كبرى لا تُضاهَى، ومثلها كانت ألمانيا التي انبعثت بعد دمار حربي غير مسبوق.. إلى منظومة من الدول المتلاحقة على خط الوصول، وبعضها ينتمي إلى دار الإسلام مثل ماليزيا وإندونيسيا، ممن انتفضت على التخلف، ووقفت على قدميها، وباتت اليوم يُشار إليها بالبنان. فما السر في تخلصها من التخلف، وبقائنا نحن راسفين فيه، رغم أخذنا نحن أيضًا بالتعليم ونظام التمدرس؟ لا ريب أن النهضة منوطة بالتعليم الفاعل والمدرسة الناجحة. لكن هل كل مدرسة هي وسيلة للنهضة؟
لا تتحقق النهضات -بحسب كولن- إلا في خضم عارم من التوتر والعنفوان الذي يجعل الطاقات تتسابق على البذل، والجهود تتنافس في إجادة الإسهام، والقدرات تتضافر في الابتكار والإبداع.
فالنهضة الأصيلة هي تشكيل عمراني وتثمير مدني نوعي، يقتضي -حتمًا- دافعيات ثابتة وهِممًا متجددة وعزائم استثنائية تُهيِّئ لميلاد الطفرة، وترافق مراحل تَحَقُّقها واسترسال نمائها بلا كلل، وتجتاز بالمجتمع إلى صعيد وطيد، تلازمه فيه اليقظة، وتنتفي عوامل الغفلة حتى لا تتكرر عاديةُ انطفاء النور وانطباق الحلكة من جديد على الحياة.
والنهضة تحَوُّلٌ باهر في الأحوال وفي الوتائر، فالاشتحان الذي يلازم المخاض ينبغي أن يشمل كافة نُظم الحياة ومرافقها.. وإلا اختلّت الانطلاقة وتعثرت، وربما تفاقمت الأوضاع القائمة بأكثر مما كانت عليه من هشاشة ووهن.
والنظام التعليمي في طليعة المُفعلات التي يجب أن يستهدفها الضبط والتعبئة تمهيدًا للوثبة المأمولة؛ إذ لا يمكن أن نتوقع من مؤسسات تدأب على نظام تعليمي متخلف، أن تجهّز وتمدّ المجتمع بالدفعات القادرة على التحول به إلى الأحسن، والأفضل.
النظم التي تُواتي القفزات التاريخية، وتستجيب لرهانات النهضة نُظمٌ يميزها التجدد الروحي، والغنى العلمي، والرشد المنهجي الذي يولد في الجيل حرارة الشوق إلى العمل الارتقائي الشامل، ويعبئهم بإرادة التطور الجذري، من هنا كان التعويل على النظم والآليات والقنوات التي لا تحركها روحية التوثب والاستبسال، مجرد لغو، ولا طائل من ورائها.
النهضة بين المدرسة الكسيحة والمدرسة الناجزة
إن المدرسة الكسيحة في نظامها التربوي، والمهلهلة في برنامجها التعليمي ومنهاجها المعرفي، لن يزيد دورها في أحسن الأحوال، على توطيد الرتابة، وتكريس الآلية، والمُضِي في ضخّ نفس النوعية من المتخرجين الذين يتهيأون في مناخ راكد يورثهم نفس الاعتلالات التي تسود الواقع الاجتماعي والمدني من حولهم.
إنما المدرسة الناجزة هي التي تُحدِث في ذاتها وفي ميكنزماتها وارتفاقاتها، الثورة، كي تستطيع أن تخرّج الإنسان الفعَّال.
المدرسة المحقِّقة للفلاح والنجاعة هي التي تستوجب أن نستصلحها أولاً، قبل أن نطمع في تحصيل المردودية الصالحة من الأجيال على يدها.
على عكس ما تواترت عليه التنويهات بالمدرسة، رأينا كولن يكشف أن إناطة صناعة المستقبل بالمدرسة من غير توفير لمنظومة التحسينات والمستلزمات المختلفة، رهان غير مضمون.
المدرسة وحدها -بالنمط التنظيمي الراهن- لا تقدر على المضي بالمتخرج إلى صعيد العطاء، فعلى الرغم من أنها الخلية العمومية الأولى للتكوين، إلا أنها تظل قاصرة عن منحنا النموذج الإنساني الذي يتوفر على مقومات البناء الكامل بمجرد اكتفائه بما حصَّله فيها من معرفة، فـ”من العسير جدًّا عليها، بل من المُحال أن نستدل على أنموذج واحد أنجزته المدرسة وحدها”؛ إذًا لا بد من متممات للمقدار المعرفي المتحصل عليه تحت سقفها؛ حتى يستوي النصاب، ويستكمل الناشئ تأهيله.
لا ريب أن إسهام المدرسة التقليدية المعاصرة يظل نظريًّا وافتراضيًّا ما لم تكن البيئة التي يتحرك فيها المتمدرس بيئة سليمة من الآفات، ومنسجمة مع قيم أصالتها. فالزاد الذي توفّره ثقافة المجتمع ينمي بشكل عملي، وفوري، بل وقبلي، ما تلقنه المدرسة للأجيال.
وحين تتشبع المدرسة وتتجاوب مع قيمٍ تُمَجِّدُها الأسرةُ، ويقدسها المجتمع، وتحتفي بها رزنامة المواسم والمناسبات، وتتجسد من خلالها العزة الجمعية، ويتعصب لها الضمير القومي والملّي، عند ذاك يتوطد التناغم بين الفرد ومحيطه، وتتغذى المناهج التعليمية بما تسترفده من قيم البيئة، وبالمقابل تتخصب البيئة بمظاهر الشحذ والتطوير الذي تُفَعّلُها به روافد التكوين، بما فيها الرافد الإعلامي بمختلف وسائطه، وبكل الخطورة التي يمثلها؛ إن هو سار في اتجاه الهدم والتمييع.
إن التعويل على المدرسة وحدها في صنع إنسان المستقبل كما هو الاعتقاد السائد حاليًا، ليؤكد السذاجة وسوء التبصر، ولقد آن لنا “أن نتقبل المدرسة بواقعها وحقيقتها، ولا نأمل منها إلا ما يمكن أن تمنحنا إياه.. إن تعليق الآمال كلها بالمدرسة منطلق مبالغ فيه وتفكير سطحي وبسيط”.
من هنا يتوجب إعادة التفكير في المناهج التربوية، وقبل ذلك وبعده ينبغي إيجاد المعلم المهيأ الذي تظهر جدارته في نتائج التفوق التي تُسفِر عنها جهوده كل سنة، وفي النجابة التي يشحن بها تلاميذه، وفي روح الإيمان التي يتشربونها منه باستعذاب واستلذاذ.
في هذا الإطار تقترح منهجية كولن النموذج المدرسي المثمر، من خلال اعتماد منظومة المدارس العصرية التي زرعتها في تركيا، وعممتها بعد أن أثبتت تفوقها وانتزعت الاعتراف من المجتمع قبل أن تنتزعه من الدولة.
وإن حركة افتتاح المدارس التي يمضي بها رجال الخدمة قُدُمًا داخل تركيا وخارجها، لتندرج ضمن رؤية تستهدف تكوين فصائل من المتفوقين، وتخريج شتائل من الناجحين، سيكونون -حتمًا- خميرة يفيدون مجتمعاتهم، وستنتعش بهم الحياة والمدنية في بيئاتهم.
ثم إن المدرسة بالمواصفات العملية التي يقترحها كولن تغدو إلى جانب وظيفتها التكوينية الأساسية، وسيطًا مُهمًّا ضمن وسائط التحسيس، وبذر اليقظة والوعي بضرورة الترابط الملي والإنساني.
إن من المقاصد العليا للتعليم في فلسفة كولن: النهوض بعملية توليف وتقريب المواجد بين المسلمين؛ إذ إن مقوم الدين والرابطة التاريخية المشتركة يستلزمان دمج نظُم التربية والتعليم في إطار التوجه الاستقطابي بين أقطار الأمة، وهذا من خلال توظيف المقاربة البيداغوجية والتربوية المتجانسة في مشروع الخدمة، الأمر الذي سيقوي من تحقيق انعقاد اللُّحمة الإسلامية على أكثر من صعيد، وفي ذلك ما فيه من قوة وعز للمسلمين.
ومن المؤكد أن التعليم المدرسي بمنحاه العصري الذي أثّرت في محتوياته الروحُ اللائكية النافذة عالميًّا في المناهج المعرفية، قد أتى على جوهر الروحية الفطرية التي تربط الفرد بأصالته. فلقد استطاعت المدرسة العصرية (مضافًا إليها الإعلام بأنواعه) أن تزحزح النفوس عن بيئتها المعنوية، وأن تجعلها تتكيف مع ثقافة متسللة وطارئة على حياتنا الإسلامية.. ثقافة لا ترعى الحرمة، ولا تعبأ بالدين، الأمر الذي أوجد هذا الإنسان المسلم المعاصر الذي تطبَّع دون شعور منه على روح مجافاة القيم الأصلية، مع ما رافق ذلك من غلظة شعورية ونضوب عاطفي استرخت به لُحمة الأسرة والروابط الجماعية العتيقة.
إن بيداغوجية البناء والنجاعة التي يشدد عليها كولن، هي التي تحرص الحرص كله على تقطير روح الدين الحق وشَهْدِ العقيدة الصدق في نفوس الناشئة، يتلقونها ممزوجة مع ما يتلقونه من مواد التعبئة الثقافية والتمكين المعرفي؛ بحيث يتذوقها الناشئ في صلب القاعدة النحوية، وفي العملية الرياضية، والدرس التحليلي، والمحاضرة الاقتصادية، وفي الأمثلة المَسُوقة، والاستنتاجات المستخلَصة.. فبذلك يتولد في الأعماق عشق الحقيقة، وحب العلم، والإخلاص إلى الحياة التي تضحى جزءًا من كونٍ مفتوح على الآخرة، ومشروط بعقيدة التقوى والاحتساب الغيبي.
أهم ما تسعى إليه المدرسة الناجحة
وتظل الناحية العقلية من أهم ما تسدد نحوه المدرسة الناجحة؛ إذ تركز على تعبئة القلب بالمخصبات العشقية وبالمواجد، وتأهيب الذهن، وشحذ الملَكات، وتنمية روح التفكير والنقد والاختراع، فبذلك يكون الفرد بما أحرزه من تجلية ذهنية في المدرسة وفي مؤسسات التكوين، إضافة نوعية، ومددًا مفعمًا بالحيوية، تغتني بها الحياة. إن ترويض وتنشئة الجيل على التفكير المنتج القائم على تعويدهم ربط أذهانهم بمجال الكون وما يحويه من معان وبينات، هو من أوكد غايات مدرسة كولن: “إن من أجدى الأمور في بناء الجيل الحاضر هو تيسير تنقلهم بين عوالمهم الداخلية، وبين حقائق الوجود؛ لتحفيز عزم التفكير المنظم لديهم، وتحبيب الإيمان والتعليم والتمحيص والتفكير إليهم، بتدريبهم على مطالعة الآفاق والأنفس ككتاب مفتوح”.
لا شك أن المتخرج حين يكون قد ترقى عبر مراحل تكوينه الأولى في جو بيداغوجي وعلمي وروحي متكامل، سيكون على درجة من التأهل والتوازن عالية، الأمر الذي يرشحه لأن يندمج في الحياة العملية دون بوار، وسيتحول إلى المجتمع وقد اكتسب صبغة الإنسان الصالح الذي تتوطد به الفضيلة والسماحة والفاعلية.
إن هذه التجربة الناجحة التي تعمل دائرة خدمة كولن على توسيعها، لا تفتأ تُثبِت من سنة إلى سنة، وحيثما حلّت، اقتدارَها على تكوين النشء التكوينَ النوعي، وتهيئ الدفعات النبيهة، والمرشحة لأن تكون بدورها في المستقبل، قاطرة يتكرس بها الأفق المضيء”.
وإن مما يقع على كاهل البيئة الحية التكفل بالخرّيج، والحرص على الاستجابة لما يحمل من كفاءة واستعداد، حتى لا تنهدر الطاقات بددًا كما يحصل في نظمنا التربوية الراهنة.
وما لم توجد المناهج التطبيقية والبرامج الاستثمارية التي تستقبل المتخرّجين، وتتلقف أصحاب التحصيل، وتحولهم إلى عَمَلة وصُناع ورجال إنتاج وتعمير وتطوير، فإن المهمة التربوية تظل بتراء، وبلا سند حقيقي.
إن تقصير المجتمع الأهلي عندنا في الحراك التعميري، يديم ما نراه من نزيف في القدرات، لاسيما على مستوى جموع الدفعات التي تتخرج في كل موسم، والتي لا تزال تتلاحق وتتكدس؛ إذ تجد نفسها أمام الأفق المسدود.
إن من شأن الاستثمار الاقتصادي والثقافي والإنتاجي عامة، أن يفتح الأبواب في وجه الشباب، ويدمجهم في الحياة العملية، وإذا ما هيّأت المشاريع التي توفرها مؤسسات التوظيف ومرافق الاستقبال، مناخًا أخلاقيًّا وتنويريًّا ومدنيًّا يعزّز عملية الإدماج، فلا شك أنها ستساهم في التحول بالمجتمع إلى وجهة الصلاح، وإلى النهج القويم الذي تسوده قيم الخير والطمأنينة.
البيئة والبناء
إن دور البيئة الصالحة في بناء الشخصية السوية المتشبعة بأصالتها، دور أساس في منظور كولن، بل إنها المدرسة الطبيعية التي لا يفلت من تأثيرها أحد، ولقد “ظلت البيئة مصدر القيم الثقافية في كل الحضارات.. وإن هذه القيم الثقافية التي تسود الحياة الاجتماعية هي البيئة العامة التي تحضن وجدان الأمة، وتمازج تفكيرها، وتغذّيه، وإن علاقة المدرسة بالبيئة علاقة تفاعل عضوي، وبقدر ما تكون المدرسة متوجهة نحو الهدف، ومتسمة بالعمق، تصبح ميناء أو مطارًا أو منطلقًا للأمة؛ بشرط أن تصهر مكتسباتها في بوتقة الثقافة الذاتية”.
إن البناء يولّد المواهب والعبقريات؛ لأنه يساعد على شحذ الاستعدادات الفردية والجماعية،، بل إنه يساعد على اكتشافها، واستنقاذها من الضياع الذي يطبع البيئات المتخلفة: فإن النجاحات الخارقة للعادة، المتحققة أمس واليوم، والتكوينات العالمية الكبرى، مرتبطة -إضافة إلى عبقرية الأفراد ونبوغهم- بالبناء الاجتماعي المولّد للعبقرية، والوسط المناسب لتنشئة المكتشفين، والبيئة العامة الحاضنة للعبقريات. فالدائرة الصالحة أي البيئة الفاعلة هي التي تخلف البيئة الموات، وتصبح أرضية فلح وخصوبة.
إن المدرسة المتعصرنة اليوم، في حاجة إلى المراجعة الكلية، لاسيما على صعيد البرامج والأهداف؛ إذ ليس لها أهداف محددة، فإن وظيفتها هي في أحسن الأحوال إزالة الأمية، لكنها بالمقابل، تُورث أمية أخرى؛ إذ تشغل الناشئة -وخاصة المتسربين منهم- عن البدء مبكرًا في تعلّم الحرفة؛ لأنهم يتمدرسون أولاً، ثم حين لا يُوفَّقون يجدون أنفسهم في حاجة إلى بداية تعليم تأهيلي، من خلال تعلم حرفة أو ممارسة عمل ما.. والحال أنه -وكما أسلفنا- حتى المتخرج بشهادة يجد نفسه مضطرًّا لأن يبدأ التكوين ميدانيًّا.. ولقد زادت الهوة اليوم بين مضامين التعليم الكلاسيكي وبين النظم المعرفية والاستخدامية التي لا تفتأ سبلُها تنفتح باطراد أمام البشرية، نقصد الوسائط الافتراضية، من حاسوب، وإنترنت، ولغات، وعلوم المستقبل، وما إليها.
ولذا بات اليوم تجديد تصوراتنا إزاء المدرسة والتمدرس أمرًا ملحًّا.
وإذا كان إفلاس مؤسساتنا التعليمية في العصر الوسيط قد سبَّب اندحار حضارتنا الإسلامية، فلا شك أن أبرز العوامل التي فاقمت من الوضع التقهقري يومئذ، هو انعدام الرؤية التربوية، وغياب المشروع المستقبلي الذي يُفترض أن يرسمه كل نظام تعليمي بصير.
لقد استمرت منظومة الزوايا والتكايا والمساجد كما يسجل كولن، في مزاولة تعليم اجتراري مقطوع عن الحياة، بلا هدف، وغير معني بتاتًا بحاجة الفرد والأمة، ولا مهتم بما يتراوحها من ترديات، الأمر الذي كرَّس العقم، وسدَّ الأفق، فلا غرابة، والحال تلك، أن نرى الانحدار ينتهي بالأوساط التعليمية في تلك البيئة إلى حدّ راح فيه رجال الترشيد يقصرون مادة التعليم على تحفيظ الأدعية، والقصد هو مواجهة الانسدادات والضوائق بالضراعة وحدها، غافلين عن وصية المولى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾(الأَنْفَال:60).
لقد أشار الأستاذ كولن إلى هذا القصور الفادح الذي كانت عليه المدارس التقليدية في العصر الوسيط، فسجَّل أن مؤسسات الماضي الثقافية والروحية، ممن كانت تربي مهدنسي فكرنا وعُمال روحنا، لم تكن تواجه الحياة بمشاريع تجعل من رهان السيطرة على المستقبل مطمح الأجيال.
والأستاذ كولن يرى أن الفداحة مستمرة معنا؛ إذ حالنا اليوم بالقياس إلى ما تقتضيه منا متطلبات الجهوزية المستقبلية هو حالهم عينه بالنسبة إلى ما ظلوا يفاعلون به واقعهم: غفلة عن المستقبل، وتردٍّ في السلبية.. فنحن لا نزال سادرين في بلادة عن إنتاج رزنامة مشاريع كبرى، شاملة، وحاسمة، نراهن بتنفيذها على طي صفحة التخلف نهائيًّا، وبلوغ مستوى الانعتاق من الانحطاط.
الكلمة المفتاحية
في إجابة على تساؤل يطرحه الأستاذ كولن حول كيف يحوّل الإيمانُ الإنسانَ إلى إنسان كامل؟ يجيب قائلا: الكلمة المفتاحية (لا إله إلا الله) بذرة الإيمان، والإيمان هو منبت المشاعر السامية في الأرواح؛ إذ يجعلها تنجذب إلى عشق المعرفة والعلوم التي تتصفى في القلب، وتضحى حسًّا داخليًّا ودوحة باسقة تمتد بأذرعها حول الكيان، وتلفّ الشخصية من كل جهة وجانب، وبذلك تصير سلوكيات الفرد سلوكيات عاشق مشتاق؛ حيث تعمّق فيه العباداتُ اللدنية وازعَ التقوى، وتُقوّي رابطتَه مع السماء، وبذلك يندرج سعيه وإنتاجه وعطاءاته في دائرة الحسنى والمعروف.
ولا تفتأ النية الاحتسابية تتجه بأعماله نحو الله، مدفوعة بما يسميه كولن قوة الجذب المركزي، ويصير الرجحان -في تصرفاته وخدماته ومساعيه- للذوق الناشئ عن تلك السيرة المتعالية عن أنواع الضعف بالعامل الروحي، فتنطبع كل منجزاته بالطابع الجمالي؛ نتيجة كثرة العشق في أعماقه؛ ذلك لأن الروح المرتوية بالإيمان تترك رسمها على الأعمال، لاسيما إذا كانت هذه الأعمال، بحيث ينطبع كل منتَج وكل إنجاز بطابع الدقة والرقة والإتقان، فلكأنه ينتمي إلى عالم الفن والثقافة.
إن المحرك القلبي يوجّه سائر أعمال الفرد المحتسب وتصرفاته، ويضفي عليها غلالة من مشاعر الحب التي تعمر قلبه، ففي كل جهد تكمن نية التقرب إلى الله؛ لأن ما يرفع إلى الله يقتضي أن يكون متناهي الصنعة والأناقة؛ لذلك تتولد الأعمال موسومة بالحسن، جانحة إلى التمام والكمال؛ إذ إن داعي الإيمان يتعالى صوته أنَّى توجه الإنسان القلبي، وحيثما سار سَمِعَهُ يهتف بمعاني الإنسان – الكون – الله التي تتحول في الروح إلى سند معنوي ينعكس على الرؤية والمشاعر والأعمال.
إن الفكر الإيماني يستمر في التأثير على الأنشطة الأدبية والعلمية، وسائر ما ينيط به الإنسان القلبي همته؛ لأن هذا التفكير المصهور بالنور الغيبي، سرعان ما يضحى بدوره مصهرًا يقولب كيان الفرد، ويكسبه جِبِلّة شفافة؛ لأنه يأخذ مع الترسخ صورة طبيعة ثانية في الإنسان، الأمر الذي يهيئ -بتنامي هذه الطبيعة الثانية في الأفراد والقطاعات والقيادات والمجاميع المرابطة في الورشات والمعامل والمختبرات- استحكام صبغة الفاعلية، ويفتح الطريق واسعًا لبناء الحضارة.