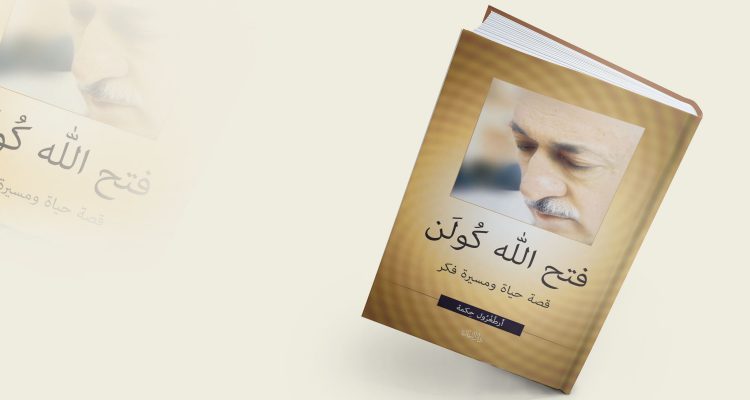أخذ الأستاذ فتح الله إجازة لزيارة مدنٍ أخرى في الفترة التي كان فيها في قِرْقْلَارْ أَلِي، كانت الإجازة عشرين يومًا، إلا أنها استمرت أربعين، وفي طريق عودته مرّ بأنقرة وطلب من الأستاذ يَشار طُوناكُور مساعد رئيس الشؤون الدينية إجازة عشرين يومًا أُخرى، لكنه أوعز إلى الأستاذ فتح الله أن يستبدل به طلبًا يبيّن فيه أنه يرغب بالتعيين في إزمير، فاعتذر الأستاذ فتح الله عن تقديم مثل هذا الطلب، إلا أنّه ألحّ عليه وأوعز إلى أحدهم أن يكتب الطلب، وحمله على التوقيع مستغلًا احترامه له.
ولما غادر الأستاذ يَشار طُوناكُور من إزمير إلى أنقرة قال وهو يودِّع محبِّيه في إزمير: “سأرسل لكم شخصًا وستنسونني”؛ فصدر قرار تعيين الأستاذ فتح الله في إزمير بتاريخ 11 آذار/مارس 1966م، وودَّعه جمع غفير من محبِّيه في قِرْقْلاَرْ أَلي، وبدأ العمل مديرًا في سكن طلاب ثانوية الأئمة والخطباء “كَسْتانه بَزارِي”، وكان السكن الطلابي يعاني من الفوضى؛ فاضطُرّ بادئ الأمر إلى مواصلة العمل ليل نهار في إدارة السكن فلم يكن ينام سوى ساعة أو ساعتين أملًا في عودة الانضباط إلى السكن؛ يحكي الأستاذ فتح الله عن أيامه الأولى التي قضاها في كستانه بزاري قائلًا: “بناءً على تقييمي المبدئي اقتنعت بأنّه من الضروري ملازمة الطلاب بشكلٍ دائم، فاقتضى هذا منّي أن أصل الليل بالنهار فلا أنام، فحالة الطلاب عمومًا تقتضي ذلك؛ فهزُلَ بدني كثيرًا إذ قلَّما أتناول الطعام، ورغم ذلك كنت أكتفي بنوم الساعة أو الساعتين في اليوم، وأحيانًا أصل ليلي بنهاري دون أن أنام، وبينما أشرف على الطلاب وهم نائمون كنت أتجول عدّة مرات في الحمّامات والغرف، وإذ كنت أعتني بالطلاب عن كَثَب كنت أعمل على إصلاح كلّ ما أراه مخلًّا بالنظام”.
وضاق بعضهم ذرْعًا باهتمام الأستاذ فتح الله بالانضباط عامَّة وبعنايته بالطلاب خاصَّة؛ فلجؤوا إلى حِيَل عدَّة، وحاولوا زعزعة مكانته عند الطلاب؛ فأصبح انضباط السكن أمرًا صعبًا إلى حدٍّ ما في الأشهر الأولى، وأظهر بعضهم سلوكًا معاديًا لدَماثة الأستاذ فتح الله، فاجتمع رئيس الجمعيّة السيد “علي رضا كُوَنْ” بهؤلاء الأشخاص وحذَّرَهم بقوله: “هذا الأستاذ لا يأخذ من السكن شيئًا ولو لقمة، فلو بدر منكم سلوك يضايقه، طردتكم جميعًا”.
وأخذ أمناء الوقف والطلاب كذلك يَقْدُرون الأستاذ فتح الله قَدْرَه، يذكر خليل مَزِيك – وهو من أوائل تلامذة الأستاذ ورابع أربعة أرسلهم عقب وصوله إزمير لمتابعة الخِدمة التي بدأها في أدرنه من قبل – تودُّدَ الطلاب للأستاذ ورأيهم فيه وكذلك مواقفه معه بقوله: “قدمت إلى كستانه بزاري في عام 1965م، وجاء الأستاذ فتح الله في صيف 1966م، كان الطلاب جميعًا ينظرون إلى الأستاذ فتح الله نظرة ريب، كان شابًّا يومئذ إلا أنّه كان يبدو وكأنّه شيخ كبير مهيب وقور رزين.
قال لي إبراهيم أفندي إمام جامع كستانه بزاري: “أشعر بشيء ما نحو هذا الأستاذ الجديد، ووصلني خطاب يوصِي به”، يعني الخطاب الذي أرسله الأستاذ يَشار طُوناكُور، ولما لاحظ الأستاذ إبراهيم جوهر الأستاذ فتح الله مما قرأه في الخطاب وما رآه من ورعه، بدأ يوصينا به ويقرّبنا إليه شيئًا فشيئًا، وكنّا يومئذ صغارًا؛ فلم ندرك أهمية الأمر، ولم نُعْنَ به كثيرًا، لكن ما إن بدأ الأستاذ فتح الله دروسه في التزكية حتى بدأنا نحبّه ونَقْدُره قَدْره؛ كان الأستاذ فتح الله يتناول مواضيع عِدّة، ويطيّبها بعبق من حياة الصحابة، فحياتهم محور أساس ومضرِب المثل في أحاديثه؛ وكان – وهو يسرد الأحداث – يتأثَّر فيَبكي ويُبكي مَن حولَه، وسرعان ما ألِفه الطلاب وأمناء الوقف أيضًا، بل إنّ الأساتذة الآخرين الأكبر منه سنًّا ممن سبقوه إلى كستانه بزاري بدؤوا في تقديره، ثم ما لبث هُنَيْهة حتى غدا شخصيَّة مرموقة في إزمير.
في شهر رمضان كنت أصلي التراويح بختمة في كستانه بزاري، وكان الأستاذ فتح الله يعظ في مساجد شتَّى قبيل صلاة التراويح، فكنا نتناول وجبات خفيفة، فتكفيه لُقيمات مما تيسّر على الإفطار، كان يشتري الجبن واليوسفيّ، وكنَّا نُحْضِر الخبز من سكن الطلاب، لنفطِر معًا، كان الأستاذ فتح الله لا يتناول من طعام السّكن، حتى إنه كان يدفع ثمن الخبز، وثمن وجبات من يأتيه زائرًا”.
بعد زُهاء ستة أشهر من شروع الأستاذ فتح الله في العمل بُني له كوخ في فناء السكن، مِتْران في مترين، لا شيء فيه ولو ماءً، وأصبح هذا الكوخ أرضًا طيّبة نثَر فيها بذورَ أحلامٍ تراءت له وهو يدرُس في مدرسة قُورْشُونْلو، وتمرّ السّنون ويحكي الأستاذ عن هذا الكوخ وهو يَذكره بشوق في وعظه وحواراته: “كنت أحبّ كوخي كثيرًا رغم أنّه كان صغيرًا، فلو مددت قدمَيّ للامستا جدرانه، ولم يكن به حمَّام، فكنت أغسل يدَيّ من مياه البرميل خارج الكوخ، لكن هذه الغرفة الصغيرة كانت من الأماكن التي تُشبعني في خدمة الإسلام بشكل كبير، مكان متواضع بسيط، إلا أنّه كان منطلَقًا لخدمات كثيرة ستكون فيما بعد، وكان كمورد الماء يغصّ بالنّاس على الدّوام”.
وعِلاوةً على عناية الأستاذ فتح الله بالطلاب عن كَثَب، فإنه كان يُلقي مواعظه في أماكن شتَّى بمنطقتي بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وليس في إزمير فحسب، وسُجِّلَت هذه الدروس ووزِّعت على كثيرين رغم أنه لم يحبِّذْ ذلك، يروي جاهد أردوغان -وقد بذل جهدًا مشكورًا في تسجيل الدروس- ملاحظاته الأولى حول الأستاذ وفترة الوعظ قائلًا: “اضطرِرت في عام 1965 أن أترك حِرفتي، وكان لديّ مصنع للملح، لكنني كنت أرى يومئذ أنَّ تسجيل دروس العلماء المشهورين أمثال الأستاذ طاهر بُيُوكْ كُورُكْجو ويَشار طُوناكُور لتوزيعها على المناطق المجاورة يُعدّ خِدمة للإسلام، وكان وعظ الأستاذ يشار خاصة يؤثِّر فيّ أيَّما تأثير؛ فبذلت ما في وسعي لنشر مواعظه في المناطق المجاورة؛ وذات يوم صدر قرار بتعيين الأستاذ يشار في أنقرة مساعدًا لرئيس الشؤون الدينية، فرغب أكابر إزمير إلى الأستاذ يشار أن يسعى لإيقاف هذا التعيين الجديد، واجتمعوا عنده ليتقدموا بطلبهم هذا، وكنت معهم يومئذ، فقال لنا: “لا تحزنوا على فِراقي، فلسوف أرسل إليكم مَن تحبونه أكثر مني”، ولا ريب أنهم جميعًا كانوا يعدّون هذا منه مواساة لهم، وأنّ شيئًا من هذا لن يحدث.
رحل الأستاذ يشار، وبِتْنَا ننتظر الأستاذ الجديد بشغَف، ولم أكن لأصِّدق أنه سيكون كما قال الأستاذ يشار؛ فأنا أعرف كلّ مشايخ هذا العصر في بلادنا، وتدور عجلة الزمان ويأتي الأستاذ الجديد، فذهبت لأستمع إليه، ولا ريب أنَّه لا داعي لإحضار المسجِّل، وكاد النّدم يأكلني وأنا أسمع موعظته، وأردِّد في نفسي: ليتني سجّلْت، انتهى الدَّرس وغدوتُ مبهورًا؛ لقد كان وعظًا مؤثِّرًا ما سمعتُ مثلَه قطّ، فعزمت مِن فوري على أن لا أغادر صغيرةً ولا كبيرة من مواعظه إلا سجّلتُها، والحمد لله الذي هداني لهذا، فأصبَحَت تلكم الوظيفة شغلي الشاغل، ودأبت عليها – بفضل الله – إلى اليوم، وعسى أن يدوم فضل الله عليّ ما دمت حيًّا، فيا ربِّ وفِّقني ولا تقطع سَيْبَك عنِّي[1].
كان الأستاذ أحمد فَيزي -رحمه الله- لا يستكثر من الوعاظ، ولا يُعجبه أمرهم، وما استطعت أن أحمِله على سماع أحدٍ منهم، فهو من أهل العلم أصلًا؛ وذات يوم قابلته وأنا في طريقي إلى الموعظة، وأظنّ أن ذلك كان في الأسبوع الثالث من وصول الأستاذ فتح الله إلى إزمير، فسألني: إلى أين؟ فقلت: إلى الموعظة، إنّه واعظ ليس له نظير؛ هلمَّ معي، فأبى، فآليتُ عليه – وكان يحبّني كثيرًا – فلبّى دعوتي وحضرنا معًا؛ فلما انتهى الوعظ وصلَّينا الجمعة بدأ الناس بالخروج من المسجد، فشرعتُ أجمع أغراضي لنخرج، وكان بين الأستاذ فتح الله والأستاذ أحمد فيزي عدّة صفوف، فلما نهض الأستاذ فتح الله هبَّ هو أيضًا وتوجّه إليه مسرِعًا وتصافحا، لا أدري ما دار بينهما، فإن كان هناك ما أعلمه فهو أن الأستاذ أحمد فيزي اغتبط أيّما غبطة بحضوره الموعظة؛ فما إن انتهينا حتى سارّني قائلًا: “أصبْتَ، إنّه واعظ ليس له نظير”، قلت له هذا من قبل، والآن شاطرني الرّأي.
لم يكن الأستاذ فتح الله يرضى أن تُسجَّل مواعظه قطّ، لكننا لم نعبأ بذلك، ونجحنا في تسجيل الدروس، فالإمام الغزالي يقول: “أحيانًا تكون الموافقة قبيحة لا ينبغي أن تقع بل الأدب المخالفة ما أمكن”[2]، فسلكنا نحن أيضًا هذا المسلك[3].
كان للأستاذ فتح الله برنامج مكثَّف، فهو في عملٍ دؤوب ليل نهار؛ يحكي بكلماته هذه كيف كان يقضي يومه يقول: “كنت أعظ في أكثر من مكان -مكانين أو ثلاثة- في إزمير، وفي الوقت نفسِه لا آلو في الحضور إلى الأماكن التي تطلب مني موعظة، كنت أعِظُ كلّ جمعة في جامع كستانه بزاري، أما المواعظ الأخرى فأجعلها ما استطعت يومَي السبت والأحد، فالحمد لله أنِّي كنتُ أُطيق ذلك؛ مثلًا كنت أذهب يوم السبت لأعظ في أحد الأماكن، فيستغرق طريقي الليل كلَّه، وفي اليوم التالي أعظ في مكان آخر، وأقضي المساء في الطريق بلا فتور؛ ولم يكن شيء من هذا ليشغلني عن دروس الطلبة في الصباح، فكنت أُدرِك دروس الطلاب على وقتها”. فلو تأمّلنا رِحلاته هذه في المواصلات العامّة في ذلك الحين، لأدركنا شيئًا من المعاناة التي كان الأستاذ يتكبدها.
ورغم أن الأستاذ فتح الله كان يهدف من مواعظه ومحاوراته إلى الوصول للطبقة العريضة من الناس؛ إلا أنّه كان يرفض بَتَاتًا أن ينسب إلى شخصه ما يبديه الناس من شغَف بالموعظة، وكم كان يغضب عندما يصرف الناس اهتمامهم لشخصه بدلاً من الحقائق التي يتكلم حولها، وكان يتجمَّل بالتواضع -إحدى خصاله المميزة لشخصيته- وتواضعه يظهر عند اهتمام الناس بمواعظه.
وللسيد “مُحرّم قَلْيُونْجو” ذكرى يحسن ذكرها مثالًا على هذا، يقول: “ذات يوم ذهب الأستاذ فتح الله ليَعِظ النّاس في مقاطعة “بَرْصا” فذهبت معه بالحافلة، فلما وصلنا وجدنا الناس ينتظرون، فالموعظة بعد العصر أو المغرب، وبينما كنَّا ننزل من الحافلة إذ سمعنا نداءً من مكبِّرات الصوت بالبلدية: “انتبهوا جيِّدًا فاليوم سيعظنا الواعظ المشهور الأستاذ فتح الله كولن”، وتحيَّن الأستاذ فتح الله الفرصة ليتسلل من بين الزحام، وركب من فوره سيارة تنادي: إزمير.. إزمير..، ولحِقنا به بصعوبة في وسط هذا الزحام، ولم نعرف السبب؛ وعلمنا بعدُ أنّه غضب كثيرًا عندما سمع صوت مكبِّرات الصوت، فغادر المكان، ولم يعظ فيه ذلك اليوم.
ومثل هذا وقع في مدينة بُورْصة أيضًا، ففي إحدى المحاضرات تعالَت أصوات التصفيق عندما بدأ الأستاذ فتح الله بالحديث، فأشار إليهم ألا يفعلوا، إلا أنهم فعلوها ثانية، فحملق الأستاذ كالعقاب هذه المرة وأكمل حديثه، فلما تكرر الأمر قال: “السلام عليكم”، وغادر المكان، وكانت المحاضرة في سينما، ويحضرها جمع جمٌّ من الناس”.
نعم، إنّ مواعظ الأستاذ فتح الله بالغة التأثير، لكن لا يمكن أن نختزل وصفَها ببيانه المفلِق فحسب، فعِلاوة على هذا تلقاك مُعاناته قبل أن يتفوّه بأيّة كلمة، فقبيل الموعظة بيوم على الأقلّ يتفاعل مع موعظته في جيشانٍ هائل؛ لذا كان يفيض إخلاصًا وصدقًا في وعظه للسامعين، ولا ينِي في محاسبته نفسَه طَوال الموعظة، ولا يقول ما لا يفعل، وميزانه في هذا الأمر حسّاس جدًّا، يقول: “لو تثاءبتُ أثناء الصلاة في الليل، لقضيت شهرًا لا أتكلّم فيه بتاتًا عن الصلاة أمام عُمَّار المسجد”؛ إن هذا ليشير إلى محاسبته العليّة ونظامه الداخلي العالي.
كان الأستاذ فتح الله يُعنَى بشؤون الطلبة عن كَثَب، رغم برنامجه المكثَّف، وبلغ عدد من يُولِيهم عنايةً خاصَّة سبعين طالبًا؛ وقد أينعت دروسه بتأثيرها فيهم سعادةً وأملًا في ربوع قلبه.
ويحكي الأستاذ نكتة لأحد طلابه في هذه الفترة تشير إلى مدى تأثير دروسه فيهم، يقول: “إن كانت أعينُ الطلاب في درس الأخلاق لَتفيض من الدَّمع، وذات ليلة كنت أتجول في غرف النوم، فرأيت خليل مَزِيك قد ربط نفسَه بأعلى السرير المزدوج، فسألته عن صنيعِهِ، فقال: “فكرت فيما قلْتَه بالأمس، فربطت نفسي لئلا يغلِبَني النوم”.
مضَت سنتانِ على وصوله إلى إزمير؛ فازداد عدد الطلاب كثيرًا، وبات الاهتمام بهم في فترة الصيف ضرورة؛ فقام بتنظيم دورات تأهيل في مخيّمات صيفية، فواجهته عقبة التمويل، حقًّا إنّها معضِلة، فقصَد أنقرة يلتمس مِن أهل الخير الذين يعرفهم مَن يموّل حاجات المخيم لا سيما الخيام، فنهض هؤلاء بإنشاء أول مخيم، فالتحق به سبعون طالبًا؛ وما زال العدد يزداد في الأعوام التالية، حتى صار الطلبة في السنة الثالثة يتناوبون على المخيم لكثرتهم.
اضطُرّ الأستاذ فتح الله – وهو مَن يقف وما يزال وراء الخِدمة يومَ أن بدأت على هذه الشاكلة – إلى الاحتكاك بمن يتربَّصون به ويثيرون الزوابع من حوله، وكان منهم أن أرسلوا خِطابًا فيه ما فيه من تحقير لقاضيةٍ كانت تنظر في دعوى ضدّه في أدرنه، محاكِين توقيعه؛ فتحرّت النيابة عنه، إلا أن وكيل النيابة أدرك بعد التحرّي أنها مكيدة مُلفّقة، فبرَّأ ساحتَه.
وبينما الأستاذ يُمنَى بمثل هذه المكائد أخذ بعض الإداريين في سكن الطلاب يثير المشكلات أيضًا؛ فقد كان في صلته العميقة بالطلاب وتأثير وعظه فيهم ما يثير حفيظة بعض الإداريين في السّكن والوقف، كان هو المعرفة إلا أنهم أرادوا له أن يكون نكرة؛ فبذلوا قصارى جهدهم ليقصوه عن عمله؛ ويقتضب الأستاذ فتح الله وصفَه لهذه الفترة الحرجة بقوله: “برَّح بي الألم حتَّى لَكأني ألعَق الصَّبِرَ”، فتجشّم الصبْرَ على صُنَّاع المشكلات، فلما بلغ السيل الزُّبى اضطُّر أن يغادر كوخَه الخشبيّ بعد خمس سنوات أمضاها فيه، فترك هذا الرحيلُ آثارًا كبيرة في عالمه الداخليّ، وكان قد علِقَ هذا المكانَ فتجلَّى تعلُّقه به في كلامه عن كستانه بزاري إذ يقول: “كان سكَن الطلاب في كستانه بزاري كلَّ شيء في حياتي، ولم يخطر لي على بال أن أرحل عنه يومًا، حتَّى إنني تمنّيتُ أن يكون أحد أركانه قبرًا لي، فمرادي الأول والأخير أن أُدفن في كستانه بزاري، لأسمع أصوات الطلاب من قبري؛ نعم، فهذا هو كل ما أتمنى وأطلب من الدنيا؛ لذا رفضت دون أدنى تفكير ما عرَضه عليّ رجال الأحزاب بعزمٍ وإصرار من منصب رفيع”.
“كانت حدَّة الأزمات في كستانه بزاري تزداد يومًا بعد يوم دون توقف، فاتخذت منزلًا في حيّ “كُوزَلْ يالي”، وفي ليلةٍ ليلاء جمعت أمتعتي وحملتها في العربة، وساعدني الطلاب في ذلك، رحلت عن كستانه بزاري وعيناي تفيضان من الدمع، وقلبي يتلظّى بلوعة الفراق، فلربما برَّح بي الشوق إلى كوخي الخشبي الذي أنِسْتُ به سنين عددًا، ويكأنّي فقدْتُ شيئًا من جسمي بعد أن ألِفتُ كوخي وكستانه بزاري، ناهيك عن طلابي الذين نزلوا مني منزلة الرّوح من الجسد…
وأنَّى لي أن أنسى تيكم الأيام، أو كوخي الخشبي، وقد أفضيتُ بأقدس أسرار روحي إليه؟ لا أظنَّ أنَّ لي أن أنساه، وكيف أنساه أو أنسى طلابي الذين يتراءى لي خيالهم في كلّ شيء، ففي لحظات الوداع كانت أعينهم تفيض من الدمع حزنًا، وكأنيّ بنظراتهم البريئة تتوسل وتستغيث: لمن تتركنا؟ آهٍ آهْ… ليتني أقدر أن آخذهم معي جميعًا؛ إلا أنّ ذلك لم يكن في وسعي يومئذ”.
“كأنّ عجلة الزمان لا تدور، فالثواني باتت سنين، أمَّا الأيام التي قضيتها مع طلابي فأكاد أتخطّى فيها الزمن وكأنني أسابقه، فما أقوم به وما ينبغي عليّ أن أفعله يضيق به الليل والنهار، فالواجبات أكثر من الأوقات، أي هل لمثل هذا الوقت الضيِّق أن يستوعب هذا الكمّ من العمل الذي يتطلَّب أكثر من أربعة وعشرين ساعة في اليوم؟”
خلَّف الرحيل عن كستانه بزاري حزنًا هائلًا، فهذا المكان ليس كغيره، فكم وكم من الخِدمات شعّ نورها منه.
في هذه الفترة لمعت في الأفق فكرة إصدار جريدة، فأصدر هو وصالح أُوزْجان جريدة أسبوعيّة اسمها “الاتّحاد”، وحظي صدورها بتأييد السيد زبير كُونْدُزْ آلْب، وسرعان ما استفحل الخلاف حول الجريدة، فإذا بها بوّابة خلاف وقد كان يُرجَى لها أن تكون رابطة لا ممزِّقة، فلما رأى الأستاذ فتح الله أنّ الأمور لا تسير على ما يرام، وأن الجريدة لا يمكنها تحقيق هدفها على هذا النحو، عزف عن المشاركة في فعالياتها.
وفي هذه الفترة أيضًا سافر الأستاذ فتح الله ليحجّ، وكان ثالث ثلاثة أرسلتهم رئاسة الشؤون الدينية مشرِفين على بَعثة الحجّ عام 1968م، فأورثَته تلك الزيارة فضل شوق وشغف بحياة الصحابة لا سيما أنّه ترعرع على حبِّهم، وكان إذا تحدّث عن محبَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم يغطّ في بكائه غطغطة القِدْر، وكانَ هذا الشوق هو رفيقَه في رحلته كلِّها، وها هو ذا يحكي مشاعر غمرَته في أول وهلة رأى فيها الكعبة والروضة المطهّرة يقول: لما رأيت الكعبة والروضة المطهّرة لأوَّل وهلة إذا بي في حالة روحية لا تُوصَف، ولو فتّحت لي أبواب الجنة كلّها حينئذ –على فرض المستحيل- ودعيت إلى دخولها، لرغبت عن دخول الجنة حتمًا ولرغبتُ في البقاء بجوار الكعبة الشريفة والروضة المطهرة؛ لقد وجدْت في مجاورة الحرم الشريف والروضة المطهرة لذة روحيّة غامرة ومتعة ليس لها نظير…
تذكَّرْتُ طلابي لا سيما طلاب كستانه بزاري، فلهم عندي مكانة متميزة، فأعددْتُ قائمة بأسمائهم، وأحضرتُها معي إلى الحج، فدعوت لهم فردًا فردًا، عِلاوة على أنني دعوت لآخرين أعرفهم بأسمائهم”
من ذِكريات أيام كستانه بزاري التي لا يتأتّى نسيانها المخيماتُ التي أطلَّت ببشائر جيل جديد؛ وهي مخيمات صيفية أنشئت في “بُوجا” بإزْمير عند قرية “قَايْنَاقْلَار” في عرين أشجار الصنوبر بين الحقول؛ أُنشئت لتربية الطلاب وتهذيبهم، وتعليمهم كيف ينبغي أن يستثمروا وقتهم بشكل صحيح، فكانت مكانًا مناسبًا للمخيم، فالمكان يمتاز بالهدوء والهواء الطَّلْق على ما فيه من مشقة في تحصيل مستلزمات الحياة.
ويُعرِب الأستاذ فتح الله عن أهداف المخيم قائلًا: “يهدف المخيم إلى استغلال الطلاب لعطلة الصيف في هذه المخيمات، كيلا يذهبوا إلى قريتهم أو بلدتهم فينقطعوا عن طلب العلم، ومن أهدافه أن تنتظم عقولهم وقلوبهم وأرواحهم، وأن يتعمقوا في العلوم الشرعية.”، ولهذه الكلمات إشارات دالّة تفسِّر تأثّر من كانوا معه بأفكاره حينئذ. ويذكر الأستاذ أن الأيام التي قضوها في المخيمات تركت أثرًا عميقًا على الذين حضروها.
في السنة الأولى ضمّ المخيم 50-60 طالبًا، وفي السنة الثانية والثالثة ناهز عددهم الألف، فصاروا يتناوبون بعدئذ على المخيم، تراوحت أعمار من التحق بالمخيم في السنة الأولى بين 13-14 عامًا، ثم التَحق به طلاب الجامعة في الأعوام التالية.
لم تكن المخيمات مألوفة في هذه الفترة، فلم تجد كثيرًا من المؤيدين، فمن الناس من تردد في تعليم الشباب بهذه الطريقة؛ فواجه الأستاذ فتح الله عقبات عدّة في هذا الصدد، منها محاولته توفير مصروفات المخيم من ناحية، وتطبيق النظام والالتزام به في الحياة اليومية بالمخيم من ناحية أخرى، وتصدِّيه لصعوبات المكان الذي نُصِب فيه المخيم، يقول: “كان المخيم الأول كئيبًا بعض الشيء؛ فأنا المسؤول عن كلّ شيء، مِن نصب الخيمة إلى تجهيز الطعام، ولو فسد شيء من هذا فعليّ أن أصلحه، وكثيرًا ما كانت مضخة البئر تتعطل، فأصلحها بنفسي في كلّ مرّة؛ ولم تتوفر الكهرباء في العام الأول، وحصلنا في العام التالي على مولِّد كهربائي صغير بلغت قوّته ثلاث كيلو وات، وكثيرًا ما كان يتعطل المولّد أيضًا، وتصليحه عليّ طبعًا…
وكلما ازداد عدد الطلاب تضاعفت المشقة، ففي السنة الثالثة خاصّة حلَّت بالمخيم أزمة كبيرة في المياه، كنت أحمل المياه بعربة من الآبار من مسافة بعيدة في تلك المنطقة، فكنت السائق والساقي والمدرِّس، في الحقيقة إن توفير الطاقة لكل ذلك كان أمرًا شاقًّا لأبعد حد، لكنني كنت أحاول جاهدًا.
كان المولِّد الكهربائي قديمًا جدًّا، كنت أضطر كلّ يوم إلى فكِّه وإصلاحه، وَيْكأنّي أصبحت مهندس مولِّدات كهربائية! وأحيانًا كان لا بدّ من حفر البئر قليلًا، فأحفره بالمجرفة بمساعدة الأصدقاء، ثم تعاضدْنا لنبني الحمّامات، ففعلنا، بل حفرنا لها الصرف الصحي أيضًا.
وإنما أذكر هذه الأعباء لأنني أرى فيها أجمل لحظات حياتي، لا لأحكي عن مكابدات قاسيتُها يومئذ”.
وتفاقمت المشكلات بثالثة الأثافي؛ إنّها مشكلة تخلّي أمناء الوقف في كستانه بزاري عن مساعداته كليًّا للمخيم لا سيما المخيم الثالث.
وضاق بعض الناس ذرْعًا بزيادة عدد المقبلين على المخيم، حتى وصل الأمر بهم إلى قطع الطريق على الأستاذ فتح الله وطلابه، بل قاموا بتهديدهم بشكل غير مباشر؛ فطاف الأستاذ فتح الله شهرًا كاملًا في جبال “نِيف” يبحث فيها عن مكان للمخيم، حيث يقول الآن: “أعرف جبال نيف كما أعرف راحة يدي” إلا أنّه لم يجد فيها مكانًا مناسبًا، وخاطر بكلِّ شيء وأنشأ المخيم في نفس المكان.
كان الأستاذ فتح الله يقوم بأنشطة المخيم كلّها، ولا يغادره بلا ضرورة، اللهم إلا يوم الجمعة إذ كان يذهب إلى إزمير يخطب الجمعة ويلقي المواعظ؛ وفي السنة الثانية أخذ إجازة ولم يغادر المخيم، أما في السنة الثالثة فكان يغادر المخيم كلّ جمعة فقط ليخطب ويعِظ.
أمَّا أيّام المخيمات بأنشطتها الاجتماعية والرياضية الكثيرة عِلاوة على ما فيها من دروس تُلهب حماس الطلبة فيصفها الأستاذ فتح الله قائلًا: “ازدان المخيّم بالنظام والأدب والعلم معًا؛ فخطونا بهذا أول خطوة نحو عالمٍ طالما حلَمْنا بنَضْرته وصفاء آفاقه؛ واقعُ الأمرِ أنَّني لم أكن أفكّر في مغادرة المخيم والنزول إلى المدينة بلا عذر، نعم كنت آتي إزمير كل جمعة للخطبة والموعظة، وفي السنة الثانية أخذت إجازة ولم أغادر المخيم قطّ، أما في السنة الثالثة فلم أكن لأغادر المخيم إلا يوم الجمعة للخطبة والموعظة، لم يكن شيء على وجه الأرض يعدل مذاق التعبّد بقيام الليل، وبالتأهبّ لصلاة الفجر على وقتها في صيفٍ لياليه كأنَّها الضيف، وبالقراءة حتّى السحر. حاولت أن أنظم بقصيدة – وإن لم تكن بذاك – عن مشاعري تُجاه هذه المخيمات، وليت شِعري هل استطاع شِعري أن يُعرِب عن شعوري؟ لكنني لم آلُ جَهْدًا في التعبير عن خبايا ما في سريرتي من شوق ولذّة”.
“أيام المخيمات” هذا هو اسم القصيدة التي أشار إليها، وكتب الأستاذ مقالة في الموضوع نفسه عنوانها “الزمن في المخيمات”.
ومن الأهميّة بمكان لمن يؤرّخ لتلك الحقبة واصطبغ بمشاعرها أن يصف لنا في شعره أو مقالته كيف مرَّت تلك الأيّام، وجوهرَ ذاك النشاط المتميز الذي أُعِدّ للشباب في فترةٍ حِيلَ فيها بينهم وبين الروحانيات.
الزمن في المخيمات
إن الحديث عن يوم من أيام المخيمات بل عن ساعة فيه، لا عن أسابيع أو شهور أمرٌ لا طاقة لنا به، وأنّى لنا ذلك! وهي أشبه بحياة الجنة التي تسري في ذاتيتنا وتعيش في أعماق أرواحنا وتفوق تصوراتنا بأذواقها الأخروية؟. كلّ دقيقة فيها كانت كغمام الربيع تمطرنا بالذكريات، ونحن نلقي بأنفسنا على سفوح المستقبل النورانية في هذه الأحلام، ونحيا مرة أخرى بأيام الماضي المجيد بنُورها وألوانها وبهجتها ولهجتها…وكنا نستشعر بعمق أكبر أحيانا المحاسنَ الحاليةَ بألوان الذكريات وأضواء المثل العليا، ولربما كنا ندرك في بضع دقائق بأن البقاء يحيط بمشاعرنا وأفكارنا.
كنا نستيقظ كلّ سحر عندما تهب نسمات الأنس، على خرير الماء، وحفيف الأشجار، وزقزقة الطيور وأحيانا على نسيم عليل، فنهرع إلى السجاد الظامئ إلى سماع أنين الساجدين وآهات المتهجدين، ونشعل من جديد القنديل الذي كنا نعده للممر البرزخي، ونهرول إلى نوره عندما يشتد ظلام الليل، ثم نأخذ في انتظار شروق الشمس كما تنتظر القلوب المؤمنة البعث والحشر في قبورها.
كانت الشمس تنساب من بين أغصان الأشجار كل صباح، وترسل إلينا نشوة الأوراق بخيوطها الياقوتية الذهبية، فتغشى العيون، وتمتلئ الخيامُ والتعاريشُ بيوم جديد لامع منعش مشمس محمّلٍ بأحلى النسمات، يجعلنا نعيش في عالم من الأحلام يبعث على الحيرة والذهول.
وبعد الضحى نقع تحت وطأة لهيب حرارة الظهيرة التي ينفرد الإنسان فيها بروحه، مما يدفعنا إلى اللجوء والركون إلى أحضان أشجار الصنوبر والدلب. فكنا نتجول في حقب زمنية تتداعى فيها الأفكار بين حفيف الأوراق التي تحركها تلك الرياح اللطيفة، وعندما تشتد علينا حرارة الشمس أحيانا تزعزعنا الوساوس القائلة: “لا تنفروا في الحرّ”، لكن سرعان ما نفيق إلى أنفسنا جفلين قائلين: “قل نار جهنم أشدّ حرًّا لو كانوا يفقهون”، وكأننا في ساعات الصباح اللطيفة الجميلة الضاربة إلى الزرقة كنا ننفتح على عالم آخر وأعماق أخرى.
كم كنا نتمنى في تلك اللحظات أن نكون شعراء حتى نترنم بتلال الدنيا المطلّة على الآخرة، أو رسامين حتى نرسم ونخلّد هذه الجماليات المتداخلة، أو موسيقيين حتى نسمع تلك الجوقات الموسيقية الطبيعية التي نسكر بأنغامها، ونشاركها ألحانها.
وبعد العصر كانت أشعة الشمس الذهبية في هذه الساعات الضاربة إلى الزرقة تميل إلى الأفول رويدا رويدا. فنبدأ في الشعور بساعات المساء البنفسجية العميقة البليغة. وحينما تودّعنا الشمس وهي تلوّح بمنديلها الأصفر فوق أشجار الصنوبر والدلب كنا نشعر بالغروب بكل حزن وأسى، ونجفل ونرتعد ونحن نشهد كيف يضرب الفناء والزوال بكل قوة على وجه كل شيء يذبل شيئًا فشيئا، ولم نكد ننهار قائلين: “لا أحب الآفلين”، حتى نستعيد قوانا بنفحات: “إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين”، ونأخذ في الاستعداد إلى التجوال في فضاءات الليل التي تُلجِئ الناس إلى الاستغراق في الأفكار العميقة.
ومع المساء تشتد الرياح التي كانت تهبّ في العادة حلوة لطيفة، وتصيبنا بالبرد أحيانا وكأنها رياح الشمال. في تلك الأثناء يسكن جميع مبتهلي النهار الذين تربعوا فوق الأشجار، ولا يُسمع إلا أصوات بلابل الليل. وفي ساعات متقدمة من الليل تشتد الألوان وتعذب، وتصبح أبلغ تأثيرا وأكثر جاذبية حتى تجعلنا نفكر في حيرة: إذا كان طريق الجنة ممتعًا كلّ هذه المتعة؛ فكيف هي إذًا؟!.
في هذه الظلمة الحالكة التي تفقد فيها المصابيح بريقها نبدو ويبدو كل شيء مختلفا، وفي هذا الجو الساحر الذي يختلط فيه الخيال بالحقيقة يصبح أهل المخيم المؤهلون للولاية أشبه ما يكونون بالروحانيين، ويسري هذا الجو النقي في أعماقنا سريان النهر.
وعندما يحل وقت النوم تنطفئ كل الأضواء ما عدا قنديلا صغيرا أو اثنين. فتتذكر الأرواح الغوّاصة فناءها وتبحر في التفكير فيه وكأنها تتحنث، وتأخذ في البحث عن الماوراء من طرق شتى، وتصرّ على فتح أبواب السموات بمختلف اللغات، فتصاب القلوب بقشعريرة من جراء صيحاتها التي تحاكي أنّات إنسان عصر السعادة.
وفي أوقات معينة من اليوم تتنزل علينا الصلوات والتسبيحات والأذكار الجماعية، حتى كنا نشعر وكأن الملائكة الذين ينزلون بها يمسحون على رؤوسنا بأيديهم اللطيفة الرقيقة الوضّاءة.
كانت هذه الصلوات والأدعية تسري إلى أعماق أرواحنا بمعانيها التي يتعذر التعبير عنها وطلاسمها التي يصعب التصديق بها، ثم تَعرض أمام ناظرينا خرائط الرحلة السماوية.
المخيم في رأيي كان بقعة مباركة تهبّ عليها رياح المحبة والشفقة ووجود الأصدقاء. كنا هناك مثل النحل في خلية روحية، نتردد بين رحيق الأزهار والعسل اللذيذ، إحدى يدينا في الأزهار والأخرى في الخلية. ولقد توحدت هذه الأفكار والمشاعر وامتزجت بأرواحنا، ورغم مرور سنين عدة فإنني ما زلت أشعر بها بقوة وحيوية في قلبي وروحي وذاتيتي.
كانت تلك اللحظات الشاعرية النيرة التي قضيناها في المخيمات تتلون خاصة أثناء أداء العبادات ودروس الوعظ وحلقات المذاكرة وتتعمق وكأننا نحتضن الروحانيين. وكان الحنين إلى الجنة يعلن عن نفسه في أرواحنا على اعتبار أنها هي الوطن الأصلي لأبينا آدم، حيث كنا نشعر بين أطياف الضياء بالدقائق والساعات في المخيمات والجو الأخروي المفعم بالليونة والجدية والوقار، وأن الله تعالى الذي يستخدمنا في العبودية سينجز وعده لنا. فكنا نقول في أنفسنا: “هذه هي الحياة!”
إنني لا أصدق أن هذا الماضي المبارك المنير كان عبثا وهباء؛ لأن تلك الأيام وإن مرت خلال حقبة زمنية وجيزة إلا أنها كانت بالنسبة لنا مرصادا للماضي بأكمله، وخرائطَ برزخية تتبدى فيها أحلام المستقبل.
وكلما قلّبت ذكريات روحي أرى أن تلك الأيام المفعمة بالشاعرية والجاذبية والشفقة واللين ما زالت تتفتح حيوية في داخلي على الدوام وكأنها ورود تتفتح براعمها دون اعتبار لموسم أو غيره، لم تكد تذبل حتى تتفتح من جديد، فتتقد روحي بأسمى المشاعر الرومانسية، وتتجدد في ذهني ذكريات لطيفة، حتى إنني أشعر بنفسي تحت تلك الأشجار اللطيفة وكأن أصوات الجراد قد اختلطت بأصداء الطلاب ذوي الأنفاس النورانية وتسبيحاتهم وتراتيلهم وشكلت جوقة موسيقية مختلفة. ثم أبتسم على طالعي في متعة مختلطة بالأحزان.
من يدري كم من أسرار لم تكشفها لنا تلك المخيمات!. لقد استوعبنا ما تسلل منها إلى آفاق أفكارنا وتخيلاتنا، وحاولنا عرضها بقدر المستطاع، غير أن تلك الأيام ستظل بالنسبة لي حتى النهاية أزهى فترات حياتي.
فلو أتيحت الفرصة للناس لاصطحاب ذكرى ما في الرحلة إلى الدار الآخرة فلا جرم أنني كنت سأحمل معي ذكريات تلك المخيمات التي تشبه أزهار الربيع في تألقها وخيالاتها وغموضها وزرقتها.
ورغم أنني أعرف صعوبة الحديث عن هذا الجو الحالم في تلك المخيمات لمن لم يعيشوها معنا فإنني وددت أن أتحدث عنها؛ لعل رغبتي هذه تسوق المؤهلين الذين يسمعون حديثي ويرون عجزي وضعف قابليتي في السرد والحكي إلى التنقيب عن هذه المخيمات ودراستها والتعبير عنها بأبعادها الحقيقية. فإن كان لحديثي منفعة بهذا القدر اعتبرت نفسي سعيدا ومحظوظا.
أيام المخيمات[4]
إن الذين عاشوا معنا تلك الأيام المفعمة بالأحلام
حيث يهب نسيم الجِنان،
سمع من سمع منهم نغمات البقاء
بأصداء فولاذية.
***
لتلك البقاع أشواق وأنين
كأنها تشتاق إلى تلك الوجوه المُشرقة
فلو نطقت الأشجار والأحجار
لحدّثتنا بأحاديث ساحرة
***
تغريد الأطيار، وحفيف الأشجار، وأنين الأخيار
وأفئدة غدت لنجوم الليالي من السُمَّار
في كل مكان قلوب أوّاهة تجأر ليل نهار
نغمات ما زالت أنّات للوادي الأخضر
***
قامات تقوم حتى الصباح بالدعاء
وعيون ساهرة ذات معان بلّورية
إن هذا التضرع يماثل ما في السماء
سنوات خلَت وما زال قلبي يحنّ لتلك الأيام
***
لو رأيتَ النهر لارتعدتَ وقلتَ:
ما زالت تلك النظرات السعيدة تبتسم في قاعه
ولبادرتَ ساعيًا إليه
إنِ اليوم فذاك وإلا فغدا…
[1] توفي جاهد أردوغان في 10 يونيهْ/حزيران 1991م؛ إن الله تعالى استجاب دعاءه فظلّ ينشرُ مواعظ الأستاذ فتح الله حتى الوفاة، رحمه الله رحمة واسعة.
[2] إحياء علوم الدين: 2/56. وسياق المقولة (كان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليق الحسن، فكان يعتذر منه على المنبر ويقول في خطبته: إن حسناً مطلاقٌ؛ فلا تُنكحوه، حتى قام رجل من همدان فقال: والله يا أمير المؤمنين لننكحنّه ما شاء، فإن أحبّ أمسك، وإن شاء ترك، فسَرَّ ذلك عليًّا، وقال: لو كنتُ بوّاباً على باب جنّة … لقلت لهمدان ادخلي بسلام
وهذا تنبيه على أن من طَعَن في حبيبه من أهل وولد بنوع حياء، فلا ينبغي أن يوافق عليه، فهذه الموافقة قبيحة بل الأدب المخالفة ما أمكن).
[3] يُحكى أن الأستاذ فتح الله عاتبه ذات يوم من أجل تسجيله المواعظ، لكن السيد جاهد رد عتاب الأستاذ بأسلوب يحاكي العتاب أيضًا قائلًا: “لا أسجّل المواعظ لأجلك أنت، ولكنني أسجّلها ليستفيد الناس بها، هذه مهمتي التي تهمني، فلتهمك مهمتك!” فلم يستطع الأستاذ فتح الله أن يجيب، فاستمر هو في مهمته إلى آخر عمره رحمه الله.
[4] من شعر الأستاذ فتح الله.