الرؤيا ليلة السفر
كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا حين دق جرس منبهي برنته التي تعودت عليها منذ سنوات. كانت يداي المرتخيتان تبحثان عن المنبّه لإسكاته، ليس رغبة في العودة للنوم، وإنما هو شعور بعدم إشباع في النوم، بعد سهر طويل لترتيب الحقيبة، ومستلزماتِ عُدّة السفر. جسدي مستعد، ويبدي رغبة في النهوض، ولكن روحي كانت تقاوم حيوية الجسد، وتحاول إبقاءها في برزخ عالم الأرواح، تخاطب من التقت بهم لساعات بلغة لا تعرفها، لكنها استطاعت فهم معانيها واستيعابها جيدا.
نعم كان المنبه يهتز يمينا ويسارا على مائدة طاولتي، بينما كنت أتجول في عالم لا أعرفه، ومع أناس فضلاء كرماء، سألوني عن اسمي بلغة مُرَكَّبَة فأجبت: “مريم”.. سألوني عن أصلي ونسبي؟ فأجبت “بنت آيت أحمد”، حفيدة المجاهد الأنصاري طلحة الدريج ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت.
كان الجو دافئا مع غيوم بيضاء توحي باحتمال سقوط زخات ثلجية، وفي هيبة المكان، كنت أتساءل وأنا أرفع عيني إلى هذا التمازج الذي يعبر عن سر رباني كبير، استشعرتُه من خلال حضور من كانوا يملأون فضاء تلك الجلسة الربانية. كان سر الجلسة في صمت أصحابها، إلا ما استثني من سماع تسبيح لفظ الجلالة، الله.. الله.. الله…
كنت أحدق في عيون من جمعني القدر بهم في حيرة، عساني أتعرف إلى أحد منهم. ألمح بحياء وجوهًا ملأت بأنوارها عنان السماء الصافية، الملونة بغيوم بيضاء تزداد اتساعا وامتدادا كلما ازداد ذكر لفظ الجلالة الله.. الله.. الله.. الله…
نعم أنا هناك معهم، ولكن أين أنا؟!. أين ذاك الهناك؟!. أهو في الأرض أم في السماء؟ من هؤلاء، ومن أتى بي عندهم؟ أهو القدر أراد أن يجمعني بهم في الرؤية ليلة سفري إلى إسطنبول؟!..
الساعة تشير إلى السابعة والربع، بدأتُ أحاول التسحب بلطف من تحت لحافي الدافئ. فأنا بين حالة وجدانية روحية عميقة عشت تفاصيل مشاعرها في منامي، وبين موعد مع رحلة إسطنبول التي ستقلع ظهرا من مطار الدار البيضاء. إسطنبول التي رسمت في مذكرات طفولتي ومن حكي جدي سيدي طلحة صورة البطل الفارس المقدام محمد الفاتح، والأيوبي والنورسي.. بلد العلم والكرم والمدارس والتكايا.. بلد الجمال والطبيعة الخلابة بشقيها الأروآسيوي..
الرحيل إلى المركبة الروحانية
نزلت مسرعة من باب إقامة الرشيد، محل بدء رحلتي متوجهة لمحطة قطار سلا، حيث موعد اللقاء مع قطار التاسعة صباحا نحو مطار محمد الخامس، ومن النافدة كنت أراقب بحذر رفيقة رحلتي التي كانت متوجهة أيضا إلى تركيا، حيث كان ترتيب القدر يسوقنا من نقطة اللقاء الأول محطة أكدال إلى مطار البيضاء، متوجها بنا من على متن طائرة حديدية الصنع إلى فضاء مركبات نورانية إيمانية، صنعت كراسيها بأياد ارتوت بلغة التسبيح والذكر، وزين ثوب كراسيها بخيوط حريرية رفيعة تفانى من نسجوها في إبداع هندسة رسوماتها، فاكتملت براعة الناسج والصانع والحرفي.
نعم إنها مركبة ربانية، تعب صانعها على اختيار جودة مواد تصنيعها، فهي مواد خام طبيعية، انبعثت من معدن باطني، له خصوصية التفرد والتميز، وخدمة الإنسان محور الكون في الحياة.
بدأت عقارب الساعة تتجه نحو موعد إقلاع المركبة الحديدية، بينما علا نداء المركبة الروحانية يرحب بنا، بدقائق معدودة قبل الإقلاع على متن الخط الرباني الذي سيقلنا نحو أفق العرفان والوجدان.
إنه نداء الربان زياد يخاطبنا بصوت روحاني حيي قائلا: “مرحبا بكم على خطوطنا التركية النورانية، حيث سنوفر لكم أرقى خدمات فتحية ربانية”.
وكعادة أبناء العلماء والفضلاء الأحرار في الترحاب بأهل العلم، يتقدم ربان المركبة النورانية وينزل من غرفة قيادته، ليقدم أرقى مشاعر المودة باستقباله في قاعة الوصول، ضيفتان شرفهما القدر بأن ينعما بالإقلاع الثاني في رحلة إيمانية تحت قيادته. وشتان بين المركبتين، مركبة الصنع الحديدي للخطوط التركية التي كنا نحاول النوم على متنها، تفاديا لملل طول المسافة، ومركبة الخطوط التركية ذات التميز بخدمات الفتوحات النورانية.
لم يطلب منا مساعد الربان، ربط أحزمة الأمان، وهو يحرك مقود مركبته نحو اتجاه منطقة العمرانية، فسألت عن السبب؟.. ترى أيخْتلف نظام طيران الفتح عن كافة أنظمة وبرامج التحليق والطيران العالمية؟! أهو نظام يحتكم لسند قانون متصل المدد، بطريقة دعاء الجوشن الكبير “الأمان الأمان الأمان.. الأمان الأمان الأمان..؟”، أم أن أيادي الربان زياد، ستسلمنا بأمان الأمان، إلى مدخل مطار الفتح بالمنطقة الآسيوية، حيث مدخل قاعة كبار الزوار من أهل المدد الروحاني.؟!
“باران” الغيث ومستشفى “سماء” الروح
إنه اللقاء الأول في إقامة باران الغيث.. باران المعنى، من صاحب المعنى.. باران العطاء بلا حد.. باران القائدة فاطمة نور، نور على نور.. وألف سلام لمن أشاع بنور شمعته الباهتة، من “إِزْمِير”، أنوارا كونية تشعّ بنورانيتها فضاء العالمين.. وسبحان مَن سخر لنا هذا وما كنا له مقْرنين.
هنيئا للرحم الذي خرجت منه فاطمة، وهنيئا للمربي “فتح الله” الذي حباه المولى U، ببنوة آلاف من الأبناء والبنات، وفّاهم حقهم، ورعاهم بأجود رعاية، وكفلهم بأحسن تربية، فقدمهم لخدمة الإنسان، بأرقى درجات التميز والكفاءات والتواضع.
فاطمة.. وما أدراك ما فاطمة؟! إنها روح تسري رغم أنف كل متجبر لتبحر في أعماق نفسه.. إنها الجود والغيث.. إنها الإيمان والتربية، الإخلاص والتفاني، المحبة والرحمة…
يا سلام.. ترى أي أرض هذه أقلنا فيها ربان السفينة النورانية؟ أنحن ما زلنا على سطح الأرض، أم ارتقى بنا إلى عالم برزخ الأولياء؟
منذ اللحظة الأولى، أحسست وأنا أحيي طالبات اليُورْتْ “النزل” وهن يحضنني بلهفة لقاء المحب لحبيبه أن غرفة إقامتنا بالطابق الخامس في باران تحمل أسرارا اجتمع ثقل معانيها، ليضغط على كتفي، ويحرك مشاعري، نحو مَن جمعني بهم القدر في منام ليلة سفري لإسطنبول.. والتقيت ببعضهن رأْي العين في غرفة الطابق الخامس.. ارتبكت قليلا دون أن أبين ملامح تغير أحوالي، وفي محاولة مني لرفع ثقل الضغط النفسي الذي أصاب جسدي، كانت فاطمة ترتّب مائدة العشاء التركي مع طالبات من أرق وأجمل ما رأت عيني على الإطلاق.
بدأ ترتيب برنامج رحلة نداء فتح منافذ الروح يوم 22 ديسمبر2010 على الساعة التاسعة صباحا حيث رتب لنا ربان الرحلة وقائدها زياد أبي لقاء في مستشفى سما. وأنا أجهز نفسي للموعد، كنت أتساءل عن سر هذا اللقاء، “لم المستشفى؟ وما علاقة زيارتنا بمدير مستشفى؟”..
لم أكن أعلم أن الجواب سيكون في عيادة مع طبيب ماهر، سيخصص لنا أول جلسة علاجية، تبدأ بتشخيص أمراض القلوب التي كنا نحملها معنا، لتنتهي بوصف العلاج المناسب، تكفّل ربانُ مركبتنا بشرائه لنا من صيدليات إسطنبول، وتقديمه لنا بجرعات محددة، في أوقات معينة..!
كانت أمّ سداد برفقة الملاك الطاهر جمال، تحلق بروحها الراقية، كحمامة سلام بيضاء في فضاء “سما”… ترتقي بسموّ أميرات زمان العهد النوراني بمدخل سما.. وقبل وصولي لطابق عيادة الأستاذ مصطفى، بدأ قلبي يخفق بعدما أخبرني زياد، بأن هذا المستشفى، كان محطة راحة أبدية لعلماء وصانعي مجد الأمة.. فقرأ حدسي، وأجاب عن سؤالي، قبل الوصول إلى مقر موعد اللقاء.
نعم لقد عشت في هذا المستشفى، وارتويت بتفاصيل مشاعر عميقة، عبّر عنها من سطّر تاريخَ مجد “عودة فرسانِ” العزةِ والفتح النوراني، العلاّمة “فريد الأنصاري” رحمة الله عليه.
ترى يا مريم، أيسوقك القدر لحضور مراسيم مقامات شهود المدد الإلهي المتصل مباشرة بالعلماء ورثة الأنبياء؟!.
كان المدخل عبارة عن حديقة، امتزجت تصاميم هندسة غرس أشجارها، ونبات زهورها بفنية بالغة، انطبعت بمرتفع زجاجي، يطل على باقة من النباتات الخضراء، ذكرتني بمرتفعات جبال كنتن الخلابة بماليزيا.. تجولت بعيني، يمينا وشمالا، لأرى أغصان الأشجار تنمو وتترعرع في جنبات جدار على شكل لوحات فنية راقية رسمها فنانون أتراك نحتوا فيها سر حرفة وصنعة الأجداد، فأرّخوا بها إبداعات شموخ ريشة الفن العثماني التشكيلي الذي ملأ أجزاء ومقاطع من مساجد وقبب ومداخل المتاحف الأثرية العثمانية.. وأنا ألتقط صورا أحتفظ بها فخرا بهذا المستشفى الرائد، في الجمع بين استقطاب كفاءات طبية عالية، وتجهيزات رفيعة المستوى، وبين قيم احترام الفن الحضاري الإنساني، بالارتقاء بمشاعر المرضى الروحية، وضمان راحتهم النفسية قبل الجسدية.. كنت أسأل نفسي في صمت، عن سر هذا الاعتناء الغير عادي، بالأمن الروحي والجسدي للمريض..
فسبحان من يسر الأيادي الناعمة، لصقل مواهب مريدي مشايخ الفن الحرفي.. وسبحان من ألهم صاحب الذوق والفن والجمال، إيحاء جعل فضاءات عباد الرحمن خضراء، تنطق بلغة تسبيح من أحياها.!
وأنا في طريقي نحو مكتب الأستاذ المعالج لصدإ الروح، وقفت بإكبار أمام غرفة لا أعرف لماذا أحسست بأن شيئًا يجذبني نحوها؟!
تسللت في فضول، لأرى ترتيب الغرفة، وأتمعن في إطلالتها الجميلة على البوسفور.. سمعت صوت زياد يقول “سبحان الله.. كنت تعلمين مريم أنها غرفة المرحوم فريد الأنصاري..!”.
الحقيقة أنني لم أكن أعلم.. ولكن أحسست برغبة ملحة في الوقوف عند باب هذه الغرفة، وفي صمت رهيب، خيم على روحي، استحضرت سيرة هذا العالم المغربي الجليل، فهمست بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على روحه الطيبة، سائلة من المولى جمع كل أهل المحبة في جنة النعيم، على سرر متقابلين.
“أمّ سداد” لم تعرف سر سكوني وجمودي، في زاوية تلك الغرفة، فدخلت مهرولة تحاول كسر صمتي، أخرجتني بلطف وهي تمسك يدي وتشير إلى عمود ضخم يمر عبر ممرات المستشفى، تبتسم وتشير إلى سقف الممر “تعرفين ما هذا مريم؟”.. لم أبد أي تجاوب. وكأن روح هذه السيدة الفاضلة، أحست باضطراب أحوالي، فلم تحرجني بانتظار الجواب، بدأت تشرح لي تفاصيل هذا العمود السحري العجيب، الذي يحمل قنينات دم التحاليل الطبية للمرضى، ينقلها من عنبر إلى عنبر، بفعل ذبدبات مغناطيسية كهربائية.
مازال ثقل لحظة استحضار مقامات هذا الرجل العظيم -ألف رحمة ونور عليه- تثقل كتفي، وتستوحي لحظات حرقة فراقه… منارة أضاءت سماء علماء المغرب… وفي عزم شديد، استرجعت مشاعري، التي انساقت مع محبة خالصة أكننتها لهذا العالم الجليل، الذي أجمع المغاربة قبل الأتراك على حبّه، فحركت رأسي معبرة عن إعجابي: “حقا يا أم سداد، إنها تقنيات عالية المهارة. لم أرها من قبل حتى في أحسن مستشفيات لندن”.
كان اللقاء مع الأستاذ مصطفى، مدير مستشفى سما، ينطق بروح المكان، ويوحي بهيبة جلال أسرار تحمل الأمانة. لا أعرف لم انتابني شعور، وأنا أتحدث على مائدة الفطور معه، بأنه الدينامو والطاقة المحركة، لخلايا النحل التي تجوب بساتين وحقول العالم، بحثا عن إنتاج أجود العسل لعلاج مرضى هذا المستشفى.
الأستاذ مصطفى، يحمل أسرارا، لم أتوصل إلى اكتشافها بعقلي. لكن عيونه المشعة ذكاء وبريقا، كانت تتكلم بلغة السر، والكرامات التي لا يصل مددها، إلا للعارفين.
كنت أواصل الحديث تباعا، عن مواضيع فكرية، وهموم معرفية، يعيشها كل من يحمل الرسالة، للارتقاء بكرامة الإنسان. تحدثت عن أسباب اللقاح الثقافي، وأنا أحاول عدم الإثقال على المترجم زياد، فأختصر المسافات، وأركز على أساسيات الجوهر.. أتابع حديثي: “المنتج الثقافي سيدي، ونحن على مشارف جسر البوسفور، رمز التواصل بين حضارتين آسيوية وأوربية، يعبر أربع وسائط لتحقيق التواصل الحضاري بين الجماعات البشرية وهي: 1-التجارة، 2-الحرب، 3-الحمل، 4-التعرض والتعريض. مفهوما التجارة والحرب واضحان بلا شك”.
يرد عليّ الأستاذ مصطفى: “أَوَتْ، أَوَتْ، واضح جدا”.
أتابع: “أمَّا مفهوم الحمل سيدي، فالمقصود به هو تحرَّك الأفراد بين الكيانات الحضارية، حاملين معهم بعض منتجات حضارتهم (المادية والمعنوية) إلى حيث يقصدون.. ومن ثم يعودون من المناطق الحضارية التي زاروها، وقد جلبوا معهم منتجات طريفة يقدمونها إلى مجتمعاتهم؛ بينما يشير مفهوم التعرض والتعريض، إلى فئة واسعة من نشاط أجهزة الإعلام في الدولة الحديثة، وكذلك المعارض، والمؤتمرات، والمهرجانات، وزيارات الفرق الفنية، والعلماء والأكاديميين، وأنشطة الترجمة بجميع أشكالها ومستوياتها”.
الأستاذ مصطفى: “نلاحظ من تعريف التواصل حسب ما ذكرت أستاذة مريم، أنه ينطوي على توافر عناصر التبادل بين الأطراف المعنية، وإن كان هذا، لا ينطبق على مفهوم الحرب للوهلة الأولى، ولكن في الأغلب ينتهي الأمر بها (أي الحرب) إلى تبادل الأخذ والعطاء، بين الغالب والمغلوب”.
أجيب: “أكيد سيد مصطفى.. إذا نظرنا إلى مفهوم التواصل، بعين الرضا، فإن هذا لا يعني أننا نقبل بجميع الوسائط، التي يتمُّ بها هذا التواصل، بل يجب علينا الاستفادة من الجوانب الخيّرة فيه، وترك الجوانب السيِّئة، وهنا تبرز عقلانيّة المتلقّي، في اختيار ما يُعرض عليه من منتجات الحضارات الأخرى.. فيميز ما يناسب ظروف حضارته وإمكانيات تطلعاتها المستقبلية، بعيدًا عن انفعالاته العاطفيّة غير المدروسة، واتّخاذ المواقف المتسرّعة والأحكام الجاهزة، ورفض كل ما هو جديد، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والاطلاع والدراسة”.
كنت أحاور الأستاذ مصطفى، وكلما نظرت في بريق عينيه الذي يشع ذكاء، كلما قوي صوت الهاتف الروحي.
وبلغة همس داخلي، كان يقطع عليّ تسلسل أفكاري، ليخبرني بأن من أقابله، تحمّل مع مهندس البناء المعرفي والعملي للخدمة عبءَ أمانة، ثقل حملُها على جبال شامخة… مما كان يوثق لديّ صلة الربط الروحي، بسر الكرامات الذي استشعرته فور اللقاء المباشر بهذه الشخصية المتميزة. إنه سر المعنى الذي لا فهم له، بل هو معنى المعنى الذي لا صفة له.
وبينما كانت روحي تسحبني نحو ثقل فهم معاني أسرار المعاني، كان عقلي يتدارك ويشدني نحو قراءة التفكير العقلاني الممنهج، لشخصية فقيه الأولويات، في علم المواقف، وحسن التدبير والموازنات.
نعم كان كرم الهدايا الرمزية المعنى مسبوقا بكرم معنى الرمزية في الجود الأخلاقي والعناية الإنسانية، وهي عناية رفيعة المستوى، مصممة بأرقى وأثمن جواهر العفة، والتواضع، والمحبة لأهل العلم والفكر.. فازدادت قيمة أحجارها الكريمة في نفسي.
أخذنا الحوارُ الممتد نحو عوالم سوق المنافسة الحضارية، وأخذنا الاستمتاع براحة هدوء المكان، رفقة ضيوف آخرين، جمعتنا بهم مائدة فطور، الأستاذ مصطفى.
كنت أراقب دخول وخروج المسؤول الإداري عدة مرات للمكتب.. ينسحب ثم يعود مرة أخرى، وكأنه هُدهد يسعى لإخبار السيد بأمر هام.. لم يخب حدسي.. أخيرا جمع المسؤول أنفاسه، وقدم في خطى ثابتة نحو صاحب الضيافة، فألقى في أذنه همسا خفيفا. ترى ما سر ارتباكه؟ وما سر ذاك الهمس الخفيف الذي لا يكاد يسمع؟! طبعا بالنسبة لي حتى لو لم يكن خفيفا، يستحيل أن أفهم معناه دون ترجمة. ردّ الأستاذ مصطفى بكلمات مختصرة جدا، فهمت منها كلمة “ممكن”..
خرج المسؤول مسرعا، عاد بكاميرا، يلتقط لنا بها صورا. صاحب الضيافة مستمتعا بالزيارة، يسلمنا بانشراح هدايا ودّية أخوية، تعبر عن رمزية ميثاق عهد المحبة. وأنا ألتقط صورا تذكارية مع فريق عمل هذا المستشفى الضخم أخبرني الأستاذ زياد، قائلا: “أتدرين من كان على موعد مع الأستاذ مصطفى، ونحن في مكتبه؟”. قلت: “طبعا لا أدري، ومن أين لي أن أعرف؟”..
زياد: “إن المسؤول حين همس في أذن الأستاذ مصطفى، كان يخبره، في تلك اللحظة عن وصول موكب رئيس دولة، في زيارة محبة وأخوة لمكتبه، وأن البروتوكول على الباب يحتاج القيام بمسؤولياته الأمنية في مكتب الاستقبال”.
أسأل بفضول لم أعهده في نفسي: “طيب، وماذا كان رده؟!”.
زياد: “أتدرين ما كان جوابه أستاذة مريم؟ قال له: أجّل الموعد إلى ما بعد عشر دقائق أخرى، لأنني في حضرة أهل العلم والمعرفة. والعلماء ورثة الأنبياء، هكذا علمنا ديننا، وهكذا تربّينا على يد العلامة فتح الله الذي عشق العلم وأهله”.
الآن فقط، سمعت رمزية لحن عزف المزهرية العثمانية الأصيلة، هدية الأستاذ مصطفى، وهي تنشد أنشودة قصة لحن عودة الروح، لتتناغم ومراسيم الاحتفال بعرس زفة العالم، حين تكرمه وتقدره السلطة.
إن المجد لله، والعزة لله، والنصر من الله، والفتح من الله، والرحمة صفة الله، والتواضع صفة أولياء الله.
هذا ما نطق به قلبي قبل لساني وأنا أودع أبرع طبيب في جلسة استشفائية بالطابق العلوي من مستشفى سما الروح، حيث تم استئصال جزء كبير من أمراض، ورم غفلة قلبي وصدأ روحي.
كانت أم سداد تعانقني، وهي مثقلة من جهة، بالإصرار على حمل هديتي، ومن جهة أخرى بالتفاني في خدمة أهل الله صحبة الزوج، الذي أكرمها الله به، وأكرمنا بصحبته.. زوج ينحدر من سلالة، جذورها ثابتة، وأصولها متفرعة، ومتصلة بالنسب الممتد، نحو غصون شجرة الفتح الرباني.
كان ربان مركبتنا النورانية، يخبر سائق الرحلة بموعد اللقاء الثاني، حيث تبدأ مهام تحديد جرعات وصفة الدواء اللازم، لتفاعل خلايا محركات أدمغتنا، وأنزيمات دم قلوبنا.
خواطر من ذكريات أحفاد طلحة رفيق درب الفاتح
عندما ينسج الطفل خيال ثياب مذكراته الطفولية، ويحيك بها وشاحًا من اللؤلؤ الأبيض، يبقى هنالك خيط مشع يلتصق بثنايا الروح، لعله الخيط الذي يربطني ببيت جدي.. البيت الذي تعانقت فيه أرواح وأجساد المحبين، بما غمرها من نشوة عشق الوصال، في مدارج السالكين.
كانت صبيحة عيد فطر، وهو العيد الذي نجتمع فيه في بيت جدي، حيث فضاء الغرف الممتدة الواسعة، والمزينة بمفارش متحفية، مزركشة بألوان فضّية، وأثاث ينطق بلقاء وتمازج الحضارات.. مزهرية سورية.. زربية تركية.. مفارش لبنانية.. ومرايا ولوحات من كل البلدان التي كان يجوبها جدي، ترحالا وعناقا روحيا…
جدي سيدي طلحة، المتصوف المحب لأهل الذكر، والزهد والورع، حفيد العالم المجاهد طلحة الدريج الأنصاري، جيش آلاف الجنود لغزو البرتغال، والدفاع عن حصن الإسلام بمنطقة سبتة ما بين 1426 و 1429م.
كنت أعشق اللعب بجوار النافورة، المنحوتة بفسيفساء أزرق، ممزوج طينه بصفار فاقع لونه، تظهر أشعة الشمس، بنسيج خطوطها الممتدة نحو الماء، تحيط بها نباتات وأشجار صغيرة من كل الزوايا، تعانقها الأزهار برائحة الفل والورد والياسمين، تسحرني بهدوء بركتها التي كنت أراها نهرا ممتدا.. أمرح، وألعب، وأسبح داخلها، كأنها لؤلؤة زمردية، تزين طوق فناء البيت. عند الشروق، كانت تغمرها أشعة الشمس، لتشرق معها آمال جديدة. وعند الغروب، كانت الشمس تودعها، وتودع من يحيط بها من نساء البيت، وهي تبتسم لي ابتسامة، تتلاشى شيئا فشيئا، من وراء ستائر الغيوم، على أمل اللقاء في اليوم القادم.
* * *
غرفة جدي كان فيها سر سحري، يلحق بمن يقترب منها، فيطير بمشاعره على أجنحة بساط سحري، لحن صوته تعانقه رنة الإخلاص.. الحب، الثقة، رشفة الذكر بمسبحته الكستائية، تحرك فيوضات روحه، فتنهمر الدموع، كما تتهاطل الأمطار مع غيوم سوداء.
كنت أسأل مرارا أمي عن سر بكاء جدي؟ فتجيبني “جدّك -بنيتي مريم- تسكن روحه محبة الجهاد والمجاهدة، الجهادُ بنيتي ورثه من أسرة أجدادك، من بني الدراج الذين استقروا بغرناطة، ومنها نزحوا إلى مدينة سبتة في بداية القرن السابع الهجري، حيث نصب جدك، العلامة أبو عبد الله الدراج، خطيبا وقاضيا لسبتة 693 هـ، وقد كان أحد الناجين من “المدينة المحتلة” ومن المذبحة الرهيبة التي أعقبت سقوطها في يد الصليبيين سنة 818 هـ – 1415م. أدى به حال المجازر الصليبية، إلى النزوح بثروته بعد وفاة والده، من سبتة إلى مدينة تطوان، ومن منطقة أنجرة الغربية بموضع ملوسة، حيث اختار خلوته، وسخر ثروته لشراء السلاح والعتاد، ووظف علمه وورعه، لشحذ همم المريدين. فانطلق فارسا موحدا في حملته العسكرية لملء فراغ الساحة الجهادية.
جدك طلحة الدريج السبتي مريم، نزح إلى تطوان أواسط القرن السابع الهجري، جراء التعذيب والشنق، الذي لقية المسلمون من مجازر محاكم التفتيش الصليبية. كان معاصرا لعبد الرحمن الجزولي، وأحمد بن سلام بن مرزوق المجكسي. وقد شاركا إلى جانبه في العديد من الغارات الجهادية بين 1420 و 1429 م. ومن تطوان تزعم فقيه وقاضي سبتة قيادة المقاومة بثلاث حملات جهادية. الحملة الأولى بنيتي في 1427م حيث عبأ فيها نحو أربعمائة من الفرسان، وآلافًا من المشاة، اقتحم بها ميدان سبتة في مقاومة الغزو الصليبي والوجود الأجنبي. والحملة الثانية، 1428م وزع فيها الطلائع السبعة من المجاهدين، على كتلة شبه جزيرة قصر أفراك، فتراجع البرتغاليون بقيادة بيدرو دي مينيسس، وتقدم المجاهدون إلى موضع “الميرة” (porto lameira)، حيث امتد زحفهم إلى برج المشنوقين (torre dos enforcados). وفي هذه الحملة وقع جدك -صغيرتي- في الأسر إلى أن افتداه الفقيه الفكاك مع خمسين من رفاق دربه في الجهاد. أما الحملة الثالثة عام 832هـ – 1429م فتمكن فيها من العودة بأتباعه من المريدين الجزوليين إلى ميدان سبتة.
في الحملة الثانية التي أسر فيها جدك، حدثت كرامات، لم يذكرها عن نفسه، وإنما حكاها لنا مجموعة من قيادات الجيش البرتغالي والإسباني، الذين جاءوا إلى مقامه لزيارته. قالوا لنا: إن أحد قادة الجيش البرتغالي حاول التعدي على جدك بتعذيبه أثناء الأسر، فخرجت طلقة بارودة لا يعلم مصدرها، ووجهت لصدره، فألقي صريعا على الأرض. هناك هلل مجموعة الجنود الذين شهدوا الحادثة، بصوت جماعي “ولي ولي” (santo.. santo). منذ ذلك الحين، يقصد العديد من أبناء وحفدة الجنود الإسبان ضريحه، ويقيمون له موسما سنويا”.
على صغر سني لم أستوعب كيف يقيمون له موسما، وهو من كان يجاهد ضدهم دفاعا عن أرضه، وصدا لغزواتهم الصليبية! فسألت أمي عن السبب. فأجابت أمي قائلة: “صغيرتي، أحسنت السؤال.. فالزوار الأوائل كانوا يعلمون حقا مكانة هذا المجاهد العظيم، ومنهم من حضر كراماته أثناء أسره في سبتة، على يد “ضون ضوارتي”. لكن بعد ذلك تعمدت سياسة الاستعمار الإسباني في الشمال، إقامة المواسم الاحتفالية بالأضرحة، مع نشر طقوس الشعوذة ومراسيم الذبائح، تخديرا لعقول أبناء المنطقة، ومحاولة للقضاء على مسار تاريخ المجاهدين وتحويله إلى مواسم طقوس احتفالية، تذبح فيها الذبائح وتقدم القرابين، وتعلق الأعلام، فتطمس بعد حين من الزمن حلقات من جهاد الأبطال، وتخلط سيرتها بشخصيات أسطورية خرافية، أقيمت لها أضرحة على أزمن متباعدة.. ألم أوضح لك الصيف الماضي، عندما كنا في زيارة قصر الحمراء، بغرناطة، أن هناك معالم إسلامية تتعمد السلطات الإسبانية محوها من ذاكرة المكان؟!”.
كنت أمعن النظر في ملامح وجهها، وأنا أردّد “نعم أمي أتذكر جيدا”.
أمي: “الله يرضي عليك يا مريم، هكذا أريدك أن تتذكري تاريخ مجد حضارتك. هكذا عاش أجدادك مريم بالجهاد والمجاهدة، مجاهدة العدو، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس.. فكيف تسأليني صغيرتي اليوم عن حال جدك مع البكاء؟ كيف تسأليني عن سر مجاهدته وهو سليل البيت الذي خرج من فنائه أبطال الجهاد؟! ففي هذا البيت عاش جدك المجاهد، زاهدا، مجاهدا، بماله وعلمه وعرفانه، إلى أن توفي به ودفن في الضريح المجاور له.. هنا بخندق الفرجة خارج باب النوادر، سفح جبل درسة حيث نجتمع اليوم صغيرتي”.
في مساء ذلك اليوم، تعرفت على تاريخ أجدادي، وشاءت الأقدار أن أسمع من جدي قصصا تصلني من مقام رباطه، إلى أرض رباط محمد الفاتح..
بعد مغادرة الوفود من ضيوف مباركة العيد، وتجديد ميثاق المحبة والوصال، أحس جدي أن أهل بيته من خدام الزاوية، أرهقهم التعب من كثرة الاستقبال، وخدمة الضيوف.. فدعا كل أبنائه وأحفاده لشرب الشاي، وسط عقد الدار، حيث النافورة الحبيبة، تداعبني عن بعد، وترسل لي إشارات القدوم إلى حوض مائها، لمؤانستها بعد غروب شمس يوم حافل بزيارات أبعدتني عن حضنها.
تربع جدي فوق اللحاف الأخضر المزركش بالطرز الرباطي الأصيل.. جلبابه الأبيض الناصح يزيده بهاءا ونورا.. وجهه المستدير، كدائرة القمر، يضيء فسحة الأمل في لقاء المحبين.
بدأ جدي حكيه عن رحلاته في طلب العلم، وحج بيت الله الحرام، بينما كنت ألتهي بدمية على شكل عروسة تطوانية، أحاول في شرود تام، إعادة عقد أقفال قفطانها، بعدما انسحب من خصرها.
يتابع جدي تفاصيل رحلاته من الجزائر إلى مصر إلى سوريا ولبنان، فعمان والأردن فأوروبا، ليستوقفني فقط حديثه عن تركيا.
كعادة الأطفال، عدم الدقة في التركيز لفترات طويلة، كنت ألهو وأمرح، وأقف للحظات قليلة، أحاول تتبع ما يحكي عن بلد أحسست أن لغة عشق غير عادية، تحرك أعماق جدي وهو يخبر الحاضرين، عن سحر أسراره، لدرجة توقعت معها أن تركيا سيدة حسناء فتنت جدي بسحر جمالها…
فجدي يتحدث عنها بلغة الهائم، بروحه ووجدانه.. يطوف بين جنبات فضاءاتها، ومساجدها، وتكاياها، يسرد تفاصيل لقاءاته، بأهل العلم والذكر والمحبة.. شدني أسلوب السرد والحكي، تربعت على ركبتي جدي.. حضنت بحنان دميتي، وأدركت أنني منخرطة، في حضرة جلال ما يحكي عن أهل تلك البلاد.
أخبرنا جدي عن أعمامي من بلد أبي أيّوب الأنصاري، ومحمد الفاتح، وعن لقاءاته المتكررة بأعلامهم في تكايا الذكر، ومجالس العلم والصحبة. كنت متحمسة لمواصلة سماع ما يحكي، مشدودة الانتباه، لتغير ملامح وجه جدي، وهو يحكي باتقاد مشاعر غير عادية، قصص ساعات طويلة، من العناق الروحي، والوجداني، بمشايخ العلم، والزهد والورع.
سألت جدي يومها ببراءة سؤال الطفولة: “جدّي أخبرْني من تكون تركيا؟”.
فأجابني بلطف، وهو يداعب ضفيرة شعري: “تركيا -يا صغيرتي- هي عزة الإسلام، وشموخ حضارته، ورقي عمرانه الإنساني..”. ويتابع: “كنت ذات يوم، وأنا في طريق حجي لبيت الله الحرام، أقيم في فندق قريب من مسجد أبي أيوب الأنصاري t، الصحابي الجليل، الذي شهد العقبة، وبدرًا، وأحدًا مع رسول الله ، الذي نزل ضيفا في بيته بعد هجرته من مكة إلى المدينة. توفى سنة 52هـ أثناء حصار يزيد بن معاوية للقسطنطينية، ودفن قرب هذا المكان، الذي كنت أعشق السكن كلما زرت بلاد الأناضول. في صباح اليوم الموالي لإقامتي في إسطنبول، نزلت أبحث في السوق عن محل لعلّي أجد فيه التين التركي، وأقتني منه بعض الحاجيات. وأنا واقف بباب الدكان بجلبابي المغربي الأبيض، سمعت صوتا يحدثني بالعربية:
– أأنت من الجزائر؟
جدي:
– مرحبا سيدي، أنا من المغرب، الذي آمل يوما أن يصبح مغربا كبيرا.
فقال:
– مرحبا بأهل المغرب، من أي مدينة أنت؟
جدي:
– أُصولي أندلسية عربية أمازيغية فاسية تطوانية؟
تبسم الرجل وقال:
– أهلا ومرحبا بأهل المغرب.. أعرف فاس، وتطوان، وقرأت عن الأمازيغ والأندلس بمن احتضنتهم من علماء جامعة القرويين.
الرجل التركي:
– مرحبا بك وبعلماء وشيوخ وزهاد المغرب في أرض الأتراك، هل تأذن لي سيدي في ضيافتك ببيتي هنا في إسطنبول، لكنه في الجهة الأسيوية؟
جدي: لم أتردد للحظة في قبول دعوة ضيافته. وهذه عادة أبناء دار الزاوية في المغرب، يرحبون بالغريب، ويقبلون ضيافته، إن دعاهم لبيته. ولكن رفيقي الحاج أحمد شدني برفق إلى زاوية الدكان، وهو يعاتبني بلطف، عن ثقتي، وقبولي دعوة رجل مجهول. أصرّ على منعي من الذهاب، تحسّبا من حدوث ما لا يحمد عقباه، ونبهني من احتمال الوقوع في فخ النصب. من دون أي التفاتة لرأي الحاج أحمد، قبلت دعوة الرجل وذهبت معه.
كنا نجوب شوارع إسطنبول الساحرة، ينقلني بين دروب وأزقة أحيائها التي زينت بيوتها بمنارات علامات قدوم الحجاج، وأساساتها بأروع وأجمل تصاميم هندسة الفن الإسلامي”.
الكل متابع بشوق تفاصيل أحداث القصة.. فيتابع جدي: “وصلنا إلى البيت، قدم الشيخ صلاح الدين واجب الضيافة، وأبى إلا أن يغسل يدي بماء ورد، صبه من إبريق نحاسي عثماني. ملأ المائدة بأصناف الحلوى وأطباق الأكلات التركية الشهية، ثم تركني لفترة غير قصيرة رفقة عمه الذي درس بالأزهر الشريف. تبادلنا أطراف الحديث عن أحوال الحجاز التي قدمت منها، ليعود صاحب البيت بعد حين صحبة عشرة أفراد، حيّوني بتحية السلام عليكم، مصحوبة بكلمات تركية، وكأنني أتذكر منها “شكالدز” أو “هُوشْ كَالْدِينِيزْ”، وهي تعني “مرحبا بكم”.
أخبرني أن جيرانه وبعض مريدي التكايا، جاءوا ليتبرّكوا بالجلوس في حضرة شيوخ وعلماء أهل المغرب. كان أغلبهم يتحدث اللغة العربية الفصحى.. تناولنا مواضيع كثيرة بالبحث والدرس والمذاكرة، وختمنا الجلسة بالذكر، والابتهال، والدعاء. كان الرجل فصيحا محدثا فقيها وأديبا، سألته عن مهنته، فأجابني بكل تواضع: “إمام مسجد صغير بهذا الحي”.
ونحن نودع بعضنا البعض، همس في أذني أحدهم ليخبرني بأن صاحب البيت، من كبار علماء وأهل الورع في تركيا. قبّلت رأسه وانحنيت إجلالا لتقبيل يديه، فسبقني بتقبيل يدي. تعانقت أرواحنا، وافترقنا على دموع المحبة والصفاء الوجداني، الذي سبر أغوار نفسي العميقة، فسجل ميثاق عهد، وبصمة حب، وتعلق واحترام، لتواضع حفدة أبطال التوحيد والعلم بتركيا”.
كنت أسمع وعلى صغر سني حكي جدي، الذي فهمت مقصده جيدا. ساعتها لم أتذكر اسم العالم التركي، ولا مؤلفاته، ولا عنوانه الذي وصفه جدي لأعمامي، وتلاميذه، ومريديه.. لكن الأيام كانت كفيلة بتعريفي بأبنائه وحفدته، ممن جسدوا لي واقعيا، حفاظهم على تقاليد وأصول أجدادهم العلماء.. هي نفسها صفة التواضع التي حكاها جدي عاينتُها في لغة ورقي الحفدة، خدمة وتفانيا في حسن استقبال، وإكرام أهل العلم والمعرفة.
يومها تيقنت أن حكي جدي معززا بحكي الأستاذ عبد القادر الإدريسي وشفيق الإدريسي، عن ورع وزهد، وتواضع الحفدة من ورثة أهل العلم والصلاح، كان حقيقة تاريخية، لمستها عن قرب بعد زيارتهم لي وترحابهم بقدومي، صبيحة يوم 30 يونيو 2010 في بهو فندق “جراند جواهر” إسطنبول، أي بعد وفاة جدي بأكثر من ربع قرن.

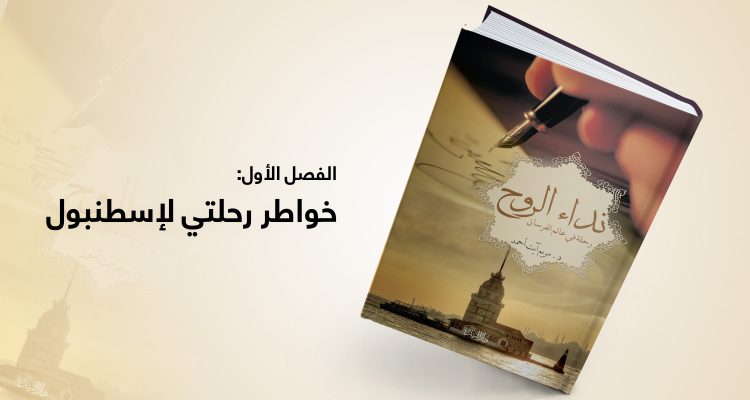
Leave a Reply