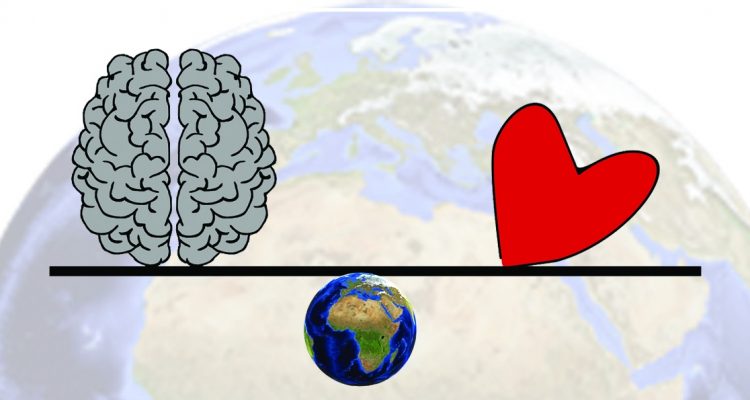مع مطلع الألفية الثالثة نما تيار تربوي فتيّ جديـد، عـُلقت عليـه الآمـال مـن أجـل مواجهـة تحديـات القرن (العنصرية، والقهر، والعنف، والتطرف الخ). ويتباين وصف ومقاربة هذا التيار بين الوالدين والمعلمين والتربويين والمهنيين (فرادى، ومؤسسات). فهو: “التربية العطوفة”، و”التربية الخيّرة”، و”التربية غير العنيفة”، و”الأبوة الإيجابية”، و”آباء سعداء، وأطفال سعداء” الخ. ومهما تنوعت عناوينه فهو يجمع توليفة منتقاة من الممارسات التربوية والتعليمية تهدف لضمان رفاه الأسر والمجموعات الاجتماعية والإنسانية على حد سواء. لكن هل هذا التيار الحديث “نسيج وحده” في هذا المضمار، ولم يسبقه إلى “التربية العطوفة” سابق؟ ستحاول السطور القادمة الإجابة عن ذلك السؤال المحوري.
مدارس الخدمة وجامعاتها تعتمد “رؤية إيمانية علمية” تطبق سبل التفاعل المعرفي والعلمي والتعليمي والقيمي والتربوي والسلوكي والمهاري، مع الحرص على تجديد وتنوع الأساليب، والمحافظة على المضمون.
على المستوى المفاهيمي. يقترن مفهوم “العطف” بنظريات “الرعاية” التي وضع أسسها عالم النفس والفيلسوف الأمريكي “كارول جيليجان” خلال ثمانينيات القرن الماضي. ووفقا لنظرياته تـُعد “خدمة” ورعاية بعضنا لبعض، وبث الاحترام المتبادل، وتكريس الإصغاء الجيد بين كل الأطراف أنشطة إنسانية يرجى تنميتها وتطبيقها باستمرار. وبخاصة توجيهها نحو خدمة ورعاية الضعفاء والمعالين: كالأطفال الصغار، والشيوخ الكبار، والمرضى والمعوزين. وتشـمل تربيـة الأطفـال والناشئين تعلـم ثقافة “العيـش المشـترك”، واحترام الآخرين، الأمـر الـذي يفـرض تنميـة قيم الخيـر والعطاء والتعاطـف بيـن بعضهـم البعـض.
وتجد “التربية العطوفة” إلهامها في تقنيات “التواصل غير العنيفة” التي طورها عالم النفس “مارشال روزنبرغ” خلال ستينيات القرن الماضي أو مفهوم “الاستماع النشط للأطفال” الذي نحته العالم الأمريكي “كارل روجرز”. ويهدف هذا “التواصل غير العنيف” إلى تجنب استخدام الكلمات “كأسلحة” مع التخلي عن الأحكام السلبية والمُسبقة والتمسك بالتعاطف بدلاً من ذلك. مع رفض ظاهرة “العنف التربوي، والتعليمي”، والعقوبات القائمة على استعمال العنف والإهانة والتحقير والازدراء. فهذه السلوكيات العنيفة والمهينة تؤدي إلى “تحطيم الشخصية” التي ينبغي احترامها وتقديرها وتنمية مواهبها، كما أنها “مُعدية” تؤدي لانتهاجها، “فمن شبّ على شيء شاب عليه”. وربما تبرر بعض الأسر انتهاج سلوكيات عنيفة كي تتجاوز مخاوف عملية: كيف يمكن حث الأطفال على احترام القواعد؟، وكيف يمكن التعامل مع نوبات غضبهم ورفضهم وعنادهم؟
الخدمة” حركة مدنية تربوية تعليمية إعلامية مجتمعية تقوم على “خدمة” الإنسانية. قامت انطلاقاً من أفكار واجتهادات نادى بها الأستاذ ” فتح الله كولن”.
وتشير فكرة “الوالدية الإيجابية، والتعليم الإيجابي” إشارة مباشرة إلى تيار “علم النفس الإيجابي” الذي أشرق في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998. وذلك في ضوء زخم أعمال عالم النفس “مارتن سيليغمان” الذي استشرف رؤية جديدة لعلم النفس في القرن الحادي والعشرين. “علم” لم يعد مقتصراً على دراسة الاضطرابات والأمراض النفسية بل يتعدى ذلك لجعل البشر “سعداء وخلاقين”. وبتطبيق هذا المبدأ في ميدان التربية والتعليم سيتم تجاوز مختلف العوائق التي تحول دون مساعدة الطفل في التعبير عن مهاراته وإبداعه حتى في الفضاء المقيد بقواعد الراشدين. كما تؤسس “التربية العطوفة، ليس فقط على مبادئ علم النفس الايجابي، بل على دراسات ميدان العلوم العصبية واللغوية. حيث يؤكد المختصون بوجوب تدخل تربوي يتوافق مع التطور الحاصل في هذا الميدان الذي يمثل “شرعية علمية عليا” في عالم اليوم.
التربية العطوفة: “عقيدة وترياقاً“
يعتبر كثيرون أن “التربية العطوفة” تمثل “عقيدة وترياقاً” تربوياً جديداً. وتقدم “طريقاً ثالثة” يجمع بين توجهات التعليم “السلطوي”، والتعليم الأكثر “تسامحاً”. حيث تتصدى “التربية العطوفة” لظاهرة سوء معاملة الأطفال، وتعترف بالدور البنيوي للقواعد الضرورية لضمان “العيش المشترك”، مع منح الطفل الحق في أن يُحترم كشخص. حيث شهد القرن العشرون ظهور شكل جديد من أشكال “الديمقراطية الأسرية” يُرمز إليه بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989. والتي تؤكد على “معاملة الطفل كشخص في حد ذاته”. فهو ليس “كائناً صغيرا” بل له فرادته وتميزه ومن ثم يجب صياغة المهام الأبوية وفقا لذلك. حيث يكمن دورهما في مساعدته على “اعتناق نفسه وان يصير هو هو”. ولكي يصبح “الطفل هو نفسه”.. تقدم “التربية العطوفة” حلاً مثالياً: “من خلال تعزيز قدرته على التعبير عن مشاعره ودواخله واحتياجاته وتمكينه من تطوير شخصيته ليكون مقبولا اجتماعياً. ومساعدته على فهم أفضل للآخرين وتطوير تعاطفه الخاص تجاههم”. وهذه مهارات ضرورية لصحة الأفراد كما أشارت منظمة الصحة العالمية عام 1993. لذا فلن تكون “التربية العطوفة” ضرورية لتحقيق “التلاحم الاجتماعي” فحسب بل ستصبح قضية “عافية إنسانية عامة”. ولعل هذا ما تسعي إليه “الخدمة” العطوفة منذ نشأتها.
يعتبر كثيرون أن “التربية العطوفة” تمثل “عقيدة وترياقًا” تربويًّا جديدًا، وتقدم “طريقًا ثالثة” يجمع بين توجهات التعليم “السلطوي”، والتعليم الأكثر “تسامحًا”.
“الخدمة” العطوفة
“الخدمة” حركة مدنية تربوية تعليمية إعلامية مجتمعية تقوم على “خدمة” الإنسانية. قامت انطلاقاً من أفكار واجتهادات نادى بها الأستاذ ” فتح الله كولن”. وانتشرت في 170 دولة حول العالم، وشملت مؤسسات تعليمية تزيد عن 3000 مدرسة، و30 جامعة ومئات المدن الجامعية وبيوت الطلبة إلى جانب مؤسسات علاجية، ودور نشر ومؤسسات صحفية وإعلامية واغاثية للمنكوبين وضحايا النزاعات والحروب. وهل “الخدمة العطوفة”.. ليست إلا تربية، وتعليماً، وإعلاما، وإغاثة؟ يجيبك الواقع، حيث يتنافس الناس على إلحاق أبنائهم بالمدارس الدولية والجامعات المنبثقة عن الخدمة. لما تميزا به من معايير جودة عالية، وتناغم بين القيم الأخلاقية ومعطيات العلوم العصرية مما جعلهما يرتادا المراتب الأولي ويحققا النجاحات الباهرة أينما وجدا في العالم.
تتصدى “التربية العطوفة” لظاهرة سوء معاملة الأطفال، وتعترف بالدور البنيوي للقواعد الضرورية لضمان “العيش المشترك”، مع منح الطفل الحق في أن يُحترم كشخص.
ولم لا.. فمدارس الخدمة، تطبق الخطوات الهامة لتنمية شخصية الدارسين بها عبر تهيئة وتوفير الظروف المدرسية والأسرية والتربوية والبيئية التي يسودها الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي والإرشاد والتربية المعنوية. كذلك الابتعاد عن كل ما يعيق نمو وتطور ملكات التركيز، والتأمل، والتدبر، والتفكر، والتعقل، والإبداع. فمثل تلك العمليات التعليمية والتربوية -المباشرة وغير المباشرة-تتعهد الأبناء بالحدب والدفء والرعاية، وتنمية القدرات، وإذكاء المواهب، والإجابة الدائمة والمناسبة عن أسئلتهم. وتهدف لجعلهم يُحسنون القيام بعمليات التفكير ليصلوا لنتائج صحيحة، والعيش وفق “نمط حياة” إيماني وإنساني مشترك يتفادى نسق الأفكار السلبية والأحكام المُسبقة، مما يجعل الخريج يتميز بالاستقلالية والمسؤولية. وهذه المدارس والجامعات تعتمد “رؤية إيمانية علمية” تطبق سبل التفاعل المعرفي والعلمي والتعليمي والقيمي والتربوي والسلوكي والمهاري، مع الحرص على تجديد وتنوع الأساليب، والمحافظة على المضمون، وهي أمور هامة في تعهد القدرات الإبداعية للطلاب. كما تحرص على استدامة التواصل والمتابعة مع أسر الطلاب عبر “إشعاع” المدرسة على محيطها. فالتلميذ “ابن أسرته، ومدرسته، وبيئته”. وقبيل هذا وذاك، تحرص “مدارس الخدمة” على تكوين المعلمين القدوة الأكفاء -سلوكيًّا وعلميًّا-لينهضوا بعملية التربية والتعليم الكفء. فبذلك يتم جني ثمرات التربية القيمية والإيمانية والأخلاقية والتعليمية المرجوة والأكيدة، وركيزتها بناء الإنسان منذ نعومة أظفاره. كما كان هذا نهج نبينا العدنان صلي الله عليه وسلم.
نهج النبي العدنان، في تربية وتعليم الغلمان
على كثرة أعبائه الضخام، وتعدد مهامه الجسام نجد اهتمام رسولنا ﷺ بتربية الغلمان، “تربية ودودة عطوفة” فمن هديه الشريف حث الأم (الحاضن الأهم الأول) بملازمة أطفالها ـ وخصوصاً في سنواتهم الخمس الأولى ـ ليشعروا بالطمأنينة والأمن: “نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده” (رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). مع توفير كل العطف والحنان والحب، وأخبارهم بذلك الحب. فقد جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أتقبِّلون الصبيان؟ فقال ﷺ: “أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة” (البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها). ومن الجميل أن يسمع الأطفال آباءهم يقولون لهم: “إنهم يحبونهم كثيرًا، وأن يشعروهم بهذا الحب وتلك الحفاوة. وحين التزم رسول الله “الحسن بن علي”، فقال: “اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه”، قال “أبو هريرة” رضي الله عنه: “فما كان أحد أحب إليَّ من الحسن بعد ما قال الرسول ما قال”. ومع كل ذلك العطف والحب هناك حزم، فقد أخذ “الحسن” رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ:” كخ، كخ.. ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة” (البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
يتنافس الناس على إلحاق أبنائهم بمدارس الخدمة وجامعاتها، لتميزهما بمعايير الجودة العالية، والتناغم بين القيم الأخلاقية ومعطيات العلوم العصرية مما جعلهما يرتادا المراتب الأولي ويحققا النجاحات الباهرة أينما وجدا في العالم.
وفي عنايته العطوفة بالأطفال، ما رواه “أنس” قال: كان ﷺ أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له: أبو عمير وكان إذا جاء قال: “يا أبا عُمير ما فعل النُغير؟” (طائر صغير كالعصفور، كان يلعب به، لكنه نفق) [البخاري ومسلم وغيرهما). ويقول “أنس”: ربما حضرت الصلاة ـ وهو في بيتناـ فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وتنضح، ثم يقوم ونقوم خلفه، فيصلي بنا. إن ﷺ يداعب الصغير ويواجهه بالسلام والخطاب، وفي ذلك فائدة عظيمة، وإنه لتقدير منه ﷺ، وهو العظيم المرسَل إلى البشرية، يقدر الصغير فيثق بنفسه، ويشعر بقدره واحترام الناس له.
وتستوقفك الأسس التربوية والتعليمية منه ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما. يقول كنت خلف رسول الله يوماً فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده تُجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلامُ وجفّت الصحف”(الترمذي). فتأمل كيف يتعامل ﷺ مع غلام من الغلمان فيغرس في شخصيته “المستقلة” هذه الأسس، فكان “ابن عباس” رضي الله عنهما في الأمة ما كان.
تـُعد “خدمة” ورعاية بعضنا لبعض، وبث الاحترام المتبادل، وتكريس الإصغاء الجيد بين كل الأطراف أنشطة إنسانية يرجى تنميتها وتطبيقها باستمرار. وبخاصة خدمة ورعاية الضعفاء والمعالين: كالأطفال الصغار، والشيوخ الكبار، والمرضى والمعوزين.
وهناك نهي عن “النظرة السلبية للناس” والتي فيها احتقارهم وازدراؤهم، واعتبارهم مخطئين وخاطئين، فقال ﷺ، في شأن الكِبر: “هو بَطر الحق وغمط الناس” والمعنى أن حقيقة الكِبْر إنما هي “ازدراء الناس ورد الحق تعصباً لما هو عليه”. وخطورة التعصب تتمثل في كونه قيْداً على الحرية، وعقبة في طريق الإبداع إذ يلغي التفكير الحر، ويشلّ القدرة على النقد ومحاورة الآخرين ومناقشة آرائهم بموضوعية، ومن ثم كان على المسلم أن يربي ابنه على الموضوعية، وعلى قبول تعدد الآراء، والنظر فيها، واختبارها بالعقل، والتشجيع على التفكير العلمي الخلاق. وهذا هديٌ بثّه في نفوس أصحابه الذين كانوا يصطحبون أطفالهم في مجالس الكبار، لتُبْنى شخصيةُ الطفل فتكبر، ولا شك أن احتكاك الصغار بالكبار له فاعلية في تنمية الشخصية، ويشجعها. روى ابن عمر -وهو لا يزال غلاماً -قصته في مجلس كبار الصحابة مع الرسول ﷺ حين قال: كنا عند النبي فقال: إنّ من الشجر شجرة مَثَلها مَثَل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكتُ، قال النبي ﷺ: “هي النخلة”.
وإن الكشف عن نبوغ الطفل مبكراً وتحسّس جوانب تفوقه ورعايتها هو منهج الرسول ﷺ في تربيته لصحابته. هذا زيد بن ثابت كان ابن إحدى عشرة سنة حين قدم الرسول ﷺ المدينة، وقد كان غلاماً فطناً تبدو عليه علامات النبوغ. قال “زيد بن ثابت”: أُتِي بي إلي النبي ﷺ حال مقدمه المدينة فقالوا: يا رسول الله هذا غلام بني النجار، وقد قرأ مما أُنزل عليك سبع عشرة سورة، فقرأتُ على رسول الله ﷺ فأعجبه ذلك وقال: “يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمنهم على كتابي”، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقتُه، وكنت أكتب له ﷺ إذا كتب إليهم. ولعل حاجة الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير سبل وإمكانيات “التربية العطوفة” و”الأمن النفسي” أكبر من أسوياء الغلمان ومن ينشئون وسط أسرهم المعتادة. لذا نجد الإسلام ينهى عن الإساءة إليهم والانتقاص من حقوقهم، يقول تعالى: “فأما اليتيم فلا تقهر” (الضحى:9)، ويقول النبي ﷺ: “خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه، ثم أشار بإصبعيه السبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين” (رواه البخاري).