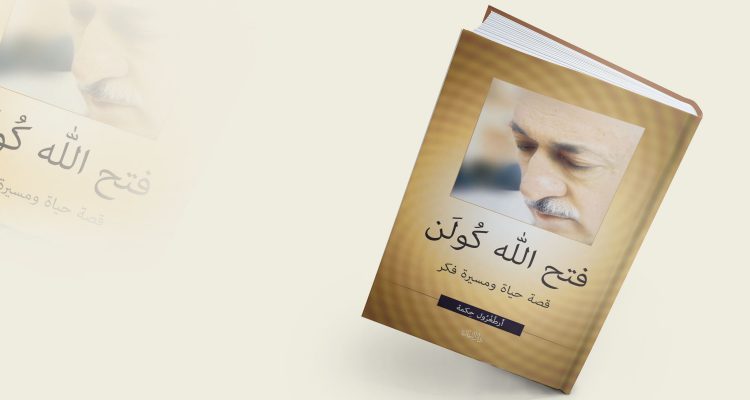يحبِّذ والد الأستاذ فتح الله أن يعمل ابنه خارج أرضروم بينما كانت أمُّه تضنّ به وتكره فراقه، فتقرّر أن يذهب إلى أدرنهْ حيث أقارب والدته، ومنهم حسين طُوب، وهو إمام هناك؛ اتجه فتح الله إلى أنقرة أوَّلًا، ومكث فيها بضعة أيام في منطقة “الحاج بَيْرام ولي” المنورة وأحبّها حبًّا جمًّا، وزار النائب بمجلس الشعب السيد مصطفى زَرَن أحد أقارب والده، وبات عنده ليلة؛ وكان في تلك الأيام يتابع مسابقة وزارة الأوقاف للوظائف، ثم اتّجه نحو إسطنبول، ونزل في فندق “أرضروم” بسِرْكَجي الذي يسكنه أبناء مدينته وبات فيه بضعة ليال؛ ثم وصل أدرنه ذات ليلة، فنزل في فندق عند مسجد “الشرفات الثلاثة” الذي غدا إمامه بعد ذلك؛ وفي الصباح قابل الأستاذ حسين طوب، فذهب به إلى المفتي إبراهيم أفندي، لكنه رآه شابًّا فاستهان به، وقال: لا بد أن أمتحنه، ففعل ووظّفه وقال: “ما زال يافعًا، لكنه أجاد تكوين نفسه”.
وفي رمضان تكلِّف دار الإفتاء بأدرنه طلاب المعاهد الشرعية وحفظة القرآن الكريم من المحافظات المجاورة بالإمامة، ويتعهد الأهالي بالمسكن والمطعم وشيء من المال، فإذا انقضى شهر رمضان عاد كلٌّ إلى مسجده، ويُعْرَف هذا بنظام “إمامة رمضان”، فعُيِّن الأستاذ فتح الله إمامًا في شهر رمضان في مسجد اسمه “آقْ مسجد (المسجد الأبيض)”؛ فأُعجِب المصلُّون بما رأوا في خطابته وعلمه أثناء دورس ما بعد الصلاة؛ فلما انقضى شهر رمضان ذهب بعض وجهاء الحيّ إلى الأستاذ حسين طوب، وطلبوا منه أن يساعدهم في استمرار الأستاذ فتح الله بهذا المسجد، ففعل، ويومئذ بدأت رحلة الأشجان والمعاناة، ولم تمض مدة وجيزة حتى غدا معروفًا في أدرنه كلها بوعظه ودروسه، شابّ يافع لكنّه أثّر بوقاره وأخلاقه أيَّما تأثير على من جلس إليه واستمع له؛ نعم كان الأهالي يمدّون يد العون لأمثاله إلا أنه أبى أن يأخذ منهم شيئًا.
وفي تلك الفترة عقد امتحان الوعاظ، فسافر الأستاذ فتح الله إلى أنقرة، ومكث بها خمسة عشر يومًا، ثم عاد إلى أدرنه، فأبلغ مصطفى زَرَنْ دار الإفتاء بأدرنه بنجاحه في الامتحان؛ فتقدم الأستاذ فتح الله بعريضة لوزارة الأوقاف بأنقرة، ليكون مفتي أدرنه، فرُفِضت لأنه لما يخدم العسكرية بعد، وعُين إمامًا لمسجد “الشرفات الثلاث”، وسرعان ما صاغ لنفسه عقد حبّ واحترام هناك؛ ولما كان مسجد “الشرفات الثلاث” في مركز المدينة كان يأتيه وجهاء أدرنه وبعض المسؤولين أيضًا؛ ويعلِن الأستاذ فتح الله مقدَّمًا عن موضوع موعظته؛ وكان في معرفته وإحاطته بتفاصيل الموضوع – في الاقتصاد أو العدالة أو الحقوق أو علم الاجتماع أو غيرِها – ما أكسبه تقديرَ المصلّين جميعًا.
استأجر منزلًا في زقاق مسدود، وذلك في فصل الصيف، فكانت النسوة يجلسن على أرصفة الزقاق من الضحى حتى جهمة الليل؛ فكان يضيق ذرْعًا بذلك عند ذهابه إلى المنزل وإيابه منه، وأبدى بعض من يوقّره من أهل الحي رغبتهم في مصاهرته؛ فغادر الحي إلى نافدة في مسجد الشرفات الثلاث، عرضها متران، وعمقها متر ونصف، فوضع بها أمتعته: كتبه، وبطانيتين، وطبقين، وكوبًا، وملعقة؛ يقول: “تجافيت عن كل ما يبعث على الكسل، فبدأت باتخاذ ما يلزم لتحقيق هدفي على أتمّ وجه”.
لم يترك الأستاذ فتح الله طراز حياته هذا حتى في قرّ أدرنه القارس، وزهِد في أكل ما له دَسَم، فعَكَف على العلم، وعُنِيَ بمن حوله. كانت الحياة الروحيّة في أدرنه تكاد تقفر؛ فهجر النوم واعتزل في نافذته، وراح يبني “دنياه الصغيرة”.
ويذكر صديقه الأستاذ حاتم مثالًا لتربية النفس عنده، يقول: “كثيرًا ما كنت أزور الأستاذ فتح الله في مرحلة رياضة النفس؛ فلم أره يأكل، وإذا برّح بي الجوع قال: هناك بعض الطعام، كُل منه، فأدعوه لنأكل معًا، فيأبى؛ وأحيانًا كنت أقلِّده فلا آكل؛ وغالبًا ما كنت آكل ما في المِزوَد من طعام. وبينما هو في حديقة المسجد ذات يوم إذا برائحة البيض المقلي تزكم الأنف، وسرعان ما تذكر أرضروم، والبيض الذي كانت تطبخه له والدته في التَنُّور، وبينا نحن على ذلك إذا بالسيدة خَيْرِيَّة -عجوز صالحة ذات غيرة على الدين، كان الأستاذ فتح الله عندها كأحد أبنائها- قد طهت بيضًا، وقدَّمته للأستاذ فتح الله، وكان بطني يقرقِر، فانتظرت أن يدعوني لنأكل، ومضى وقت طويل ولم يفعل، فلم أتحمل فقلت: هيا نأكل هذا البيض قبل أن يبرد، فقال: كُلْ، واترك لي منه، فإني أحتاجه”، فما أكل رغم إصراري عليه، فأكلت منه؛ وأمضى الأستاذ فتح الله ثلاثة أيام يسخن فيها البيض ويشمّ رائحته ثم ينتحي جانبًا من الحديقة، ثم يردّ البيض دون أن يأكل منه لقمة، ثم عرفْتُ أنه كان يروِّض نفسه بشمّ ما تشتهيه دون أن يأكله”14. هذا تأويل الأستاذ حاتم، فمن الممكن أنه ربما فعل هذا ليسلي نفسه بشيء يذكّره بوالدته.
عُرض عليه الزواج كثيرًا في أدرنه سواء من أقاربه كالأستاذ حسين طوب ومن أصدقائه، فأبى، وكم عُرِض عليه في سنوات لاحقة، فكان يأبى، ولعل تفسير هذا في قوله: “لا يعلم نيتي وما في أعماق قلبي إلا الله، فضّلت أن لا يشغل عقلي شيء سوى خدمة الدين والدعوة، ميزاني دقيق وحسّاس فربّما تضيق به النساء، وهذا أيضاً كان له أثر كبير في عزوفي عن الزواج؛ قرّرت منذ البداية أن أهب نفسي لخدمة الدّين”.
حياته في الشريعة كحياة السمك في الماء، ضبطَها بميزان الشرع وآدابه؛ مثلًا: لما وصل أدرنه كان أول ما قام به التحقُّق من طريقة ذبح الحيوانات، فلما رآها مخالفة لأحكام الشرع ما أكل فيها لحمًا قطّ.
مثال آخر يكشف دقة موازينه يومئذ، يحكي الأستاذ حسين طوب أنه رآه يشتري الشمع من ماله ليضيء به نافذة المسجد التي يسكنها، ليقرأ في الليل؛ فقرر أن يتخذ له مصباحًا يضيء النافذة، وأقلّ ما في هذا أن يرفع عنه المعاناة أثناء القراءة، فأتى بالكهربائيّ، لكن الأستاذ فتح الله رفض قائلًا: إنها كهرباء المسجد، والوقف هو من يدفع، وهو لا يحل لي”.
أنهكَته ظروف الحياة الشاقّة، فضعُف ومرِض، وقضى خمسة عشر يومًا في المستشفى؛ وتضاعفت بُرحاؤه لما بلغه مرض والده؛ ففاضت مشاعره على لسانه بأشعار تحكي أشجانًا كابدها في تلك الفترة.
لقي الأستاذ فتح الله ما لقي من افتراء الحسّاد والحاقدين ومكائدهم التي حاكُوها له، عِلاوة على تدهور صحته، فكانت حفاوة الناس بوعظه وتقديرهم له، وحبّ التجار الجمّ واحترامهم البالغ، يثير حفيظة حسّاده؛ فتآمروا عليه أيام الانتخابات المحلية، واتهموه بأنّه خالف الصمت الانتخابيّ؛ فاقتحمت الشرطة المسجد وألقت القبض عليه، وفي الطريق أخذ أحد أفراد الشرطة يشتمه بقبيح الكلام، فردّ على الشرطيّ وألقمه حجرًا، فهو لا يتحمل شيئًا من الإهانة، ولا يتهاون في عزته وكرامته؛ وكان مدير الأمن “السيد رسول” يحضر مواعظه ويعرفه حقّ المعرفة، فبرّأه وأفرَج عنه؛ يقول الأستاذ فتح الله: “هذا أول اعتقال لي، فامتعضت كثيرًا، وأويت إلى نافذتي حزينًا”، كانت تلك بداية مؤامرات ما زالت تطارده؛ وكلما حصحص الحق ظهرت براءته كما في المرة الأولى وعاود حياته الخاصة مرةً أخرى.
ودافع عنه ورعاه وردَّ عنه افتراءات الحاقدين وإفكَهم مفتي أدرنه بعد انقلاب 27 مايو/آيار 1960م الأستاذ “يَشار طُوناكُور” الذي أسهمت مواعظه في تجدد الحياة الدينية في أدرنه؛ لِما رأى في الأستاذ فتح الله من علمٍ وجدّ، وراح يذكر مناقبه وعلمه في أروقة الحكومة؛ فالأستاذ يَشار هو إحدى نقاط التحول الجوهرية في حياة الأستاذ فتح الله، وكان الأستاذ فتح الله يكنّ له كلّ احترامٍ وتقدير، فكان يعظ في مسجد الشرفات الثلاث قبل صلاة الجمعة – كما هي العادة في مساجد تركيا – ثم يدرك الصلاة في مسجد “السليمية” ليستمع لخطبة الأستاذ يَشار.
إمام ذو عشرين ربيعًا إلا أنّ وضوح أسلوبه في الحوار شهَرَه في أدرنه، لم يقتصر كالأئمة على الوظيفة فحسب، بل كان يجول ويحاور الفئات كافّة بدءًا بالمحافظ حتى رئيس الوحدة العسكرية.
شخصية فعّالة نشِطة تحمل صاحبها على فعل كلّ ما يخدم الدّين؛ شهد هجمات شنّها الإعلام على الإسلام حينئذ، فكان يقدر ما بُذِل لمواجهتها، ويساند من يواجهها ويدعمهم بما تيسّر، يقول في مذكراته عن تلك الفترة: “كنت أدّخر مالي وأشتري به كتبًا مفيدة لأوزِّعها حسبةً، فكانت تأتي أدرنه نسخة أو نسختان من مجلة “بُيوك دوغو (الشرق العظيم)”، فكنت أشتري منها لتصبح خمسًا وأوزعها؛ أما مجلة “حُر آدم (الإنسان الحُرّ)” الأسبوعيّة، فكان يأتي منها خمسة وعشرون، فبلغتُ بها أربعين؛ وهي صوت الإسلام حينئذٍ، ومثلها “بيوك دوغو”، و”سبيل الرشاد”… أجالس من سأعطيه المجلة، ونشرب الشاي ثم أعطيه، فالخدمة في مناخ كهذا شاقّة جدًّا، فهذه أشياء لا عهد لأحدٍ بها، كنت أخفي مجلة “بيوك دوغو” بين صفحات جريدة “الجمهورية”[1]، وأضعها في جيبي حتى أصل إلى مكان تسليمها، فأسلمها خُفية بعيدًا عن الأنظار، كان لا بُدّ من هذا ليستمر العمل.
في تلك الفترة كان نجيب فاضل[2] ينسج “نسيج الإيديولوجيا”[3]، وكانت كتابات “بَيامي صفا”[4] يلفها الغموض بالنسبة لقراء تلك الفترة، ورغم ذلك كنت أقرؤها؛ كان الإسلام هو شغلي الشاغل والعالم المثالي الذي تزدان به أحلامي، فظاهري يوحي أني في عزلة، ولكن الزوايا جعلتني منفتحًا أجيد فنّ العلاقات الاجتماعيّة حيثما حللت؛ ولمجالستي الكبار الفضل في مهارة التحدث مع الآخرين بسكينة وطمأنينة، فكنت أجالس وأحادث وأحاور الفئات كلّها، خاصّة المشايخ وكبار العلماء، فنَمت لديّ مهارة المحادثة، فكنت أبلِّغ وأنصح أيّ شخص مهما كان مستواه الاجتماعيّ بسهولة ويسر؛ وفي نفس الوقت حالَ الحياءُ الشرقي بيني وبين الجرأة على الكبار، فكنت أجالسهم وأحاورهم وقتًا طويلًا بمنتهى الأدب، وأكاد أكون عرفت وجهاء أدرنه كلهم، ولماّ أبلُغ العشرين؛ وكنت أحاول أن أوجّه ما منحني الله من قوة روحية في الطرق الإيجابية، فكنت أجالس الناس في المقهى، فنشرب الشاي، وأحاول أن أتحدّث إليهم عن مسائل دينية”.
ويروي حافظ أحمد أفندي واقعة تكشف عن تأثير أحواله وتصرفاته في الناس فضلًا عن مواعظه، يقول: حاضَرَ رجلٌ كريم في مجلس بين أناس فيهم الأستاذ فتح الله، فأنصت إليه ولم ينبس ببنت شفة، فلما انتهى الرجل قال له: أنا من تحدث اليوم، لكنك كنت أنت الواعظ الحقيقي.
ورغم العقبات التي واجهته إلا أنّه استقام على نمط الحياة الذي رسمه لنفسه، وذات مرة نفدت نقوده؛ فلم يقدر أن يشتري ولو خبزًا، وبات طاويًا أيامًا، وبينما هو يتوضّأ وجد خمس ليرات على الأرض، فاشترى طعامًا يسد الرّمق، وكفَتْه حتى استلم راتبه، فزادها خمس ليرات، وتصدّق بالعشر على الفقراء؛ وذات مرّة صعد المنبر ليخطب العيد والجوع يعتصر أمعاءه، فأكل ملعقة عسل من قعر قنينة كانت عنده؛ ولم يكن يعرف أن العسل لا يُؤكل والمعدة فارغة، فعانى من غثيان أثناء الوعظ. رغم كل ما عاناه لم يشكُ أمره ولو مرّة، ولم يدعه ذلك لتغيير نمط حياته رغم كل المشاق الماديّة والمعنوية؛ وكأن هذا السلوك لا ينتهجه إلا أفذاذ يصنعون تاريخ الحضارة.
كان الأستاذ فتح الله غيورًا على دينه منذ شبابه؛ فعندما طُرح موضوع كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية وهو في السادسة أو السابعة عشرة، كتب مقالًا ينتقد فيه هذه الفكرة؛ فروحه مثاليّة جيّاشة حتى إنه ليقول وهو تلميذ صغير بمدرسة مسجد قُرْشُونْلو: “ليتهم وضعوا الدنيا على أناملي فأُديرَها”، كان يجتنب أمور السياسة، ولكن هذا لم يمنعه أن يعترض وتثور ثائرته عقب انقلاب 27 مايو/أيار؛ وللأستاذ يشار الفضل في تهدئته تجاه ما يستنفر طبيعته الثائرة، فلنصائحه أثر بالغ في التخفيف عنه فيما تضيق به نفسه، وكان لرسائل النور أكبر الأثر على تهدئة نفسه الثائرة.
كان لوظيفة “الإمام الملقِّن” لمحكومٍ عليهما بالإعدام في أدرنه أثرٌ بليغ في حياته؛ كُلِّف عام 1959م بتلقين رجل اسمه راسم، وكان الإعدام يومئذ علنيًّا؛ فكان يحاول أن يلقّنه الشهادة وبعض الدعوات، فيرد المجرم: “سيأتي أتاتورك، وسنذهب معًا إلى البيت”؛ فالمشهد حزين، لكنّ الناس كانوا ينظرون إليه وكأنه مهرجان أو احتفال، وهذا أيضاً جعل الأستاذ فتح الله يتقطع حزنًا.
وألغي الإعدام علنًا، فأُعدِم الثاني – واسمه محمد – بعيدًا عن الناس، وكم تأثر الأستاذ فتح الله بالحادثة، يقول: “سألته: تتوضأ؟ فأجاب: نعم، فلما بلغ غسل رجليه خارت قواه؛ أتذكر هذا وكأنه اليوم، لم يُتِمّ الوضوء، فبدأت ألقنه الشهادة، فلا يستطيع أن يكمل، وكأنّما محيت من ذاكرته”.
[1] جريدة يساريّة يوميَّة تركية بدأت تصدر في 7 مايو/أيَّار 1924م، وما زالَت.
[2] نجيب فاضل قيصه كُورَكْ: من أشهر المفكرين والشعراء والكُتّاب الأتراك في القرن العشرين (1904-1983م)، لُقب بـ”سلطان الشعراء” لطول باعِه في الشعر.
[3] نسيج الإيديولوجيا: كتابٌ لنجيب فاضل، عرَض فيه حياتَه الفكرية والحَرَكية.
[4] بَيامي صَفا: مفكّر ورِوائي وقصصيّ تركيّ، (1899- 1961م).