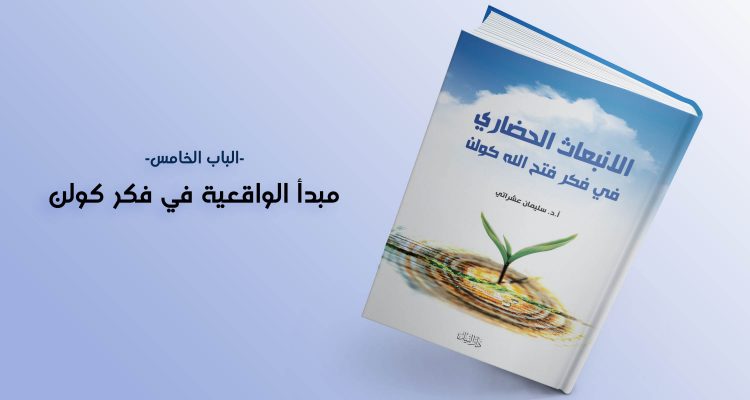يقول كُولن: “الأفكار مناطة بالتطبيق وإلاّ بقيت أحلامًا وردية”. كثيرًا ما سجَّلنا للأستاذ كولن واقعيته الفكرية، وقصدنا بالواقعية الفكرية هذا التمثل التوصيفي للواقع، والترصد الإحصائي الحسي والسببي لمكوناته، والتصور العملي لمعضلاته وتعقيداته.
ومن المؤكد أن قطاعاتٍ لا تنتهي من التفكير البشري لا تفتأ تتفق في كل عصر وكل منعطف على تخيل حلول، وافتراض بدائل، يتحسن بها الواقع الإنساني ويستقيم، لكن جلّ ذلك التفكير -لقصور النظرة- يظل مجرد تحويمات فوقية، لا تمتلك قابلية القبض على كيمياء الأوضاع المدنية والحضارية، وتحويلها في الاتجاه الذي يُحدث الانفراج.
نسبة كبرى مما تخطّه أقلامُ أهل الفكر يُعدّ -عند التمحيص- تجريدًا ذهنيًّا، وافتراضًا تصوريًّا لا سلطان له على الحياة، فهو من قبيل الإنشاء ليس إلا. وإن كثرة كاثرة من كتابات المفكرين والأيديولوجيين والمنظّرين هي في الحقيقة أصداءٌ لأدبيات الميتافيزيقا، كما تعاطاها الإنسان في القديم، بل إنها صدًى معاد، ونُسخة تتكرر على الدوام، عن حلم المدن الفاضلة؛ إذ يذهب الجنوح التنظيري بأصحاب هذه الكتابات إلى خارج مدارات الواقع، فيخبطون بعيدًا عن الموضوعية، من حيث يحسبون أنهم يُفَعِّلون الواقع، ويضعون أسس تغييره.
مما تميز به فكر الأستاذ كولن أنه يقبض بقوة على مبدأ الواقعية، ويتسم -أصالةً- بها؛ لأنه يعي أهمية الدور الذي يجب على المفكر المسلم أن يلعبه في عهود الخزي التي لا تزال الأمة تعيشها منذ قرنين تقريبًا. إنه دور استنقاذي، استعجالي، يسدد نحو الغايات بلا توانٍ أو تردد، انعطافًا بالأمة نحو الصحوة والمعافاة.
من واقعية نظر كولن، أنه يشترط توفر الدولة الحرة لتنفيذ المخطط النهضوي الحضاري، فأهم أركان عملية إنجاز الحضارة -بحسبه- هو الإنسان المؤمن المؤهل، وأقوى أسسها الحيوية هو دولة حرة ومستقلة، وأثمن رؤوس أموالها هو الزمن.
ومن المؤكد أنها نظرة موضوعية، ومتزنة؛ إذ ما أكثر ما رأينا أهل الفكر المعارِض للنظم الشمولية يجعلون في أولوية شعاراتهم الدعوة السافرة إلى الثورة على الدولة، والانقلاب على نظمها؛ توسلاً لتنفيذ أي إصلاح أو تعديل في البنية والمعطيات المدنية. لكن الأستاذ كولن، بواقعية تقديراته، يرى أن دور الدولة أمر أساس في الإقلاع الحضاري، غير أن كولن يشترط للدولة أن تكون حائزة على مقوّم الحرية؛ لأن الدولة الحرة هي المؤهلة لخوض التغييرات الكبرى، وإنجاز الوثبات الأبعد. ذلك لأن كولن صاحب فكر عملي، استمد مقومات تفكيره من خلال ملابسة واقعه الوطني، وارتباطه به، وأيقن أن شمولية الرهانات المصيرية، والتحولات الكبرى، إنما تتحقق على يد الدولة المرَشََّدة التي تدرك دورها، وتنهض به، فتشمل بجناحيها سائر مكونات المجتمع، وتؤهبها، وتدفع بها نحو الغاية الانبعاثية، الأمر الذي يختزل الوقت، ويحقّق النجاعة والفاعلية في تحقيق الأهداف.
حقًّا إن كولن يرى أن الإنسان الفعّال، المتجدد في روحيته وجدارته، هو الطرف الأبرز في صناعة النهضة، لذا فإن خطة تهيئة وإيجاد هذا الإنسان؛ إذا ما تمت برعاية الدولة تكون أسرع وأشمل، عكس ما يكون عليه الحال إذا ما كانت مساعي هذا التهييء والتكوين تجري خارج إشراف الدولة، أو عكس إرادتها، فعندئذ يكون الجهد سباحةً ضد التيار، وتنشأ علاقة الاعتراض والقمع التي تعيق أي صحوة، بل وتصادرها، وتضطرها إما إلى الانطفاء، وإما إلى العمل في جنح السرية والتخفي، مع ما يكون في ذلك من مخاطر على العاملين، ومن ضآلة ومحدودية على مستوى المردود والنتائج العائدة عليها.
هناك أنانية وقصور تعكسه أحيانًا شعارات دعوية تعتمد العمل التنظيمي الحصري، فكأنها تجعل من العمل التكتلي غايتها، فهي من ثَم تقصد إلى تحقيق الكيان الفئوي، أو التنظيمي، أكثر مما تهدف إلى الخدمة والبناء.
لا ريب أن الضغوط السياسية والأيديولوجية القامعة تحتّم على العاملين انتهاج سبل التستر والحذر، وإن من طبيعة هذا النوع من العمل -غالبًا- التزام التنظيم الهيكلي الخفي. فمساحة التحرك والتأثير ضيّقة، ومحفوفة بالتهديدات، ونتائجها غالبًا ما تكون بطيئة، ومتعسرة. وإن الاستمرار على اتباع نهج الحذر والتحفظ إنما تسوّغه روحية الثبات على الموثق، والحرص على المضي في الاستصلاح، ولو على نطاق محدود، وعدم إلغاء راية الدعوة على أمل أن تتهيأ الظروف الأفضل والأوفق للعاملين. من هنا رأينا الأستاذ كولن يقرر أن النهضات تنفّذها الدول الحرة، فهي التي تضمنها وتعطيها الصبغة الوطنية والقومية، بحيث تغدو رهانًا جمعيًّا، ومقصدًا مركزيًّا تتضافر على بلوغه الإرادات الخيّرة والجهود المباركة.
لا ريب أن مبدأ إناطة النهضة بالدولة الحرة -كما رسم كولن- إنما أسَّست له تجربةُ العمر، وتَقلُّب الأوضاع بالأستاذ في مجتمعٍ سارت به سياسة التغريب على طريق الانسلاخ والتفريط في الهوية الأصلية.
ذلك لأن التقدم بالعمل الدعوي، باعتباره خطة نافذة وفعّالة في اتجاه البناء والتسديد، ظل يدبّ دبيبًا تحت ضغط القمع والمنع، قياسًا إلى الآمال التي كانت تسكن أعماق الأستاذ، وبالنظر إلى الدافعية العارمة التي لبثت تحرّكه وتجعله يوقف حياته على حلم تعميم الاستفاقة وتجذيرها في مجتمعٍ كانت آليات الأسْلبة والسلخ تفعل فعلها المنكر فيه، بعنادٍ وبلا هوادة.
أجل، كان الأستاذ يدرك أهمية تلك الأحجار القليلة التي يضعها أساسًا لليقظة، وقيمة تلك الخطوات التي يقطعها بكل جهد وإجهاد على طريق توطيد الصحوة، وكان موقنًا بأن ضم موضع شِبر إلى الأرضية المضاءة بنور الدعوة، هو فتح مبين.
الدولة، القائد، الأفراد والبناء الحضاري
إن تبني الدولة لمشاريع النهضة أمرٌ من صميم اختصاصها؛ إذ لم تنشأ الدول ونُظم الحكم إلا لكي تجتهد وتجنّد هياكلها الإدارية ومؤسساتها المركزية، ووسائلها القاعدية لصرف الجهود العامة، وتثمير المقدرات المتوفرة، أو الاحتيال لتوفيرها في حال شحّها أو نقصها، وتحويل ذلك إلى إنجازات تعمير ومرافق تمدين، تتوسع بها الحياة، ويزدهر المجتمع، ويؤصل من الأسباب والإرادات ما يكفل اطراد خطاه على طريق الرخاء والصلاح.
يحدث هذا عندما تكون الدولة مالكة لأمرها، سيدةً في قرارها، مطلقة اليدين من القيود التي تشلّ الحركة والإرادة. من هنا رأينا الأستاذ كولن يجعل من عامل الحرية شرطًا تكتسب الدولة به صفة التأهل لإنجاز النهضة وشقّ الدرب إليها.
الدولة الحرة هي القادرة على ضبط خططها، ورسم مسيرتها ووجهتها بالشكل الحصيف والاستراتيجي الذي يجنّبها الوقوع في مصائد القوى الاستغلالية، فهذه القوى بقدر حرصها على استبقاء وسائل التموين حكرًا لها، بقدر ما تستميت في إبقاء الأمم المغلوبة والمتخلفة عالقة في وحل الضعف والتبعية.
ينبّه كُولن إلى أن القيادات والسياسات حين لا توفّق في سوس الأمم ببصيرة وسداد، تكبّد رعاياها من أنواع العناء ما يعمّق من حطتها، ويزيد من انبخاسها بين الأمم.
ومن المؤكد أن السعد معقود على نواصي القادة.. فمتى ظهر القائد الحازم، المتبصر في خياراته، الألمعي في قراراته، المراهن على غايات تعزّز من شأن قومه، وترسّخ مكانتهم، سارت الأمة بخطا ثابتة وعزيمة مكينة، ورؤية واضحة نحو هدفها في المدنية والتعمير.
وإن ظهور قادة الفكر -في تقدير كولن- حين لا يتوفر الحكم الرشيد، يكون أجدى وأنجع في تهييء القاطرة التي تشق المدى بالمجتمع نحو الانعتاق، بل وإنه لَحَظٌّ أسنى، تُغبط عليه البلادُ والأوطانُ.
الدولة الحازمة تختزل المسافة إلى المدنية؛ لأنها ترمي بكل ثقلها في اتجاه تحقيق الغايات، فلذا تعوّل على تشبيب روح العنفوان في الإنسان، وتُربّيه على التمرس بقيم المنافحة والتصميم، وإحباط التحديات بالعزيمة والحكمة والدهاء الذي يكفل النجاح.
الدولة الحكيمة هي التي تنهض بمسؤوليتها في بناء الإنسان، وتثمير الفرص أمامه، بل وهي التي تعمل بلا كلل على خلق هذه الفرص التي تمضي بالمجتمع على سكة البناء المتين. وإن من أهم ما يتجسد فيه رشد الدولة على صعيد التعمير: استغلال الزمن، واستثمار عامل الوقت؛ إذ إن إهدار الزمن هو عنوان صريح على التخلف، والبعد عن النجابة والصواب.
في كل الأحوال تظل مسؤولية النخبة حيال مهمة الإنهاض، مسؤولية لازمة لإيقاد شعلة الصحوة، بل ما أكثر ما انطلقت الشرارة من آحاد الأفراد، فالرموز الصالحة قادة الفكر والروح، هم جذوة يدخرها القدر لبعث الحياة، وتجديد مَطلع الفجر.
وإن بناء محاضن النخب وتكثيرها، هو استزراع يحقّقه الأقطاب النورانيون بكدّهم ومرابطتهم في الساحات، يستقطبون إليهم الخيريين من ذوي النفوس المجبولة على البر وحب الفضيلة. وإن كل جمع من الطيبين تراهم تداعوا إلى العمل الجاد، والعطاء المثمر، إنما يكون اجتذبهم إلى رحابه رجلٌ رباني وقف حياته على العمل الصالح، فليست المجَرَّة سوى مجاميع تترامى في الفضاء العالي، متحلقة حول شموس وأقمار، من حيث تستمد الضوء والانتظام والحركة والوظيفة.
ينفتح الطريق أمامنا نحو المستقبل على اتجاهات عدة، وسبل شتى، فإما أن نستنيم إلى الحال المخدرة التي وضعتنا فيها تاريخيتنا منذ العصر الوسيط، ونمضي في التقهقر، شبه أموات، إلى أن يقع التحلل ونبيد. وإما أن ننغمس في مدنية الآخر بلا وازع ولا ضابط (وهو ما اختاره المتغربون المستلبون)، ونترك مصيرنا منوطًا بتوغل واستشراء هذه المدَنية وتفاقم غلوائها، وبكل ما يلحقنا من شرورها وهي تزدردنا لا يجد منا مقاومة ولا رد فعل.. وإما أن نعيش الغياب التاريخي، مثل رقدة أهل الكهف (وكان لهم ما يبرّر رقدتهم، عكسنا تمامًا)، فتنساب بنا الظروف والأطوار، كورقة جافة، تدحرجها الريح على القارعة، وتكورها السوافي عبر المجاري..
“وإما أن ننفتح على ذاتيتنا، ونلتحم مع ماهيتنا، وننفض الغبار على مقوماتنا، ونستحيي مكامن الوجدان، فينبعث الوعي، وينتعش الضمير، وتتجدد المعنويات، وتنطلق الحياة كرَّة أخرى؛ إذ مقومات الكينونة حين يلابسها دفء الوعي بالذات، وتنقدح فيها شعلة الانتفاض والانبعاث، تسترد قابلياتها الجوهرية في الحركة، وتندفع نحو اتجاه مرسوم سلفًا في فهرست الانتماء، الأمر الذي يجعل القافلة تستأنف السير، والعجلة تنساب في مدارها، وتمضي باسم الله مجراها ومرساها”.
إن أهليتنا في بناء الحضارة، والترشح لإدارة مستقبل الإنسانية، أمرٌ مشروع، بل وحتمي، بكل المعايير، وبحكم منجزات الماضي، وما شاده الأسلاف من شامخ العز، وراسخ التحقيقات المدنية والحضارية التي لم يمحها الزمنُ، على الرغم من تزايد لواحق الإبداع الإنساني الذي أعقب غروب شمسنا؛ إذ ما زالت هناك تجليات لا تُحصى، ماديةً ومعنويةً من حضارة المسلمين، حية، وماثلة للعيان، ومنوَّهًا بها، ولا تفتأ الإحالة إليها، والاعتراف بقيمتها، صريحة ومؤكدة ومتواترة.
وإن ما يميز الإسلام أنه أعطى الإنسانية العقيدة التي تظل التشريعات الوضعية تنظر إليه بإكبار، وتبقى مدينةً لها في كل اجتهاد. كما أعطاها الحضارة التي حملت سماته الروحية وسجاياه الفكرية والجمالية، ومحامده الأخلاقية والقيمية، بخلاف سواه من الديانات الأخرى التي ظل نتاجها المدني والحضاري قوميًّا، حصريًّا أو يكاد (الصين، الهند، إلخ).
لقد تبنَّت حضارة روما العقيدةَ المسيحية فدجنتها على وفق مزاج إباحي، أبيقوري، فاضح، وجعلتها عقيدة تُراوِحُ عبر مسيرتها من الشمول الذي أحالها عقيدة ظلامية، منهِكة للإنسان، معنتة له، حائلة بينه وبين ربه؛ إلى عقيدة العزلة، والانقطاع، والبعد عن الواقع (ما لله لله، وما لقيصر لقيصر)، فكانت ديانة معبدية، تتكيف بضغوط الحضارة ولا تكيّفها، عكس الإسلام.
وانظر إلى الظاهرة الحياتية التي أخذها الإسلام اليوم، من خلال الأقليات المسلمة المهاجرة في الغرب، والحضور اللافت لهم، ليس في ظاهرة ميعاد صلاة الجمعة الأسبوعي فحسب، ولكن في مواسمه، ونظام حياته، ومعاشه، وأُسس تفكيره، فإنك تدرك أن البعد الانفتاحي هو مَيْسمٌ في هوية هذا الذين؛ إذ ينتهي دائمًا إلى إحداث التأثير، وجذبهم بيسر إلى مبادئه.
إن الإسلام كما يعرفه الأستاذ كولن هو العقيدة التي تهيأت لتكون للعالمين موردًا؛ حيث تأصلت لها سجية الصلاحية في الزمان والمكان مطلقًا، فمن خصائصه العضوية “أنه يدخل إلى أضيق المعابر في الحياة الفردية والعائلية، والاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والثقافية، ويجول في وحدات الحياة كلها بصوت العصر الذي هو فيه، ويلفت النظر في كل وحدة من وحداتها بصورة أشد إحكامًا من أحكم شيء واقعي”.
من هنا كان التَّوْق إلى بناء الحضارة اليوم، من صميم مقتضيات صحوة المسلمين، وإحساس متنوريهم وأعلامهم الخيرين بأن للإسلام حلولاً ناجعة، في وُسْعه أن يستنقذ بها الإنسانية اليوم -كما الأمس- من تردياتها المخيفة، وتشوهاتها المريعة.
فقه الحضارة
يجعل كولن من عناصر (الإيمان، والزمن، والهدف) أركانًا لاستراتيجية بناء الحضارة. وإذا ما تأملنا هذه المصادرة القانونية الثلاثية، رأيناها تضمِّن العامل الإنساني في أطراف المعادلة جميعًا؛ إذ القاسم المشترك بينها هو الإنسان.. ونستطيع قراءة هذه المعادلة كالتالي: الإنسان (المؤمن، صاحب الهدف، المستغل للزمن)، هو الذي يبني الحضارة.
ومثل هذا التقعيد لمقومات الحضارة وبنائها، رأيناه حاضرًا في كتابات المفكرين وفلاسفة المدنيات، ولعل أقرب هؤلاء إلى الأستاذ كولن المفكر مالك بن نبي، فقد ألفيناه هو أيضًا يشترط للنهضة وقيام الحضارة ثلاثة أركان = التراب + الزمن+ الإنسان.
ويمكن قراءة تمثُّل آخر لكولن يتعلق برؤيته لبناء الحضارة، محدداتُه هي (الله، الكون، الإنسان)؛ حيث تمثل الأستاذ أن وازع الإيمان هو أصل جوهري في الكون، وأن روح الإيمان ماثلة في الوجود، في صورة نداء يسري في العوالم، يردد معاني هذا التجلي الله – الكون – الإنسان الذي هو تسبيح بحقيقة ما فطر الله عليه الكائنات والكون، من حتمية التجدد والاستمرار. فهذا النداء هو صوت الفطرة الإلهية المنغرسة في صميم كل كائن، والمركوزة في حنايا كل مخلوق.
إن دورة المواسم مثلاً، هي تجسيد حي لهذه الفطرة التعميرية التي جبَل الله عليها مخلوقاته، وإن قانون التكاثر وعشق فصائل الجنس لمُكمِّلاته من ذات الجنس، هو عنوان آخر على فطرة التعمير التي هيَّأ الله بها الكون، وختم على ما يستوطنه من أشياء وأحياء، بل هو تسبيح معنوي وحسي تشهده قلوب النورانيين، وتشارك في نسج أنغامه، فأرواحهم هي في الحقيقة آلاتٌ تصدر عنها أنغام الذكر والشكر كما يصدر صوت الشجن عن الناي.
إن الصبغة الإنسانية الراسخة للإسلام، هي من أبرز البواعث التي تحتّم على المسلمين أن ينشروه ويستنقذوا به البشرية مما ترسف فيه من تفاقم الأيديولوجيات المضللة والفلسفات التجريبية القاصرة عن تحقيق الحد الأدنى من الطمأنينة والسلامة، وإن طرق الدعوة وإن تعددت اليوم، إلا أن أمثل الكيفيات التي تناسب إذاعة الدين الحنيف بين العالمين، هي أن يتقوى المسلمون، ويبنوا المدنية التي تحمل طابع الإسلام، وتعكسه روحيًّا وماديًّا، فيكون الطراز المدني المنجز خير دعاية ودعوة للإسلام.
الأسس الإنسانية في الإسلام
إن عدالة الإسلام ثابتة، ولا مراء فيها فيما يخص مراعاته لحقوق الإنسان، وصيانته للكرامة البشرية، وعدم تمييزه بين العباد (إلا بالتقوى)، وفتحه المجال أمام كل من ينتسب إليه ليكون بأهليته وكفاءته صاحب شأن ورأي ومسؤولية حيال الأمة، وبالتالي حيال الإنسانية جمعاء؛ لأن الإسلام لا يعترف بأدنى امتياز للمسلم على غير المسلم فيما يخص الحقوق الإنسانية العامة، فكلنا عباد الله، بل على العكس من ذلك، يفترض الإسلام على الذي انتسب إلى هذا الدين الحنيف، أن يكون مسؤولاً عن الخلائق مسؤولية نفع وإصلاح، باعتبار ما تُلزمه به آية الخروج ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ..﴾(آلِ عِمْرَان:110).
ومن البديهي أن الأمة المستصغَرة، والضعيفة، والمغلوبة على أمرها، لا يمكنها أن تحوز منزلة الخيرية، أو أن تبلغ مرتبة إسداء المعروف، ومنع المنكر، ما ظلت على ضعفها وصَغَارها.
من هنا كانت آية الخروج هذه آية إلزام، وتكليف شرعي يقتضي من الأمة أن تتوفر على شرط القوة، حتى لا يُستباح الحوض، أو يُنتهك العرض.
وإن التقوى التي وضعها الله عز وجل معيارًا للقرب منه أو البعد، هي تلك الروح المفاعلة للناس، والمتساكنة مع المحيط بانضباط أخلاقي، وتعفّف جوارحي، وتماسك قلبي يلجم الأهواء ويكفّ في النفس الرغبة في التعدي والتجاوز.. فالتقوى بهذا الاعتبار هي الصفة الإنسانية التي يغدو بها العبد حائزًا على مرتبة الاحتساب والإحسان؛ حيث يضحى في مقام يحمد العباد جميعًا منزلته وإنسانيته؛ إذ يجدونها تفيض عليهم بالحسنى والمبرّة والحنو.
إن هذه الأسس الإنسانية التي يمتاز بها الإسلام هي التي ترشّحه في كل عصر، للانتشار. فليس هناك من يستطيع أن يطعن في مبادئ الإسلام، وفي إنسانيته، إلا المتعصب.. وإن تَمَنُّع خصومِه عن أن يفتحوا معه الحوار، لا يوجد له تبرير إلا خوفهم الأكيد من أن يُفتضَحوا ببضاعتهم في ساحة السجال.
ولذا نرى كولن يجعل من الدعوة حراكًا شموليًّا، لا ينبغي أن يقتصر على الجانب التحسيسي والخدمي فحسب، بل إنه يرى أن الدعوة في إطارها الخدمي الحالي كما تنهض بها دفعات الشباب، وكما تتضافر لها اجتهادات أخرى من جهات أخرى، فردية وجماعية، رسمية ومدنية، اجتهادات ما زالت شبه جنينية وغير متصلبة بالخبرة والإمكانات التي لا تجعلها عُرضة للانقطاع، بل والتي هي في أحيان كثيرة مجرد مظهر من مظاهر المزايدة والتباهي والتستر عن التقصير والإخلالات المقترَفة في حق الله والأمة، إن الدعوة بهذا المستوى النشوئي الغض، لا يمكن أن يكون لها المحصول المجدي، والمنتَج الحاسم ما لم تندرج ضمن نهضة شمولية يضطلع بها المسلمون، وينخرطون في بنائها.. نهضة تراهن على إشهار النموذج الحضاري الإسلامي الذي يرى كولن أن كل الترديات الأخلاقية والاجتماعية والثقافية لحضارة الراهن المادية، تنتظره وتتطلع إلى بزوغه، كالفجر إثر ليل دامس.
مصادر العزة والبعد الروحي
ومما نسجله في هذا الصدد أن نظرة كولن لهذه الحضارة المنشودة، لا تعتدّ في المقام الأول بالجوانب المادية والتجهيزية حصرًا.. تلك الجوانب التي تضعها عقلية الابتزاز والصفقات والربحية في طليعة اعتباراتها وحساباتها، بل إنه يركز على الجوانب الروحية، وعلى الركائز المعنوية التي يراها هي الضامن الأهم للتأسيس والإنجاز.
حسابات خيالية ننفقها كل سنة على مشتريات وتجهيزات بدعوى تحقيق الإقلاع، دون جدوى. إنما هي صبيانيتنا، وانبهارنا بالثروة المجانية التي كفلها لنا البترول، واستنامتنا لمخادعات وتنويمات الرأسمالية التي عوَّلنا عليها في استيراد الاستشارة والخبرة، والتجهيز والتعليم وفي كل المناحي المدنية الأخرى.
وقديمًا زعمت الأسطورة اليونانية التي هي جزء من مكونات عقليتهم، أن الإله بروميثيوس استأثر بالنار وحده، وأبى أن يعطيها للآخرين.
فالبداهة تجعل النبيه يدرك أن من كانت حرفته النجارة لا يمكنه أن يتنازل عنها لغيره، وإلا أغلق باب رزقه وفرَّط في شرط تفوقه، وكذا من كانت مهنته الصناعة، لا يمكنه أن يتيح لسواه أن يتلقن أسرارها؛ ضنًّا بخبرته التي هي مصدر ظهوره وأساس معاشه.
ومما لا ريب فيه أن ظروف انفتاحنا على الأمم الأخرى، وسذاجتنا في التواصل مع الاجتماع الدولي، نحن الأمة التي رسفت في البداوة والتخلف على مدار القرون، يجعلنا نقنع بل نغتبط بالحظ البخس من القبول المغشوش إدامة للغفلة والسذاجة التي تميزنا.
من هنا رأينا كولن يرجح في منهجه التمثلي لبناء الحضارة: البعد الروحي، ويجعل البعد المادي قرينًا له أو تابعًا؛ لأن اشتحان روحية المجتمع وقادته بالإيمان، واتضاح الهدف أمامهم، يجعل الجهد يتكثف باتجاه تهييء الجهوزية المادية، إما بانتقاء الوسائل والعدة من الآخرين (مرحليًّا)، وإما بالابتكار والتدبير الذاتي.
كان يرى عن كثب دُولاً بلغت من العُدة التصنيعية ما بلغت، آذنها الانهيار وباتت أملاكها وأساطيلها، بل ومقدراتها من العلماء والباحثين وأهل الفن والمهارات، تركةً تتوزعها الأمم، وبضاعة زهيدة السعر لا تجد من يعرض فيها الثمن.
أممٌ تعالت في الجحود، وداست على الروح، وآمنت بأن الإنسان قيمة شيئية تحكمه الانفعالية الشرطية، فيفعل أو لا يفعل، حسب الطلب، أمم اعتدَّت بالقوة المادية وحدها، وجعلت السبق للمادة على الروح، وتحسبت للمستقبل بقانون الحتمية الذي أناطت به كل فتح، وزعمت أنه القانون الذي يستمد وقوده من غبن الكادحين وصراعهم من أجل اللقمة، فيدأب الزمن على الحراك، يبني النهضات، ويقيم الصروح، من غير ما تدخل لقدرٍ؛ إذ لا قَدَر هناك -بحسبها- ولا اعتقاد في غيب أو دين (الدين أفيون الشعوب). تلك الدول لم تفدها عُدَّتها وصناعتها واحتياطها المادي في شيء، بل آذنتها مشيئة الله، فتزلزلت وتهاوت وتفككت تحت مرأى ومسمع العالم.
بل كان كولن ينطلق في استقراءاته للوضع الكوني، من حتمية أخرى يعتد بها المؤمنون، هي سنن الله التي قطعت بهلاك المتجبرين ما إن ينتهوا إلى الخط الأحمر الذي حدَّده الله، والذي لا مجال لتجاوزه (كالأجل، لا يتقدم ولا يتأخر)، لذا لبث (كولن) يلحّ ويحرّض على وجوب الرهان على الجانب الروحي في الإنسان وفي المجتمع والمدنية؛ إذ إن الإسمنت المسلح الذي لا تنال منه الزعازع ولا الزلازل هو الإيمان، وهو سَنُّ الروح بِمِسَنِّ الإخلاص، وتجهيز القلب بالعشق.
كانت آية الإيمان العملي متجذرة في عمق أعماقه ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾(البَقَرَة:3)، فكانت دلالتها منطَلقًا له في تَمَثُّل ما ينبغي أن يكون عليه الصرح الحضاري المتين، والكيفية التي يُقام بها، والأسس التي ينهض عليها، والعُدة والوسائل التي يكتمل بها “الإيمان بالخيرية والمسؤولية الإحسانية، وإيصال التعمير إلى الآفاق، والتعويل على أفضال الله في ما وهب للإنسان من رزق، هو مستخلَف فيه”.
ويمكن في هذا الصدد القول: إن سائر كُتب الأستاذ تندرج ضمن هذا التوجه التعميري الذي نرى اليوم فرق رجال الخدمة ينهضون بشيء منه.. فمن كتابه عن السيرة، إلى كتابه عن السلوك (التلال الزمردية) إلى كتاب الموازين، إلى ما سواها، لاسيما تلك التي باشرت موضوع التكليف الحضاري الصريح، هي جميعًا تنظير لما ينبغي أن تكون عليه روحية المسلم العامل.
في هذه المصادر جميعًا، يؤكد كولن أن الإسلام يحفّز المسلمين على إقامة المدنية التي تستند على دعائم الروح، والتي تسري الأخلاق السماوية في شرايينها.. المدنية التي تسمو بالكرامة الإنسانية، وتضمن الوقاية للفرد حتى لا يغدو عبدًا لجسده.
تحرير الإنسان في الإسلام
إن مفهوم تحرير الإنسان في الإسلام لا يعني فقط تخليص البشرية من ظاهرة استعباد الإنسان من الرقّ الذي طالما استهدفه بسبب لونه، إن مفهوم الحرية الإنسانية في الإسلام يتسع فيشمل صون الآدمي من كل وضع تنقهر فيه النفس البشرية، وتُسَاس بما لا يحتمله الحسّ السليم والوازع الفطري السوي، فتحريم الإسلام للزنا مثلاً، إنما هو حماية المرأة من شرّ ما تُسَام به من هتك، وهي تبيع عرضها و(تأكل بثدييها)، لكن الحضارة المادية، وباسم الحرية الشخصية، شرعت للبغاء ومكّنت أن يُشهَّرَ عنه في أكثر مدن وحواضر العالم.. والأمر يقال عن الخمر؛ إذ المدمن فردٌ مستلَب، عبدٌ لداء نفذ فيه، داء يُعَدُّ المجتمعُ عنه مسؤولاً حين رخََّص للمسكر، و«كلُّ مُسْكر حَرام» أن يسوَّق، وأن يتعاطاه الناس بلا مانع.
وقل مثل ذلك عن آفات القمار، وألوان السمسرة، والاحتكار، و..أليس عالم الحضارة المادية هو الذي يعدم سنويًّا الفوائض التي لا تُحصى من النعم والمنتجات، إبقاءً للسعر عاليًا.. أليس هو الذي يحتكر ترخيص التصنيع في المجالات الحيوية كحقل صناعة الأدوية، توفيرًا للدواء الذي تعجز عن دفع ثمنه البلاد الفقيرة لصالح شعوبها؛ لأن دوائر الاحتكار العالمي ترى في هذا الترخيص حدًّا لابتزازها من الكسب الشَّرِه؟!
لهذا وغيره، يرى كولن أن الحضارة المنتظرة التي سيؤسس لها النهوض الإسلامي الراهن، ستعمل بلا هوادة على علاج كل هذه السلبيات التي تُرهق في الإنسان إنسانيته، وتُخرجه عن سَوِيته؛ لأنها آثام في حقيقتها مناقضة لجوهر الطبيعة الإنسانية المهيأة للخير والرشد، فالشر والظلم ليس من الفطرة السليمة، ومسؤولية الإنسان أن يتمرس بالخير، تساميًا إلى منزلة التكريم التي خصَّ الله بها الإنسان.
إنها آثام وتعديات شاذة، تبرّرها فلسفة نابعة من فكر لا أخلاقي، أو بالأحرى لا ديني، بعيد عن روح الرحمة والتشارك، أدى إليه التحلل من أحكام السماء، وسوّغتها الاستنامة إلى أحكام الإنسان المحادد لله، الباغي في الأرض، المنكِر لقوانين الروح والغيب.
سمات النموذج الحضاري الإسلامي
إن إيجاد النموذج الحضاري الإسلامي الأصيل هو رهان المسلمين اليوم، وامتحانهم الذي يجعلهم حقًّا شهودًا على العالمين، وإن مواصفات هذا النموذج ومقوماته الروحية والتشريعية والقيمية والمدنية مرسومة في ما قرر القرآن من تأسيسات حدية، وما أرشدت إليه السنة من توجيهات تنويرية، وفي ما باتت عليه عقلية رواد الأمة ومصلحيها من تفوُّقٍ وإجادة وإبداع.
يتحتم -برأي كولن- على الأمة أن ترادف الجهود، وهي تتوجه إلى المستقبل، فتعمل من جهة، وبلا هوادة على تصحيح الأضرار الجسيمة التي لحقتها، ليس فقط جراء رقدتها طيلة قرون، ولكن أيضًا مما أصابها نتيجة تلوثها الفادح بمفاسد مدنية العصر، لاسيما على الصعيد الروحي؛ إذ دمرت أوبئة المدنية المادية أهم الخصائص الروحية التي اغترسها فينا الإسلام، ومكّنتنا منها مسيرة مظفّرة امتدت على مدار قرون، كنا خلالها أساتذة العالم، ومرشديه، قبل أن تنحرف فينا الفطرة القويمة بحَيْدتنا عن توجيهات دستورنا القرآني، وترشيدات سيرة نبينا الكريم.
الجهد الأوفى المنتظر منا -إذن- هو استصلاح ما فسد، والعودة إلى مقومات ديننا الحنيف، واسترداد رأس مالنا الروحي الذي فرَّطنا فيه -أول الانحراف- بفعل الغفلة، ثم بالتنكر لجوهرية وألْماسية معدنه، بعد ذلك حين انخدعنا بزخارف المدنية المعاصرة العرجاء، التي أضاعت ارتكاز الروح، فسدرت في الضلال المبين.
لقد وضعتنا الفلسفات المادية، تحت هيمنتها، فأذْعنَّا للقهر طويلاً مع أن “القرآن يحرّم علينا الحياة تحت وطأة الوصاية” ؛ ذلك لأننا فقدنا مقوّم القوة الذي لا تقوم لنا بدونه راية، حتى وإن كنا نملك أقدس الكتب وأعظمها ترشيدًا وتنويرًا، والسبب هو أننا هجرنا هذا الكتاب المبين، واتخذناه ظهريًّا.
فبتجهيز روحيتنا من جديد بمبادئ القرآن وتعاليم السنة، تتهيأ كينونتنا للانبعاث والعطاء والإبداع والبناء. في هذا الإطار، لا مندوحة لنا من العودة إلى الإسلام؛ اكتسابًا للحصانة من الاختراق “الإسلام كحليب الأم، له الدور الأساس في ضمان وتنشئة جهازنا المناعي”. فـ”تفوق الإسلام ناتج عن كونه حقّق نقطة التقاء السعادة البشرية ورضا الله”.
الجهد الآخر ينصبّ على تحصيل المعارف العصرية، لاسيما العلوم التجريبية والتكنولوجية، والتطبع من جديد على أساليب التفكير والبحث والاكتشاف، فبذلك نمكّن لقوانا الخاملة واستعداداتنا الضامرة من أن تنبعث بأكثر مما كانت عليه من حيوية وتوثب في الماضي، عندما كنا رادة الحضارة وروادها.
وإن من شأن ما رزحنا ولا نزال نرزح تحته اليوم من وطأة الانبخاس الحضاري، وما يضغطنا اليوم من إحساس بالهوان وبالدون، أن يُفَعِّل في أرواحنا من الطاقة ما نتدارك به الركب، ونسترد المكانة.
إن الشرط العلمي والمعرفي المؤهِّل للبناء، لا بد أن يَقرن في صلبه البُعدَيْن: الروحي والعقلي، القلبي والمنطقي؛ تجاوزًا للوضع المتفاقم الذي تعرفه مدنية اليوم التي انتهى بها الوهم والجحود والوثوق الأخرق في الذات وفي المادة، إلى الطريق المسدود، من حيث فشلتْ نظمها (المالية والأيديولوجية) في الصمود أمام تحديات الحياة والتاريخ، وكذا من حيث عجز فاعلياتها القيمية والتصورية عن ضبط الاستشراف السديد والتحوط الرشيد للراهن والمستقبل؛ إذ سارت (المدنية المعاصرة) في طريقٍ يرجّح كفة الإيمان بالمحسوس على حساب الإيمان بالله، والامتثال لأوامره، والأخذ في كل تخطيط واستشراف بالبعد الروحي الذي يجعل إرادة الله حاضرة في كل مسعى أو رهان.
لقد شذَّت مدنية العصر في مجال المعنويات، وذهبت بعيدًا، إذ أصرت على أن تدوس المُثُل الأخلاقية الأصيلة باسم التطور الفكري والحرية الشخصية، وتعمدت أن تسلك سياسة إدماج المحاذير الدينية والموانع الفطرية في الحياة، من حيث التعاطي السافر والتداول المعلن، فشرَّعت أخلاق التهتك، وأحلََّت ذيوع الإباحية، وأطلقت العنان لفكر الشذوذ، وهدم المقومات الوجودية (تفكيك الأسرة، الزواج المثلي، العهر المدني، وما يشاكل ذلك من كبائر ظلت الديانات تحذّر من مغبتها)، فكان حتمًا أن ننتظر حلول نقمة الله؛ حدًّا لتعاظم هذه البوائق والمفاسق التي نراها تتلاحق اليوم في العالم، منذرةً بما لا بد من وقوعه، سُنة الله في الأرض، ولن تجد لسنته تبديلاً.
وإن الكيفيات التي تأخذها النقم الإلهية لعديدة، وتُناسب حجم الجُرم والغواية، وإننا لا نفتأ نتدرج في اكتشاف صور للهول، ولقد رأينا كيف تُروِّعُ ضربة تسونامي عارضة مثلاً، أهل الأرض جميعًا، وتذكّرهم بما أصاب الأمم الهالكة من تصفية ونسف كما أخبر القرآن، فيذهلون ساعة عن غرورهم، ثم تعاودهم الغفلة، فيمضون في سدورهم وضياعهم؛ ذلك لغياب الضابط الروحي في القلوب.
الفواعل والطلائع.. قادة الفكر والروح
يرى كولن في الإنسان أبرز فواعل البناء الحضاري، وأهم وسائله ومرتكزاته؛ لذا شدّد على وجوب تكوينه التكوينَ الذي يجعل منه قوة فاعلة، ومرَشَّدة، وموقنة من أن ما تبذله من كدّ وكدح، هو عطاء يندرج ضمن روحية الحمد التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها حيال ربه، المنعم بالوجود، والمتكرم بالمنن. وفي غياب النظام السياسي الراشد، الذي يجعل من بناء الإنسان وتكوينه غايته الأولى، يتحتّم على المجتمع أن يتولى أمر إعداد نُخَبه بذاته.
ولا ينبغي أن تُصاب الأمة باليأس؛ إذ العناية الإلهية تدخر لها دائمًا صالحين، ينهضون ضميرًا يحدو الناس إلى الهدى.
ما اكفهرت الحياة واشتدت حلكتها بالأمم، إلا هيَّأ الله لعباده منارة تضيء الليل، وصوتًا يشدو بالسُّرَاة. إن التمحيصات الدامغة التي تتعرض لها الشعوب حين تجثم عليها المُلِمّات، تعمل حتمًا على إظهار القوة المضادة التي تتصدى للكابوس.. فالأمم كالأفراد تُبدِي من القوة والتفجر حين يُطبِق الخطبُ الداهمُ عليها، ما لا قِبَلَ لها به، ومن حيث لا تحتسب، حتى لكأن هناك طاقات خارجية انضافت فجأة لقواها، وساندتها في لحظة الخطر، وردَّت عليها الشر.
ومن المؤكد أن قابلية الخير في الشعوب، هي التي تجعل الأسماع تعاود الإصغاء إلى أصوات الخيرين، وهي تهيب بهم أن يثبتوا، وأن يصمدوا في وجه الكواسر.
وكل فذّ من الخيرين إنما يكون مَطْلَعُه في قومه بمثابة الفجر بعد الظلمة، أو كالماء العذب ينبجس في قلب الفلاة، بل إن ظهور الأفذاذ الذين هيَّأهم القدر لأن يكونوا صُناعًا للتاريخ، وبُناة للمدنية، لا يكون إلا وقْت اشتداد العتمة واستفحال الخطوب؛ إذ لا يجود بالنفس، ولا يبذل الروح حين تنتكس الرايات وتنحني الهامات، إلا جبابرة الروح، أولو العزم، ورثة الأنبياء.
لكأن ظهورهم في قلب البأس، وبروزهم في عتمة المحنة، إنما يندرج ضمن ما هيَّأ الله من قانون توازن تَطَّرد به الحياةُ والعمران. أجل، إن سعي العظماء، قادة الفكر والروح، إنما هو مظهر من مظاهر الشِّرْعة الإلهية التي ما أوجدت داءً إلا أوجدت له دواءً يقاومه ويزيله.
يتحول الأفذاذ إلى جذوة متأججة، ويتنامى جهدهم فيغدون مشكاة فيها مصباح، ثم لا يلبثون أن يضحوا عامود نور يضيء القارعة، وما يعتمون أن يصيروا فَلَقًا في السماء، وشمسًا تحضن المدى، وتستقطب الورى من حولها.
﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾(الأَنْعَام:95).. كذلك هو شأن الصالحين في أممهم، ينبلجون من عمق الظلمات، وينجمون من صميم النسيج البشري الذي استلبته سلطةُ البغي، وصيَّرتْه مجردَ جموع من الموات، هنالك ينتصبون في الميدان، شاهرين سلاح الإيمان وحده في وجه الباطل، فُرادى في المُنازَلة، كل شيء ينكرهم ويدفعهم، لا يكادون يجدون حانيًا ولا شفيقًا، لكأن قومتهم كانت تناصب الحقَّ العداءَ، ولم تكن للحق مُناصِرة ولا عن الكرامة باحثة! حتى عموم المستضعفين يقفون من أولئك الشُّهُب موقف المتفرج والخاذل، بل وأحيانًا -وتحت تشويش أهل الباطل- يبدون النُّكر والعداء لمن نهضوا يحامون عنهم ويدافعون، فلا يُحزِن أهل العزم ويُدمِي قلوبهم إلا أن يروا السهام تختلف إليهم من كل حدب، والحراب تتناولهم من كل صدد، لكنهم يستميتون في المواجهة، يخوضون المعركة كرًّا لا فرًّا، يثبتون ولا ينثنون.
يقف هؤلاء الربانيون في قلب المعمعان، ومنهم ومن صبرهم واحتسابيتهم تتولد المقاومة، هيِّنة، ضعيفة كالبذرة في رحم الأرض. قليلون من يوقنون أن تلك المصابرة المطوقة من كافة الجهات، سيُكتب لها أن تصمد وتستمر، لكن أهل الإيمان يزداد يقينهم في الانتصار على قدر اشتداد الضراوة التي تستهدفهم، وشيئًا فشيئًا تنجُم الأكمام، وتتفتح البراعم، ثم يلوح الربيع.
لكن كيف يهيئ المصلحون المستقبل، وفي أي صورة يتمثلونه، وبأية خطة يمهّدون له؟
من احتراقهم المتواصل ينشأ الدفء، وتسري الحياة، فمن بيضة مفردة يُولد طائر، ثم آخر، ثم سرب.. وعند ذاك يتهيأ للشعلة أن تضحى مشعلاً يتصاعد في السماء، ولا يلبث أن يشد إليه الأنظار من الأرجاء كافة.
حين ينغرس مصل الإيمان في وجدان الناشئ، تسكن الرحمةُ قلبَه، فيشبّ على المحبة، وينطبع بها مزاجه، بل ويصطبغ بها كيانه وشخصيته، وعلى قدر ما يَرْقى به العمرُ، تتأصل فيه خميرة الخير؛ لأن نزوعات النفس تكون قد هُيِّئت للانجذاب نحو السمو ونشدان الفضيلة، نتيجة ما تلقحت به في المنشأ من عشق، فتتمكن في روحه قابليات الكمال، وتترسخ طبيعة النفور من النقص والرذيلة، ومن كل ما يسيء إلى القيم وشموخ الروح.
على هدي هذه التنشئة الصالحة تدأب الحلقات والمنابر والصفوف والمكتوبات على التوسع في توفير المدود وتكبير الاحتياطات.. إنها ترسم في الأفق خَطًّا نورانيًّا تجعله سقفًا للمريدين والأتباع والخيرين، يبلغونه ويستوفون به أهليتهم للحياة البرّة.
فقادة الروح ومهندسو الكمال الإنساني يدركون أن مراقي الكمال شاقّة، تستغرق العمر كله، وإن مهام البناء الملحّة لا تتيح للاحتياط أن يتهيأ، ويتوفر بالحد المناسب والسرعة المطلوبة، فلذا هم يعوّلون على منهج التنشئة الذاتية؛ إذ يدركون أن النفس الكريمة حين تنجذب إلى محافل البر، تكتسب سريعًا قابلية الحياة، فهي تزدهر بالحظ التنويري الذي أُتيح لها أن تحصّله، ثم تمضي حيثما مضت، وقد ضربت جذورها في التربة، تستمد أسباب الحياة بذاتها، كشجرة الغاب، تتعالى بالطبيعة، وتهيئ من حولها مشاتل تلتف بها، وتخلفها حين الهرم.
كل مَجْمع يصنعه الأبرارُ يتحول إلى دينامو يولّد الإضاءة، وكل منتسب لمدرسة الإيمان، يكتسب من عناصر النماء ومن كيمياء العشق ما يكفل له أن يسير على الطريق، متدرجًا بذاته عبر مدارج السمُوِّ، ويعزز فيه مكاسب الروح؛ إذ تتحول مسيرة حياته، في خضم ما ينذر له العمر من خدمة وبذل، إلى رحلة للترقي؛ حيث سيتعمق ارتباطه المعنوي بعهود العز الخوالي، فيضحى في كل آنٍ يعيش بمواجده أجواء الوحدة الجامعة، فلكأنه وهو من صحابة هذا العصر، واحد من زمرة الصحابة العظام، نشَّأََهُ هو توجيه يستمد تسديداته من منابع النبوة المحمدية، ونشأهم هم خير الخلق محمد بن عبد الله، أفضل الورى، وسيد الأنام r.
حين نسِقي الناشئَ برشفات الإيمان العِذاب، نكون قد وضعنا قدمه على طريق بناء وتأصيل المدنية الحق؛ إذ من شأن العبد المؤمن أن يتصلب في وجه الاختراقات، ويمتنع عن ملابسة التلويثات التي تعج بها الحياة، فبدل أن ينضم إلى هَوْجة أهل الفساد الذين تفرزهم المجتمعات حين تغفل عن الفضيلة، يضحى هو عامل نقاء ونظافة، يشمله الطهر في ذاته، باعتباره حاملاً من حوامل الأخلاق والإحسان، ويشمل بالتبعية محيطَهُ، بدءًا من أسرته ومخالطيه، فالعنصر النجيب الذي تصقله مهذّبات الدين، يُعَدُّ من أهم فاعليات بثّ الخير والطمأنينة والاحتساب في المجتمع، ذلك أنه بعد أن يسلخ مرحلة الشبيبة في الاستقامة والرعاية والتطوع، يغدو عنصر صلاح، يقضي العمر في العمل الصامت والقنوت المتواصل، أشبه بملائكة الله (ولقد رأينا نماذج من هذا الصنف الألماسي بين شباب الخدمة)، أو يقوم -بدوره وهو مرابط في الجبهة- بتأسيس خلية أُسرية لا يكون عناصرها -كلاً أو بعضًا- إلا آخذين بشمائل الصلاح والتهذب الروحي، فينشأون على التخلق والشهامة ونشر المحامد، وهكذا تتسلسل منهم القوامة الإيمانية والأخلاقية، ويتسع من خلالهم نطاق الفضل والجمال، وتسترسل تجذرات الخير عموديًّا وأفقيًّا، وتتنامى مساحات الاستنارة والفلاح، وتخضرّ أرضية الواقع الاجتماعي، وتتداعى الأجيال في مسيرة الحياة الكبرى إلى نهج الرشد والتمدن الفضيل، فيتعزز الإنتاج والإبداع، وتتناسل أنواع الاجتهادات التأصيلية الأخرى في سائر ميادين الحياة، الأمر الذي يتكرس معه بروز النموذج الحضاري المتفرد الذي يكون له أهلية التأثير والريادة والأستاذية العالمية.
إن الحضارة تكون أكثر عمقًا وعراقة إذا تمت على هذا المنحى الإنشائي، ووفق هذا المنهاج الاستزراعي الذي يبدأ نقطيًّا، ثم تتسع حدوده، وتترامى أفضيته ومجالاته؛ إذ إن التأثيلات المدنية حين تتجذر، تكتسب قدرة متصاعدة على التسارع، بحيث تخرج وتائرها عن وضعية البطء والريث والتراجع التي تدأب عليها في مراحل النشأة، إلى حال من الإقدام والمضاء والسرعة، ما يجعل قيم الأصالة تشع وتكتسح الأرجاء؛ إذ يغدو ضوءها مطلب الإنسانية جمعاء.
إن العراقة تعني اكتساب المجتمع قيم الاستحفاظ، وتطَبُّعَ أفرادِهِ على خُلُق اللباقة، وانطباع أرواحهم بالفاعلية والتوليد الإبداعي المتكاثر.
كل ناشئ في المدرسة المؤهلة تربويًّا وعلميًّا، هو حبة مباركة، تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، وبذلك يقع التراكم، ويزداد الاحتياط المفَرِّش لميلاد مدنية الخير.
المحركات والدوافع
الدافع المادي دافع آني، مُناط بالهدف المنشود والغاية المتوخاة، أي بالكسب والجزاء، فقدرته على التحريك والتجييش ظرفية، عرضة للانطفاء والخمود، فلذا كان من مقتضياته التجديد والتحريض والإشراط، إنه من طبيعة تحفيزية، عينية، ملموسة.
الجزاء المعنوي رهين بالكسب الأدبي، وبالنجاح القيمي، فتحقيق المَثَل الأعلى والمبدأ الأكرم هو القصد والمطلب الذي ترابط من أجله النفوس الأبية.
إن العينية الكسبية غائبة في المجاهدات المعنوية، أو إن هي وجدت، ففي درجة ثانوية لا غيرُ.. من هنا كانت المراهنات المعنوية هي الممحص الحقيقي الذي تتمايز به الإرادات وتتراجح العزائم.
وإن الفرد الذي تحرّكه الدوافع المادية وحدها، يظل مهيأً للفشل والخور، ما إن يعترض طريقه إلى المكسب المادي عارض قهري، أو أن يستغني ويجد البديل، عكس مَنْ تحرّكه الدوافع الروحية، فهذا لا يتردد في مهْر غايته الأسنى بروحه، وافتدائها بمهجته؛ ذلك لأن حياته تستمد قيمتها من قيمة المُثُل التي يعظّمها، فلما كان تعظيمه لمُثُلٍ أسمى من المادة وأغلى من المتاع، كانت حياته -الأثمن ما يملك- هي الرصيد الذي لا يتردد في بذله لأجل صيانة تلك المُثُل.
بحياة المبادئ تحيا الروح، وإن استشهاد الفرد في سبيل مبادئه يُعد حياة له وخلودًا، أما الذي يعترك لأجل أن يستحصل الغنائم المادية مجردة من بُعدها المثالي، فهذا قيمته من قيمة تلك الغنائم، لا دوام لها ولا استمرار، فهي ذات طبيعة استهلاكية، وكل مستهلك هو عرضي، لا جوهري. وإن معدن الذهب نفسه ليكسد ويتدنى في التسعير؛ لأنه على نفاسته، مادة يعرض لها عامل التخفيض والرفعة، وهو أمر لا يطال الروحيات بتاتًا.
إن هذا الاعتبار النبيل المغروس في وجدان الكائن البشري هو أُسّ وجودي يتلقنه الفرد من الفطرة ومن الحياة ذاتها، ولقد مضت مدنية العصر الراهن -من خلال ما أفرزته من فكر إلحادي غاشم- تنسب كل مظهر أخلاقي ومبدئي إلى غريزة من غرائز القصور في تكوين الإنسان.
لا ريب أن النفس الإنسانية جُبلت على الضعف، لكن الخالق -عز وجل- هيَّأها للتزكية، فجعل المُثل والأخلاق مَناطاتٍ لها، ورافعاتٍ، ومحرّكات تنزع بها إلى الكمال.
ولئن تسفّلت بنا الطبيعة البدائية، وأوقعتنا في ما يجرح الحس السليم، فإن ذلك من آثار النزعة الحيوانية التي تنطوي عليها تركيبة النفس البشرية، ولذا هيَّأ الله الرسالات والرسل لترشيد الناس، وجعل الدين يسوس إلى الحسنى، ولا يُكره أحدًا على اعتناق شرعة تجرح الذوق والحس السليمين، بل إن تعاليم الدين تشحذ مكامن النبل التي تنطوي عليها الفطرة السوية، لكن الحضارة الجاحدة، المتحاملة على الفضيلة وعلى الدين، تمضي في تتفيه القيم وتقزيم الروح، مقابل تمجيد الحس وتعظيم المادة، الأمر الذي ألحق بالغ الضرر بالمقدسات، وآل الأمر إلى أن خَفَت وهج الفضيلة، بل وخبت النعرة التي طالما تأججت في الضمير الإنساني حيال مظاهر امتهان المكارم ودوس المحامد.
محامد أخرى ظهرت وحلت محل الأصلية العتيقة، وازعُها استفحالُ الأنانية والبهيمية وقابلية الاستعباد المادي وما شاكل ذلك من قيم تسترخص النفس وتسوم الكرامة.
لقد بات المحفز المادي وحده -تقريبًا- محرك الإرادات؛ حيث ساد الاعتقاد؛ نتيجة تدهور البيداغوجية المدنية، بأن الصراع المادي -وليس الصراع ضد شيطان المادة- هو قانون التحولات والتطورات، الأمر الذي تراجعت به مساحة الاحتساب، فالضمير بات أصمَّ، مشروطًا بالأرقام والأحجام والنسب الأجرية المنتزعة في معركة الغش والعيش.
لهذا وغيره يرى كولن وجوب التصدي لهذا الانجراف الأرعن الذي توشك الحياة أن تنقلب به، وتخرج عن نطاقها الطبيعي السليم.
أسس الرؤية الحضارية لدى كولن
وإن من أهم ما يؤسس عليه كولن رؤيته الحضارية: بعث روح الدين الحق، وتعويم القطاعات المدنية بقيم الروح، تخليصًا لما علق بالحياة المعاصرة من خبائث وأدران.
وإذا كانت الأسطورة هي من أبرز مقومات الوجدان الثقافي الأوروبي (الغربي) ومحددًا بارزًا في هويته الأدبية، يسترفدها من تراثه الإغريقي الروماني، ولا يزال يوظّفها في معارفه، ويرسي عليها أسس فكره، فلا ريب أن الدين هو جوهر الهوية الإسلامية؛ إذ استطاع هذا الدين بألماسية محامده وكلية مقاصده، أن يستوعب ما في متَجَذِّرات وجدان الأقوام والأمم التي انبلج عليها فجر الإسلام، أو التي انتهى إليها نوره بعد ذلك، فجَبَّ منها ما متَّ للشرك بصلة، وسدَّد المقومات الكريمة، وجعلها تندمج في أسس كبرى لهويته الجامعة التي يشترك في حمل خصائصها المسلمون كافة. من هنا أضحى الإسلام بفضل ما انبنى عليه من فرائض وعبادات، أكبر محركات العاطفة والشعور والوجدان في نفسية المسلم، وأقوى البواعث على الفعل والبناء. فـ”العبادات موجّه أساس حاضر في كل الأحوال”.
أهمية الدين أنه طاقة دائمة، وحافزية متجددة لا تسقط في الابتذال بتاتًا، عكس ما سواه من الحافزيات كما أسلفنا. فقابلية انبعاث الدين من رماد الردة أمر واقع، ولا مراء فيه، من هنا كان الدين يمثل أكبر مُقَدَّرات التجييش، وأنفس ذخائر التحشيد التي يمكن أن يرصدها الإنسان للرهانات الكبرى، والتحديات المصيرية.
تشبُّ الثوراتُ والوازع يحدو أصحابها العُزّل إلى التيقن من كسب النصر، مع أنهم لا يملكون من شروط المرابطة إلا الإيمان؛ ذلك لأن الإيمان ظل يعتبر في كل عصر، السلاح الذي لا يضاهيه سلاح في خوض المعارك، وحسم المنازلات.
والدين الإسلامي بما هو مكوِّن تعبدي وسلوكي يومي، بات هو مَحْضن القيم، ومستزرعها، والنسيج العضوي الذي تنمو فيه، وتتشكل، وتأخذ صورها وألوانها.
فالثقافة في المجتمعات الإسلامية مرتبطة عضويًّا بالدين، ولا تكاد تغيب نواة الدين الإسلامي حتى في سلوك الفرد الملحد؛ لأن الوازع الديني فطرة في الإنسان عامة، لا يستطيع التجرد منها، ولأن الختم الذي يتركه الإسلام على من يظلهم ويمسّهم، لا يكاد يَمَّحي مهْما سعى الإنسان إلى استئصاله من أعماقه.
وشخصية الفرد والجماعة إنما تقولبها الثقافة، باعتبار أن الثقافة هي الأرضية الأرحب التي تصب فيها منجزات التعليم، والفضاء الأوسع الذي تؤثثه مكاسب التربية، فلذا تتأهل الثقافة المستصلحة وتتأهب لتجنيد الأجيال، شريطة أن يُشحذ مكونُها الروحي، ويُجَلَّى مقومُها القدسي.
ولا ينبغي أن نُفَعِّل الدين ونعتبره مجرد وسيلة ووسيطًا يوصلنا إلى أهداف بعينها، ثم نتخلى عنه؛ إذ العلاقة بالدين تكون عندئذ واهنة، وغير صميمة، ومغرضة، وانتهازية، ومنافقة.
إن مثل هذه العلاقة تصطنعها الأيديولوجيات، وتسوس بها الجموع، وتغافلهم، ثم لا تلبث ساعة الحقيقية أن تحين، فتتهاوى صروح الدجل أمام الأنظار، وتترنح أحلام الافتئات.
تَكتنز الثقافة وتتفتح في مواسم اشتحان القلوب بالإيمان، فالفرد الصادق في إيمانه، والجماعة المخلصة لعقيدتها، والمجتمع الذي تترجح فيه كفة الخيرين (والرجاحة تكون دائمًا نوعية)، تغدو ثقافته مصطبغة بصبغة العقيدة؛ لأن الصدر العامر بالتقوى، يفيض محبة واستقامة، ويزخر دينامية وسباقًا إلى الخيرات؛ ذلك لأن الثقافة هي البلازما التي تستوي فيها خلايا الإيمان، وإن القيم الثقافية تستمد من العقيدة طاقتها، فتضعف بضعفها، وتقوى بقوتها؛ من هنا كانت الدعوات الإصلاحية وهي تركز، على استحياء، قيم الدين في نفوس الأفراد والجماعات، إنما تتوخى خلق مجال ثقافي تتعزز به دافعية الخير التي يستهدفها الدين، ويحرص على تركيزها في المجتمع. “إن الثقافة بألوانها المختلفة -في المجتمع المستصلح- تحوم وتدور في محيط العقيدة، وتنهل من مناهلها، وتتغذى بغذائها، وتنمو بها، ثم تتحول بفضلها إلى حال فوق الزمان والمكان”.
بالباعث الثقافي حشدت الماوية (الصينية) الحشود، وساقتهم إلى الجبال الشاهقات والهضاب الفاخمات، فنضّدوها بأظافرهم، ومهّدوها بأناملهم، وبمثل ذلك أقحمت الهتليرية الأمم في الحروب، وخاضت الشيوعية معامع من دم وتضليل، وحسبت أنها تَنْفذ بالإنسان عبْر بوابة الأيديولوجية إلى الفردوس الأرضي، لكن ثقافة الحشر تلك، كانت ثقافة تدويخ وقتية، لا يمكنها أن تتجدد بنفس الاستماتة؛ لأن مرجعيتها هو الاجتهاد البشري الذي لا مجال للثبات عليه؛ لأن الأجيال تتبدل، والفكر يتجدد، والأطوار تتعاقب، ويتجاوز بعضها بعضًا، إلا الدين، فإن جوهره مهيأٌ أبدًا لخلق ذات الشروط التجنيدية التي تستمد عصاميتها من المُثل العليا، من الخالق ذي الجلال.
ومن المؤكد أن الأيديولوجيات جميعًا تتذرع بمنطق أخلاقي صوري إلى مقاصدها، فهي تغلّف أهدافها بغلاف سفسطائي خادع، بحيث توهم من لا يكون بصيرًا بدهائها، وتوقعه في المغالطة.
مركزية الدين في الإصلاح
هكذا إذن تَتبدَّى لنا مركزية الدين، بوصفه أهم فاعليات التحريك الاجتماعي والإنساني، وأقوى ديناميات التحشيد الجماهيري، وأمكن عوامل نشر الأخلاق والتمدن؛ إذ الأفراد، وكذا الجماعات، تجد نفسها حيال تعليمات الدين سواسية، تتقاسم نفس التكاليف، وتتوقع نفس الجزاءات الغيبية، الأمر الذي يجعلها تقف على بُعد واحد من الخالق عز وجل، وتدرك أن الإلزامات المشتركة التي تنهض بها ليست من إملاءات أحد، فهي تعاليم متعالية عن الاجتهاد الإنساني، وأن المسار الذي تسلكه (الجماعات) ليس من رسم أحد، حتى نداءات الدعاة والمصلحين إنما هي في حقيقتها تذكير بما قررته العقيدة، وتنبيه إلى ما يفوت الناس من خير وبركة ببعدهم عن الشريعة.
وبتشغيل محرك الدين في النفوس، يتأتى تأصيل ثقافة اجتماعية يفرزها السلوك الاجتماعي المنضبط والمتطابق -بالقدر الأوفى- مع الشرع، وبذلك يتأتى للمجتمع أن يسترجع حيويته الوجدانية واتزانه المزاجي برجوعه إلى جو الدين، واستظلاله بمناخ اجتماعي يعيده إلى ثقافته الأصلية، بحيث يغدو مرأى الفساد يؤذيه، ومشهد التحلل والتهتك والإخلال بالقاعدة الشرعية والأخلاقية يسوؤه.
بل إن من شأن التأصيل الثقافي المطلوب، أن يكفل للمجتمع الوقاية الذاتية من المخاطر الهدامة والمعتقدات الغريبة، ويتم ذلك من خلال تدريب الروح الاجتماعي وتقوية حساسيتها وقدرتها على القيام برد الفعل المناسب، حيال كل اختراق أو اندساس يشوش على منظومة القيم، أو يحاول أن يَعْدِلَ بها عن مسارها وطبيعتها.
فتنمية دينامية الممانعة الإيجابية في صيغ الثقافة الأصلية، يجعلها أقدر على التبادل والتحاور، وأكثر صلابة في مجال التمرسات السجالية.
ودائرة الاستصلاح التي تسفر عنها الجهود بعد عقود من الجهاد والبلاء الحميد الذي يتجشمه الأفذاذ المصلحون، لا تكون -غالبًا- إلا محدودة النطاق، لكنها على محدوديتها تمتلك تلك الجاذبية الأصيلة التي تستمدها الظواهر النورانية من قدسية المبادئ التي تتقمصها، وهو ما يجعل تلك الدائرة مهيأة للتوسع، يعطيها نبل شعاراتها وتسامي سلوكياتها رجاحة في التأثير، وقدرة على التوجيه؛ إذ تغدو الأوساط المستصلحة بمثابة المنائر التي تشدّ إليها الأنظار.
بالدين الحنيف نضمن للحضارة أن ترسو على روحية مطهرة، وبالثقافة المؤخْلقة على الخُلق، نسدد نحو بعث الوجدان المبرأ من لوثات التردي المادي والمعنوي.
فالثقافة حين تنبع من صلب العقيدة، تهيئ للمجتمع أن يتداوى من اعتلالاته المعنوية على نحو شبه ذاتي، فمن شأن المجتمع والأوساط المستنيرة أن تُهيئ المناخ الثقافي الذي يستوعب الانحرافات ويكيّف التشوهات.
إن الفرق بين التحصين المدني كما يدعو إليه كولن، وبين الإطلاقية التي تنادي بها الفلسفة الليبرالية، هو أن كولن يسير بالعملية الاجتماعية مسارًا بيداغوجيا، بمقتضاه يتوجب على المجتمع أن يكوّن الأسباب التي تجعل مظاهر الانحراف ومفرخات الأمراض تنحسر ذاتيًّا، وذلك حين تتوفق الجماعات إلى أن تجعل أوساط الانحراف -ربما تحت تأثير علاقة المحيط المقرب منها، ورد فعله السلبي تجاهها- تستشعر بنفسها فسادها، واعوجاج الطريق الذي تسير فيه، فتتراجع أو تعيش وهي على وعْي بما تتسبب فيه من أذى للمجتمع، ومِن تعدٍّ على معتقداته.
ومن المؤكد أن الحياة لا تخلو من قذى، رغم تعمق مساعي الإصلاح، فالحياة المستصلَحة أشبه بالجسد السليم، يظل مع كمال عافيته يرشح بنفاياته ويفرز مستقذراته، وهي حال من طبيعة الحياة ذاتها، فالشر لا ينتفي من الحياة، لكنه لا ينبغي أن يكون القاعدة.
الليبرالية فتحت السبل في وجه مستقبل بشري متهمج، يغدو فيه الشذوذ هو القاعدة، والاستقامة هي الخرق، ومنعت الإنسان من أن يعرب عن مشاعره حيال التشوهات، بل وحتّمت عليه أن يباركها، وإلا صُنّف رجوعيا، وأصوليًّا، وأركاييك.
وإلى جانب المحرك الديني والمحرك الثقافي، يتوجب دمج عامل الوعي بالتاريخ في الفعل الإحيائي؛ إذ بمعرفة المجتمع لماضيه، وبوقوف الناشئة على المراحل والعهود التي سلختها الأمة من هذا الماضي، وما اتسمت به هذه العهود من قوة وضعف، والمكاسب التي ظفرت بها السلالة، وعلل الانتصار والانهزام في مسيرتها، ستتمكن من وضع اليد على سند توجيهي حاسم، يقيها العثرات.
بل إن كولن وهو ينوّه بما لمعرفة التاريخ من فوائد تجنيها الأجيال، لا يفتأ يمتد بالبصر إلى مراحل ما قبل الإسلام، مذكِّرًا بما كانت عليه السلالة التركية من بدائية وضآلة وانعدام شأن في مضمار التحضر والتمدن. فكولن يدرك أن قراءة التاريخ في كُليته، يعطي الأجيال الصورة بكامل أبعادها، فيتهيأ لها حينئذ أن تعرف مكاسبها التي لا تُحَدّ من جراء انتمائها إلى الإسلام.
لقد هيّأ الإسلام الأمة التركية أن تكون أستاذة الدنيا لقرون من الزمن، بعدما كانت قبائل ينحصر همها في تتبع المراعي والتنازع على الكلأ. وكان الإسلام قد فَعَلَ مثل ذلك بالعرب والبربر ومن إليهم؛ إذ أخرجهم من الخمول، وبوَّأهم منزلة الريادة في العالم، لقرون من الزمن.
فالتاريخ -بحسب كولن- هو من أهم محركات التفعيل الاجتماعي والثقافي والقيمي التي لا مناصَ من استثمارها على الوجه الأفضل؛ تأهيلاً للأمة كي تشقّ طريقها، وتُعدِّل من مسارها التغريبي البئيس.
إن صورة الهوية الجماعية تتجلى في ملامح الماضي، وتنعكس بكل ما تحمل من سيما الحسن أو الشوه في مرآة التاريخ. ثم إن الرابطة بين الدين الإسلامي وبين التاريخ رابطة تلازم وتناسب؛ إذ جلّ الأمم التي اندمجت في الإسلام وجدت نفسها تزهد في ماضيها ما قبل الإسلام؛ لأنها لم تتأهل لكتابة التاريخ بالحرف المذهّب إلا حين انخرطت في فيالق الإسلام. حتى الأمم ذات العراقة ترى مطاعن السذاجة والاعتقاد الفاسد والشذوذ المخزي تتلبس ما كان لها من مدنية قبل أن تشرق عليها شمس الإسلام.
من هنا كان درس التاريخ في صدارة المعارف التي ينبغي أن تتلقنها الأجيال؛ إذ إن أضاليل التغريبيين تعول في التسويغ لمنهج الانحراف الذي تسلكه، على طمس التاريخ، ومصادرة الذاكرة الجماعية، وتشويه الحقائق، والعمل بلا هوادة على قطع الشعب عن جذوره، وجعله يعيش يتيمًا من غير ماضٍ، كل ذلك من أجل أن يسهل عليهم ربطه -ذيلاً- بجسد مدنية وحضارة الآخر.
الهياكل والقيادات
لإنجاح المشاريع، أيًّا كان طابعها، لا بد من وجود القيادة التي تباشر الإشراف على إدارة تلك المشاريع، ومتابعة مراحل التنفيذ؛ ذلك لأن التقدم في العمل، وضمان الدقة في الإنجاز، يقتضي العين الساهرة، والعقل اليقظ، واليد الصناع، والتدبير الحكيم القادر على إيجاد الأرصدة الوفيرة لتغطية أي مصروف تستلزمه الخطة ويكتمل به البنيان.
ومعلوم أن البرامج الإنجازية تتولاها فرق من العمَلة التي تستوجب بدورها مسيرين وخبراء وأيدي عاملة يلازمون العمل وينخرطون فيه، حتى يبلغ كماله.
ولما كانت إدارة المشاريع، فضلاً عن التخطيط لها، أمرًا حاسمًا ودقيقًا، يتوقف عليه مصير تلك المشاريع ذاتها، كان إشكال الهيكلة من أبرز ما شدد عليه كولن، وكرر التوصيات بشأنه، بل لا نحسبه أغفل الحديث عن الهيكلة في سائر ما كتب؛ ذلك لأنه نظر إلى مسألة التأطير والتسيير ليس فقط على أنها نشاط تقني وأدائي يتم بالكيفيات الاعتيادية التي تتأدى بها الأعمال العادية، أي ببذل الجهد الذي يقتضيه التخطيط، أو الذي تُمليه توجيهات الخبرة، وحسب، بل لقد نظر إليها على أنها من صميم الجهد الروحي والتعبدي الذي يجعل الأعمال تتم في أكمل ما يكون الكمال، باعتبار أن العمل ليس واجبًا ينهيه الإنسان وكفى، بل هو قُربة يتقرب بها العبد إلى ربه، وتزكية يترقى به الشعور، ويكتسب مزيدًا من معاني الاحتساب والسمو، فكل إنجاز هو خطوة على سلم العروج، وبذلك يضحى الأداء إنجازًا يسلك صاحبه في دائرة أهل التميز، فهو فنان دافق الحس، رهيف اللمسة، وهو صوفي روحاني الذوق، نوراني اللقطة.
في حياة المؤمن المحتسب هامشٌ ميمون من عشق وعذوبة، يجعل كل أمر ينجزه، يخرج من يديه وهو في صورة تحمل طابع التميز والمخصوصية التي هي -في الحقيقة- صدًى ملموس لذلك العشق، وأثر مرسوم لتلك العذوبة التي تتوفر لروحه، الأمر الذي يُضفي التفوق والملاحة والمقبولية على كل ما يفعله المؤمن، حتى كوب الماء؛ إذا ناولك إياه، روَّاك وأمْرَاك.
لا ريب أن مما ساعد الأستاذ كولن على رسم المقاييس الوافية، والمعايير الفعّالة التي تأخذها شخصية الإطار المسؤول القائم على تنفيذ الخطط والمشاريع – سيرةُ حياته هو بالذات؛ ذلك لأنه شبَّ وتدرج في أطوار العمر مديرًا لحياته التي خرجت في كلياتها وتفاريقها عن النموذج الحياتي العادي.
نشأة كولن وتأثيرها
نشأ كولن يلاحق مراكز التكوين والتعليم التي لم تكن متوفرة لمن في وضعيته، يتحول من أفق إلى أفق، تحدوه الاستزادة في التحصيل، فعاش مستنفرًّا، يقظًا، تقتضيه حياة الوحدة والعصامية أن يكون مستجمعًا لتركيزه الذهني والتدبيري، ما يسيطر به على شؤونه الخاصة والعامة، بحيث لا يفوته من واجباته شيء. فهو يدرك -أو كان عليه أن يدرك في كل لحظة-أن حياة الانفراد والتطلع، تحتم عليه أن يمتد أبدًا من نطاق اليقظة إلى سائر محيط علاقاته؛ ضمانًا لمضي المسيرة، فقد كانت قاطرة المراحل تتقدم به، يسلمه بعضها إلى بعضها، فلا يزيده ذلك السفر في البلاد، إلا اغتناء في التجربة، وفاعلية في التصميم، وقدرة على النفاذ في خفايا الحياة والإنسان والمجهول.
من مسيرة حياته، ومن تراكم مرصود تجاربه، وما تأصل له من استنارة روحية وجِلاء فكري، استمد كولن مقاييس القيادة، واستلهم مواصفات الهيكلة والتأطير.
باشر في مطلع شبابه إدارة ملتقيات الفتوة، وتسيير المخيمات المدرسية، يكتتب لها الميزانيات عن طريق التبرع والإحسان، ويوفر لها العدة ووسائل الإيواء والنقل، والتموين والتطبيب، والتنشيط وسائر ما تتطلبه حياة البناء المركز من ضمانات السلامة والبهجة والمردودية التكوينية، ما يجعل منها أفقًا تكوينيًّا مفتوحًا على الحياة، ومعززًا لأسس التنشئة السليمة، فاكتسب بيداغوجية إدارة المال والأعمال، واستحكمت فيه قدرة استئلاف الطوائف من الفتيان والشباب، وبذلك اكتملت لديه خبرة القيادة والسيطرة الحكيمة، وانضافت إلى ما احترفه من رئاسة منبرية كان يمارسها بوصفه إمام مسجد، الأمر الذي جعل الأداء الوظيفي والترشيدي، بل والمقاصد تتباين باطراد مع ما كان نظراؤه يؤدونه في مساجدهم، ويتوخونه في وظائفهم.
ومن المؤكد أن حياة العزوبة التي عاشها كانت من أهم عوامل نبوغه في الترتيب والإدارة.. لقد تعلم من تلك الحياة كيف يدير شؤونه؛ صغيرها وكبيرها، وكيف يرتب الأوليات على نحو احتسابي لا مراء فيه، وحين تُنبئُنا سيرته مثلاً بأنه كان يغتسل لصلاة الفجر في عزّ الشتاء، عندما تتجلد المياه في الأنابيب، فيسكب هو الماء على نفسه في مغسل مفتوح على زمهرير وقَرٍّ تئن لهما الحجارة، فإننا ندرك أي الرجال كان؛ إذ الواجب الديني كان لديه مقدمًا على كل ما عداه، “حفظ الدين قبل حفظ النفس، في حين أن الإسلام يضعهما متلازمين، إلا حين يكون الاستشهاد خادمًا للإيمان”، ولا ريب أن الذي يعيش موصولاً بربه على هذا النحو من التجرد الوطيد، هو إنسان روحاني بامتياز؛ إذ لا ننس أن العزوبة عند أهل الله هي الإعلان الأظهر عن الخيار التبتلي الذي لا مجال فيه لِلُبْس أو استرابة، وأن من يختارها نهجًا في الحياة يكون في وضع مثالي، من حيث التأهب للعمل الصالح، والتأهل للسعي والاحتساب الدائبين.
فالعزوبة التي يلتزمها المبجّلون، لا تعني فحسب، التفرغ للعبادة التي هي مناط وجودهم، ومحور حركتهم وسكونهم، ولكنها تعني أيضًا تجسيد مقاصد الإيمان الأساسية التي هي السير بالناس والمجتمعات نحو البِرّ، وإرشادهم إلى الخدمات والأداءات والتثميرات التي تعزز في الإنسان خيريته، وتجعله يمضي قدمًا على طريق تحصيل رضا الله.
أثر التخلية والعزوبة في كولن
من تمام الإخلاص أن يكون قلبك مشرعًا لعشق فريد لا يساهمك فيه مساهم، إن عزوبة الصالحين تندرج ضمن منهج التخلية الذي ينهجونه قاعدة للتعبئة والانطلاق.
ومن بركات هذه التخلية أنها تتيح للسالك أن يوسّع من أفق تأمله الروحي، فيشمل الحياة وأحوال الناس؛ إذ الخلوة توطّنهم على تعزيز روح القدوة، والسير على منهاج الأنبياء وفي طليعتهم النبي r، فيكون من جملة ما يستحصلونه من ذلك السبيل، الرحمة والشفقة والحدب على عباد الله وعلى مخلوقاته طرًّا، الأمر الذي يجعل السعي الصريح، والاعتراك الفعلي لفائدة الإنسانية ولرفعتها الروحية والمادية، من مرتكزات العمل الاحتسابي الذي يتقربون به إلى الله، وبذلك تغدو الخلوة لا تعني العزلة والتحصن في معتكف يبعدنا عن الناس والحوادث، بل تضحى الخلوة حالاً رهانية لا يفتأ فيها القلب يُشتَحَنُ بأذكار وأوراد وتسبيحات تتنزل في عين الواقع في صورة منجزات تثقيفية، ومكتسبات تعليمية وتجهيزية؛ تنهض بمستوى روحية المجتمع، وتغيّر من أوضاعهم العقدية والنفسية والاجتماعية، وتجعل منهم عبادًا يتمازج في سلوكهم أداء الواجب مع محبة الله، فتنسجم من ثمة رؤيتهم إلى الدنيا والآخرة، فتشملهم سكينة السلام، ويطيب لهم أن يستغرقهم الحمد والشكر في سائر ما يتعاطون من عمل وكدح.
تُرى، والحالُ هاته، كيف لا ينبغ في الإدارة والتنظيم والتأطير مَن كان رسول الله r قدوته ومرشده وملهمه؟!
بل إن العزوبة هي اعتكاف وتبتل مستمر في الزمان والمكان؛ إذ حيثما كان العبد المعتكف، سواء ألبث في مصلاه في ركن البيت، أم سار في الأسواق يسعى وراء هدف يصلح به أحوال الناس، فإنه في الحالين يعيش على صلة بربه. فهو في حضرته باستمرار، قد تدرب على أن يعيش بشطرٍ من وعيه الحياتي مع الناس، وأن يخصَّ ربه بالشطر الأكبر من شعوره ومن وارداته.. وحتى حين يعروه أحيانًا السهو، فإنه يستنكر من نفسه تلك الانفكاكة، ويعمل على استدراك تلك الخسارة. فعدَّاد الرقابة الذاتية يعمل دائمًا، وبذلك ينعم الصالحون بمِنَّة البركة في كل ما يطلبون، ولأنهم يطمحون إلى ما طمح إليه معلموهم ومن يتخذونهم منائر الاسترشاد والقدوة، نقصد الأنبياء والرسل عليهم السلام، فإنهم لذلك يستشعرون أن الوقت يمر بهم مر السحاب، فلذا تجدهم متوترين، يتمنون لو أنهم ملكوا الأمر لجنَّحوا في الآفاق، وسابقوا المواقيت، واستنجزوا كل ما يحلمون باستنجازه.
المصلحون والاحتراق الذاتي الدائم
فعلى الرغم من يقينهم بأن البركة هي بعض ما منَّ الله به عليهم، إلا أنهم يجدون ما تضمنته رزنامة التغيير والبناء التي يراهنون عليها، أكبر مما تسعفهم به الحياة، ويتيحه لهم العمر من طاقة ووقت.. لذلك تراهم يعيشون الاحتراق الذاتي الدائم، تنوء كواهلهم بأحمال كالجبال الراسيات، يستغرقهم عمل دائب لا ينقطع، هو تسبيح صميم، ويستنفدهم استغراق عميق في البرازخ، هو عين العمل والكد، يمضون دائبين على الحداء وتجنيد ذوي العزائم، مشددين على إيجاد المدود التي يطمئنون بها على مواصلة ما دشّنوه من طرق العمل والبناء؛ إذ يعتبرون أن الدأب على فعل الخيرات هو أوكد الواجبات التي يعيش لأجلها المؤمن، فالحياة بالقياس إليهم هي مزرعة الآخرة، وأهل الحظ هم الذين يدركون أن الحياة الحق هي دار القرار، إنما الدنيا هي للكدح والتعمير، لذلك جعلوا شعارهم نحن لا نحيا لنعيش، بل نعيش لنحيا.
من حياة التفرد والقنوت استمد كولن مدودًا من التفتيقات الروحية والفكرية عزّزت لديه ما امتلك- بالفطرةً- من قابليات الفطنة والذكاء والتفوق، فلذلك تهيأ لإدارة مشاريع، حجمُها حجم نهضة تراهن على قلب الأوضاع وتجهيز الأرضية للانطلاق الذي لا رجعة فيه.
انظر كيف يَسْتَضْئِلُ خرائط لا تني تتوسع وتمتد عبر القارات، تتمثل في منظومة من المنجزات والمشاريع الإنهاضية، تستنفر الآلاف المؤلفة من العاملين في مختلف الدرجات، والمساهمين في شتى المستويات، والمستفيدين في مختلف المجالات، وهي لا تفتأ يومًا بعد يوم، تثير الدهش والإعجاب والإكبار بتنامي وتائرها، والأبعاد والطرز والمعايير التي تميزها.
من مداومة التوحد يكتسب المفكر إمكانات نفاد ضافية، يستمدها من استقرائه الدائم لسير الرموز والفرديّات. وإن توطين النفس على مساكنة الأزمنة النيرة والعهود الخَيِّرة، وفي مقدمتها عهد البعثة المشرق، وما حققته السيرة المحمدية في مضمار تصنيع الروح، وقلب الأوضاع، والانعطاف بالتاريخ من اتجاه إلى اتجاه معاكس، في أقل من عشريتين، ثم ما أنجزه الراشدون في بحر عِقد من الزمن، نضدوا خلاله الأرض، وساسوا إمبراطوريتي البغي والطغيان (فارس والروم)، وبسطوا الجناح على مركز الأرض، واستظلوا أممها تحت راية الإسلام.. إن توطين النفس على التأمل في كل ذلك، وفهم أسراره وقوانينه، لهو أعظم غُنْم وأثمن كسب يمكن أن يستحصله الدارس والمستقرئ والمتفحص من صفحات ذلك الماضي الذي أسّس لميلاد حضارة الإسلام، ووفّر لها تلك الاندفاعة التي استرسلت قرونًا، لوّنت خلالها الدنيا بألوان الإسلام الزاهية.
فبصيرة المتبصر تزداد جِلاء باسترفاد تجارب التاريخ ومواعظ الشريعة؛ لأنها ستستوعب في متنها أرصدة ذهبية من العبر والتسديدات التي تساعدها على الفوز.
ثم إن القائد يجد في الانخراط في مهام البناء، وما يقتضيه ذلك من اضطلاعه بأعباء القيادة، مجالاً آخر لمدود أخرى من التوفيقات والخبرة، يستخلصها من التحامه بالواقع، واشتباكه مع التحديات، وبذلك تغتني رؤيته، وتكتسب المرونة والواقعية؛ لأنها تراهن على النفاذ والفاعلية تحديدًا، ولا استعداد لها أن تخطئ في الرمية؛ لأن من يجعل هدفه الأسمى هو تحقيق النهضة، وتجاوز العثار المزري بالمكانة، واللحاق بالركب، لا يمكن إلا أن يكون أشد ضنًّا بالوقت والإمكانيات.
العقل الملهم وقادة الفكر
يرى كولن أن النهضة يصنعها العقل الملهم؛ إذ لا بد لكل التحولات النوعية من قائد يترسم لها التصور والخطة والتنفيذ. وأبرز من يجعلهم كولن مصدر إلهام لهذا النمط من قادة الفكر، هم الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد r؛ إذ جاءت بعثته، عالمية، تصنع الإنسان الخالد، وتُرسي المعالم والسبل التي تعزّز من شأنه، وتضمن له أن يظل خليفة لله في الكون.
مواصفات القائد المدشن للنهضة الحضارية مواصفات قلبية بالأساس، استمدادية، تتوسل إلى مقاصدها بالمدد الإلهي الذي تعْلم برسوخ إيمانها، أنه القادر الذي بيده الأمر، ومنه يتلقى العبد رشده وتوفيقاته.
الإيمان هنا، هو عامل إسناد أساسي؛ لأن المؤمن -بما يعمر قلبه من ثقة في ربه- يجد تلك الطاقة الخارقة التي تستشعرها الروح حين تتوطد أواصر اليقين بينها وبين السماء، فهي بانجذابها نحو خالقها، لا تعود تلقى في ما تخوض من عراك، ما نراها عليه من أحوال المكابدة والتمزق والرهق.
لقد ظل أهل العشق يحدثوننا عن انخطاف أرواحهم تحت تأثير جذل التنعم والتبهُّج وهم في صلب الامتحان، يتحولون من شدة إلى شدة، يُسحقون ويُمحقون، وما ذلك إلا لأن الروح ارتاضت لديهم على أن تتعالى عن الآلام؛ لأن القلب في كل الأحوال والظروف، مُخيِّم في الحضرة، منتش بما يَهُبُّ عليه من نسائم الاطمئنان.
رجال الخدمة ودورهم في البناء
ولقد رأينا كولن من جهة أخرى، يُنيط مهمة إنجاز النهضات بقطاعات المتطوعين، أهل الخدمة، أولئك المُسَبَّلون الذين يستمدون القوة والاستماتة من مناخ التضحية الذي يتحركون فيه، ذلك المناخ المشحون بكهرباء الإيمان الذي لا يفتأ ينبعث من أفئدتهم العامرة بالتقوى، ولا ينفك ينتهي إليهم من الخيوط الموصولة مع مصادر التأطير التي ترعاهم بأبوة ومسؤولية. فهؤلاء الخُلَّص هم أيضًا يتقدمون في الأشواط على هدي استنارة قلبية، وحماس روحي متصاعد.
هؤلاء الحواريون الذين أقبلوا على المعركة، حاديهم ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(التَّوْبِة:105)، لهم هم أيضًا حظوظهم من العشق؛ إذ لا يدوم انخراط، ولا تتزايد نتائجه، إلا حين تستحكم رابطة الانتساب الروحي إلى صفّ أهل الخدمة وبذل الجهد، بحيث تضحى مسألة النهضة والمصير، مسألة وجود شخصي، ورهانًا ذاتيًّا تهون لأجله كل التضحيات.
يقول كولن واصفًا رجال الخدمة ودورهم في البناء: “إن انبعاثنا مجددًا بثقافتنا الذاتية يتطلب رجالاً متحفزين للإيمان، ومهندسي فكر سائحين في الغد بأُفقهم الفكري، وعباقرة يحتضنون الوجود والأحداث بأصواتهم الفنية، ويتعرفون بتحسساتهم وتفحصاتهم الدقيقة على آفاق جديدة أبعد من الآفاق التي نحن فيها”.
ويؤكد هذه الصفات التي يرشح لها رجالَ الخدمة، قائلاً: “إن جند الإدراك الذين يؤدون وظائف مثل فتح الآفاق أمام نظامنا الفكري المنغلق، ويشغلون تبلدنا في المحاكمة العقلية المتقادمة، المبتعدة عن السماوية بتدويرها في الفلك القرآني، ولا يغفلون أثناء ذلك عن المناسبة المفعمة بالسر بين الكائنات والإنسان والحياة، ويمثلون نموذجًا للدين يجسد إحياء الأوامر الدينية وتحقيقها بحرص بالغ، إلى جانب مراعاتهم أصلاً مهمًّا من أصول الدوام والتمادي في السبل المسلوكة، وهو التوافق مع آفاق صاحب الشريعة في التيسير والمواءمة والمسامحة؛ حتى تكون سمته فيضان التبشير وترك التنفير، وإنهاء العقم المزمن منذ قرون بتسليم قوة العلم والتفكر لإمرة الإسلام وتفسيره، وتحويل كل مكان مدرسةً كان أو معبدًا، شارعًا أم مسكنًا، إلى مراصد ترصد الحقيقة الكامنة خلف الوجود والحياة والإنسان، وتشغيل منافذ الرؤية المتأملة في اللانهاية، والتي يمتد زمان تعطلها إلى قرون.. وتقديم أجندة حضور الإسلام في مرتبة النظر دومًا وفي وحدات الحياة كلها، وتحكيم الحساسية في قضية السبب والنتيجة حسب مبدأ تناسب العلية، والتصرف الرياضي والعقلاني.. هؤلاء هم من يعينونا في التجدد، ويعلموننا أركان الحضور والوجود الدائم الأبدي”.
لا ريب أن كولن -في هذه النظرة التي قوَّم بها رجال الخدمة- يسدّد نحو أُفق المثالية الذي يفترضه مقامًا لهؤلاء المندفعين في سبيل إحياء الأمة. ومن المؤكد أنه أضفى في هذه التوصيفات التي تعلي من مكانة وشأن أهل الخدمة، خصائص من المقامية والسلوك والافتدائية التي بلغها هو ودرج عليها في حياة العطاء التي يحياها.
بل نراه لا يزال يتطلع إلى ميلاد النوعية الفذّة التي تحسم الرهان. فهو يدرك أن الطلائع التي كتب الله لها أن تنحاز إلى لوائه، سيكون لها الخلف الذي يمضي بالغاية قدمًا، ويتحمل مسؤولة انتزاع الفوز، ويحقق ما تسعد به الأرواح.
“نحن أمة تنتظر وتترقب رجال عزم وإرادة وجهد، يحملون هذه المسؤولية، فلسنا بحاجة إلى حسنات ونُظم فكرية تستجدي من الخارج أو الداخل، بل حاجتنا الماسة إلى أطباء الروح والفكر الذين يحفّزون في شعبنا كله حسّ المسؤولية وشعور القلق والاضطراب.. حكمة حكماء الروح والفكر الذين يمكّنون التعمق في أرواحنا بدلاً عن وعود السعادة المتقلبة إلى زوال ويرفعوننا بحملة واحدة إلى مراتب نرى بها المبدأ والمنتهى معًا وسوية”.
لا مناص لرجل الخدمة من أن يتحلى بسمة العشق؛ إذ لا يسع المنخرط أن يضطلع بأدق المهام وأكثرها بسالة، إلا إذا كان من أهل الروح، ولا يترشح للأدوار الدائمة والمتواصلة وذات العناء المتصاعد، إلا عنيد، يعيش الآخرة في الدنيا.
النهضة لا تستغني عن جهد أحد، فالجدار يُبنى بالأحجار المقولبة، وبأنصافها، وبالقرش والحصى، بل ويُلحَم بالجبس والطين.
إنما يختص بمهام الدقة والحسم وإنجاز الفتوح، المُسَبَّلُون من ذوي الانجذاب العروجي، الذين يتراقصون جذلاً في عز الالتحام، حين يحمى الوطيس. هؤلاء بلغوا رتبة الامّحاء، لا ينافسهم أحد لجبروتهم القلبي، ولا ينافسون أحدًا؛ لانخطافهم إلى ما يرفرف على الرهانات من تجليات الرضا الإلهي.
وإذا كانت خطة الانتقاء للأدوار تضع أهل الإمعان التبتلي في المقدمة، فإنها تتحفظ حيال الذين يُظهرون تدينهم أو المتدينون، فالأنانية غالبًا ما تقعد بهم عن بلوغ عتبة التجرد الذي يتنزه به الفعل من الغرضية. إن ضرر هؤلاء يقارب ضرر اللادينيين، “الصنفان كلاهما لا يوقّر الدين، وكلاهما لا يتسامح في التفكير الحر، وكلاهما منغلق أمام فكرة المشاركة والتقاسم”، وكلاهما حجر عثرة في سبيل تحقيق الانسجام داخل الصفّ.
إستراتيجية قرن العلم بالدين
من أُسس تجديد وعي الأمة تعميم الشعور بالمسؤولية بين كافة أعضاء المجتمع، وإشعارهم عن صدقٍ بأن رهان النهضة، وما يُقام من مشاريع الإقلاع، هو عين التكليف، وفرض العين على كل واحد وواحدة؛ إذ إن ما يجعل الوهن يصيب المشاريع، ويعطلها، ويتركها هملاً، هو عجز أصحابها عن المطاولة والاحتمال. وكل تحول نوعي تتبناه فئة أو قطاع أو حزب، ولا تفتحه في وجه الأمة كافة، بمختلف مستوياتها ومكوناتها، مآله إلى التحجم والتقزم والتراجع.
وإن تنافس القوى في بلاد الغرب يقوم على التنافس في إعلاء الوطن، وصونه، والسير به في طريق التقدم، عكس التصارع السياسي عندنا، المعتمد على نفوذ يستهدف ترسيخ الحكرة، والتسلط، وتأبيد عقلية المافيا.
إن النهضة غاية الأمة بكافة تعداداتها. والمؤكد أن العجز يفتك بالرهانات الكبرى بسهولة حين لا يكون لها الاحتياطات الكافية، ولا يتوفر لها شرط التضافر وتشابك الأيدي.
إن مهمة الطليعة المؤمنة، المتنورة، تفرض عليها حشد الكفاءات والطاقات والمناصرين من سائر الأوساط. وإن مسؤولية تأصيل الحراك، وتمتين قواعده، وجعله غاية الأمة جمعاء، هي مسؤولية النيرين، أهل السبق إلى التدشين النهضوي المنطلق.
“ولا شك أن إنجاز ما تمليه هذه المسؤولية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأبطال يصونون مصير الوطن، ويحمون تاريخ إنساننا ودينه وأعرافه، وتقاليده ومقدساته كلها.. أبطال طافحين بحب العلم، منشدين إلى الإعمار والإنشاء، متدينين أخلص من الخُلَّص، محبين للشعب، ومرابطين أبدًا على أداء واجباتهم بشعور المسؤولية، فبهؤلاء وبجهودهم ستهيمن أفكارنا، ومحصلة هذه المفاهيم والأفكار على حياة شعبنا”.
وإن أخطر ما يتهدد البرامج الجادة، ويتعقبها بالنسف والتعطيل، أن تظهر إلى الناس في صورة مقاصد فئوية لا تهم المجتمع، ولكنها تهم الداعين إليها. حينئذ يقف المجتمع والسواد الأعظم منه، موقف المتفرج، بل ستمتد منه الأيدي للاعتراض والإعاقة والتفليس، إما بدافع التنافس أو للمعارضة المبدئية، أو بإحساس من يريد أن يركب العربة ويقودها هو لا غيره، وفي كل ذلك ما فيه من عوامل الفشل والوهن والاستسلام.
ليست النهضة جدولاً من النتائج، يتفرغ بعدها العاملون إلى المتع وجني الثمار، كلا إن النهضة تحوُّل صميم، يشمل الأفراد والمجتمع عامة، سلوكًا وثقافةً وتطلعات، ويجعل من العمل الصالح مقوم حياة، ومبرر وجود، وشرط أخلاق واجتماع، لا كينونة بدونه، ولا شرف، ولا كرامة.
من هنا كان على الطليعة التي يُكتب لها أن تكون حاملة المشعل، بل والجذوة التي أشعلته، أن تتفانى في توسيع مساحات المشاركة؛ بحيث لا تفرّط في أي جهد تتمكن من استقطابه لتعزيز المسيرة.
والمؤكد أن أفضل أساليب الاستقطاب والتوسع في دوائر العمل، هو السلوك الفردي والجماعي الذي يظهر عليه الرواد. ففي أصالة العطاء، وسماحته، وفي سلوك نكران الذات، خير وسائل الشد والتأثير الذي يتمكن العاملون من خلالها أن يقووا من جانبهم، وأن يعززوا من صفوفهم.
إن خلق ثقافة التجميع والمشاركة والأداء المشترك، والعمل المتقاسم، هو أحد أبرز المقاصد التربوية التي يحرض عليها الأستاذ كولن. فكل المقومات التعبدية والتعاملية التي يقوم عليها الإسلام، تركز على المقصد التجميعي المنتج، وتحرض على المرمى الجماعي المثمر؛ ذلك لأن الإسلام قد أرسى الأسس التي تؤكد مبدأ الجماعة؛ لأنه دين المشاريع، وتجديد النهضات، والتأهيل البناء والإيجابي لخوض التحولات الكبرى؛ لأن سند الأمة المسلمة الأول والأخير في كل هذا وذاك، هو السند الإلهي الذي لا يمتنع عن قدرته شيء.
تلافي الثغرات في المنهج والأداء والإنشاءات
من أوكد ما يلفت إليه الأستاذ كولن ويشرطه لنجاح الخطط النهضوية، أن ترتكز على قاعدة من الانسجام، وألا يخالطها التهلهل الذي يجعل بنية الخطة مخترقة بما يسميه كولن (الثغرات)؛ ذلك لأن الرشادة في التقدير تفترض أن يشتمل كل برنامج أو منشأة أو تأسيس على مقومات حيوية تفي بتلبية الحاجة وتغطية النقص في قطاع حياتي ما، فإذا لم يتوفر البرنامج على هذا البُعد التكاملي، جاءت النتائج المتوخاة منه ناقصة، أو زائدة، أو غير ذات جدوى؛ لأنها -ميدانيًّا- تعجز عن أن تستجيب للمطلب الحاجي أو التجهيزي أو الارتفاقي، فلا يكون لها من ثمة لزوم.
وإن مما يثير الذهول أن نرى مؤسسات التكوين في عالمنا العربي تستنيم لنظم تعليمية بلا هدف، فما زالت المراكز الجامعية، والمعاهد التكوينية، والمدارس العليا تخرّج سنويًّا الآلاف المؤلفة، من غير أن تضع السياسات الوطنية الخطط التي تستوعبهم، ليس فقط من أجل امتصاص البطالة، ولكن لجعل التعليم ينهض بدوره الأول والأخير وهو إنشاء القوى التي تتحول عند تخرجها إلى قوى ينتظرها عالم الشغل، في شتى مفاصل الحياة، فتدور الماكينة بهم وبجهودهم، فتتوسع بهم أرضية التصنيع والتجهيز والزراعة، والبحث الكيماوي والذري والخدماتي، وتنشط حركة الإبداع، وتتقلص باستمرار حاجة المجتمع والأمة إلى الاستيراد، بل وتدخل عالم المنافسة، وتقتطع لها في الأسواق الدولية مساحات لصادراتها من المصنوعات والمنتجات.
لا زالت الجامعات العربية والإسلامية، تُكَوِّن الميكانيكيين، ولا تزال بلداننا تستورد العتاد والسيارات، وحتى المفكات والمسامير.. وما ذلك إلا لأن الخطة التمدْرسيّة بالمدارس وُضعت بشكل ساذج، بحيث يضحى دور مؤسساتنا في التكوين هو تهييء دفعات الشباب المكون، وترشيحهم للهجرة الجبرية، وإفادة الآخر بما نتكبد فيه باهظ الأثمان؛ لأن التخطيط القومي والوطني لم يضع في حسابه ابتكار شبكات المؤسسات التي تصنِّع المجتمع، وتحوله من مستورد لكل شيء، إلى مكتفٍ، وإلى مُصدِّر.
هكذا تستمر أوطاننا في هدر الأموال الباهظة بلا كبير طائل؛ لأن التخطيط عشوائي، لا مهندس له يرشِّدُه، ولا عقل يسدده ويضعه على سكة النجاعة الحق.
من جهة أخرى نرى كولن يشدد على وجوب توفير عامل الانسجام وتفادي الثغرات على مستوى التنفيذ والانضباط؛ إذ يرى أن البناء النهضوي يقتضي الجماعية، فالمشروع التنموي، وإن شجّع وعزّز المبادرات الفردية، ودعم أصحابها، بل وبحث عنهم وتبناهم، إلا أنه يحرص على أن يدرج المبادرات الفردية ضمن نسيج الخطة، بحيث لا تبدو عشوائية، أو زائدة عن منظومة الوحدات، أو معارضة لما تتوخاه الخطة.. فبذلك التصفيف الإدماجي الذي تخضع له الجهود الفردية، والمبادرات الأحدية، تضمن برامج النهضة شرط الانتظام، فيغدو النماء شاملاً، ومتكاملاً، وتغدو إمكانات التوسع العضوي، أو المتوازي، أو المتلاحق، أمرًا ممكنًا، بل ولازمًا؛ إمضاء لمشاريع النهضة في الاتجاه الشمولي المتكامل.
“إن الهمم والمبادرات الفردية إن لم تنضبط بالتحرك الجماعي، ولم تنظم تنظيمًا حسنًا، فستؤدي إلى تصادم بين الأفراد -وبين فقرات البناء وفروع التأسيس-.. وبالتالي سيختل النظام”.
فمن شأن جدولة العمل، وتقسيم الوظائف، وتوزيع المأموريات، أن يحدث الدينامية التي تهيئ مزيدًا من الفرص، وتفتح مزيدًا من الآفاق في وجه الخدمة والتثمير.
إن مبدأ الالتزام بشرط الانتظام والانسجام في برامج التنمية ومكوناتها، بقدر ما يشدد على أهمية التنسيق في ما بين الفروع والوحدات، لأجل السير بها في طريق التوسع المتكامل والتكاثر المتناسل، يشدد أيضًا على أهمية ترصُّد الكفاءات المتفرّدة، وإيجاد الموقع المناسب لها؛ لتقوية الدفع. فمن الجهد المتفرق تنشأ القوة الفاعلة، شريطة أن يتم تنظيمها في نسق وسياق، “ينبغي أن لا تطفأ جذوة الطاقات الفردية بتاتًا، باحتساب ضررٍ قد تسببه، بل على العكس تجب العناية الرفيعة حتى لا تهدر ذرة واحدة من تلك الطاقة، وتوجّه نحو تحقيق الهدف المنشود”.
ولا يستتب النظام والتخطيط والانضباط، إلا في جو سمح، يكتنف علاقة الجماعات والفئات القائمة بالخدمة. وكل خلل في الروابط -حتمًا- يسري معه الخلل إلى المشاريع، فيؤذيها ويضرّ بها.
وإن كولن الذي عاش بروحية الحلقة، فهو حتى حين يتفرد وتغيبه الوحدة، يكون في حقيقة الأمر يعيش وسط أخلاء يستحضرهم في قلبه، وينادمهم.. ذاك هو شأن المتبتلين ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾(الْمُزَّمِّل:8)، فلذا هو يرى أن للجماعة بركة تستمدها من رابطة المصافاة في ما بينها، ومن التآخي، ومن الطاعة التي يرى فيها كل فرد من المجموع فضل الآخرين عليه، وأنه لا شيء بوحدته، لولا ما ينعكس عليه من إخوته العاملين معه.
إن مراعاة واجب الانضباط، وتحقيق الطواعية، واستنزال التوفيقات بدعاء الجماعة، و(العمل الخيري أفضل الأدعية وأبرها وأحظاها بالإجابة الإلهية)، والحذر من تعاكس الإرادات، وتصادم الرؤى، وظهور الأنانية لدى المؤطِّرين، هي بعض وصايا مدونة السلوك التي وضعها كولن للعاملين؛ إذ لا ينبغي لرجل الخدمة -وهو في غمرة الأداء والبذل- أن ينسى أنه يسير على هدي أهل الشوق والعشق، فالتجرد يكون من أخص صفاته، وإلا يكون مجرد متربص، ومتدرب، وعليه أن يبذل الجهد الخالص ليرقى إلى العتبة، حتى تنفتح عيناه على النور الوهاج. كما أن الاستعداد بالفطنة، والإسراع إلى استيعاب كل مدد مفيد مما يعرض المجموع، أمرٌ من صميم واجبات العاملين.
ففي ما تقدمه المدنية الراهنة من أفكار ووسائل في مضامير البناء والتسيير والسيطرة على الإنجاز، هو من المكاسب التي ينبغي أن تُنتَقى وتُدمَج في المنهاج، شريطة أن يُعمل على تأصيلها وتكييفها مع روح الخدمة.
إن من شأن اليقظة والتفطن أن يستبقيا باب الاجتهاد والتحسين مفتوحًا، وإمكانات الترقي في الإنجاز متضافرة. الأمر الذي يجعل الخدمة مسارًا يستقطب الأجيال، يلتحقون بها من مختلف الاختصاصات والاستعدادات، يضيفون إليها أدوارًا بعد أدوار، ويمضون بها قُدُمًا. فالنهضة استرسال وصعود في المدنية والأخلاق، والتاريخ حلقات يتنافس الأجيال في كتابتها بما يبذلون من أعمارهم وأعمالهم.
على أن يكون الحرص الحريص في كل ذلك، هو أن يجعل العاملون من قاعدة الإيمان بالله مقياسًا أوحد للنجاح في كل شأن ينجزونه أو هدف يراهنون عليه.