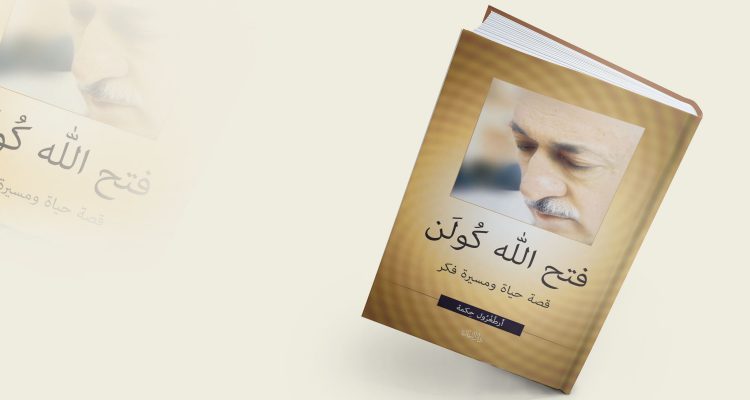انتقلت عائلة الأستاذ فتح الله إلى مركز “باسِينْلَر” (“حَسَن قَلْعه” سابقًا)، ثم إلى قريةٍ بين باسِينْلَر وأرضروم تُدْعَى “قُورُوجُق”، ومنذ أنْ حلَّ جدّه الأعلى خليل أغا بهذه المنطقة كانت تراوده أحلام العودة إلى أخلاط، بيد أنّ العائلة لم تستطع أن تعود، فاستقرّ بها المقام في قرية قُورُوجُق حتى غدا أكثر أهلها منها.
الإنسان في علم النفس الحديث إن هو إلا نِتَاج البيئة والوراثة؛ وهذه الفكرة وإن كنَّا لا نسلِّمها بإطلاقها، إلا أنّ تأكيده على البيئة التى يتربّى فيها الفرد له أهميّته، فمن يسبر حياة الأستاذ فتح الله يتبيّن له أن بيئة أسرته التي تربّى فيها كان لها بالغ الأثر في شخصيته، وأنَّها أساس في تكوين أهمّ خصال حياته “الفكر والحركة والدّقة”، لقد اصطبغت بيئة أسرته بصبغة الإسلام وهديه رغم كلّ الصِّعاب والعقبات في ذلك العصر، بل إنّ كل فردٍ في الأسرة كان قد اصطبغ بصبغة الإسلام.
كان لخُورْشِيد أَغا بن خليل أغا ولدان: سليمان أفندي والمَلَّا أحمد، اشتغل سليمان أفندي بالتجارة؛ أما الملا أحمد والد شامل أغا جدّ الأستاذ فتح الله فقد آثر الزهد رغم أنّه أُوتي سَعة من المال، فالزهد والتقوى لباسه، ورياضة النفس أساسُه، فله في حُبيبات الزيتون غَنَاء، قويّ البنية، طويل القامة، مهيب، يحترمه الناس جميعًا، في إشراقاته الروحيّة سرّ عظمته الحقيقية، حياته كلُّها تنسُّك وتعبُّد، لم يُعهَد عنه التواني في أداء العبادة، وأصبح يقوم الليل كلَّه في العقود الثلاثة الأخيرة من عمره، لا يغمض له جفن ولو في السَّحر عندما يصرَع النَّومُ السُمَّار، ولا يغفو سوى ساعة أو ساعتين فحسب.
كان شامل أغا جدّ الأستاذ فتح الله أشبه الناس بوالده، فهو مثال الوقار، والحيطة، والجديّة، والشّدة في أمر الدّين، فحياة الرّوح هي محور أفعاله، فشعاره “اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة”، وهو رجل جادّ وَقور يحترمه الناس جميعًا، حياته حياة الأولياء؛ يتهجد حتى الفجر، وله في لُقيمات يقمْنَ صلبه الغَنَاء، يصوم حتى تظن أنّه لا يفطر، له من الأشقّاء أربعة: شاكر أغا، وعاكف أغا، وذاكر أغا، ومحمد علي أغا.
وما إن حطّت العائلة رحالها في قُورُوجُق حتى اضطرت للهجرة مرتين:
الأولى: أثناء الحرب العثمانية الروسيّة (1877- 1878م) المعروفة بـ “حرب 93”[1]، اضطرب أمر العائلة، فرحل الملا أحمد بأسرته إلى ضواحي مدنية “سِيواس”، وأعوَزَت العائلة هناك، فلما انتهت الحرب عادت إلى قُورُوجُق.
في عام 1890م بُعيد العودة الثانية إلى قُورُوجُق بـنحو 8-9 سنوات؛ توفي الملا أحمد.
الثانية: إبّان الحرب العالمية الأولى، ففي هذه المرة ذهب شامل أغا بأفراد الأسرة إلى إحدى قرى “يَرْكُوي” في مدينة “يُوزْغات”، وما إن انتهت الحرب حتى عادت العائلة إلى قريتها في أرضروم، عادت مترجِّلة لِما حلّ بها من ضيق ماديّ.
ورغم هيبة شامل أغا العظيمة، إلا أنه كان بينه وبين حفيده فتح الله اتصال روحيّ لم يستطع أحد أن يلحظه، كان يحبّ حفيدَه كثيرًا وإن لم يكن يظهر ذلك، فما رُئيَ هذا الرجل العثمانيّ يبكي قطّ إلا عندما رأى حفيده لأول مرة بعد غياب كان لسبب تعيين والده إمامًا في قرية أَلْوار، احتضنه فأخذه البكاء، وفاضت مشاعره بهذا الشِّعر:
غادرت وردتنا البلد الذي جفاه أحبّتي والعندليب
فابكِ إن شئت حبيبَك أو دعِ واضحك إن شئت فالبَينُ نحيب
ولشامل أغا ستة بنين وبنت اسمها دُرْدانة، والبنون هم: رامز وراسم ونور الدين وأنور وسَفَر وسيف الله.
أمّا أجداد الأستاذ فتح الله لأمِّه فلا تكاد تختلف بيئة حياتهم الروحيّة عن أجداد أبيه في شيء، كان جدّه أحمد أغا حفيد قُورْت إسماعيل باشا ورِعًا حتى إنَّه -رغم كثرة معارفه- لَيَخْشَى الذهاب إلى المدينة حذَرًا من أن يُقارِف ذنبًا، وكان يختم القرآن كل أسبوع مرة فأكثر؛ أما جدَّته السيدة خديجة فهي من سلالة حامي أدرنه شكري باشا.
كان للأستاذ فتح الله خال اسمه عبد الرزاق طُوب، قضى عنده فترة من طفولته، وهو إحدى فرائد عِقْده الروحيّ، وصفه الأستاذ فتح الله بأنّه من “أهل القرآن”، وقال: “إني لَأشبه الناس به في خِلْقته لا سيما العينين”.
ولجدّته لأبيه السيدة مؤنِسة أثرٌ بليغ في حياته، فكم كان يذكرها في مواعظه وإنَّ لأنينها ونحيبها من خشية الله أثرًا كبيرًا في نفسه، فعبادة الله ومحبته محور حياتها، حتى إنّها إذا سمعت اسم الله لم تملك عينيها، صوّامة صامت اثني عشر عامًا متصلة، يصفها الأستاذ فيقول: “يا لَلَّه كم أثَّر فيَّ عمقها مثل البحار الهادئة، فبشائر الإيمان عليها بادية، وصِلتها بالله ظاهرة، كانت مبتسمة وكان جل ضحكها التبسم”. وفي هذا ما يشير إلى أنها كانت تجتهد في أن تجعل من أفعالها مِرآةً للإسلام.
في عام 1905م وُلِد رامز أفندي والد الأستاذ فتح الله، حالَت هجرة الأسرة وما فيها من عقبات بين رامز أفندي والاستمرار في طلب العلم، إلا أنَّه بعزمه وإرادته تعلَّم تلاوة القرآن الكريم في عقده الثالث، وسرعان ما رقي به شغفه بالقراءة والعلم على سُلَّم العلوم الشرعية، حتى إنّه عُيِّن إمامًا؛ كان من سمته الدقّة البالغة في الحياة والخشوع في الصلاة، يستثمر وقته بدقّة، فتجده يملأ الفترة ما بين عودته من الحقل إلى إعداد الطعام بقراءة الكتب، وهو في الطريق تجده يقرأ القرآن الكريم أو يذاكِر ما حفظه من نَظْم العربية والفارسية؛ كان مضيافًا، لا يكاد بيته يخلو من العلماء وكأنّه معهد شرعيّ؛ كان قويّ الحافظة حادّ الذكاء، كان يتميز – فضلًا عن هذا كلِّه – بالدماثة، ففي هذا المقام يقول الأستاذ محمد قِرْقِنْجي: “يا لَه مِن رجل! فرغم نشأته في قرية إلا أنه يباري من تربَّى في مدرسة أندرون العثمانية[2] من النبلاء، فأن تعرف متى وكيف وبأي أسلوب تتحدث تعوزك لهذا تربية خاصَّة وأخلاق سامية”.
من الخصال البارزة في رامز أفندي تعلّقه بالصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى لكأنّه مجنون بهم، وكثيرًا ما كان يقرأ عن حياتهم؛ فورث عنه الأستاذ فتح الله هذا الحبّ الجمّ لهم، بلغ ولع رامز أفندي بالصحابة أن أهل بيته كانوا يشعرون أنهم والصحابة أسرة واحدة، فذكرهم ديدنه، والحديث عنهم متعته، ولو رأيت هذا العاشق الولهان يحدِّث الناس عن الصحابة ويسرح بناظريه في الأفق لحسبتَه يراهم رأي العين.
كان رامز أفندي – في رأي الأستاذ فتح الله – أرضًا طيبة يُستنبت فيها الطيب النافع، إلا أنّ الأجواء لم تأذن للرياح أن تسوق السحاب إلى هذه الأرض، وكان مدرسةً في الوَرع، كان إذا عاد بالبقر من الحقل يلجمه لئلا يأكل من عشب الحقول ولو قليلًا.
تربية الشرق هي نمط علاقة الأستاذ فتح الله بوالده، كان يجلس بين يدَيه ليتعلّم القرآن، فيحبِّب إليه حفظه، ولم يكن ليُظهر حبَّه لولده أمام أحد رغم أنّه كان يحبُّه حبًّا جمًّا.
أمَّا والدة الأستاذ فتح الله فهي السيدة رفيعة، معلِّمه الأوّل، وهي من أسرةٍ عريقة، فعمُّها هو مفتي الشام يومئذ، كانت ربّة منزل فيه خمسة عشر فردًا تقوم على شؤونهم، ومع هذا دأبت على تعليم نساء القرية القرآن رغم الأخطار في الفترة التي حُظِرت فيها قراءة القرآن وتعليمه؛ علّمت وليدها فتح الله قراءة القرآن وهو في الرَّابعة، وما إن تعلّمه حتى قرأه كلَّه لأول مرة في شهر، فكان للسيدة رفيعة أكبر الأثر في حياة الأستاذ فتح الله بعشقها لتعليم القرآن الكريم، ومواظبتها على أداء العبادة، وحياتها الملأى بالمسؤوليات.
يا لَلَّه ما أوثق صلة هذه السيدة بربِّها! ذات ليلة همّ الأستاذ فتح الله ابن الثانية أو الثالثة عشرة أن ينام قبل أن يصلي العشاء، فآذنَتْه أمّه بالصلاة، فأجاب: “إنني مُرهَق، لعلِّي أستيقظ ليلًا وأصلي”، فقالت: “ربما يشق عليك ذلك، فتفوِّت الصلاة، ثكلْتُكَ الليلة إذا لم تنهض لتصلي.” بلغ بها إيمانها أنها تستغني عن فلذة كبدها إن لم يأتِ بما أمر به الله.
بيْنَ الأستاذ فتح الله وأمِّه وشيجة حبّ وثيقة، فهو يدها اليمنى في البيت، إذ إنها – وهي مريضة – كان لها ثمانية أولاد ترعى شؤونهم، فكان الأستاذ فتح الله – وهو يحفظ القرآن في هذه الآونة – يغسل الملابس والأطباق، ويطبخ ويعجن؛ نعم فدأب أمِّه على تحفيظ القرآن، ورعاية أولادها رغم أنها مجهَدة مرهقة، ومواظبتِها على أداء الفرائض حقَّ الأداء، كل ذلك كان له بالغُ الأثر في حياته.
توفي ثلاثة من إخوته العشرة وهو طفل، كانت السيدة نور الحياة أكبرهم، ثم فضيلة إلا أنها وافتها المنية وهي طفلة، ثم الأستاذ فتح الله، فصبغة الله، ثم المسيح، ثم فقير الله إلا أنه توفِّي وهو طفل، ثم حسبي[3]، فصالح، وفضيلة، ثم نظام الدين إلا أنّه توفّي وهو طفل، ثم قطب الدين أصغرهم؛ وبين الأسرة عُرى وثيقة من الحبّ والتقدير، فعندما غادر الأستاذ فتح الله أرضروم إلى أدرنه ومنها إلى الجيش لم يكلِّم المسيح أحدًا خلال أربع سنوات فارقهم فيه أخوه الأكبر، فقلّما يتحدث إلى أحد، إذ صار شغفه بأخيه فتح الله حجابًا بينه وبين الناس. كذلك كان الأستاذ فتح الله، يحكي أن أختًا له توفيت في طفولته فبكى عليها كثيرًا وزار قبرها كثيرًا وكان يدعو: “اللهم ألحقني بأختي لأراها”.
يُروَى عن أمِّه وذوي القربى القريبة أنّ أصوله من جهة أبوَيه من شجرة أهل البيت المباركة، لكن الأستاذ يقول: “إنّه لا يمكن القطع بشيء في هذا؛ فكتاب شجرة العائلة مفقود”.
ومن ألمع الحلق التي تشكّل منها عقد الروح في حياة الأستاذ فتح الله: الشيخ “أَلْوارْلي أَفَه”، فهو واسطة العقد، بل كأنه مغنطيس المعنى ومنبع تتغذى منه روح الأستاذ فتح الله، فالحديث عنه قبل دراسة حياة الأستاذ فتح الله ضروريّ جدًّا؛ لنطّلع على معرفة بيئته التي ترعرع فيها.
برَزَ الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه في طليعة علماء عصر الجمهورية، فنشأته شهدت أفول الدولة العثمانية وظهور الجمهورية، وله أثرٌ كبير على الأستاذ فتح الله في تربيته وتعليمه، يقول الأستاذ: “الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه هو اليد الخفية التي كانت وراء ما أجده من مشاعر”؛ فتربَّى في أرضٍ كان ينبوعها السيد أَلْوَارْلي أَفَه؛ وكان له في قلوب الأسرة كلِّها حبّ جمّ وتقدير وتوقير، يقول الأستاذ: “أتذكر أن خالي كان يجله حتى لكأنه يكاد يبسمل كلما ذكر اسمه؛ أمَّا خالتي فهي متيمة بهذه البيئة، ولأبوَيّ وشيجة عريقة به… فمنذ أن رأيت النور ألفيت أبوَيّ يرتشفان من هذا الينبوع الصافي كأنهما ظمـآن برّح به العطش”.
وتحدّث عن صلته بالشيخ أَلْوَارْلي أَفَه فقال: “لم يكن ينبس ببنت شفة إلا حسبتها إلهامًا من عالم آخَر، فعندما كان يحدِّثنا كنَّا ننصت إليه كأنّ على رؤوسنا الطير، وكأننا نسمع كلامًا حديثَ عهدٍ بربه! لا أدعي أني أحطتُ به فهمًا؛ فيوم وفاته كنت في السادسة عشرة، إنّه الروح التي دغدغت باكورة الروح والمعنى في حياتي، يتنزّل بأسلوبه لأعي عنه وأفهمه لا سيما أني صغير لا يبلغ عقلي ومداركي كُنهَه؛ لقد عاش عظيمًا، لكن لم يجد الكبر إلى قلبه طريقًا، كان يطوف في كعبة القرب من الله، لا يأبه لشيء من الأبهة والعظمة، فهو كطير حوما ترى ظلّه لكنك لا تراه”.
أحبّ الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه الأستاذ فتح الله أيّما حبّ، وكان يناديه “تلميذي”، ولا يرضى أن يفارقه بتاتًا، ولما بلغه أنه سيتعلّم العربية على يد معلِّم آخر، استدعاه وقال بوقار بنبرة يخصّه بها: أحلف بالله ثلاثًا أنك لو ذهبت لمُزِّقت إِرَبًا إِربًا.
وغدت تلك الحلقة واسطة العقد في عالمه الروحي، ولطالما تجلّت آثارها في روحه، فتربية الأستاذ فتح الله منذ نشأته كانت في بيئة علمٍ تسود أجواءَها ألطاف روحية، إنها بيئة مفعمة بنسائم حياة التكية الروحيّة تارة، وبعلم المعاهد الشرعية تارة أخرى، ذاك هو المناخ الذي نشأ وترعرع وتربّى فيه الأستاذ فتح الله.
[1] اشتهرت هذه الحرب في التاريخ العثماني بـ “حرب 93” لوقوعها عام 1293 من التقويم الرومي.
[2] مدرسة في القصر العثماني أُسست في عهد السلطان مراد الثاني، وحُدِّثتْ في عهد السلطان محمد الفاتح، هدفها تربية الهيئة الإدارية والعسكرية للدولة، وتأهيل القوى العاملة في العاصمة العثمانية وفي الطبقة البيروقراطية في الريف.
[3] حسبي ندائي كُولَن توفي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012م.