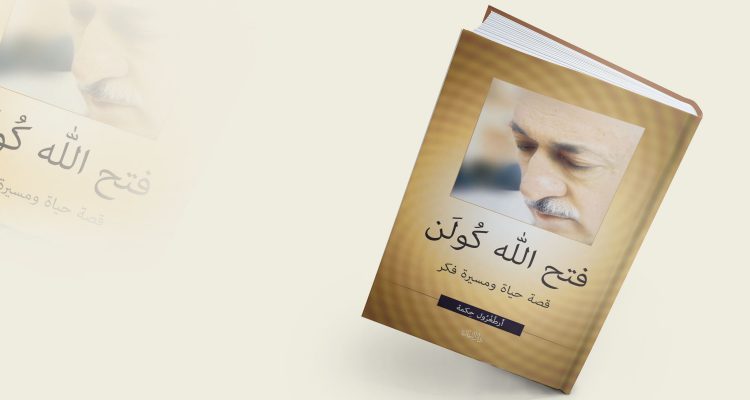ألقى الأستاذ فتح الله أولى محاضراته بجامعة أرضروم عن مولانا جلال الدين الرومي، فتركت أثرًا بليغًا على المحاضِرين والحاضرين كما سبق، وكانت الثانية في ندوةٍ نُظِّمت في “الهلال الأخضر” بإزمير، وحظيت محاضرته “التقنيات والعلوم الطبيعية في ضوء القرآن” باهتمامٍ واسع. وهاتان المحاضرتان كانتا استجابة لرغبة الناس لا لبرنامج معين. وفي هذه الفترة كان يلقي دروساً في المقاهي. وهذا محرّم بك قد شهد مسامرات المقاهي الأولى وحذِقَ ظروفها وغاياتها، يقول: “جاء الأستاذ فتح الله إلى كستانه بزاري في شهر 7/ 1966م، كان واعظًا ذا أسلوب لم نعهده في الوعاظ حتى اليوم، فهو ليس كغيره شكلًا ومضمونًا، فمثلًا عندما خرج ليعظ راقبنا صعوده على المنبر بشغف، ظننّا أنه كما هي العادة سيرتدي تلك الجبة السوداء جُبّة الأستاذ يَشار المعلقة على الجدار، ثم يرقى المنبر، لكنه طلع علينا بجُبَّته البيضاء، فانفعل الناس عندما رأوه، وهبّوا من مجلسهم، حتى إننا نسينا تشغيل المسجِّل، فمن يومئذ أصبحنا نغدو إلى المسجد كلّ جمعة مبكِّرين لنستمع إليه.
عُنِي بالشباب، ومعظم روّاد المقاهي منهم، كان روّاد المسجد معدودين، فقال: إذا كان الشباب لا يأتون، فلنذهب نحن إليهم، فبدأ بمنطقتنا “مَرْسينْلي”، فحجزنا المقهى لأوّل لقاء بشقّ الأنفس، ولا أحد يعلم أنه سيتحدَّث، والمقهى مميّز، فهو مكتظ بالطلاب والشباب.
كيف بدأ أول لقاء؟ بدأ الأستاذ فتح الله بالحديث، وكنّا اقترحنا أن نقدِّمه للناس، ونمهّد للموضوع، فأبى وقال: ليكن تلقائيًّا؛ أتذكر أنه بادئ الأمر قال: “حديثي إليكم ليس هذا مكانه، لكن أسبابًا عدّة منها الترهيب من المسجد باعدَت بينكم وبينه فأتينا إليكم، فلما تعذّر على منبر المسجد أن يبلّغ الحقيقة، جئنا إلى طاولة المقهى…”؛ فغمغم من أبوا أن تتحول الطاولة إلى منبر فيما بينهم، وأغرقوا في السب والشتم والتهم والتجريح، فلم يُعِرْهم الأستاذ بالًا، ومضى في حديثه ساعةً في جوٍّ حَرِج، ثم توافد الناس حتى ضاق بهم المقهى، فبات ليلَه يحدّثهم نحو ثلاث ساعات ونصف”.
في مطلع عام 1975م نُظِّمت سلسلة محاضرات توضِّح لمن لا يأتون إلى المسجد رؤية الإسلام في مواضيع عدة شغلت الساحة، يقول الأستاذ فتح الله عن الهدف والنمط: “ضاق المقهى بالناس، ولما كان لقاء حشد من الناس في مقهى يتطلب رخصة طبقًا لقانون التجمع والتظاهر، فتعالَوا بنا ننظّم محاضرات في أماكن أكبر وحشود أكثر بالرخصة نفسها؛ فكانت المحاضرة التالية عن “نظرية التطوّر” في المعرض الدولي بإزمير، وفي القاعة خمسة آلاف مقعد، فإذا بالناس خارجها أكثر ممن في داخلها، فصار المعرض كمصلّى العيد، وصلى الناس المغرب على العشب، ومن حضروا كانت لهم مشارب شتّى، فبعضهم يتساءل حائرًا: ماذا يمكن أن يقول واعظ في هذا الموضوع؟ وآخرون ساقهم حب الاطلاع.
“الجيل الذهبي” عنوان محاضرة وردَ على قلبي فجأة كنايةً عمن سيحملون على عاتقهم مسؤولية المستقبل، ثمة مسرحيّة بهذا الاسم مترجمة عن العربية تتحدث عن الرعيل الأول، لما عثرْتُ عليها تأملت صفات هؤلاء الربانيين الذين هم روح تبعث فينا الحياة بعد الموت، فأجملتُها في المحاضرة لتكون دعوة للجيل الذهبي”.
كان موضوع نظرية التطور قد شغل الرأي العام التركيّ كثيرًا في الستينات والسبعينات، وساد اتجاه ماديّ لا يقبل الناس خلافه، كأنه هو الحقّ دون ما سواه، فتأثر كثيرون بهذا، وعانوا أزمة عقائدية، ولم يفنَّد هذا المفهوم في ضوء مبادئ الإسلام والعلم الحديث رغم أنّه يناقض حديث الإسلام عن نشأة الخَلْق، وادّعى بعض الناس أن الإسلام غُلِب أمام هذه النظرية؛ وفي بيئة كهذه جاءت محاضرات الأستاذ فتح الله مدوِّيةً، وظَّف فيها العلم الحديث، والعلوم الإسلاميّة، وكشف عن خبايا المسائل المستعصية؛ ولم يكن يعترض أو يوافق من يؤيّد الاتجاه الماديّ بل يكتفي بعرض ما في الإسلام من ثراء له فيه سعة اطلاع، ويجيب بكلّ ثقة على قضايا العصر إجابات مطمئنة مقنعة.
جذبت موضوعات مواعظه الأنظار، ففي حديثنا عن أيام إقامته بأدرنه ذكرنا أنه خالف المعتاد، واتخذ مما يواجهه المسلمون من مشكلات عصريّة موضوعًا لمواعظه، دون أن يدخل في أمور سياسية. كانت أسئلة المسجد تأتي مكتوبة، جاءته مئات الأسئلة المتنوِّعة، وإذا تأمّلت أجوبتها في كتاب “أسئلة العصر المحيّرة” تجد أنها قارب النجاة لكثير من العقلاء اليوم، ففيها ما له صلة بالطب والاقتصاد والأدب والحقوق، وهي مقنعة ومستمدة من العلم الحديث والتراث، وتدلّ أنّ الإسلام عالج الموضوعات الإنسانية كافَّة، وتوضّح بأسلوب متميز لا حرَج فيه أنّ الإسلام هو العلم.
كانت محاضرة “الجيل الذهبي” بمنزلة البيان العامّ، ففي مطلع القرن العشرين تنوَّعت تسمية العلماء للجيل المثالي، فسمّاه بديع الزمان “الجيل الجديد”، وسمّاه الشاعر الكبير محمد عاكف “جيل عاصم”[1]، وأطلق عليه نجيب فاضل وسَزائي قَراقُوج، ونور الدين طُوبْجو وغيرهم أسماء عدّة… أما الأستاذ فتح الله فاستلهم حديثه عن الجيل المثالي الذي ينشده من آراء هؤلاء خاصّة بديع الزمان، فسماه “الجيل الذهبي”.
استهل المحاضرة بقوله: “لا بد لأي جيل من الأجيال من صفات مكنونة تجعله ذهبيًّا، وإلا لما استحق هذا الاسم”، إنها صفات ضرورية لجيل يستشعر المسؤولية تجاه العقيدة والفكر والحركة. ورسم في مقالاته بمجلة سِيزِنْتي، وكتاب “الموازين” و”العصر والجيل” صورة الجيل الذهبي جسدًا وروحًا، وصورة حركة أطلَقَ عليها فيما بعد “حركة المتطوعين”.
كانت أول موعظة له في إسطنبول في 26 أغسطس/آب 1977م بمسجد “يَني جامع” في أَمين أُونو، تحدث عن التزام المسلم والصفات التي عليه أن يتحلَّى بها، وأنّ التغيير يبدأ من الفرد، وكانت الثانية في 9 سبتمبر/أيلول 1977م في مسجد “السلطان أحمد”، حضرها رئيس الوزراء آنذاك “سليمان دَمِيرَلْ” ووزير الخارجية “إحسان صبري”.
في 28 سبتمبر/أيلول 1976م نُقِل من مَغْنِيسا إلى مركز بُرْنُوَا في إزمير، وعقد هناك جلسات “الأسئلة الأجوبة” السالفة الذكر، يقول عن رغبته في النقل: “طلبت إزمير، فعُيِّنت في بُرْنُوَا، فهي من إزمير، وهذا خير، فبُرْنُوَا في الوعظ والمسامرات امتداد لمغْنِيسا، فاستمرّت سلسلة الموضوعات؛ وعقدت ندوة للأسئلة كلّ أسبوع، وأتيحت الفرصة للحركة أكثر، فكانت الدعوات تأتيني من كل حدب وصوب، فأحاول أن ألبِّيَها”.
لم يقف عند الوعظ والمحاضرات وحوار المقاهي بل رغب بالسفر خارج الوطن لتمتد يده للناس جميعًا، قال: “من أين الطريق لاستمرار هذه المحاضرات خارج الوطن”، اقتنع بضرورة ذلك خاصة بعد أن رأى ثمار المحاضرات، فأرسلته الأوقاف في سلخ عام 1977م إلى ألمانيا، فحاضَر وحاور في برلين، وفرانكفورت، هامبورك، وميونخ. وكان يتطلع إلى السفر لبلدان أوربية أخرى لكن هذا لم يتحقق لعدم توفر الإمكانيّات.
انطلقت مجلة سِيزِنْتي في فبراير/شباط 1979م وعلى غلافها بيت للشاعر محمد عاكف:
إن لم ترحم نفسك فهلا أولادَك رحمتَ
كان الأستاذ فتح الله يكتب المقال الرئيس؛ وفي مقاله الأول “لعلك تكفّ عن البكاء يا بنيّ” أبان عمّا يستشعره من مسؤولية تجاه الإنسانية جمعاء، والمثُل والآمال التي يحملها لرفع المعاناة، يقول – وهو ينفث أحزان روحه على الأمة -:
لعلك تكفّ عن البكاء يا بنيّ
سلكنا هذا الدرب، لنشاطرك آلامك، ونُسكن همومك، ونَعْمُر قلبك، فلا تبتئس منا! تأخرنا فلم نسعفك في حينه، لكن أيقِنْ أنّنا نحمل بين جوانحنا دائمًا أنين يعقوب – عليه السلام – وعشق زليخا وهجرانها.
كلما أبصرتُ قدّك السويّ منقصما تمزق قلبي وانفطر؛ وكم انحنى ظهري واغرورقت عيناي أمام نظراتك الحزينة البائسة، أردت أن أقتبس من أُغنيتك نغمة لكل صرخاتي، وأتحدث عن ملحمتك، فأحرَق أنينك وجداني، وهالَني أمرك، وأصبحت مهمومًا حزينا لما أصابك…
زد على ذلك أنني كنتُ أستحي أنّ أمد يد العون إليك، أو أن أقابلك بشفقةٍ زائفة؛ إذ إنهم ضيّعوك على مرأى مني ومسمع، وآذوك فآل أمرك إلى هذا الحال. لقد رأيتُ ما حدث عندما أخمدوا جذوة عقلك، وشغلوك ببطنك عن قلبك، ومع ذلك لم أستطع أن أمدّ يدي المثقلة بالذنوب إليك… ورغم استغاثتك لم أستطع… قدَرُك قدَر “فاؤُسْت”، إذا فمن “مَفِسْتُو”؟ من فعل بك كل هذا؟.
كنتَ في قرار مكين، ومستقر آمن، ورزق مقسوم، وكان كل شيء على ما يرام، ثم أتيت إلى هذا العالم الموحش، فما وجدت شيئًا ولا عرفت أحدًا؛ لم يسمع أنينك وصراخك أحد سواك، ويكأنّك ندمتَ ألف مرة على خروجك، لكنه قدرك المحتوم.
أما من يطوفون بك فمنتهى سعيهم مَلْء معدتك وتلبية رغباتها، فمِن يومئذ وأنت تصرخ صراخًا يحرق القلوب، وهم يغفلون عنك بدءا من ذلك الحين، وقد كنتَ حِبّهم ومبعث سرورهم في أيديهم وأحضانهم، كنتَ وردة فريدة على الصدور، لكن شيئًا من ذلك لا يعود عليك بشيء، فكنت غريبًا، وحيدًا، بلا أنيس…!
فماضيك رحِم حاضرك، وحاضرك رحِم مستقبلك المبهم، فأنت في مفترق طرق يا بنيّ!
ائذن لي أن أكون حاميك في هذا العَناء، أعزف بريشتي من أجلك، وأُسمع روحَك أنيني. إنني أطلب الصفح منك باسم كل المجرمين ورأسي تحت قدميك. إننا خذلناك وأنت بين العاصفة والنار تستغيث، فاعف يا بنيّ عمن كانوا سبب وجودك في سبيل لذة عابرة، فأرووا بطنك وأظمؤوا قلبَك، وشغلوك عن الخلود بفترة مؤقتة، وزودوا روحك بالسفاهة والوقاحة، وأوقعوك في خضم البؤس والتعاسة. فاعف عنا يا بني.
[1] عاصم هو ابن محمد عاكف.