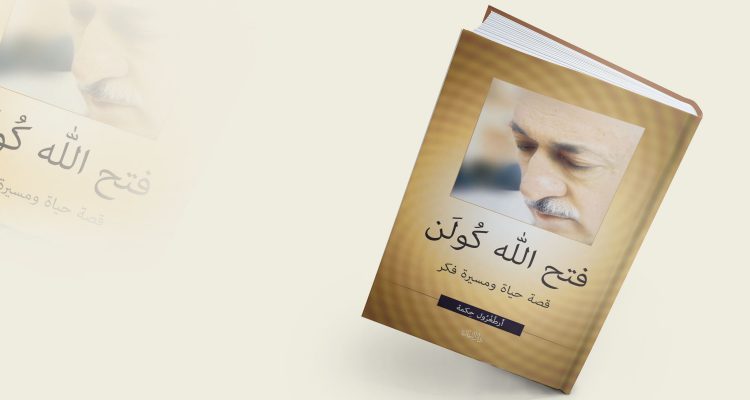استُدعي الأستاذ فتح الله للجيش في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1961م، وقد أمضى في أدرنه قرابة ثلاث سنوات؛ فودّعه جمع جمٌّ يبلغ الأربعين من محبيه عند انطلاقه من “قرق أغاج” إلى المنطقة العسكرية؛ وعلى رأسهم الأستاذ يَشار، وحسين طوب، وسالم آريجي الإمام الرئيس لمسجد الشرفات الثلاث؛ اتجه إلى إسطنبول ثم أنقرة، ومكث فيها 5-6 أيام عند السيد صالح أُوزْجان، وخدَم في أنقرة في كتيبةٍ خدم بها عمه من قبل، في السرية الأولى للاتصالات بالكتيبة الأولى بمنطقة “مَماق”، لفت الأنظار بجدّه وانتظامه، فتوطدت صلته بقيادة السريّة، علاوةً على أنّ بعض معارفه في أدرنه ذو صلة بقيادته؛ تدرّب أربعة أشهر بقطاع اللاسلكي وعمل فيه؛ ورغم أنه يؤدي الخدمة العسكرية كغيره، لكنه كان يرى أنه لا يؤدي مهمته حق الأداء، فرأى أن طعام الجيش لا يحلّ له، وكذا ملابسه المجانية، فاشترى ملابس عسكريّة من أحد الجنود الطلبة.
اضطربت البنية السياسية عقب انقلاب 27 مايو/أيّار 1960، فخطط العقيد طَلْعَت آيْدَمير لانقلاب على انقلاب 27 مايو/أيار، فأشرَكَ 15 ألف جندي من منطقة مماق، فوجد الأستاذ فتح الله نفسه بينهم يكابد آلام تلك الفترة العصيبة؛ ولما فشل العقيد سلّم جنوده أنفسهم، وصودِر سلاحهم، وصدر أمر بمنعهم من مغادرة الكتيبة مدة شهرين، فاستغلها الأستاذ فتح الله في تزكية النفس، يقول: “لك أن تطلق على هذه الفترة “الأربعين”[1]، فهي أوّل “أربعين” أُرغمت عليها في الجيش… وقفت فيها نفسي على العبادة، كنت أغدو إلى المسجد مبكِّرًا في ليالي الشتاء الطويلة، فأتعبد إلى جهمة الليل، فصفا عقلي وزكت نفسي شيئًا ما”. لقد قطع مسافات روحية مهمة في نهاية هذه التزكية؛ وشهد من التجليات الجليلة ما شهِد مما لم يبُحْ به؛ ثم عاد الجنود لمهمتهم، وعُين هو في قسم “الاتصالات السريعة” وتعلم هناك استخدام الأجهزة اللاسلكية، والكتابة على الآلة الكاتبة بعشر أصابع.
يحكي الأستاذ فتح الله عن مشاقّ في الجيش لا تُنْسى، وخاصة أوّل أربعة أشهر بحي مماق، يقول: “عندما أتذكر الجيش أتذكر فورًا أوّل أربعة أشهر، فلا يمكن نسيانها؛ لم تكن السرر كافية ، ففي اليوم الأول نمت أنا وواحد كنت أعرفه من قبل في سرير واحد، أُعطِي كلّ منّا بطّانية يتدثر بها، كنا ننام دون أن نخلع أحذيتنا لنسلم من التجمد في قَرِّ الشتاء القارس؛ فإن اقتضى الأمر الماء وجدت مشقة عظيمة، لكن بدني كان قويًّا آنذاك، فكم وكم اغتسلت في أرضروم في المرحاض، أصبّ بالكوب المياه الباردة على رأسي وأنا واقف على الثلج؛ كان الجنود يغتسلون معًا بلا مبالاة، فكنت أرفض أن أدخل معهم. وذات مرّة أُمِر الجنود بالتعري في فحص طبّي عام، فقال الطبيب: اخلع سروالك، فقلت: “سيدي، ما رأى ما بين الركبة والسرة أحد، ولا أمي التي ولدتني”، فقال: اِمْضِ، فنجوت، وكان الطبيب طيِّبًا”.
مضت فترة التدريب وكانت نحو ثمانية أشهر، وأُقرِع بين الجنود لتوزيعهم على ثُكَنِهم، فخرجت نصيبه مرتين في أرضروم، فأعادوها ثالثة لئلا يكون الجندي في بلده، فكانت في مدينة “دِياربَكْر” في جنوب شرقي الأناضول، فأبى القادة أيضًا، فجاءت في إِسْكَنْدَرُون، وبدأت مرحلة مهمّة في حياته.
كان القادة هناك ألين من أنقرة، فاستراح بعض الشيء؛ عُيِّن في مركز الاتصالات، فكان يجلس وحدَه في سيارة مجهزة بأحدث التقنيات يومئذ؛ فأتاح له ذلك أن يخرج ليشتري الطعام، وأن يستمع من خلال أجهزة الاستقبال المتطوّرة إلى إذاعة القرآن الكريم التي تبث من دول عربية، وأن يعظ قبل صلاة الجمعة بملابس مدَنِيّة.
ها هو يعيش حرًّا نوعًا ما لكنه ماضٍ في تزكية النفس التي أخذ نفسَه بها في حياته كلّها، وها هو ذا يواصل حياته بدقّة ميزانه الحسّاس في أدرنه، فهزل جسمه وضعف؛ فقلّما ينام أو يأكل، فتبين بالفحص مِرارًا أن حالته خطيرة، فوُضِع في المستشفى فترة، ثم مُنح إجازة للاستجمام لمدة ثلاثة أشهر؛ فاستطاع أن يزور أرضروم ليرى أسرته بعد غياب أربع سنوات، بل لم يُتَح لهم توديعه يوم أن التحق بالجيش، حتى إنّ أمّه عندما رأته سألته: أنت فتح الله؟ وراحت تعانقه؛ فما كانت أمّه لتعرفه إذ تغيّرت ملامحه في فترة مرضه، وكان فتًى فغدا رجلًا؛ ثم أذن له فرع أرضروم بشهر آخَر، فقضى أربعة أشهر فيها، منها شهر رمضان المبارك، فوعظ في مساجد عدة بأرضروم، وذات يوم علِم أن فيلمًا يتحدث عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيُعرض في سينما بأرضروم، فأغضبه أنّ امرأة لا وجود للدين في حياتها تمثّل دور السيدة عائشة رضي الله عنها؛ فتحدث عن هذا في الموعظة، فثار المصلون وهاجموا السينما، فحاول أن يثنيهم عن هذا قائلًا: “لا تفعلوا، فليس لنا أن نفعل مثل هذه الأفاعيل، علينا أن نعالج الأمر بطرق أخرى مناسبة”، وباءت محاولته بالفشل؛ فانضم إليهم آخرون فصاروا جمعًا كبيراً ومنعوا عرض الفيلم، وتفرّقوا قبل أن يحدث ما لا يُحمد عُقباه.
وعقدت في هذه الفترة ندوة عن مولانا “جلال الدين الرومي”، وحاضر فيها أساتذة الجامعة، فشارك الأستاذ فتح الله فيها، وألقى كلمة عن حبّ مولانا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فأبهرهم أسلوبه وبراعته في الارتجال وإلقاء الشعر الفارسيّ وشرحه، ودَحَض زعْم من زعَم من المحاضرين بأن “مولانا” يتبنى مذهب “بانْتَئِيزم”.
وشارك أيضًا في فعاليّات إنشاء جمعية لمقاومة الشيوعية في أرضروم، والأولى من نوعها كانت في إزمير.
انتهت الشهور الأربعة فعاد إلى إِسْكَنْدَرُون، فوعظ بحماس بالغ، في عدّة مساجد، يرتدي جُبّته فوق ملابسه العسكرية ويُلقي الموعظة، يشخّص داء الحياة الاجتماعية بأسلوب مثير ومؤثِّر.
وذات مرّة رغب إليه بعض من الجيش أن يمدح القائد في موعظته، فمدحه بأنه “رجل قوميّ”، فلما عاد إلى وحدته العسكرية زلّت قدمه وهو يركب، فتكسّرت أضلاعه، وعدّه تنبيهاً معنوياً له حيث ذكر في كرسي الوعظ ما هو متعلق بالأمور الدنيوية ليسترضِي فلانًا من الناس.
ثم عاود الوعظ بعد فترة قضاها في الفراش وأثارت هذه الفعاليات قلق أناس، فتحايلوا للضغط عليه، وأحرجوا أصدقاءه المساندين له في مواقف عدّة، وذات مرة خطب الجمعة – ولم يكن يتكلم عن شيء في السياسة – فلما خرج من المسجد وجد الشرطة عند خروجه يحاصرون المسجد، وكأنهم يعتقلون قاطع طريق؛ فذهب إلى قائد الكتيبة وحيَّاه بالتحية العسكرية وسلّم نفسه؛ فأفشل خطة من يريدون تَكرار أحداث “مَنَمَنْ”[2] خيّب آمالهم الخبيثة؛ وقبيل خروجه من المسجد سمع جنديًّا يقول: اضربوا هذا الوغد؛ فغضب المصلون؛ لكنه سلّم نفسه، فلم يفعلوا أيّ شيء؛ ولا شك أنهم كانوا سيضربونه لو تردّد، فقد أعدوا خططًا تنمّ عن حَنَقِهم ونواياهم الخبيثة.
قُبض عليه وسُجِن، وكان رأي بعض الضبّاط فيه حميدًا فما كفّوا عن الحديث عنه، وفيهم نقيب مشهور بسُكره، حتى إنّه كان يستولي على راتب الأستاذ فتح الله ليشتري الخمر، قال عنه أثناء المحاكمة: “فتح الله هو وحدَه المنضبط ويمتاز بأخلاقه العالية في الفِرقة، قلّ أن نرى مثله”؛ فكل قادته في الجيش يثنون عليه في خلقه ووفائه وحبه لوطنه اللهم إلا من أعمى الحقد عيونهم، فتأثرت هيئة المحكمة بهذه الشهادات؛ فسجن فترة قصيرة مع عقوبة تأديبيّة يسيرة، ثم أطلق سراحه؛ واستغل سجنه في قراءة كتاب “صفحات” للشاعر التركي المشهور محمد عاكف أَرْصُوي، وحفظ معظمه، وخلال فترة سجنه القصيرة تحسّن سلوك بعض أصدقائه المسجونين معه؛ وقد أذاعت جريدة “الاستقلال الجديد” خبرَ سجنه وإطلاق سراحه بعنوان “فتح الله حفيد محمد الفاتح”.
وكانت طبيعته النشطة تأبى أن تبقى دون عمل يستهدف مثاليته التي جعلت منه إنسانًا فعَّالا نشِطًا على الدوام ولو في الجيش ذي النظام المحكم، فيوم أن وصل إسكندرون كان عدد المصلين في الوحدات لا يُذْكَر، لكن سرعان ما ازداد عددهم بمهارته وصدقه في النصيحة والموعظة، وكانت في الكتيبة قاعة تُستخدم لعروض سينمائية، فصارت مسجدًا تُصلَّى فيه الجمعة؛ كلّ هذا والحاقدون ما زالوا يتحينون فرصةً لاعتقاله، وليُفسِدوا عليه أمره، حتى إن والده لما زاره أُلقي القبض عليه لحضوره جلسة دينية.
وتُظهر مواعظه ومقالاته أنّه يقدر الخِدمة العسكرية قدْرها، وكلما جاءت مناسبة تحدّث عن تقدير الأتراك للخدمة العسكرية، فهي ليست أمرًا صعبًا ولا شاقًّا عليه إلا أن أعداء المثاليات والقيم التي وقف لها حياته فرضوا ظروفًا تسبّبت له في مشكلات وأزمات مختلفة يومئذ، فهؤلاء هم من جعلوا الخدمة العسكريّة شاقًّا ومرهقًا؛ ولما أنهى مدة خدمته ورحل عن إسكندرون عرض عليه صاحب شركة شحن العملَ مديرًا للشركة، فرفض ورجع إلى أرضروم.
ولأرضروم منزلة متميزة في حياته الروحيّة، لكنه آثَر الرحيل عنها بعد عودته رغم حبّها لها وإصرارِ أسرته وخاصّة أمّه على البقاء معهم؛ فالهجرة من مسقط الرأس في سبيل مثاليّاته من أمهات مبادئه في الحياة إيمانًا منه بالهجرة المقدسة التي طالما حدّث الناس عنها؛ فقرر الرحيل عن أرضروم، حتى وإن لم يرجع إلى أدرنه فلسوف يذهب إلى مكان آخر يخدُم فيه الإسلام.
[1] مصطلح صوفي معناه: أن يتفرغ الإنسان أربعين يومًا للعبادة والذكر والدعاء مع التزامه بقلة الأكل والنوم والكلام.
[2] واقعة “مَنَمَنْ”: حدثت في مقاطعة مَنَمَنْ بإزمير في 23 ديسمبر/كانون الأول 1930م، وهي اسم لسلسلة من أحداث خُطّط لها لإقحام المتدينين في المآزق، بدأت بمقتل ضابط احتياطي اسمه مصطفى فهمي قُبيلاي أثناء تأديته للخدمة العسكرية في مَنَمَنْ على يد مجموعة من مدمني المخدّرات تحت اسم الشريعة؛ فسُجن كثيرون إثر هذه الأحداث، وأُعدم آخرون.