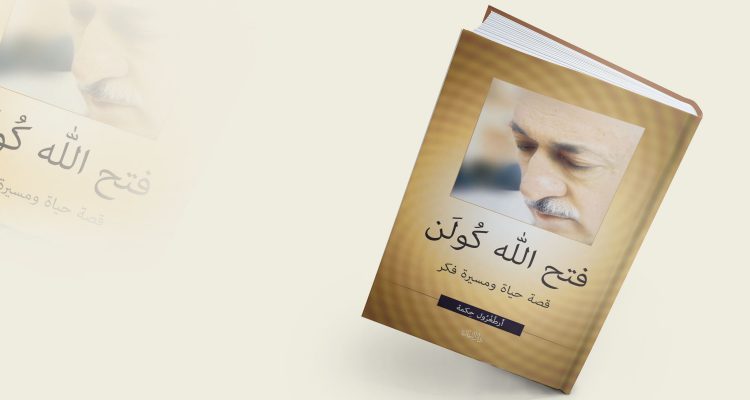حفظ الفتى القرآن الكريم عام 1951م، وإذا حفظ وِردَه راح يساعد أمّه في البيت أو عكف على الكتب يقرأ ويقرأ، لقد قرأ كتب أبيه كلّها لا سيما كتب حياة الصحابة الكرام؛ فهو يتقن قراءة الكتب العثمانية منذ صغره، وفي هذه الفترة أخذ عن والده اللغة العربية والفارسية، ولما حفظ القرآن، أخذ التجويد عن الحاجّ صدقي أفندي في “حسن قلعة”، ولم يكن له مسكن هناك؛ فكان يمشي كلّ يوم مسافة 7- 8 كليو مترات من أَلْوَارْ إلى حسن قلعة.
ألقى الأستاذ فتح الله في تلك الحقبة أول موعظة، فكانت نموذجًا مهمًّا كشف عن غزارة علمه ومهارته الفذّة في الخطابة؛ كان أبوه رامز أفندي يعظ الناس في رمضان بعد الإفطار في مسجد قرية أَلْوَارْ، فتأخر ذات ليلة، وكان فتح الله يغدو إلى المسجد مبكِّرًا، وعمره آنذاك أربعة عشر عامًا؛ فاجتمع المصلون، فإذا بوجيه من أَلْوَارْ يحظى باحترامهم جميعًا يُدعى كاظم أفندي ينظر إلى الفتى فتح الله، فتلتقي أعينهما، فينهض كاظم أفندي ويُلبس فتح الله جبة رامز أفندي وعمامته في دهشة غمرَت المصلّين وفتح الله أيضًا؛ فسنّه أصغر من أن يقف مثله ليعظ هذا الحشد، بل إنّه لم يكن يطول كرسي الوعظ، فحملوه وأجلسوه عليه؛ وما إن شرع في الموعظة حتى أخذت الجماعة -التي لم تجد تفسيرًا لتقديم هذا الفتى لكرسيّ الوعظ- تنصت إليه بذهول، وكم عجبوا لهذا الصوت الذي يدوِّي من على كرسيّ الوعظ، فكان لموعظة الفتى أبلغ الأثر على الجماعة.
أتم الفتى دراسته في أَلْوَارْ ولماّ يقرّرْ والده رامز أفندي ماذا سيفعل، فقال الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه: علينا أن نعلِّم هذا الفتى، فبدأ فتح الله يدرس اللغة العربية في أرضروم على يد سعدي أفندي حفيد الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه؛ ورغم أنّه شابّ مستقيم نزيه يكبر فتح الله بـ 5-6 سنوات إلا أنه كان قصير الباع قليل الخبرة في أساليب التدريس؛ فلم يكن ليروي ظمأ فتح الله؛ وكان فتح الله يتردد حينئذ على قرية أَلْوَار لئلا ينقطع عن مناخ الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه.
وصف الأستاذ فتح الله نظام مذاكرة الدروس فقال: أذاكر دروسي الأول فالأول، أقضي الليل في المذاكرة ولا أنام إلا قليلًا، أستضيء بشمعة، فلا حيلة لي سواها، ولا تمر ليلة دون أن يمرّ المعلم بي يَتَفقدني خفية، فيسعد بي كلما رآني أذاكر.
توفي جدّه شامل أغا وجدته السيدة مؤنسة في ساعة واحدة عندما كان يدرس في أرضروم عام 1954م، فحزن لفقدهما كثيرًا، يقول: “بكيت أياماً وليالي، دعوت ليل نهار: اللهم ألحقني بجدي وجدتي لأراهما… لم أعتد على فراقهما حتى الآن، فكلما تذكرت واحدًا منهما تلظى قلبي على مثل الجمر، وتأثّرت كثيرًا”؛ وفي هذا ما يبين عن منزلة جدّه وجدته وأهميتهما في حياته.
قبر شامل أغا جد الأستاذ فتح الله وجدته مؤنسة هانم في قرية قُورُوجُق بمدينة أرضروم
وقعت حادثة أخرى في هذه المرحلة الدراسية، فزلزلته، توفِّي الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه… انقشعت سحابة العناية التي أظلّت حياته العلميّة والروحية، يصف وقع وفاة الشيخ عليه، فيقول: ” كنت في ذلك اليوم في أَلْوَار، وأظنّه وقت الضحى، وبينما كنت أستجمّ متكئًا على أريكة في ردهة المنزل، إذا بي أسمع صوت هاتفٍ، إنه ليس بنداء بل هو صراخ! صراخ أصك مسمعي بقوله: “مات أَفَه!”؛ ففزعت، وأخذت معطفي، وهُرِعت إلى بيت الشيخ، ولما بلغتُ البيت باغتتني الفاجعة، فالشيخ أَلْوَارْلي أَفَه مات حقًّا حقًّا… فبكته الدنيا العتيقة، فقد ترك فراغًا أنَّى له أنْ يُملَأ من بعده! أيام وشهور من الأنين والنحيب… أما مقلة الروح فما جفت مآقيها حتى اليوم”.
في هذه الفترة رَحَل والد الفتى فتح الله عن قرية أَلْوَار، ليصبح إمامًا برهةً من الزمن في قرية “أَرْتُزُو”.
واستقرّ الفتى بمسجد “قُرْشُنْلُو” بمدينة أرضروم في مدرسة كان يُدرِّس فيها سعدي أفندي من قبل، مدرسة صغيرة سقُفها خشب، يقيم فيها خمسة طلاب أو ستة؛ وقد عانى فتح الله كثيرًا، فرغم المشاق التي جابهته إلا أنّه واصل طلب العلم، يحكي عن تلك الفترة فيقول: “كان لدينا موقد غاز، نطهو طعامنا ونأكله في غرفة نومنا؛ كان الطلاب الموسرون يغتسلون عند الحاجة في حمامات “قِريق جَشْمَه”، أمّا الفقراء فأحيانًا كانوا يحصلون على تذاكر مجانيّة، وإلا تجشموا الأمرَّين، وأنا منهم، فكم كنت أغتسل في المراحيض في الشتاء القارس، فتلزق قدماي بالجليد، فأغسل واحدة وأضعها على الأرض ثم أغسل الأخرى، إن أَنْسَ لا أنسى الماء البارد وأنا أصبُّه على رأسي، كنَّا حقًّا في ضنك وضيق”؛ ولهذا اضطر الفتى فتح الله لقبول مكافآت على ختمه القرآن الكريم أثناء دراسته، ولطالما ضاق بهذا الأمر، كان يرى أن ما اضطر لأخذه لاستكمال دراسته وهو شابّ ضرورة، والأصل عدم الجواز؛ فلما عُيّن إمامًا وتقاضى راتبًا ردّ ما أخذه وهو في أرضروم، وأرسله مع أخيه حسبي عندما جاء يزوره.
ويسترعي الانتباه ما ذكره حافظ سعدي قايخان زميل الأستاذ فتح الله عن الحياة في المدرسة بجامع قُرْشُنْلو، يقول:
“التحقت بمدرسة قُرْشُنْلو عام 1953م، كان الأستاذ فتح الله آنذاك طالبًا فيها، فتعرفت عليه، كانت المدرسة يومئذ مهملة، ومن يرعى الطلبة هم قلّة من ذوي الغيرة على الدين؛ لم يكن يُطهَى في المدرسة سوى البطاطس، وكانت كل غرفة تطهو طعامها بنفسها بالتناوب، وكان الأستاذ فتح الله هو من يطهو دائمًا في غرفته، وكان يفتح شهيتي عند كلّ طعام ويقول: “طهوت لك طعامًا، ستأكل من ورائه أصابعك”؛ فنظن أننا سنأكل طعامًا مختلفا هذا اليوم، فإذا بالبطاطس أمامنا مرة أخرى، إلا أنه كان يطهو البطاطس كلّ مرة بطريقةٍ جديدة، يخدم نفسه بنفسه، لم أره قطّ يأمر أحدًا أن يفعل له شيئًا، يخدم الآخرين ويساعدهم ما استطاع.
كان ينتقد ما رسَب لدى العامّة من أخطاء بلا تردد ولا وجَل، لا سيما ما يبالغ فيه من حكايات يحبّ الناس قراءتها وسردها، تجده يفنّدها على الدوام، ويقول: إنها أكاذيب؛ كنا نستغرب مواقفه حينئذ؛ وتمضي السنون وها نحن نوقن أنه كان على حقّ.
لا أعلم أحدًا مثله يحافظ على هيبة العلم؛ كنا إذا حضرت جنازة يلتمس الناس منّا أن نقرأ بشيء من المال، فكنَّا ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر؛ فمعظمنا من الفقراء المعوزين، لكن الأستاذ فتح الله لم يكن ليذهب رغم شدة عوزه، بل كان يحاول منع من يذهب، وأحيانًا كان الجدل يحتدّ ويحتدم في هذه الأثناء حتى لَكَأنَّه شِجار.
ملابسه نظيفة جدًّا، ولا يسمح لأحد باستخدام أغراضه؛ فاهتمامه بأغراضه لا يخفى، فما كنّا نهمله كان هو يعيره اهتمامًا جمًّا؛ وكان إذا رأى شيئًا جديدًا لا يألو في تعلّمه تفصيلًا، وله ميزان حسّاس في التعرف على الناس.
كان هو موجِّه المدرسة حسًّا ومعنًى، ولا أحد يتطلع إلى أن يقارن نفسه به في هذا، فنحن جميعًا أذعنَّا بهذا ولم يفرِضه علينا، كانت مهيبًا تستحوذ هيبته على من حوله وتفرِض عليهم احترامه، لا طاقة له بتحمل الظلم ألبتة، فله موقفه ممن يظلم أيًّا كان الظالم، وكان يحثّنا أيضًا على فعل هذا”.
تلك الشمائل جاء ذكرها في يوميّات الأستاذ حاتم صديق الأستاذ فتح الله، وزاد عليها تواضعَ الأستاذ فتح الله وعنايته البالغة بالنظافة، يقول: “كنّا نحضر الجنائز لنقرأ القرآن بشيء من المال، أما فتح الله فكان يأبى، طلبنا العلم أوَّلًا عند سعدي أفندي حفيد الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه محمد لطفي أفندي، فلما التحق بالجيش تحوّلنا إلى الأستاذ عثمان بَكْتاش؛ فعرّفني والدي على الأستاذ فتح الله منذ أن التحقت بالمدرسة، قال لي: “هذا فتح الله بن رامز أفندي، سيكون عونًا لك”، قال هذا وذهب وكأنه يستودعه إياي؛ فكنت أذهب معه إلى الدروس حتى بعد أن انتقلنا إلى الأستاذ عثمان؛ ولا أتذكر أني أديت صلاة بدونه قطّ، كنت ظلّه الذي لا يفارقه أينما ذهب، كان الأستاذ فتح الله عاكفًا في المدرسة يومئذ، لكنّه لم يكن في عزلة عن العالم الخارجيّ.
كانت النظافة من أبرز شمائل الأستاذ فتح الله أثناء دراسته، فملابسه نظيفة دائمًا، وله فضل عناية بنظافة مسكنه، بينما كاد مفهوم النظافة يكون معدومًا في المدارس يومئذٍ، رأيته مِرارًا يشمر عن ساقيه، وينظف المراحيض، وكان ينظف داخل المدرسة وخارجها جيّدًا، له حسّ مرهف، فهو يشمئز من أدنى شيء، إلا أنّ هذا لم يحُل دون تنظيفه لمراحيض المدرسة.
لم أفارقه أيّام الدراسة حتى رحل إلى “أَدِرْنَه”، وكان يترك المدرسة أحيانًا ويذهب، فكنت أتوسل إليه كثيرًا ليعود، وأحيانًا كنت آتي بسريره دون علمه، فإن لم أقوَ على شيء من هذا حملت سريري ولحقتُ به أينما ذهب؛ كان يعظ هنا وهناك، فأنتظره حتى ينتهي لنعود معًا إلى المدرسة، قضينا أيامًا كلّها ذكريات جميلة، بل لعلّها أجمل أيام حياتي”.
قضى الأستاذ فتح الله فترة في مدرسة مسجد “قُرْشُنْلو” ثم غادرها إلى مدرسة مسجد “كَمْخان” إثر خلاف مع سعدي أفندي، فما انقطع عن طلب العلم رغم كلّ المشاقّ.
في هذه الفترة وقعت واقعة أظهرت مدى الاحترام والأدب ورفاهة الحس لدى ابن الخامسة أو السادسة عشرة: “كانت المدرسة التي أوى إليها مثل مدرسة “قُرْشُنْلو” لا تتسع إلا لخمسة طلاب أو ستّة، فإن طرقهم ضيف لم يتسع المكان للنوم؛ يحكي الأستاذ فتح الله ما حدث معه وهو يحاول أن ينام في مكان ضيّق، يقول: “جئت لأنام فإذا بقدمَيّ بمحاذاة رأس أحد زملائي، فكرهت ذلك؛ إذ إنه لا يليق زميلي، أمَّا الجهة الأخرى ففيها الكتب، ويستحيل أن أمُدّ قدمَيّ تُجاه الكتب، والجهة الثالثة هي جهة القبلة، فليس أمامي سوى الجهة التي إليها قرية قُورُوجُق لأمدّ بها رجلي، فخشيت أن أمدّها ويكون أبي هناك، فأسيءَ بذلك أدب معاملة الوالد؛ فقضيتُ عدة ليالٍ مستيقظا لا أنام؛ وأشير هنا إلى أني لم أمد قدميّ في حياتي تجاه قرية قُورُوجُق مسقط رأس والدي ومثواه، وهذا من معاني احترام الأبوين عندي”.
استمرَّ الأستاذ فتح الله ستة أشهر في تلك المدرسة، واضطر لمغادرتها عندما ضم مؤذن المسجد نصيب المدرسة لبيته، ثم التحق بمدرسة “طاش مسجد”، وسرعان ما غادرها لضيق بعض من فيها به.
واجه الأستاذ في رحلته العلميّة عقبات كثيرة بسبب السَّكن، فعانى أيّما معاناة؛ إذ من المستحيل على شاب عزَب إذ ذاك أن يستأجر منزلًا في أرضروم، ثم عثر على كوخ صغير لحذَّاء التحق بالجيش، فأبرم معه عقدًا، لكنّ الحذّاء نقضه، ويصف الأستاذ فتح الله الموقف فيقول: “وقفت على قارعة الطريق، حقيبتي بيدي، ولا مأوى لي”.
وكان الفرَج في كوخ صغير آيل للسقوط في مسجد الأحمدية بجوار مسجد مُراد باشا، كان المسجد قد أُهمِل، فلا أحدَ يرتاده، وغدا محرابه الذي فيه من التجاويف الكثير مأوى صغيرًا بعد أن قُسّم منذ حين، فبنى الأستاذ فتح الله وزميله “ذو النور” جدارًا، ورفعاه قليلًا، وأحضرا مدفأة صغيرة، وحُلَّت مشكلة المأوى؛ وما زال الأستاذ فتح الله يقيم ههنا أثناء الدراسة حتى لحِق بأدرنه، ورغم تحذير كثيرين لهما من أن جدارهما عُرضة للسقوط في أي لحظة؛ لم يصغيا إلى أحد؛ وأنهى الأستاذ فتح الله دراسته، والكوخ قائم، وظلّ يؤوي كثيرًا من الطلبة أمدًا بعيدًا بعدهما.
مدرسة مراد باشا التي درس فيها الأستاذ فتح الله كولن
ترك الأستاذ فتح الله سعدي أفندي وذهب إلى الأستاذ عثمان بَكْتاش، فدرس عليه قرابة عامين وهو من هو في النحو والصرف، والفقه وأصوله، وغيرها من علوم الشريعة، فمفتي المدينة كان يستدعيه إلى مكتبه ليستشيره كلما عرضت له نازلة. ولما رأى في تلميذه الجِدّ والاجتهاد نقله إلى مستوى أعلى، وقال: لا ينبغي أن نشغلك بهذه الدروس الابتدائيّة، عليك بكتاب الملا جامي[1]، وراح يدرس في هذا المستوى مع من لهم قدَم سبق في العلم والتزكية أمثال الأستاذ محمد قِرْقِنْجي.
كانت علاقته بمدرسته وطيدة غير أنه لم يُغفِل الزوايا بتاتًا، فتربيتها ظاهرة عليه في مراحل حياته كلّها منذ أن بدأ مع الشيخ أَلْوَارْلي أَفَه، ولما توفِّي لحِق بزاوية الشيخ القادري راسم بابا، فعُنِيَ به الشيخ كثيرًا، فراجت إشاعة بأنه سيزوجه ابنته، فترك الزاوية ولم يعاوِد؛ لكنه استقام على آدابها وتربيتها، فالتصوف عنصر رئيس في حياته وفكره، يقول: “اختمرت روحي في الزوايا منذ الصِّغر، وما زال أثر المدرسة والزوايا في حياتي سواءً كَكِفّتَي ميزان”.
وكان يستثمر وقته بعد الدراسة جيِّدًا، فنسيج حياته في منتهى الإحكام، كان يمارس الرياضة؛ فهو نشيط مَرِن؛ واعتاد زيارة مقابر الصالحين بأرضروم في جهمة الليل دائمًا، يقرأ القرآن على الموتى هناك؛ كان فتًى مقدامًا لا يهاب شيئًا، يعود من المقابر في غيهب الغَسق فيمر بأماكن يخاف الناس منها.
وله فضل عناية بملابسه في شبابه، بل هذا دأبه في حياته كلِّها، فكان لباسه نظيفًا أنيقًا رغم الصعوبات، يقول: “كثيرة هي الأيام التي لم أجد فيها طعامًا، لكني لم ألبَس بنطالًا دون كيّ قطّ، ولا حذاءً دون تلميع، وإذا لم أجد مكواة وضعت بنطالي تحت الفراش، فإذا به كالمكوي من الثِّقل؛ وربما يعجب أصدقائي من هذا، ولا يستطيعون أن يوفّقوا بين ملازمتي للزاوية وبين زيادة الاهتمام بملبسي وتَطوافي بنشاط وانفتاح، حتى إن أحد أصدقائي غضب لأني لا ألبس البنطال إلا مكويًّا، وقال لي كلمةً لا أنساها أبدًا: “اتقِ الله يا أخي”، ولم أفهم إلى اليوم ما علاقة التقوى بكيّ البنطال”.
قد حفظ الله للشابّ في فتوته عِقْد الروح الذي نشأ وشبّ فيه، فما خلعه ولا خرج عنه؛ كان في تلك الفترة قد حضر حفل زِفاف مرَّتين: فبينما كان يشاهد في الأولى الثمالى جاءه أحدهم فلطمه وطرده قائلًا: “ماذا تفعل هنا؟!”؛ وفي الثانية لما رجع طرق الباب فلم يسمعه والده مع أنه خفيف النوم، فبات مرغمًا على الانتظار في الثلج حتى الصباح؛ فكانت له في هاتين الواقعتين عبرة، فغدا في شبابه حذِرًا أيّما حذر إزاءَ ما يفتح أمامه بابًا إلى المعاصي.
عرف الفتى فتح الله “رسائل النور”[2] وهو طالب بأرضروم، كان الأستاذ محمد قِرْقِنْجي قد دعاه إلى دروس رسائل النور، يوم أن زار “مظفَّر أَرْسْلان” أرضروم في طريقه إلى سِيواس وأَرْزِنْجان، وكان الأستاذ بديع الزمان سعيد النُّورسي كلّفه بهذه المهمّة: “طوِّفْ في الشرق”؛ أُخِذَ الفتى بما سمعه في أول درس وبمَن حضر أيضًا لا سيما أنّه رأى فيهم حياة الصحابة خاصةً الصِّدق والزهد، فتأثّر كثيرًا بهذا، ولازم الدّرس رغم اعتراض أستاذَيْه سعدي أفندي وعثمان بكتاش، يقول: “كان زهد طلاب رسائل النور يفيض عليّ بمشاعر متنوّعة، علاوة على تعمقهم في العبادات، فصلاتهم ودعاؤهم غير ما عهدتُه من غيرهم”، وبلغت سعادته أوجها عندما أقرأَه الأستاذ النُّوْرسي السلام في إحدى رسائله إلى أرضروم.
كان لرسائل النور وقرَّائِها بالغ الأثر في حياته، ففي ليلة مباركة بمسجد لالَهْ باشا صلَّى العشاء، وحضر دعاء ختم القرآن ألف مرة ومرة[3]، ثم صعد إلى مقصورة المسجد يتضرع ويدعو الله أن يُلْحِقَه بكتائب طلاب النور، يقول: “ما إِن صليت حتى وجدتني قد امتلأت شوقًا ولوعة ولهفًا لا يوصف، تضرعت إلى الله بكل كياني: “اللهم لا ملجأ لي إلا إليك، فتقبلني فيمن تقبّلت من هؤلاء الإخوة، واجعلني منهم، وحبِّب الخِدمة إليّ، لأهب روحي لها، ولا تجعلني بينهم عابر سبيل.” ابتهلت تلك الليلة حتى السّحر، بكيت وجأرتُ وفاضت عيناي حتى الصباح؛ – ما وُفّقتُ الدعاء بمثل هذا الحال في عمري إلا مرة أو مرتين – وما دعوت الله – عز وجل – في ذاك اليوم بغير هذا، وما رغبت إليه بشيء سوى قبول الدعاء”. وفي صبيحة تلك الليلة التقى بزميله في الدراسة الأستاذ حاتم عند باب المسجد، فقصّ عليه الأستاذ حاتم رؤيا رآها بالأمس، وكأنها بشرى بقبول الدعاء، قال: ” رأيت الأستاذ النُّورسي الليلة، وكان يرسل لك رسالة ومعها جرةٌ مملوءة بالجوز”.
ورحل من أرضروم إلى مُدن أَماسْيا وطُوقات وسِيواس عام 1957م ينصح ويعِظ؛ فكانت تلك فرصته للتعرف على أهل الأناضول عن كثَب، ثم عاد إلى أرضروم مرةً أخرى.
[1] كتاب “الفوائد الضيائية” في الصرف والنحو، لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد الأديب الفيلسوف المشهور بــ (الملا جامي) (1414هـ-1492م).
[2] كليات رسائل النور التي ألّفها بديع الزمان سعيد النورسي تضم تسعة أجزاء سجل فيها الأستاذ النورسي كل ما استلهمه من نور القرآن الكريم من معاني الإيمان وأملاها على محبيه في ظروف عسيرة بقصد إنقاذ إيمان الناس في هذا العصر العصيب بإحياء معاني القرآن ومقاصده في النفوس والعقول والأرواح.
[3] عادة سنوية في أرضروم يختم الناس فيها القرآن معًا ألف ختمة وختمة، ثم يدعون عقب تلك الختمات في مسجد جامع بالمدينة.